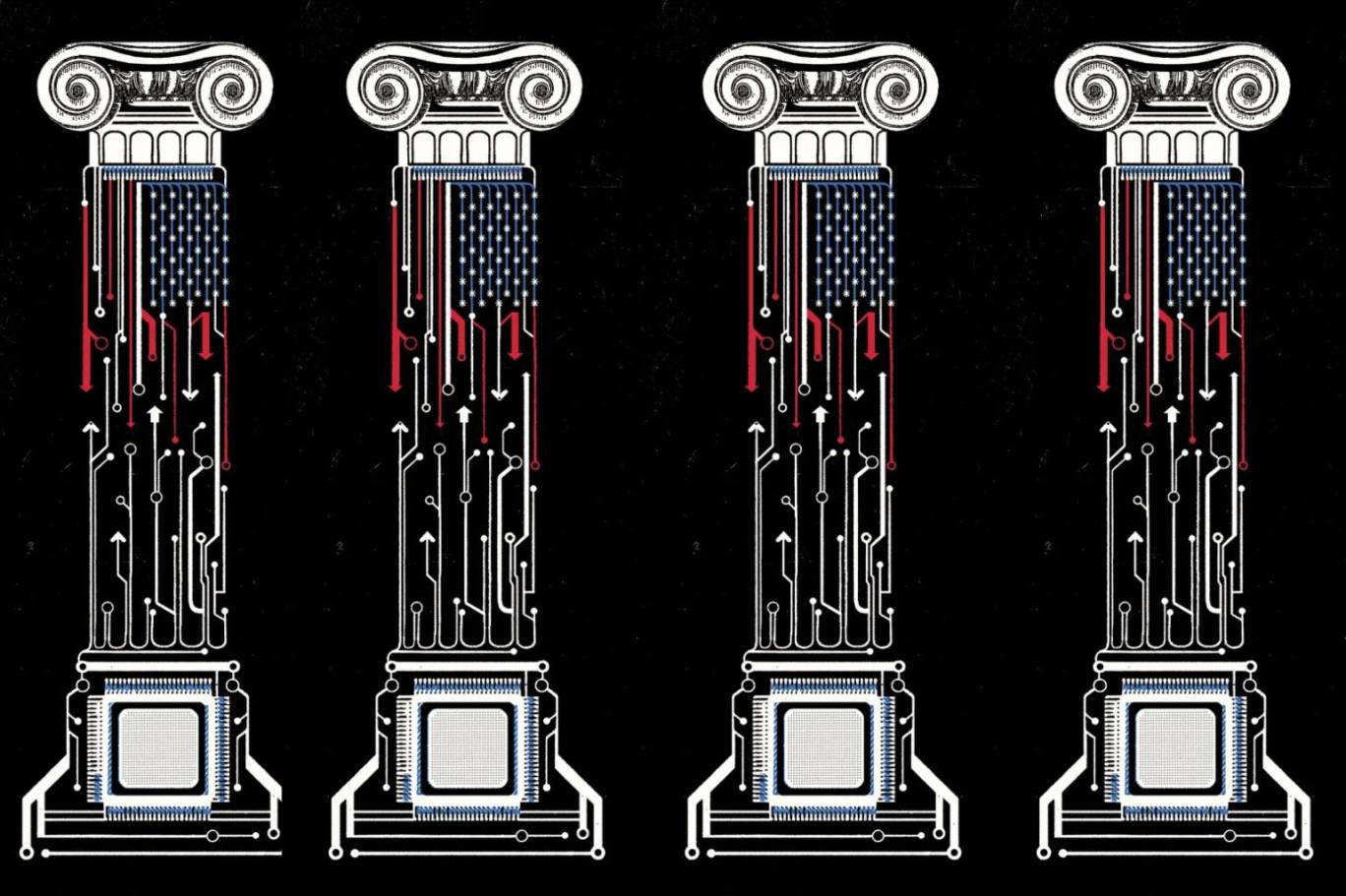ملخص
الحفاظ على ريادة أميركا في الذكاء الاصطناعي يتطلب مقايضة جديدة تقوم على تعاون أعمق بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان توفير الطاقة والمواهب والحماية الأمنية، ومواجهة التقدم الصيني، وتجنّب الأخطار المتصاعدة التي قد تهدد الاقتصاد والأمن العالميين.
قد يظهر تفوق الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي كأنه لا يُضاهى. وتتصدر شركات أميركية مثل "آنثروبيك" Anthropic و"غوغل" و"أوبن إيه آي" OpenAI و"إكس إيه آي" xAI، غالبية تقييمات القدرات التكنولوجية العامة، في معظم الدول. وتتفوق نماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية على علماء يحملون درجة الدكتوراه في تحديات تشمل الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا. وتبلغ قيمة حفنة من الشركات الكبرى للرقاقات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، ما يفوق قيمة سوق الأسهم الصينية بأكمله. ويوجه مستثمرون من أرجاء العالم مصادر متزايدة إلى منظومة الذكاء الاصطناعي الأميركية.
هذا التقدم السريع هو، في كثير من النواحي، شهادة على قوة النموذج الأميركي لتطوير الذكاء الاصطناعي الذي هيمن خلال العقد الماضي، والمتمثل في ترك القطاع الخاص يعمل بمفرده مع تدخل حكومي مباشر محدود للغاية في التمويل أو الإدارة. هذا النهج يختلف تماماً عن الأساليب التي أدت إلى ظهور تقنيات ثورية سابقة، مثل الأسلحة النووية والطاقة النووية، السفر إلى الفضاء، أنظمة التخفي، الحوسبة الشخصية، والإنترنت، والتي نشأت إما مباشرة من جهود الحكومة الأميركية أو بدعم عام كبير. ويضرب الذكاء الاصطناعي جذوره في علوم مولتها الحكومة، تشمل الحوسبة الشخصية والإنترنت، ويستفيد أيضاً من بحوث جارية تتلقى تمويلاً حكومياً. وفي المقابل، جرى تطوير الذكاء الاصطناعي وتوسيعه كنشاط ينهض به القطاع الخاص بصورة أساسية.
ولكن، ثمة سبب للتفكير بأن الطريقة الأميركية في تطوير الذكاء الاصطناعي تقترب من الوصول إلى حدودها القصوى التي ستنكشف بجلاء متزايد خلال الأشهر والأعوام الآتية، وستبدأ في تقويض - وربما إنهاء - هيمنة الولايات المتحدة. وفي نهاية المطاف، ستضع الولايات المتحدة في موقف غير مؤاتٍ أمام الصين، التي تتبع نهجاً مختلفاً في سباق الذكاء الاصطناعي.
وتوخياً لتجنب هذا المآل، تحتاج واشنطن إلى احتضان طرق جديدة للتقدم في تطوير الذكاء الاصطناعي، تتطلب ممارسة تعاون متبادل أقوى بين الدولة والقطاع الخاص. والآن، يعتمد التقدم في التطور على مصادر وقدرات ليس بالمُستطاع توفيرها أو تسهيل الحصول عليها إلا من الحكومة. ويشمل ذلك الطاقة اللازمة لمراكز البيانات المتزايدة الضخامة، وخط إمداد مستمر من المواهب العالمية، ودفاعات فاعلة للتصدي للجهود الأجنبية المتطورة في التجسس. ومن ناحيتها، تحتاج الحكومة الأميركية إلى التعاون مع القطاع الخاص في إدماج الذكاء الاصطناعي ضمن جهاز الأمن الوطني، إضافة إلى التثبت من عدم تسبب التكنولوجيا في زعزعة الديمقراطية عبر العالم.
وبكلمات أخرى، يحتاج النموذج الأميركي في الذكاء الاصطناعي إلى الاستناد بسلاسة على مقايضة كبرى بين صناعة التكنولوجيا والحكومة الأميركية. وتستطيع الدولة مساعدة القطاع الخاص على النمو بطريقة تدفع بمصالح كليهما إلى الأمام.
توسيع الحدود القصوى
من السهل فهم سبب نجاح النهج الأميركي القائم على التدخل المحدود في الذكاء الاصطناعي حتى الآن. فالتقنيات الثورية السابقة، مثل الأسلحة النووية ورحلات الفضاء، لم تكن لها تطبيقات تجارية فورية. أما الذكاء الاصطناعي الحديث، فله جدوى تجارية قوية للغاية. فقد وجدت شركات الذكاء الاصطناعي طلباً هائلاً من المستخدمين، مما أدى إلى ارتفاع الإيرادات بصورة كبيرة، ووعدت بأتمتة كثير من المهمات القيّمة، مثل البرمجة. ونتيجة لذلك، تمول أسواق رأس المال مشاريع الذكاء الاصطناعي بمستويات كانت تتطلب تاريخياً موارد حكومية. علاوة على ذلك، فإن الطبيعة المعتمدة على الحوسبة للذكاء الاصطناعي الحديث تجعله يستفيد من بنية الحوسبة السحابية التي أتقنها القطاع الخاص، وليس الحكومة.
إن كفاية رأس المال الخاص في تمكين تقدم الذكاء الاصطناعي أمر رائع لدافعي الضرائب، لكن حدود هذا النهج بدأت تظهر. لفهم السبب، انظر إلى البنية التحتية. الأساطيل الضخمة من الرقائق المطلوبة لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي اليوم تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة، لذلك ستحتاج الشركات الأميركية إلى مزيد من الكهرباء لتشغيل مراكز البيانات التي تخطط لبنائها في الأعوام المقبلة. تشير تقديرات شركة "أنثروبيك" إلى أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى إنتاج 50 غيغاواط من الطاقة الجديدة بحلول عام 2028 فقط لتلبية حاجات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعادل تقريباً استهلاك دولة الأرجنتين بأكملها اليوم. وبحلول ذلك الوقت، قد تستهلك مراكز البيانات ما يصل إلى 12 في المئة من إنتاج الكهرباء الأميركية. من دون مزيد من الكهرباء، سيتوقف التوسع في الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، وصف الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، آندي جاسي، الطاقة بأنها "أكبر قيد منفرد" أمام تقدم الذكاء الاصطناعي. وبناء هذا المستوى من البنية التحتية الجديدة سيتطلب مساعدة حكومية.
ولمدة طويلة، لم تفعل واشنطن سوى القليل في إضافة طاقة جديدة إلى شبكاتها الكهربائية. وبين عامي 2005 و2020، أضافت الولايات المتحدة ما يقارب الصفر في صافي الطاقة الجديدة إلى شبكاتها. وبعد تسلم الرئيس جو بايدن المكتب البيضاوي عام 2021، جرى تمرير قانون بتقديم تمويل حكومي لبناء بنية تحتية للطاقة البديلة، مما أتاح إضافة أكثر من مئة غيغاواط من الكهرباء إلى ما تملكه البلاد من الطاقة. وفي الأيام الأخيرة من ولايته، وقع بايدن أمراً تنفيذياً هدف بالتحديد إلى زيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ومنشآت الطاقة الجديدة.
لكن خلفه، دونالد ترمب، على رغم تصريحاته الإيجابية في شأن بناء بنية تحتية للطاقة من أجل الذكاء الاصطناعي، لم يحقق ذلك فعلياً. فقد وقع أمراً تنفيذياً يوجه بتسريع التصاريح الفيدرالية لمراكز البيانات، لكن التنفيذ لا يزال في أطواره الأولى. والأسوأ من ذلك، أن مشروعه التشريعي الكبير المسمى "قانون واحد كبير وجميل" الذي أُقر في يوليو (تموز)، إلى جانب إجراءات تنفيذية أخرى، أطاح أجزاء رئيسة من جهود بايدن لتوسيع الطاقة، مثل مشاريع حيوية في نقل الطاقة. ما كان يمكن أن يمثل مساحة نجاح مشتركة للحزبين بات ضحية للسياسة وأصبح الآن مصدر قلق كبيراً للأعمال التجارية وتنافسية الذكاء الاصطناعي.
ثمة أسباب للاعتقاد بأن الطريقة الأميركية في تطوير الذكاء الاصطناعي تقترب من حدودها القصوى
وإذا أُحسن تنفيذها، فإن حدوث طفرة في الطاقة يقودها الذكاء الاصطناعي، قد تحمل مكاسب تتجاوز تطوير تلك التقنية الذكية بحد ذاتها. وتنفق الشركات الريادية في الذكاء الاصطناعي مئات بلايين الدولارات على منشآت البنية التحتية، مما يخلق فرصاً للتوظيف. وفي ذلك المسار، تبدي الشركات التزاماً بعمليات خالية من الكربون، وقد أظهرت رغبة في شراء الطاقة النظيفة بأسعار أعلى. ومن شأن تلك الاستثمارات المكثفة تسريع التطوير المحلي لمصادر أفضل في الطاقة، يلقى بعضها استحساناً من الحزبين على غرار الطاقة الحرارية الجوفية والجيل الثاني من المنشآت النووية. وكذلك قد تحفز النماذج القوية للذكاء الاصطناعي على تسريع البحوث المتعلقة بالمناخ.
وإذا لم تُنشئ الولايات المتحدة مزيداً من القدرات في الطاقة، ستشعر شركات الذكاء الاصطناعي الأميركي بضغوط قد تدفعها إلى تعهيد عمليات تطوير المنشآت الاستراتيجية المحورية إلى، في الأرجح، مناطق غنية بالنفط كالخليج. بالنسبة إلى واشنطن، يجدر أن يؤدي أي احتمال لتعهيد عمليات الذكاء الاصطناعي، إلى قرع أجراس الإنذار. إن نقل شركة أميركية ما التدريب المتقدم في الذكاء الاصطناعي إلى دولة أجنبية، سيولد أخطاراً هائلة بالترافق مع شروع الذكاء الاصطناعي في تقوية الاقتصاد الأميركي وأداء دور أساس في القوة العسكرية الأميركية. وإذا غدت دولة مضيفة غير مرتاحة للسلوك الأميركي، فقد تعاقب واشنطن بسهولة. ومن ثم، سيوصل الفشل في بناء قدرات محلية للطاقة إلى تكرار الأخطاء التي رافقت عمليات التعهيد إبان عقود ماضية في صناعات مهمة أخرى، على غرار أشباه الموصلات التي أضحت الولايات المتحدة معتمدة فيها الآن على مزودين أجانب.
وتحوز الولايات المتحدة على التكنولوجيا والقدرة الصناعية اللازمتين لبناء منشآت طاقة جديدة. لكنها لا تزال مثبطة بسبب شبكة من اللوائح الحكومية والمرافق وبسبب التأخيرات الإجرائية—بعضها له مبررات جيدة، وبعضها لا. تفرض هذه القيود تأخيرات ضخمة في عملية الربط (أي توصيل مصدر طاقة جديد أو مركز بيانات بالشبكة) وتتطلب تقييمات بيئية تستغرق أعواماً. إضافة إلى العقبات الفيدرالية والمرافق، يمكن أن تكون السياسات المحلية وخريطة الولاءات مرهقة، خاصة للمشاريع التي تعبر عدة ولايات، مثل خطوط نقل الطاقة. يجب أن تتحمل الشركات، وليس المواطنين العاديين، كلفة بناء الطاقة، لكن السياسات الحكومية يجب أن تسعى إلى تسهيل تنفيذ الشركات لتلك المشاريع ضمن جداول زمنية معقولة.
البنية التحتية ليست المجال الوحيد الذي تعوق فيه سياسات أميركا تقدّم قطاع الذكاء الاصطناعي. فهذا القطاع لا يقوم على التكنولوجيا وقوة الحوسبة وحدهما، بل يعتمد أيضاً على العقول التي تطوره. لهذا سارع بايدن إلى تسهيل وصول أصحاب المهارات التقنية العالية إلى الولايات المتحدة، عبر إعطاء الأولوية لتأشيرات مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وتحديث معايير القبول لفتح الباب أمام العلماء البارزين.
وفي ذلك المضمار أيضاً، ذهب ترمب أحياناً إلى قول أشياء سديدة لكنه قصُر غالباً عن تحقيقها. وأثناء حملته للانتخابات الرئاسية 2024، أعلن أن الأجانب الذين يتخرجون من كليات الولايات المتحدة سينالون "تلقائياً" الإقامة الدائمة المعروفة بالبطاقة الخضراء. وبدلاً من ذلك، شرعت الولايات تحت قيادته في نبذ العمال والطلبة الأجانب، وتثير قلق حتى من لديهم تأشيرات ويوجدون قانونياً في البلاد. في سبتمبر (أيلول) 2025، ذهبت إدارة ترمب إلى حد التصريح بأنها قد تفرض ضريبة مئة ألف دولار على طلبات التأشيرات من نوع "آتش 1- بي" التي تُعطى غالباً للمهاجرين المتملكين لمهارات متقدمة. وبالفعل، بدأت تلك الأفعال بتوليد تأثيرات سلبية. ومثلاً، يشي بحث أجرته مؤسسة "نافسا" NAFSA، وهي رابطة غير ربحية للمعلمين الدوليين، أنه في عام 2025، ستعاني الجامعات الأميركية نقصاً في التسجيل العالمي للطلاب لديها يراوح ما بين 30 في المئة و40 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وإذا قطعت واشنطن نفسها عن العلماء المولودين في الخارج أو دفعتهم للعودة إلى بلدانهم، فستكون العواقب كارثية. وفي شطر كبير منه، يرجع تصدر الولايات المتحدة سباق الذكاء الاصطناعي إلى قدرتها على اجتذاب خبراء من أصقاع العالم. ووفق دراسة نهضت بها "جامعة جورج تاون" تناولت بحوث الذكاء الاصطناعي بين عامي 2010 و2021، أن 70 في المئة من الباحثين الأميركيين الأكثر تفوقاً، قد وُلدوا في الخارج. وفي 65 في المئة من الشركات الريادية للذكاء الاصطناعي المستقرة في الولايات المتحدة، وفق تصنيف مجلة "فوربيس"، هناك مهاجر واحد ضمن مؤسسي تلك الشركات. وقبل الولاية الحالية للرئيس ترمب، استُقطب من الخارج قرابة 70 في المئة من الطلبة المُسجلين لنيل درجات تخرج أميركية في الذكاء الاصطناعي. وتاريخياً، مالت غالبية أولئك الطلبة إلى البقاء في الولايات المتحدة، وقدموا إسهامات محورية حساسة للأكاديميا والصناعة الأميركيتين. ولكن، بفضل سياسات ترمب، ربما يعود كثير من أولئك الطلاب إلى بلدانهم، بدل بقائهم في الولايات المتحدة. وقد يتوجه بعضهم إلى الصين التي التقطت فرصة سانحة لتوظيف خبراء الذكاء الاصطناعي، مع ما يحمله ذلك من تحد محمل بالدلالات بالنسبة إلى المصالح الأميركية.
التحدي الصيني
لا تقتصر حماية القيادة الأميركية للذكاء الاصطناعي على التفاخر المحض، بل تمثل أمراً أساساً للأمن القومي للولايات المتحدة وقدرتها على المنافسة الاقتصادية. ولقد نجحت الصين في تحقيق إنجازات في تطوير الذكاء الاصطناعي، على رغم أن أياً من شركاتها لم تصل حتى الآن إلى حد التساوي مع نظيراتها الأميركية، فإنها لا تفتقد الموهبة التقنية في ذلك المضمار.
غير أن بكين تواجه نقطة ضعف حاسمة: عجزها عن تصنيع كميات كبيرة من الرقائق المتقدمة اللازمة للذكاء الاصطناعي، وهي فجوة زادتها القيود الأميركية التي بدأت في عهد ترمب الأول ووسعها بايدن. لكن بعد ضغوط قوية من أقطاب الصناعة، بدأت إدارة ترمب الثانية في تفكيك هذا الإجماع الحزبي. ففي يوليو، ألغت قرارها السابق (العائد لأبريل/نيسان) بقطع وصول الصين إلى أحدث الرقائق، وأشار ترمب إلى نيته إلغاء قيود أخرى وضعتها إدارة بايدن. وهذه الخطوات ستسرع بلا شك وتيرة التقدم الصيني.
وفي الوقت نفسه، تحركت بكين بقوة لضمان أنه في حال نجاحها في تحقيق الوصول إلى ذلك النوع من الرقاقات، فإن منظومتها في الذكاء الاصطناعي ستتفوق على نظيرتها في الولايات المتحدة، وتحل بديلاً منها. ولنفكر ما يحصل في الطاقة التي ضخت فيها الصين استثمارات استثنائية لمصلحة محطات الكهرباء، ووسائط تخزين الطاقة ونقلها. وبالنتيجة، تنتج الصين الآن ما يفوق ضعفي إنتاج الكهرباء في الولايات المتحدة، وتستمر بتوسيع موقعها القيادي في ذلك المضمار. وفي بضعة أشهر، أضافت الصين ما يزيد على 90 غيغاواط من قدرات الطاقة الجديدة والنظيفة، ما يربو على ضعفي كميات الطاقة التي تحتاج إليها شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية لأعوام مقبلة.
كذلك كسبت بكين تفوقاً عبر إدماج صناعتها في الذكاء الاصطناعي مع جهاز الأمن القومي. ولقد ذكرت وزارة الحرب الأميركية أن الشركات الكبرى في صناعة الذكاء الاصطناعي، على غرار "تينسنت" Tencent، تشكل أعمدة محورية في استراتيجية الصين لإدماج القطاعين المدني والعسكري. وتحوز أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تنتجها تلك الشركات استخدامات نفعية واسعة في الوكالات العسكرية والاستخباراتية. ويرجع ذلك إلى أنها تدعم تطوير الأسلحة والعمليات السيبرانية والرقابة والتتبع المحليين ومهمات كثيرة أخرى. وقد بادلت الحكومة الصينية ذلك بأنها قدمت لشركات التكنولوجيا دعماً واسعاً في السياسة والأمن. وتاريخياً، شمل ذلك الدعم تقديم خدمات عسكرية وتمرير الأسرار العسكرية المسروقة من مؤسسات الأعمال الأميركية.
وكذلك قد تفضي خسارة أميركا لموقعها القيادي في الذكاء الاصطناعي لمصلحة الصين، إلى حدوث أذى عالمي فائق الضخامة. واليوم، يستفيد المستهلكون عبر العالم من دقة وشفافية التشريعات التنظيمية الأميركية ووضعيتها المعيارية التي جرى تطوير غالبيتها بالتناغم مع ديمقراطيات أخرى، وتشمل قطاعات تكنولوجية عدة. ومثلاً، استلزمت تقنيات جديدة عدة كأدوات شحن المركبات الكهربائية، حدوث تعاون عالمي في اعتماد المعايير. وسوف يتطلب الذكاء الاصطناعي شراكات مماثلة، ومن مصلحة واشنطن أن تمسك بزمام القيادة في ذلك. وإذا سار الأمر بطرق مغايرة، فثمة خطر بأن تعمد النُظُم الأوتوقراطية إلى وضع معايير خاصة بها. وإذا لم تتوصل واشنطن إلى إرساء علاقات أفضل وأكثر مع قطاعها في الذكاء الاصطناعي وتضمن الحفاظ على ريادتها العالمية في تلك التقنية، فحينئذٍ قد يتولى جهاز الأمن الوطني الصيني مهمة تشكيل معايير عالمية بما يتوافق مع قوانين الرقابة الصينية.
معادلة الأخذ والعطاء
إن الشراكات القوية بين شركات الذكاء الاصطناعي ووكالات الأمن الوطني الأميركية قليلة، وما أُرسي منها يعيش مراحله المبكرة. وللتعامل مع هذا النقص، تحتاج الحكومة إلى فهم أفضل لماهية الذكاء الاصطناعي وكيفية عمله. وتستطيع الحكومة مساعدة الصناعات الأميركية، لكن في قطاعات تفهمها بعمق، ولا تندرج صناعة الذكاء الاصطناعي اليوم ضمنها. وأثناء عملنا في الحكومة، عملنا مع بعض المسؤولين الحكوميين ممن لديهم تمرس قوي في التكنولوجيا، ومسؤولين عسكريين يقودون عملية تغيير في العمل الإداري. ولقد وظفت إدارة بايدن مئات من خبراء الذكاء الاصطناعي كي تعزز صفوفها بهم، ولكن كثيراً منهم طُردوا أو تركوا الحكومة أثناء الأشهر الأخيرة، بمن فيهم بعض الطواقم المتقدمة تقنياً. وعلى واشنطن أن توقف هذا النزف وتستعيد قدرتها على جذب الكفاءات.
وفي المقابل، على قادة الصناعة أن يساعدوا المسؤولين الأميركيين على فهم عملهم وأن يستجيبوا لحاجات واشنطن. وعلى رغم تردد وادي السيليكون في التعاون بسبب البيروقراطية الحكومية وبطء عمل المؤسسات، لكن يجب على المديرين التنفيذيين تذكر أن التعاون بين الصناعة وواشنطن يعمل لمصلحة الجميع في الغالب. ولقد تعاونت إدارة الرئيس فرانكلين روزفلت مع شركة "فورد موتور" في خضم الحرب العالمية الثانية لإنتاج القاذفة الثقيلة "بي -24 ليبرايتور"، مما عاد على "فورد" بالأرباح، فيما نال الجيش طائرة احتاج إليها بشدة. ولم يولد "مشروع مانهاتن" إلا عبر تعاون مع شركات "دي بونت" و"جنرال إلكتريك" و"كرايسلر" وغيرها من المؤسسات الموثوقة الولاء. واستفادت تلك الأطراف الصناعية كلها عبر مد يد المساعدة. وعلى نحوٍ مماثل من التعاون المشترك بين الحكومة والشركات، سار ابتكار وتحسين الرادار والأقمار الاصطناعية والطائرات النفاثة والرقاقات الإلكترونية والإنترنت.
وثمة مساحة واحدة حساسة وحيوية تستطيع الحكومة مساعدة الشركات فيها، تتمثل في المُساندة الأمنية. ويعود ذلك إلى أن الذكاء الاصطناعي بات أساساً في الأمن الوطني، تعمل وكالات الاستخبارات الأجنبية على مسارعة الخطى في سرقة ابتكارات الشركات الأميركية في الذكاء الاصطناعي. ومثلاً، في مارس (آذار) 2024، دانت وزارة العدل الأميركية أحد مهندسي البرمجيات في "غوغل"، يُدعى لينواي دينغ، بدعوى أنه يمرر إلى الصين تصاميم رقاقات الذكاء الاصطناعي التي تصنعها "غوغل". وكذلك جهدت بكين بمشقة بغية تهريب منتجات تكنولوجية أميركية متقدمة على غرار رقاقات الذكاء الاصطناعي.
الجواسيس الصينيون سيحاولون انتزاع أي أسرار متعلقة بالذكاء الاصطناعي من الشركات الأميركية، لكن تركيزهم الأكبر سيكون على سرقة "أوزان النماذج" - الأرقام التي تشفر النموذج بعد تدريبه. هذه الخطوة تتيح للشركات الصينية تجنب كلف التدريب وتقليص الوقت اللازم لتطوير النماذج. فعلى سبيل المثال، تعمل شركات الذكاء الاصطناعي بجد لاكتشاف حيل خوارزمية تمكنها من استخدام قدراتها الحاسوبية بكفاءة أكبر، وهو أمر بالغ الأهمية للصين التي تواجه قيوداً شديدة في القدرة الحاسوبية. هذه المزايا أقل حماية بكثير من الأسرار الجوهرية في العصور السابقة، مثل الحقبة النووية أو عصر الفضاء، لأن الحكومة الأميركية لم تشارك بصورة كبيرة في تطويرها.
إذا قطعت واشنطن نفسها عن العلماء المولودين في الخارج أو دفعتهم للعودة إلى بلدانهم، فستكون العواقب كارثية
وتتحمل شركات الذكاء الاصطناعي المسؤولية الأولى في الدفاع عن شبكاتها ومنظماتها. وعلى رغم الخسارة القريبة زمنياً للخبرات فإن الحكومة الأميركية تملك قدرات في الدفاع السيبراني لا تستطيع الشركات مضاهاتها. لذا، يجب على الحكومة تقديم معونة وزانة كتلك التي تُعطى حاضراً لشركات الصناعات العسكرية وتلك المنخرطة في قطاعات البنى التحتية. وقد تشمل تلك المعونة معلومات استخباراتية عن محاولات الاختراق الأجنبية، وتقديم دعم للتمحيص الدقيق في المواهب الدولية، والتوجيه في شأن إجراءات الأمن. ويفترض بالشركات التي تعمل مباشرة مع الحكومة الأميركية في مجال الأمن القومي، أن تستوفي معايير صارمة في ذلك المجال، بالتساوي مع ما يحصل مع الشركات الخاصة المتعاقدة مع وزارة الحرب.
وسعياً إلى التوازن بين طرفي المقايضة، يجب على شركات الذكاء الاصطناعي مساعدة الولايات المتحدة في إدماج التقنيات الجديدة ضمن جهاز الأمن الوطني. ولطالما شكل غياب ذلك الإدماج نقطة ضعف لواشنطن. وربما تقود الشركات الأميركية العالم في ابتكارات الذكاء الاصطناعي، لكن، من دون ذلك التعاون، قد تتراجع منزلة أميركا في مجال تبني الذكاء الاصطناعي لأهداف عسكرية، مما قد يسبب أذىً هائلاً أثناء الصراعات. وفي غير مرة، أثبت التاريخ العسكري أن الدول التي تفشل في إدماج التكنولوجيات المستجدة ضمن قواتها المسلحة تؤول إلى الوقوع في معاناة كبرى. ومثلاً، ابتكرت فرنسا والمملكة المتحدة الدبابات أثناء الحرب العالمية الأولى، لكنهما دفعتا ثمناً قاسياً حينما سبقهم الألمان في التمرس باستعمالها في تعزيز الهجمات الخاطفة للمشاة الميكانيكية، سُميت "بليتزكريغ"، في الحرب العالمية الثانية. وللوقاية من تكرار ذلك المآل، يفترض بوزارة الحرب شراء الأنظمة الأكثر تقدماً في الذكاء الاصطناعي واستخدامها، مع تلقي توجيه عملي مباشر من الخبراء التقنيين في الشركات لإنجاز ذلك بفاعلية.
وفي أكتوبر 2024، وضع بايدن مخططاً عاماً عن الكيفية المحتملة في عمل ذلك التعاون، حينما وقع مذكرة رئاسية عن الأمن الوطني فيها توجيه للحكومة بزيادة استعمال الذكاء الاصطناعي لأغراض الأمن الوطني. وتضمنت المذكرة تحوطات وقائية صارمة تضمن عدم إساءة استخدام تلك التقنية في مجال حقوق الإنسان، والرقابة المحلية وغيرها من النشاطات اللاأخلاقية. وتعتبر تلك الوقايات أساسية للحصول على ثقة الجمهور العام ومُطوري الذكاء الاصطناعي في القطاع الخاص. وعلى عكس كثير من إجراءات بايدن التنفيذية، لم يقم ترمب بإلغائها حتى الآن، لكنه لم يحرز تقدماً يُذكر في تنفيذ بنودها المهمة، بل أقال بعض الخبراء غير السياسيين الذين كانوا ضروريين لتطبيقها.
وفيما تعمل الحكومة والقطاع على تطوير شراكتهما في الأمن الوطني، تحتاجان أيضاً إلى إيلاء انتباه خاص لكيفية عمل الذكاء الاصطناعي على حل مشكلات ملحة في تنافس واشنطن مع بكين. هناك، على سبيل المثال، طرق كثيرة يمكن للولايات المتحدة أن تستخدم فيها الذكاء الاصطناعي في العمليات السيبرانية، كما أظهر تحدي "الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني" الذي أجرته وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة. الدولة التي تدمج الذكاء الاصطناعي بسرعة وفاعلية في المجال السيبراني ستكون أكثر قدرة على حماية شبكاتها واختراق شبكات الآخرين، مما يمنحها ميزة استخباراتية هائلة. يمكن للذكاء الاصطناعي أيضاً تحسين قدرات واشنطن في مجالات أمنية أخرى، مثل الاستخبارات الجغرافية واستخبارات الإشارات واللوجستيات وتصميم الأسلحة. لكن لن يحدث شيء من ذلك من دون توجيه واضح من الحكومة ومشاركة فعالة من شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية.
خطر فائق الغرابة
ثمة سبب أخير يدعو الحكومة الأميركية والشركات الريادية في الذكاء الاصطناعي إلى إرساء علاقات متزايدة المتانة، يتمثل في وجوب تعاونهما معاً في تقييم إيجابيات وأخطار المقايضة ومُكوناتها. وفي عالم التكنولوجيا، ينعقد شبه إجماع على أن الذكاء الاصطناعي يمنح منافع هائلة للإنسانية تشمل شفاء أمراض وتطوير تقنيات نظيفة والتخلص من العمل الرتيب، إلا أنه قد يتسبب بأضرار هائلة. وتضم قائمة الأخطار، استخدام دول استبدادية للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل النظام الدولي. ومن المستطاع تفادي ذلك الأخير عبر حفظ وتوسيع قيادة أميركا للذكاء الاصطناعي، على حساب منافسيها. وثمة أخطار أخرى أشد خفاءً ومُكراً. مثلاً، يعتقد عدد من أرفع مفكري الذكاء الاصطناعي بأنه من المحتمل تماماً أن يتوصل مستخدم خبيث بمفرده إلى تسخير نموذج قوي من الذكاء الاصطناعي لتركيب عنصر مرضي مُعدٍ جديد. ومن المخاوف الأخرى أنه حتى مع حصره بأيد خيرة، ربما تتسبب خوارزميات الذكاء الاصطناعي بحوادث كوارثية عبر نهوضها بأفعال لم يقصدها مبتكروها. ويضاف إلى ذلك، حدوث أخطار أقل خيالية لكنها مؤلمة تماماً، على غرار البطالة الواسعة، والتركيز الفائق للسلطة الاقتصادية، والتمييز في قطاعات عدة كالرعاية الصحية بسبب الانحيازات في نماذج الذكاء الاصطناعي والبيانات المستخدمة في تدريبه.
من منظور السياسات، أي من هذه السيناريوهات سيشكل تحدياً تاريخياً ويفرض مقايضات صعبة. ففي عالم افتراضي يمكن فيه لمستخدم واحد للذكاء الاصطناعي إحداث ضرر كارثي، ستضطر الحكومة إلى التفكير في فرض لوائح شاملة على تطوير واستخدام الأنظمة المتقدمة، حتى لو أدى ذلك إلى إبطاء الابتكار. وإذا أدى الذكاء الاصطناعي إلى أتمتة جزء كبير من الأعمال البشرية، فقد تضطر الحكومة إلى إنفاق مبالغ ضخمة لإعادة تدريب القوى العاملة، أو ربما تسهيل إعادة هيكلة الاقتصاد. وبالنظر إلى سرعة تقدم الذكاء الاصطناعي، سيتعين على صانعي السياسات اتخاذ هذه القرارات المصيرية في جداول زمنية ضيقة للغاية - وكل ذلك في شأن تقنية لا تخترعها الحكومة وتعرف عنها القليل بصورة مقلقة.
تعميق التعاون بين القطاعين العام والخاص، وكذلك مع المجتمع المدني، لا يضمن أن تتخذ الدولة القرارات الصحيحة، لكنه يمنح واشنطن فرصة حقيقية لتحقيق نتائج إيجابية. فبفضل قاعدة تقنية أقوى، يمكن للمسؤولين فهم مدى التزام أنظمة الذكاء الاصطناعي بالتعليمات، وكيفية تعاملها مع المهمات الخطرة، والمجالات التي يمكن أن تحل فيها محل العمل البشري، ومدى ميلها للهجوم أو الدفاع في مجالات الأمن والسلامة.
إن إنشاء مركز "معايير وابتكار الذكاء الاصطناعي" في وزارة التجارة (الذي تأسس كمعهد سلامة الذكاء الاصطناعي في عهد إدارة بايدن) يمثل خطوة أولى مهمة لبناء تعاون فعّال. فمنذ تأسيسه، جمع المركز المسؤولين الحكوميين والشركات للتعاون في قضايا السلامة، وأسهم في تطوير آليات اختبار قياسية للذكاء الاصطناعي. وعمل مع وكالات أخرى ذات خبرة متخصصة لإجراء اختبارات إضافية طوعية في مواضيع حساسة، مثل التعاون مع وزارة الطاقة وشركة "أنثروبيك" لتقييم ما إذا كانت نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة تمتلك معرفة خطرة حول الأسلحة النووية. وقد حظي المركز بدور بارز في خطة ترمب للذكاء الاصطناعي، ويجب على الإدارة تمكينه من مواصلة التعاون الطوعي مع الشركات، ووضع المعايير، وإجراء اختبارات السلامة.
وبفضل عمل ذلك المركز والالتزامات الطوعية التي أعطتها الشركات الريادية في الذكاء الاصطناعي لبايدن في البيت الأبيض، تعهدت شركات الذكاء الاصطناعي بإجراء اختبارات سلامة مستقلة على نماذجها، بالاستناد غالباً إلى توجيهات المركز. وفي بعض الحالات، وافقت الشركات على إعطاء المركز نفاذاً إلى أنظمتها الجديدة قبل إطلاقها في الأسواق، وأشادت مُقابلة الحكومة تلك الخطوة بتقديمه خبرات في الأمن الوطني تتعلق بالمجالات المحددة لأعمالها. وتالياً، يجب على الطرفين تعميق ذلك التعاون، وتخصيص وقت أطول، مع ما يلزم من المصادر، للتوصل إلى إجراء تقييمات متشددة على النماذج الجديدة.
الحكومة موجودة لتساعد
غالباً ما تبدو "المقايضات الكبرى" شعارات جذابة أكثر من كونها سياسات عملية، والحصول على الصفقة الصحيحة في مجال الذكاء الاصطناعي ليس بالأمر السهل. فالتكنولوجيا تتطور بسرعة على مسار غير متوقع. ومع تحسن الذكاء الاصطناعي، ستزداد الحاجة إلى بنية تحتية وطاقة وأموال ضخمة، وستتعاظم الحاجة إلى تعزيز الأمن ضد تهديدات الاستخبارات الأجنبية، وسيتزايد الإلحاح للتعاون مع المنظومة الدفاعية. وستتصاعد أخطار سوء الاستخدام، مما يفرض مقايضات سياسية جديدة. ستظهر شركات ناشئة جديدة، وقد تتراجع شركات كبرى تبدو اليوم لا تقهر. يجب على جميع الأطراف الاستعداد لإعادة التفاوض وإعادة التوازن باستمرار، فيما سيضطر المسؤولون الأميركيون إلى البقاء مرنين وتجربة سياسات مختلفة مع مرور الوقت.
لكن وسط عدم اليقين هذا، من الضروري أن تلعب واشنطن دوراً أكثر نشاطاً في تمكين وتشكيل منظومة الذكاء الاصطناعي الأميركية. لا حاجة لأن يتطور الذكاء الاصطناعي كما تطورت الأسلحة النووية، أي تحت سيطرة الدولة الصارمة، لكن لا يمكن للحكومة أن تقف موقف المتفرج. ربما يجب أن يتطور الذكاء الاصطناعي كما تطورت السكك الحديدية الأميركية في القرن الـ19، حيث تولى القطاع الخاص معظم التخطيط والبناء، لكن الحكومة لعبت دوراً حيوياً أيضاً، إذ نظمت القوانين والتصاريح لبناء البنية التحتية، وأقرت متطلبات سلامة حكومية مدروسة مثل توحيد مقاييس القضبان وقواعد استخدام المكابح الهوائية ومتطلبات ربط العربات، مما جعل القطارات أسرع وأكثر أماناً. لم يكن التعاون مثالياً، لكنه نجح: أصبحت السكك الحديدية الأميركية ملكاً وطنياً عزز أمن البلاد وازدهارها. يمكن للذكاء الاصطناعي المتقدم أن يحقق الشيء نفسه، بشرط تطويره بالطريقة الصحيحة وفي إطار الترتيبات المناسبة. الآن، كما في السابق، حان الوقت ليقف القطاعان العام والخاص جنباً إلى جنب.
بين بوكانان هو أستاذ مساعد في كرسي دميتري ألبروفيتش في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكينز. وبين عامي 2021 و2025، شغل مجموعة مناصب في البيت الأبيض من بينها منصب المستشار الخاص لشؤون الذكاء الاصطناعي.
تانتوم كولينز شغل منصب مدير التكنولوجيا والأمن الوطني في "مجلس الأمن القومي" بين عامي 2023 و2025.
مترجم عن "فورين أفيرز"، سبتمبر (أيلول) / أكتوبر (تشرين الأول) 2025