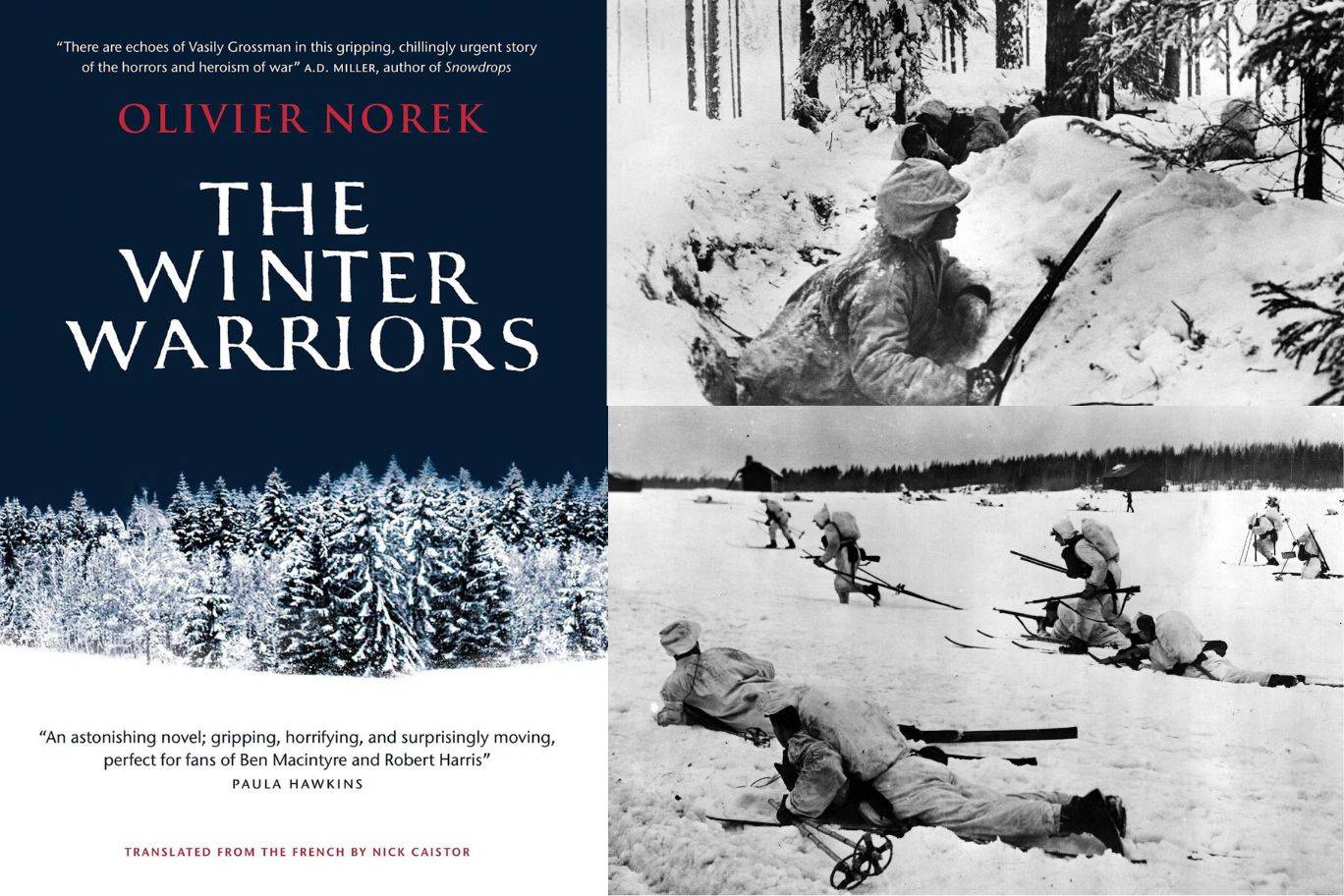ملخص
كتاب "رحلات شاتوبريان مزيناً بأعمال الفنانين" الصادر حديثا في فرنسا حقق مكانة طيبة منذ صدوره وبالتحديد لأن النقاد رأوا فيه إدراكاً عميقاً لجوهر العلاقة بين الكاتب الرحالة والأماكن التي زارها، بل حتى المكان الذي ولد فيه
عندما أرادت إحدى دور النشر الفرنسية أن تصدر قبل عقود من اليوم كتاباً حول رحلات الكاتب والمفكر شاتوبريان في أصقاع الأرض، لم تجد نفسها في حاجة لأن تطلب من رسامين معاصرين أن يمدوها برسوم ولوحات مستقاة من تصور ما، ميداني أو غير ميداني، للأماكن التي زارها خلال جولاته. كل ما كان عليها هو أن تستنجد بالتراث المعروف للفن الرومانطيقي، كما في الفن الذي صور المدن بصرف النظر عما إذا كان مبدعوه يعرفون شيئاً أو لا عن تجوالات صاحب "الرحلة من باريس إلى القدس" أو حتى "مذكرات من وراء القبر".
ففي نهاية الأمر لم يدون هذا الكاتب أخبار رحلاته من منطلق أدب رحلات واقعي، بل من منطلق تفاعل شديد الذاتية مع الأماكن التي تجول فيها، ما احتاج لتزيين الكتابات فن يعبر عن ذاتيات أخرى. وهكذا تجاورت رسوم كلود لورين وكورو وفيرنيه، مع نصوص الكاتب. وغالباً تحت ظل فولتير وصولاً، على سبيل المثال، إلى حضور لوحة لوغرو الرائعة التي تصور بونابرت وهو يزور المجذومين في يافا الفلسطينية خلال حملته على مصر وفلسطين. وما ذلك إلا لأن رحلات شاتوبريان لم تكن مثل غيرها من الرحلات كما سنرى. ففي حقيقة الأمر، حين نقرأ نصوص رحلات هذا الكاتب، ومعظم أدبه الكبير أدب رحلات على أية حال بما في ذلك رحلته إلى ما وراء القبر، لا نقرأ كاتباً فحسب، بل روحاً معلقة بين عالمين: عالم القصور التي انهارت مع الثورة الفرنسية، وعالم الطبيعة التي أعادت إلى الإنسان إحساسه الأول بالدهشة والخوف والسكينة. فلقد كان شاتوبريان في جوهره رحالة يبحث عن معنى في زمن فقد معناه. ومن هنا، لا يعود السفر عنده تنقلاً في المكان، بل حركة في الروح وسعي نحو المطلق عبر تضاريس العالم الخارجي.
الكاتب و"رساموه"
وهذا على أية حال ما أراد أن يقوله لنا كتاب "رحلات شاتوبريان مزيناً بأعمال الفنانين" الذي أصدرته مواطنته آن جيرار. وهو كتاب حقق مكانة طيبة منذ صدوره وبالتحديد لأن النقاد رأوا فيه إدراكاً عميقاً لجوهر العلاقة بين الكاتب الرحالة والأماكن التي زارها. بل حتى المكان الذي ولد فيه.
فشاتوبريان ولد عام 1768 داخل مدينة سان مالو على ساحل بريتاني في الغرب الفرنسي، فظل يحمل في ذاكرته عبق البحر وأساطير الفلاحين الغابرين. وهو جاء إلى الأدب من السياسة ثم من الإيمان إلى الشك وإلى الرحلة من الحنين. هو الذي حين سقطت فرنسا في فوضى الثورة، وانهارت القيم التي نشأ عليها، شعر كما لو أن العالم القديم يغادر بحثاً عن عالم مات، وأن عليه هو أن يغادر بحثاً عن بديل لذلك العالم.
وهكذا بدأ مشروعه الكبير: أن يعيد بناء الإيمان والجمال في نص أدبي يسير على خطى الرحالة. ومن هنا كانت رحلته الأولى نوعاً من عودة إلى فردوس مفقود. وكان ذلك خلال عام 1891 حين قرر وهو في الـ23 أن يشد الرحال إلى أميركا حيث لم يكن في ذهنه من هدف سوى أن يرى "الأرض التي لم تفسدها الحضارة بعد". هرب من فرنسا التي كانت تشتعل بثورتها، ووجد في غابات كندا ومروج المسيسيبي بديلاً عن مدن الدم والسجالات العنيفة الصاخبة في بلده. وهناك بين قبائل الهنود الحمر اكتشف ما سيسميه لاحقاً، "البراءة الأولية للإنسان".
أرض أسطورية
صحيح أن تلك الرحلة المبكرة لم تدم طويلاً، لكن صداها سيمتد في أعماله اللاحقة، حيث في "أتالا" و"رينيه" تحولت تلك المشاهد الأميركية إلى أرض أسطورية يعيش فيها الإنسان صراعات أزلية بين الطبيعة والروح، بين الحرية والقدر. فكتب شاتوبريان في "رينيه" وكأنه في حضرة كاهن، يعترف بخطيئة جيله الأوروبي: "هربت إلى الغابة لأن الحضارة خذلتني".
وفي هذا الهرب يكمن جوهر الترحال عنده: رفضه للعالم المريض، وبحثه عن البدء من جديد. لم تعد أميركا بالنسبة إليه قارة، بل مرآة للذات الغربية حين تنظر إلى نفسها في طفولتها.
ومن هنا جاء طابع الحلم الذي يغلف كل مشاهد العالم الجديد في أدبه: الطبيعة صامتة ككنيسة، والبراري تمتد كصلاة طويلة، والإنسان في خضم ذلك كله كائن وحيد أمام العناية الإلهية.
ومن هنا كان من الطبيعي لرحلته الثانية أن تقوده إلى الشرق هذه المرة، بحثاً عن الإيمان. فبعد أعوام من التيه بين المنفى والسياسة والدبلوماسية، قرر شاتوبريان أن يتوجه في رحلته الكبرى إلى الشرق. وكان ذلك بدءاً من عام 1806. انطلقت رحلته هذه المرة من اليونان ومنها إلى فلسطين فمصر فتونس. وكانت الرحلة أشبه بحج أدبي وديني، يسعى الرحالة من خلاله إلى ملامسة جذور المسيحية، وإلى رواية التاريخ بعينيه لا عبر الكتب.
وهكذا في كتابه "الرحلة من باريس إلى القدس" نقرأ مزيجاً نادراً من الدهشة والوجد. إنه يصف الطريق إلى القدس باعتباره طريقه إلى الإيمان... وهو في أثينا يبكي على خراب المعابد الوثنية، وفي القدس يتأمل صمت القبر المقدس، قبر السيد المسيح. ففي نهاية الأمر ليس الشرق بالنسبة إليه جغرافيا، بل هو زمن متعدد اللغات: لغة الأسطورة ولكن لغة الحنين بين هذه وتلك.
لكل حجر لسان
في ذلك الحين يكتب شاتوبريان قائلاً: "كل حجر في هذه الأرض له لسان، وكل ظل يروي قصة نبي أو حلم إمبراطور". وبهذه اللغة حول شاتوبريان الشرق إلى أرض متخيلة، تتجاور فيها الأسطورة والواقع، والقداسة والخراب.
لقد فتح الطريق أمام أجيال من الرحالة الفرنسيين الذين سيسيرون على خطاه، من لامارتين إلى دي نرفال، وصولاً إلى فلوبير وغيره من الذين راحوا يتابعونه ليروا في الشرق ما رآه هو قبلهم: المرآة التي يرى فيها الغرب نفسه مقلوباً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الرحالة ممهد للحداثة
إذاً في شخصية شاتوبريان الرحالة، تتجسد ملامح الرومانطيقية الفرنسية في بداياتها: النزوع إلى الطبيعة وتقديس العاطفة والحنين إلى المطلق، وتمجيد الفرد في مواجهة العالم. لقد جعل هذا الكاتب من الرحلة فعلاً وجودياً، ونوعاً من تجربة تأكيد الذات في عالم متغير. ولعل هذا ما جعل من كتبه، خصوصاً "رحلة من باريس إلى القدس"، أكثر من مجرد نص ينتمي إلى أدب الرحلات، جعله نوعاً من السيرة الروحية التي تروي قصة الإنسان الحديث منذ هبوطه مطروداً من الفردوس، حتى استعادته الحنين إليه. بالتالي يكون لافتاً أن شاتوبريان وهو الأرستقراطي المؤمن بالعظمة القديمة، لم يسافر ليغزو أو ليبشر كما فعل الرحالة "الإمبرياليون" من بعده، بل ليتعلم. كان يرى في الشرق معلماً روحياً وفي أميركا معلماً للبراءة. وهذه النظرة الأخلاقية والجمالية، هي التي جعلت رحلاته تختلف عن رحلات المستشرقين اللاحقين الذين سيحولون الشرق إلى موضوع للسيطرة والفضول. فهل كان كتاب مصور عنه يحتاج حقاً إلى من يرسم أماكن ترحاله؟