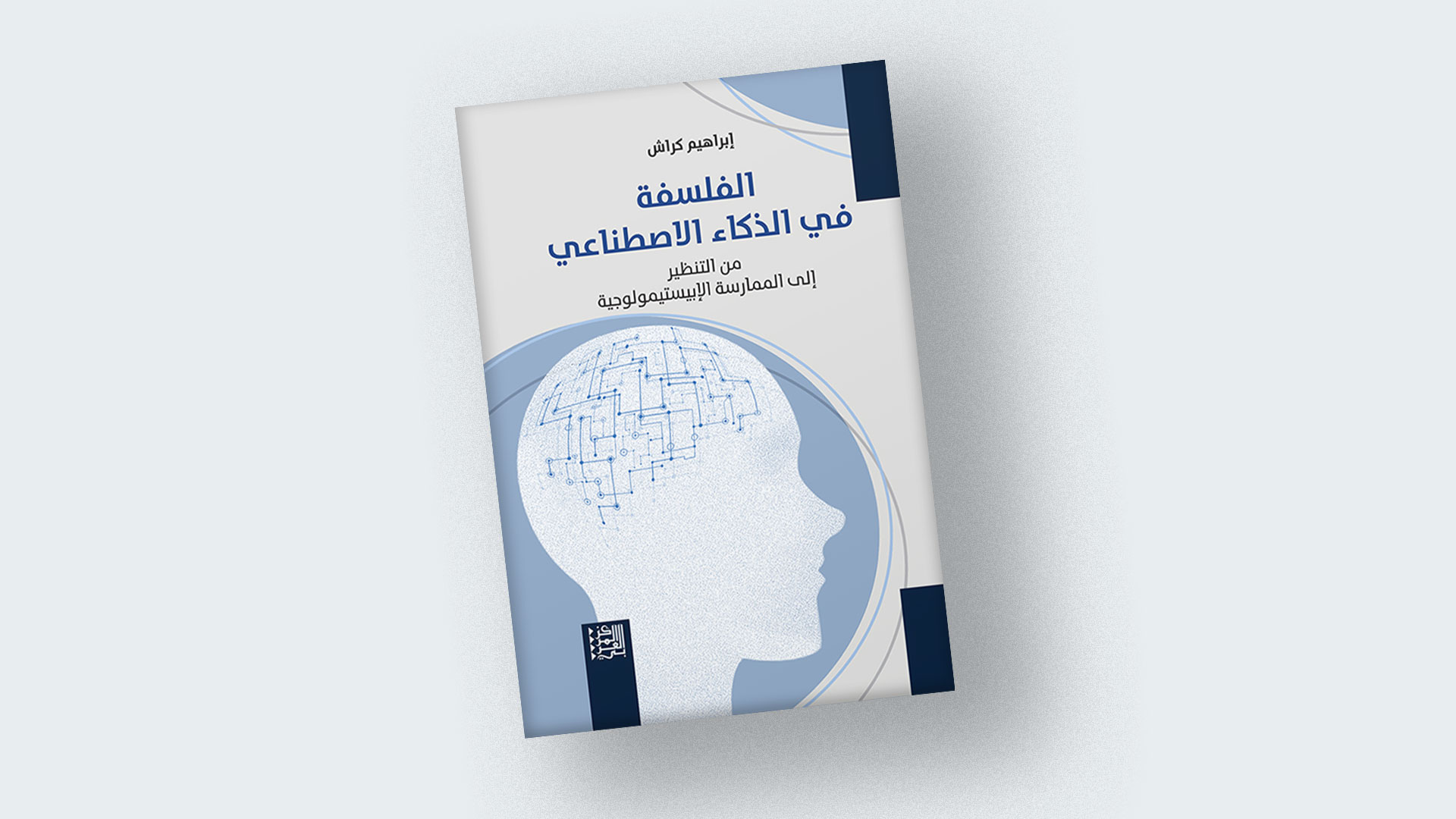ملخص
"الفلسفة في الذكاء الاصطناعي، من التنظير إلى الممارسة الإبيستيمولوجية"، كتاب للباحث الجزائري إبراهيم كراش يعيد فيه النظر في ظاهرة الذكاء الاصطناعي، من زاوية جذوره الفكرية والفلسفية.
لا جدال في أن أكثر ما يتداوله الناس، شرقاً وغرباً، سواء في وسائل الإعلام، أو في الندوات والحلقات الدراسية المعمقة والعلاقات الاجتماعية حيثما انعقدت، هو ظاهرة الذكاء الاصطناعي، ويعدها البعض أعظم إنجازٍ في مسار الإنسان نحو التطور والتقدم العلمي. وقد يبلغ البعض، في تقديرهم ظاهرة الذكاء الاصطناعي، مبلغاً يرفعونه فيه إلى مرتبة الخلق، وقد صُور لهم أنه مبتدع الحلول لمشكلات البشر وتساؤلاتهم، وأن ذكاءه- وإن اصطناعياً- كفيلٌ بإعانة البشرية، في شتى مجالات الحياة، وبأسرع من البرق كأنما هو سليل الجان والعماليق في حكايات ألف ليلة وليلة، يخرج من فوانيس الحاسوب السحرية، أو من قوارير.
في كتابه الصادر حديثاً (2025) عن المركز العربي لدراسة السياسات (بيروت)، بعنوان "الفلسفة في الذكاء الاصطناعي، من التنظير إلى الممارسة الإبيستيمولوجية"، يتطرق الباحث الجزائري إبراهيم كراش إلى ظاهرة الذكاء الاصطناعي، من زاوية جذوره الفكرية والفلسفية، وليس من باب تطبيقاته، والمآلات العملية لهذه الظاهرة التي باتت عالمية، وتمس كل فرد يسعى إلى الاندماج في سياقة العصر، ودُرجاته، واتجاهاته المتسارعة، والمستهلَكة، والخاطفة، في آن معاً.
يقوم الكتاب على فكرة توجيهية، أو طرح مفاده أن الذكاء الاصطناعي مؤسس على لوغوس (كائن لغوي يتوسط بين الخالق والكون في الأفلاطونية الحديثة) يتكون من نظريات علمية وفلسفية، ومعرفة تقنية. وبالتالي، ليس الذكاء الاصطناعي مجرد حيَل تقنية أو محصلة لاختراعات كثيرة التعقيد، لا قبلَ للمرء في إدراك كنهها أو سبر أعماقها.
ولو شئنا استعراض الظاهرة وإشكاليتها، المبسطة في الكتاب، لخالفنا الترتيب الذي أجراه الباحث، فبدأنا بالكلام على المنطلق التاريخي الذي عُرفت منه، منذ بدئها؛ من أرسطو الذي يقسم الأشياء الموجودة قسمين: أشياء طبيعية، وأشياء مصنعة، مروراً بعصر الانبعاث، في الغرب، وصولاً إلى عصر الاكتشافات العلمية والثورة الصناعية، وانتهاء بالعصر الحديث والمعاصر.
من الأسطورة إلى اللوغوس
إذاً، يعتبر الباحث، في أطروحته، أن للذكاء الاصطناعي أصولاً من الفلسفة القديمة، بنشأتها الغربية، وأنه شهد تحولاً من كونه مجرد أسطورة، في حقبة تاريخية بعيدة، تعود إلى ما قبل الميلاد بمئات السنين، نظير ما تخيل هوميروس، في إلياذته الشهيرة، كائنات آليةً شبيهة بالبشر، مصنوعة من أثمن المعادن. دليلنا على ذلك قصة الخادمتين الذهبيتين اللتين تتمتعان بالعقل وتمتلكان كفايات الصوت والقدرة على الخدمة والعمل. وكانت هذه وغيرها قد صنعها الإله هيفايستوس، إله النار والمرجل والتعدين في الميثولوجيا الإغريقية. كما نجد لدى باراسيلوس، مؤسس الطب المحكَم، فكرة لإنشاء نوع من القزم الاصطناعي نتيجة خليط كيميائي غريب. ولا نحسب، من جهتنا، أن تراث الشعوب العربية والمشرقية القديم خالٍ من هذه التخيلات والتصورات لكائنات شبيهة بالبشر، ولكن بإمكانات فائقة.
وظلت البشرية تتناقل أساطير الذكاء الاصطناعي وكائناته المفترضين حتى عصر النهضة الغربية، الممتد من القرن الخامس عشر، وحتى السادس عشر، لما حقق الطب درجة عالية من التقدم؛ إذ راح ينظر إلى الإنسان على أن به آلات (القلب، والرئتان) تعمل بانتظام عالٍ. وفي القرن السابع عشر سوف يفيد الفيلسوف ديكارت من الرؤى العلمية الحاصلة في زمنه ليطرح فكرة "الحيوان الآلة"، وهي "فرضية إيثولوجية" (أخلاقية) تفيد بوجود آلات ليس لها حس ولا شعور، وأفعالها ليست سوى أفعال انعكاسية استجابة للمنبهات من الوسط المحيط". (ص:90) وبعد ديكارت، تميز القرن السابع عشر بعمل عالمين كرسا جهودهما لبناء المتحركات الآلية والتفكير فيها، وهما على التوالي: "جاك دي فوكانسون الذي كان مهندساً في صناعة الحرير، واشتهر بالمتحركات الآلية (مثل عازف الدف، والبطة)، والآخر جوليان دولامتري الذي عبر عن أفكاره في كتاب "التاريخ الطبيعي للروح"، بيد أنه اعترف بشكل قاطع في كتابه "آلة الإنسان" بأن الإنسان هو آلة، ونوع من الآلة المتقنة الصنع". (ص:94)
وبناء عليه، غدا الإنسان، بنظر الفيلسوف ديكارت، آلةً بيولوجية ميكانيكية، يحكمها الله الخالق. وهذه الآلة تتعالى، بحكم خلقها الإلهي، عن الحيوان وعن المتحركات الآلية المصنوعة. وعلى هذا النحو، بدأ يتشكل تيار من الوعي الفكري والفلسفي، بعد ديكارت، صار هو اللوغوس الناطق عن الذكاء الاصطناعي والمعبر عنه، فاصلاً إياه عن الأسطورة السالفة. ولكن بمَ يفيدنا هذا التفصيل، في الكلام على ظاهرة الذكاء الاصطناعي؟ للإجابة نقول إن ذلك التحول الفكري، بل الفلسفي، في تصور الذكاء الاصطناعي يشير إلى مرحلة من النضج بلغتها البشرية، متكئة على تراكم الأبحاث في كل المجالات العلمية والفكرية والفلسفية والاكتشافات التقنية، حتمت تغييراً حاسماً في النظرة إلى الذكاء الاصطناعي.
ما الذكاء الاصطناعي؟
ولكن، ما هو مفهوم الذكاء الاصطناعي؟ يقول الباحث إن الذكاء الاصطناعي هو منتج بشري يقابل الذكاء الطبيعي عند الكائنات الحية، وبصفة خاصة الإنسان، ويسعى إلى محاكاة الأخير. وأي ذكاء مصطنع يفترض أن يكون طبق الأصل عن ذكاء الإنسان. ويُفهم من هذا التعريف أن الذكاء الاصطناعي ليس علماً قائماً بذاته (كالرياضيات والفيزياء والكيمياء)، وإنما هو مجالٌ تتداخل في تأسيسه علوم وتقنيات مختلفة، مثل المنطق، والرياضيات، والعلوم الإدراكية، والميكانيكا وغيرها.
أما وظيفة الذكاء الاصطناعي، المتجسد في آلة مصنوعة، فتقوم على حل المشكلات، من نوع الرياضيات، أو الترجمة من لغة إلى أخرى، أو إنتاج معلومات جديدة، أو جمع معلومات قديمة، أو إنتاج رسوم، أو إعداد تصاميم هندسية، أو إعداد استشارات طبية، أو نفسية، أو اجتماعية، أو صناعة الصواريخ وتوجيهها، في الحروب الحاصلة (بين روسيا وأوكرانيا، مثلاً) أو غيرها الكثير الكثير. وقد تيسر لإنساننا المعاصر الاستنجاد به، في كل أحواله، حتى أن فتىً كسير النفس، مستوحداً، سأله إن كان الانتحار مستحسناً في حالته، فرد عليه بالإيجاب، وعمل بنصحه، فانتحر!
السيبرانية أساس الذكاء الاصطناعي
تنبئ المناقشات الأولى التي أجراها الباحث العبقري آلان ماتيسون تورينغ (1912-1954) حول ما إذا كانت الآلات تفكر أم لا، كما حول تعريف الآلة، وطبيعة الفكر ذاته، عن الجذر الأول والحديث للذكاء الاصطناعي. وبعدما يجري مناقشة مستفيضة حول آلية الفكر، وماهية الحاسوب، واعتبارهما مساريْن منطقيين مترابطين على هيئة خوارزميات، ينتهي إلى القول بأن عمل الآلة المفترض إنشاؤها (أي الحاسوب) إنما هو لعبة تحاكي عمل الدماغ البشري.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويذهب خيال تورينغ بعيداً، على حد قول عالم فرنسي يدعى برونو لاتور، في مقالة تحليلية لمأثرة الأخير، إذ يرى في بعض التخيلات أو التصورات في الأدب تجسيداً ممكناً لقدرات الذكاء الاصطناعي الكامنة؛ شأن لعبة تمثيل الأدوار في نوع الرواية والمسرح، حيث يسعى رجلٌ متخف إلى التصرف بوصفه امرأة، أو الوصف الكافكاوي لعمل موظف بيروقراطي بائس، يسود رزم الورق من غير طائل، أو حكاية مهندسين من الجنس نفسه، يحاولون استنساخ إنسان من خلية واحدة منتزعة من جلدهم (ص:46).
الفلسفة والذكاء الاصطناعي
يتساءل إيمانويل كانط، في كتابه "نقد ملكة الحكم" عن كيفية جعل الكائنات (من دون ذكاء) تحمل الغايات، وتحل مشكلات الإنسان، يقول: "هل إن النقش المادي في دماغ النظام الحسابي المماثل لآلة تورينغ يفسر قدرتنا على الإدراك، واستخدام اللغة، والقدرة على التصور، والاعتقاد والرغبة؟ وهل يمكننا اعتبار هذه الآلة المجردة بمثابة نظرية صوَرية لعمليات التفكير التي يضمن الجهاز العصبي تجسيدها؟".
والواقع أن الذكاء الاصطناعي، في محاكاته ذكاء الإنسان، وعلومه، وقياساته، ومشاعره، وأنماط تفكيره المنطقي، والرياضي، ومعجمه اللغوي، وتراكيبه، يجمع المعارف من مجالاتٍ عدة؛ من مثل علوم الحاسوب، وعلم الأعصاب، وعلم النفس، واللغويات، والمنطق، والفلسفة، وعلم الاجتماع، والتواصل، وغيرها. وتوفر تكنولوجيا المعلومات العناصر الأساسية للذكاء الاصطناعي، من حيث الأجهزة ومنهجية العمل القائمة على المعالجة الرمزية للمعطيات. ويُعد علم اللغة أساساً أولاً للعمل في إعداد برامج الذكاء الاصطناعي، بحكم اعتباره منطلقاً لتكوين المصطلحات، والمفردات، والتراكيب الخاصة.
بين الجذور والحدود
ولكن انبهار العامة بالذكاء الاصطناعي، العائد إلى وظيفيته المتاحة لكل مواطن على وجه البسيطة، في القرن الواحد والعشرين، لا يحول البتة دون اعتراض عدد من الفلاسفة، أمثال سيرل ودريفوس، الذين قالوا بأن ثمة محدودية في تمثيل مجمل معارف البشر ومواقفهم في الذكاء الاصطناعي، وبأن الأخير لا يسعه محاكاة الوعي، أو إعادة إنتاج الفكر البشري، على برنامج حاسوب. ذلك أن الفكر، بحسب سيرل، ظاهرة مقصودة ومرتبطة بخلفية وشبكة من الحالات الذهنية. وبناء عليه، لا يستطيع الذكاء الاصطناعي محاكاة الوعي والقصد، ولا يمكنه أن يمثل، بشكل صوَري، الخلفية التي تشكل أساس حالاتنا الذهنية.
الاستخلاص الممكن
ولئن كان الكتاب لا يشير إلى استفحال ظاهرة الذكاء الاصطناعي، وشيوعها على نحو مرضي أحياناً، في العالم أجمع، فإنه يدع لنا، نحن القراء المنتمين إلى هذا العالم المعاصر المفتون بالجديد، والمرمي وسط موجات الدرجات والأساطير المعاصرة (بتعبير رولان بارت)، أن نقف موقف الحذر من الذكاء الاصطناعي. فلا نجعله إلهاً جديداً، أو نوعاً من مخلص ذهني جديد، ولا نعتبره أفقاً وحيداً لعالم الغد، ما دام خادماً وحاسوباً ظريفاً يؤدي وظائف (معلوماتية، وعلمية، وترجمية) معينة، فحسب. أما الباقي فمن قلة التعقل، والتبصر بإنسانيتنا المتشابكة الأركان والفريدة التكوين. ولنا مثلُ المؤمنين بسيادة العلم والاختراعات في القرن التاسع عشر أسطع دليل على ما نقول.