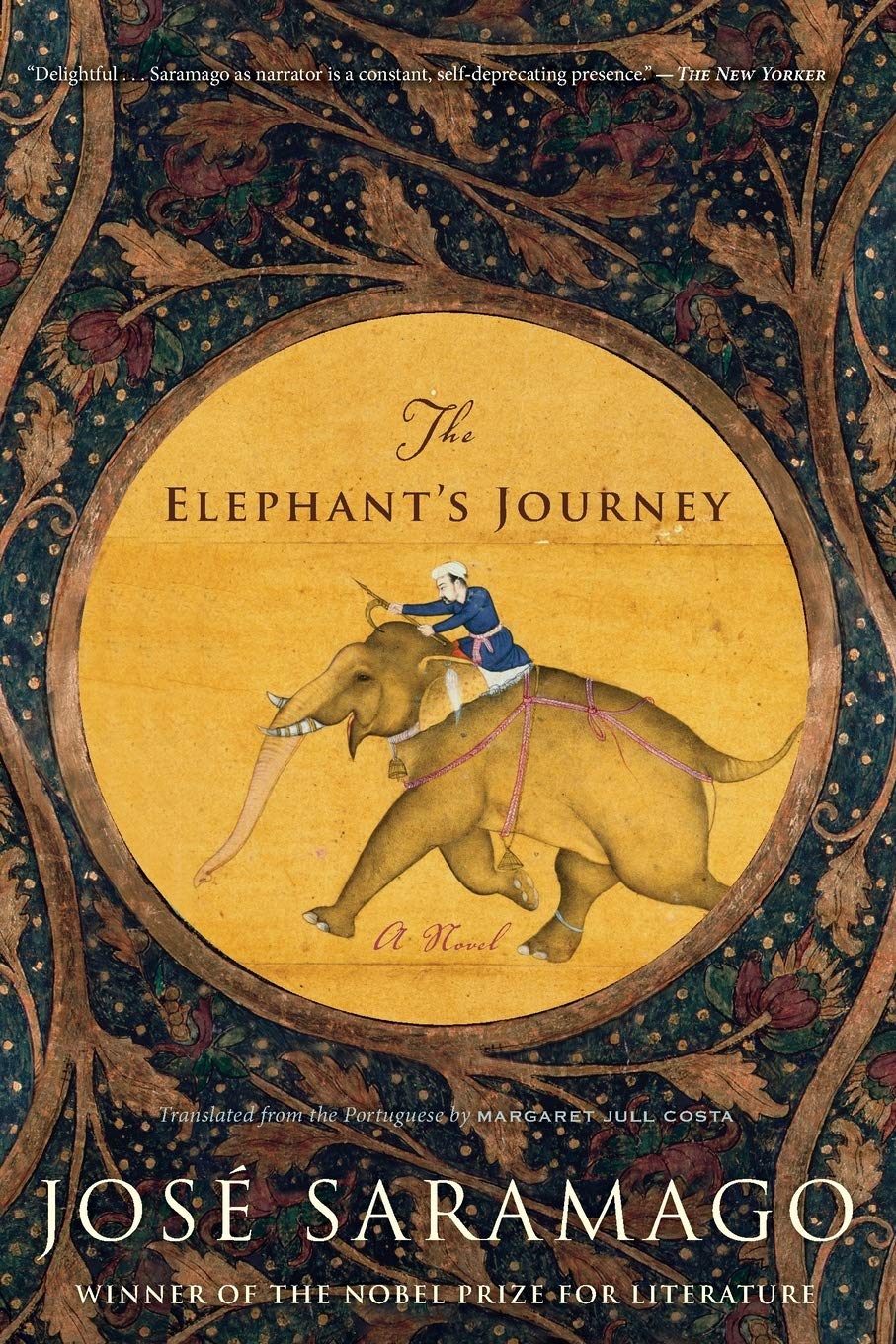من اللافت حقاً أن يكون الكاتب البرتغالي خوسيه ساراماغو قد انتظر حتى سنواته الأخيرة قبل أن يكتب واحدة من أجمل رواياته، بل تحديداً واحدة من أقرب رواياته إلى عالم سلفه الكبير بالنسبة إلى الكتابة باللغة البرتغالية (إنما في فرعها البرازيلي هذه المرة) خورخي آمادو. في نهاية الأمر يمكن القول إن "رحلة الفيل" رواية كان يمكن أن يكتبها آمادو لو أن موضوعها خطر في باله أو روي له بشكل أو بآخر. ففي هذه الرواية يطالعنا حسّ مرح وفكاهة لا يمكننا تلمس أثره في العدد الأكبر من روايات ساراماغو، وإن كان لن يفوتنا أن نعثر على ذلك القدر الهائل من تصفية الحسابات مع السياسة ومع التاريخ بل بخاصة مع الكنيسة... ناهيك بتصفية الحساب مع الخواء الفكري لدى البشر وافتقارهم إلى الإحساس بالمسؤولية انطلاقاً من العبثية الطاغية على تصرفاتهم، وهي عبثية من المستحيل العثور عليها في عالم الحيوان. ونتحدث عن الحيوان هنا ليس فقط لأن حيواناً معيناً يشغل عنوان الرواية، بل كذلك لأن هذه تدور بأكملها من حول ما أصاب هذا الحيوان على أيدي البشر.
الرواية على شكل قذيفة
طبعاً يمكننا أن نجد في هذا الموضوع وما يحيط به كل ما كان ساراماغو قد بثه في ثنايا رواياته السابقة، ولا سيما تلك الأكثر نضالية من بينها، لكنه إذ بدا ذلك مصبوغاً بالجدية المطلقة غالباً في معظم تلك الروايات، فإنه هنا اصطبغ بذلك الحس الفكاهي الذي يكاد يكون موروثاً من السوريالية، والذي طبع معظم نصوص آمادو الكبرى. ومن هنا نقول إن "رحلة الفيل" رواية كان يمكن أن يكتبها آمادو، ولم يكن صدفة أن يتركها ساراماغو جانباً في انتظار لحظة مناسبة لإطلاقها كالقذيفة في وجه جنون العالم وعبثيته قبل عامين من رحيله، وهو الذي لم يصدر بعدها سوى رواية واحدة أخيرة عاد فيها إلى الجدية والنضالية الصارمتين: "قايين" قبل عام من رحيله عام 2009، ومن بعدها "نور السماء" (كلارابويا) التي صدرت بعد رحيله بعام.
أحداث تاريخية حقيقية
ولكن مهما قلنا عن "رحلة الفيل" فإنها تبقى في النهاية رواية تاريخية بناها ساراماغو على فصل حقيقي من فصول التاريخ البرتغالي المفرط عادة في غرابته. وتلك هي حكاية تتحدث عن فيل ضخم يدعى سليمان، كان قد وصل من الهند مسقط رأسه إلى لشبونة عاصمة البرتغال أواسط القرن السادس عشر، لينضم إلى حديقة حيوان مقامة في بساتين القصر الملكي في لشبونة. ولكن حدث في عام 1551 أن قرر الملك البرتغالي جواو الثالث، وبناء على نصيحة الملكة، أن يقدم الفيل الطيب والوقور إلى أرشيدوق النمسا في فيينا ماكسيميليان الثاني هابسبورغ على شكل هدية زواج فريدة من نوعها. وهكذا بات على الفيل يرافقه وصيفه المدعو صوبرو أن يقوما بالرحلة من لشبونة إلى فيينا عابرين أوروبا في موكب فريد من نوعه. لكن الرواية ستصف لنا كيف أن هذين الاثنين، وقبل عملية الانتقال كانا يعيشان وسط ظروف بالغة الصعوبة في زاوية منسية من حديقة الملك البرتغالي، ومن هنا كان انتقالهما إلى فيينا يعني رقياً اجتماعياً وبعض رفاهية مؤكدة بالنسبة إلى الاثنين معاً. لكن المشكلة كانت في أن مشقة الرحلة نفسها عبر القارة الأوروبية كانت تطرح عليهما سؤال الجدوى بكل جديّة. فالانتقال براً وبالتالي سيراً على الأقدام عبر الجبال والوديان في الجنوب الأوروبي لم يكن بالأمر السهل في ذلك الحين. ومن هنا، بعدما بدأت الرحلة التي يواكبها الأرشيدوق النمساوي وعروسه، إذ قضت التقاليد الدبلوماسية بأن يتسلما الهدية بأنفسهما في مواكبة العديد من المسؤولين والحرس، بداية طيبة، إذ انتقل الجمع بالسفن من ميناء لشبونة إلى أحد موانئ الشرق الإسباني ومعهم العديد من الأبقار والماعز وكميات كبيرة من المؤن. ومن هناك كان على الموكب الهائل المحيط بالفيل أن ينتقل براً إلى الحدود الشمالية لإسبانيا للوصول عبر الجنوب الفرنسي إلى جنوى الإيطالية ومن ثم يعبرون مدن الشمال الإيطالي تباعاً، بليزانس ومانتوفا وصولاً إلى البندقية ومنها إلى ترنتا، حيث كان يعقد ذلك المجمع المسكوني الذي كان الأكثر حسماً في تاريخ الصراع بين الكنيسة البابوية والانشقاق الإصلاحي البروتستانتي.
تصفية حسابات
والحقيقة أن عبور الموكب مدينة ترنتا وفّر لساراموغو فرصة ذهبية للوصول بحكايته إلى ذروة تمكنه من تصفية حساباته مع السياسة كما مع الكنيسة، كما لو أن قراره بكتابة تلك الرواية استند أصلاً إلى رغبته في الكتابة عن ذلك العبور بمدينة المجمع المسكوني. المهم أن الموكب وفي ظل الصراعات الدينية العنيفة عرف كيف يتابع طريقه عابراً هذه المرة جبال الألب ووديانها والبرد القارس والصعوبات الطبيعية والأمراض تفتك بالعديد من أفراد الموكب تمارس عليهم جميعاً نوعاً من حرب لا مثيل لها. ولكن في النهاية وبحسب ما يروي لنا ساراماغو في هذا النص المدهش، الذي لا تعقد فيه أية بطولات فردية بل بطولة جماعية محورها دائماً ذلك الفيل الصابر، الذي لسنا ندري ما إذا كان مدركاً أن ذلك كله، بما فيه التضحيات والتحمل الجماعي لشظف الانتقال ومخاطره، إنما كانت من أجله، كما لسنا ندري ما إذا كان من توقعاته المشروعة أن صبره على الرحلة كما صبره قبل ذلك على الإهمال الذي كان من نصيبه في الزاوية المهملة في القصر الملكي في لشبونة، كل هذا سوف يكافأ في نهاية المطاف بحياة سعيدة مرفهة سيخصّ ورفيقه الوصيف بها في قصر الأرشيدوق في فيينا ما إن يصار إلى الوصول إليها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تلك النهاية البائسة
طبعاً لسنا ندري شيئاً عما كان يعتمل في ذهن الفيل، وساراماغو لم يدخل في تفاصيل توقعات ذلك الكائن الذي بُذلت في سبيله كل تلك المشاق. غير أن ساراموغو كان يعرف، في المقابل، الكثير عن الحمق البشري وعبثية الشرط الإنساني، ومن هنا لن نجده متعجباً على الإطلاق لما سوف يحدث بعد ذلك، إذ بعد أن يصل الموكب الأرشيدوقي بأمان إلى فيينا ويحدَّد للفيل وصاحبه مكان هادئ في الحديقة المنشودة، يحدث ما لم يكن متوقعاً طوال الصفحات الكثيرة التي كانت قد قرئت من الرواية. ستحل اللحظة الحاسمة، لحظة النهاية للرواية وللفيل نفسه: فبعد كل التعب والمخاطر وفي اللحظة التي يموت الفيل متأثراً بما لاقاه ولكن أيضاً بنوع من إهمال عومل به بعد فرحة استقراره. وهنا يتفتق ذهن موظفي القصر عن فكرة جيدة، حيث نراهم يقطعون قوائم الراحل ليصنعوا منها مشاجب للمظلات تثبت عند أبواب القصر على سبيل الزينة. وهو الأمر الذي علق عليه ساراماغو ذو الستة والثمانين سنة عند صدور الرواية بقوله "إنه العبث في أوضح تجلياته، عبث السلطة وسخافاتها. العبث الكامن في خواء الحياة التي نعيشها نحن الذين نعيش بكل غرور وكبرياء وجشع وطموحات، لينتهي بنا الأمر أقل من مشاجب زينة تعلق عليها المظلات ليس في القصور ولكن في أي مكان على الإطلاق...".
عداء إسرائيلي
في الوقت الذي نشر فيه خوسيه ساراماغو (1922–2010) تلك الرواية العابقة في نهاية الأمر بالمرارة رغم المناخ الساخر الذي يهيمن عليها منذ البداية، كان يعيش سنواته الأخيرة متوجاً بجائزة نوبل للآداب التي نالها عام 1998 عن مجمل أعماله التي كان ينتجها بغزارة، غزارة تعبيره عن مواقفه السياسية التقدمية واليسارية التي لم يكن ليتردد في التعبير عنها مثيراً غضب كل القوى الرجعية والفاشية في العالم، ولا سيما الأوساط الصهيونية في إسرائيل وغيرها التي دائماً ما ناصبته العداء بسبب وقوفه إلى جانب القضية الفلسطينية، التي جعل من نفسه خير المدافعين عنها في العالم. ونذكر للمناسبة أن عدداً لا بأس به من روايات ساراماغو قد ترجم إلى العربية، كما أن السينما اقتبست عدداً لا بأس به أيضاً من تلك الروايات، ولعل الفيلم الأفضل الذي نقل أدبه إلى الشاشة كان فيلم "العمى" عن رائعته المعروفة بالعنوان نفسه.