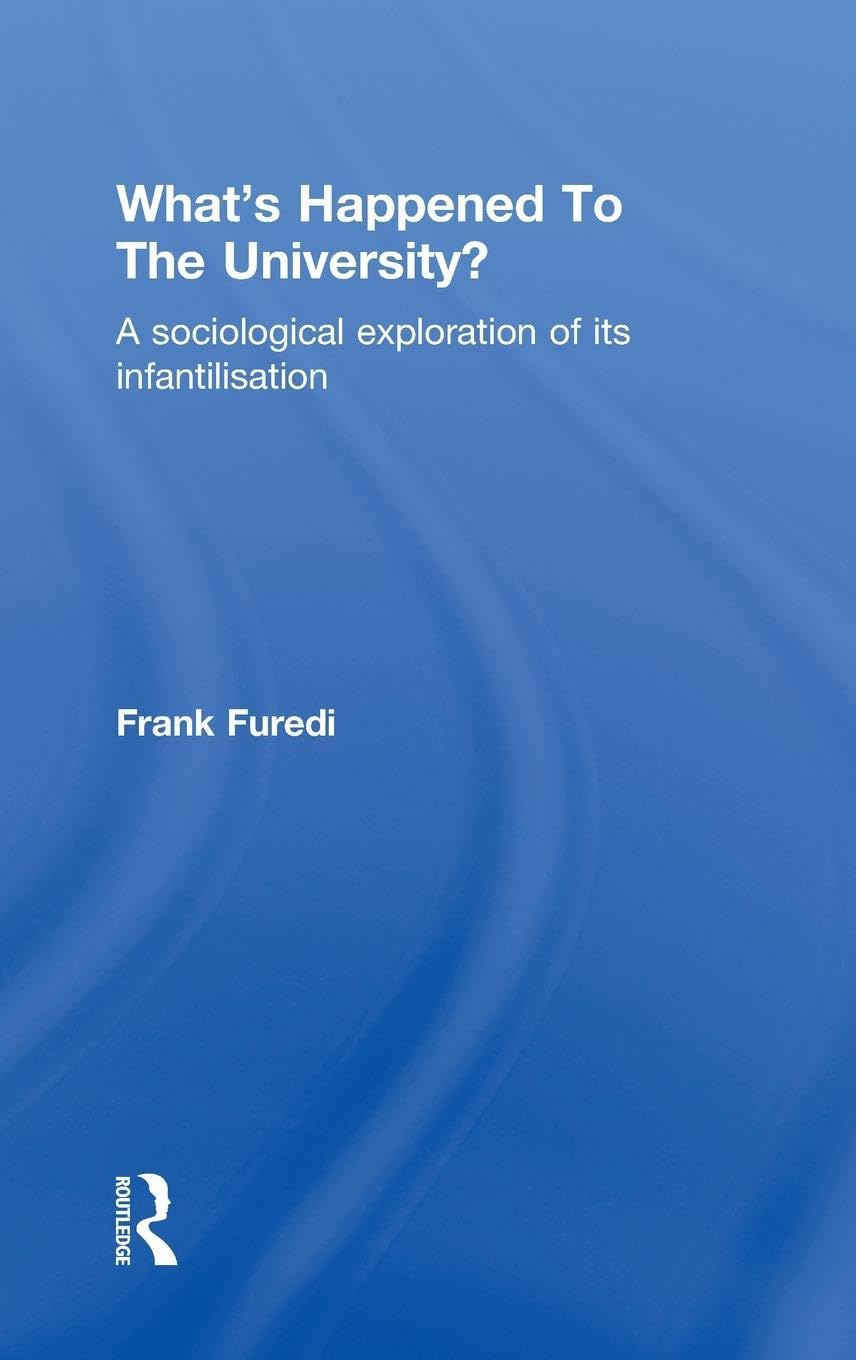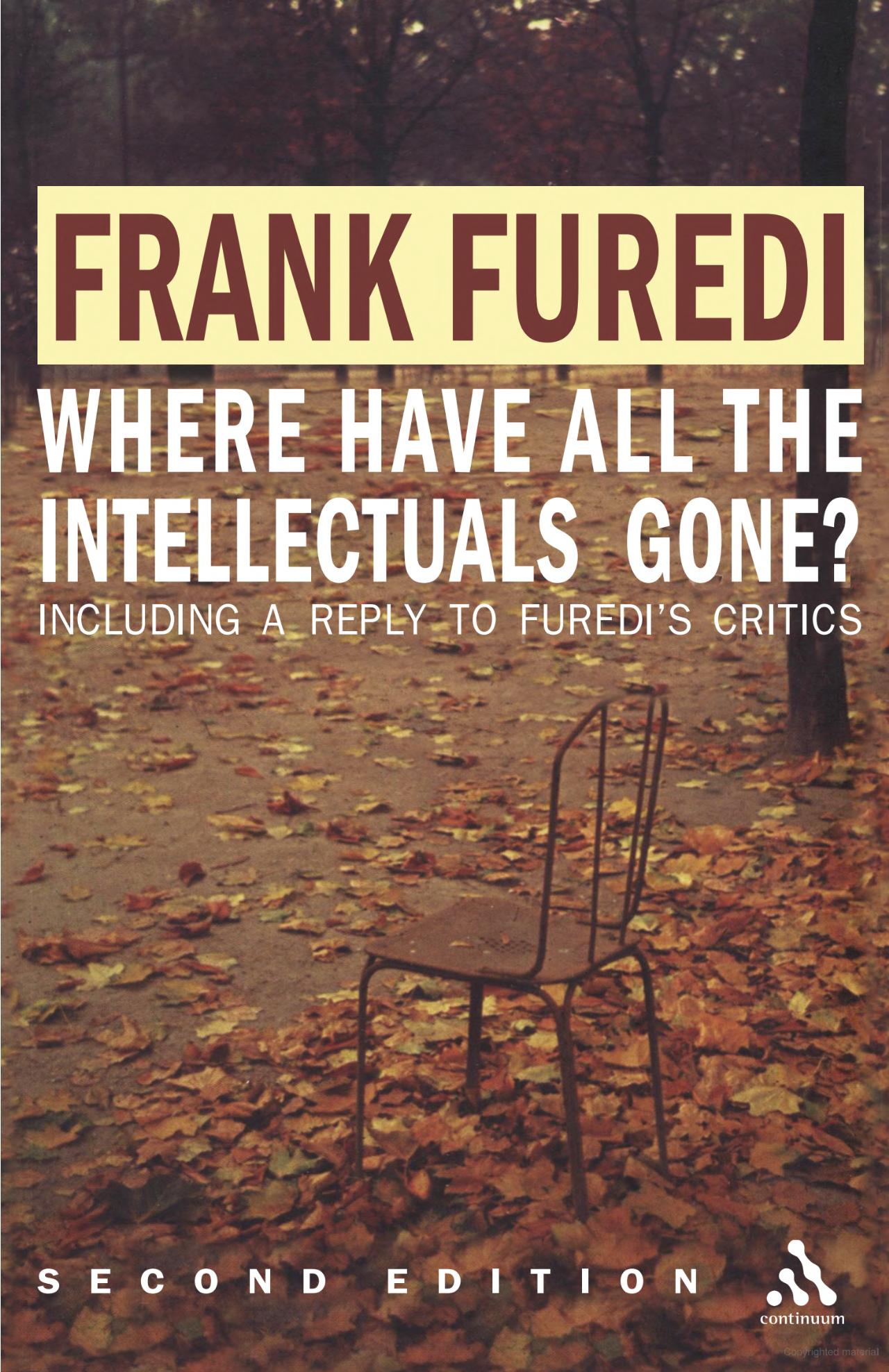ملخص
يعود شق كبير من أبرز النقاشات الفكرية التي شغلت المتخصصين وغير المتخصصين خلال الربع قرن الأول من القرن العشرين إلى تطور وسائل التواصل الاجتماعي، فعلى رغم أن بعض تلك النظريات والفلسفات انطلقت من جذور أكاديمية بحتة، ولكنها حلقت إلى آفاق جديدة وتطورت أطروحاتها وفقاً لمسارات التقدم التكنولوجي، ووفقاً لرؤى جديدة انبعثت من طرق التفاعل مع عالم السوشيال ميديا، وبينها أفكار مثل الصوابية السياسية والشعبوية وثقافة الإلغاء
بينما غرق مفكرو القرن العشرين في تبادل الرؤى حول نظريات علمية بحتة مثل النسبية، وكذلك فلسفات ونظريات تصب في خانة علوم الاجتماع والسياسة، مثل الحداثة وما بعدها، والفلسفة الوجودية، ثم صراع الحضارات ونهاية التاريخ، والعولمة، وكانت هناك مساهمات بارزة للمفكرين العرب مثل زكي نجيب محمود وعبد الرحمن بدوي، ومحمد أركون، يأتي الربع الأول من القرن الواحد والعشرين أكثر زخماً وازدحاماً، فلم يكتفِ مفكروه بصك مصطلحات جديدة تتماشى مع طبيعة العصر سريع التقلب، إنما أعادوا إحياء نظريات مهمة سبق وأن نشأت في حقب سابقة. حيث وجدت صدى أكبر لها وتفسيرات أكثر اتساعاً في السنوات الأخيرة الماضية، وعلى رغم التموجات السياسية والعسكرية والاجتماعية التي شهدها القرن الماضي الذي انشغلت فيه الدول بالترميم والإصلاح بعد الحربين العالميتين، وبتفكيك الاستعمار، مما انعكس بطبيعة الحال على النشاط الفكري ومحاولات البناء النظري والتحليلي.
لكن بالنظر إلى الـ25 سنة الماضية، فإن القرن الـ21 يبدو حافلاً ومتقلباً في ما يتعلق بالأفكار والكتب التي شغلت الساحة، مع ملاحظة تراجع الفلسفات السياسية العربية في ما يتعلق بالإسهامات الفاعلة في هذا الصدد، ومع ملاحظة أيضاً أن كثيراً من تلك الظواهر الاجتماعية والفكرية لم تكن لتخرج بهذا الشكل لولا التوحش الرقمي، كذلك هناك فئات كثيرة أصبحت أكثر انخراطاً في مناقشة تلك الرؤى، ولم يعد يقتصر الأمر على الأكاديميين والمتخصصين فقط، بل انتقلت إلى الفضاء الافتراضي، وهذا بطبيعته يعود أولاً إلى الانفتاح التكنولوجي الكبير الذي صنع ثورة في التواصل لم تشهدها أية عصور سابقة.
رأس المال واللامساواة
كل شيء يبدأ وينتهي عند المال، ولهذا فالبحوث والكتب والنظريات الاقتصادية تبدو دوماً محوراً مهماً للنقاش، وقد بدا كتاب الفرنسي توماس بيكتي "رأس المال في القرن الحادي والعشرين" 2013، وكأنه تنبؤ للفجوة الكبيرة بين الطبقات في ما يتعلق بالأملاك والثروة.
انتقد بيكتي بشدة النظام الرأسمالي السائد في العالم، لأن من شأنه تقليل فرص العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن السياسة المالية المتبعة في هذا القرن نتيجتها تراكم ثروات هائلة في أيدي مجموعة صغيرة، وحرمان الغالبية، موضحاً أن الثروة تنمو أسرع من الدخل، مما يؤدي إلى تراكمها في أيدي القلة وازدياد الفوارق الاجتماعية، فيزداد الفقراء فقراً، وتصبح الفوارق الاجتماعية مروعة.
وقد حلل الباحث الاقتصادي الذي طرح أفكاره المحفزة على البحث عن سياسة تنتصر للمساواة والعدالة، بناء على البيانات المالية لـ26 دولة، معتبراً أن الرأسمالية المطلقة ليست حلاً اجتماعياً، وداعياً إلى مزيد من الإصلاحات الاقتصادية وفرض الضرائب التصاعدية على الأكثر ثراءً، للوقوف أمام تفاقم الوضع، وقد نال الكتاب إشادات واسعة واعتُبر دعوة للتأمل والتفكير في قضية اقتصادية بمنظور مغاير ووصل إلى قوائم الكتب الأكثر مبيعاً كذلك تُرجم إلى لغات عدة.
الاقتصاد السلوكي... رؤية جديدة
على رغم أن جذور الاقتصاد السلوكي، وارتباط القرارات الاقتصادية بالعاطفة مفاهيم عُرفت منذ القرن الثامن عشر على يد المفكر آدم سميث، فإن عالم الاقتصاد الأميركي ريتشارد ثالر، الحائز جائزة نوبل عام 2017، يوصف بأنه مؤسس علم الاقتصاد السلوكي الجديد، إذ أسهمت أطروحاته، وبينها نظرية الحسابات الذهنية، وأفكاره التي صاغها في كتابه "التنبيه"، في الدفع بهذا المجال قدماً، وبصورة سريعة غير مسبوقة، لا سيما أن تأثيرات أفكار ثالر امتدت لمجالات السياسة ودفعت بالحكومات إلى تأسيس وحدات تعتمد على أبحاثه وبينها حكومة المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، فقد اعتمدت دراسات العالم البارز على تحليل القرارات الاقتصادية بناءً على الدوافع النفسية، وقد وُصف ما فعله بمثابة بناء جسر متين بين التحليلات الاقتصادية البحتة والعوامل النفسية، مما يسهم في إنارة الطريق لصانع القرار.
إسهامات ثالر على مستويات عدة كانت مفيدة، بدءاً من سلوك الشراء في السوبرماركت وصولاً إلى طريقة الحكومات في إدارة مواردها، إذ إنه يحلل في كتاباته أيضاً كيف يقوم الأشخاص باتخاذ قرارات مالية سيئة وغير عقلانية للغاية على رغم اعتقادهم بأنهم يدرسون الوضع جيداً، وشكلت تحليلاته خطوة مهمة في عالم التسويق بمفهومه الجديد المعتمد على الترويج للسلع بطرق لم تكن معهودة من قبل، لا سيما في عصر السوشيال ميديا، حيث كل شيء بات خاضعاً للمفهوم الدعاية.
اللامساواة في المعرفة أيضاً
مثلما شغل فرنسيس فوكوياما مفكري عصره في تسعينيات القرن الماضي بأفكار مثل نهاية التاريخ ونهاية الإنسان، فإن المؤرخ الإسرائيلي يوفال نوح هاراري يبدو وكأنه يستكمل هذه النظريات، ويدلل على صحتها، محذراً من أن النخبة التي تتحكم بالمعلومات والبيانات من شأنها توليد فجوة معرفية، ولا مساواة معلوماتية.
يتدرج هاراري في شروحاته ليصل إلى أن الإنسان كما نعرفه سوف يتلاشى. فمنذ عشر سنوات بدأ هاراري في تفكيك منظومة المعرفة السائدة في المجتمعات في ظل الرقمنة، وذلك بشكل استباقي أي قبل أن تسيطر على نسيج الحياة المعاصرة كما هو حاصل الآن، متبنياً ببساطة انتهاء عصر المعرفة الفردية، ومستدعياً نقاشاً أخلاقياً وفكرياً حول دور الإنسان في اتخاذ القرارات، بل وفي كونه مصدراً للمعلومات من الأساس في ظل تحكم الخوارزميات في حياته بشكل مفصلي وجوهري.
كذلك فإن كتاب هاراري الصادر العام الماضي "تاريخ مختصر لشبكات المعلومات من العصر الحجري حتى الذكاء الاصطناعي"، يبحث تطور فكرة تدفق المعلومات عبر التاريخ الغارق في القدم، وكيف أسهمت هذه الميزة في صنع الحضارة والتنوع، طارحاً أسئلة حول مدى ما يمكن أن تصل إليه القدرات الهائلة للذكاء الاصطناعي اليوم في هذا الصدد، وأن المعلومات غير المحدودة قد تتعارض مع رفاهية البشر لا العكس، بل قد تسهم الخوارزميات في تدمير البشر أنفسهم، حيث تكتسب قوة تفوق قوة مبرمجيها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لدى هاراري كتابات متعددة في السياق نفسه، كذلك أن الذكاء الاصطناعي بتأثيراته على المجتمع والسياسة والاقتصاد والعواطف يحظى باهتمام كبير بين المفكرين، لكن تظل رؤى هاراري السوداء محل جدل ومن أكثر النقاشات اشتعالاً، لا سيما بعد أن أطلق نظريته التي تتنبأ بعد بضعة عقود باختفاء مفهوم "الإنسان العاقل" الذي نشأ بعد ثورة إدراكية قبل الآلاف من السنين، حيث تعتبر كتابات هاراري، والباحث الأميركي نيل فيرغسون التي تربط بين التراكم البشري على مدار آلاف السنين وبين ما ينتظره في المستقبل جراء ثورة التكنولوجيا، من أبرز الإنتاجات التي بُنيت عليها أبحاث ونقاشات بين الأكاديميين والمتخصصين في العقدين الثاني والثالث من القرن الـ21.
فيما يمثل كتاب نيك بوستروم "الذكاء الفائق: المسارات، الأخطار، الاستراتيجيات" الصادر عام 2014 واحداً من أهم المؤلفات حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، حيث يحذر من أن يصل الكائن البشري إلى مصير التهلكة بفعل أنظمة الذكاء الفائق، مطالباً بضرورة التحكم في تلك التقنيات وربطها بالقيم الأخلاقية، حيث قد يجد البعض أن أقصى طموحه هو أن يوازي الآلة في قدراتها ولكن مفرغاً من أي أخلاقيات فيسقط في الهاوية.
عصر التجهيل... ما بعد الحقيقة
مصطلح "يتعلق أو يشير إلى الظروف التي تكون فيها الحقائق الموضوعية أقل تأثيراً في تشكيل الرأي العام من نداء العاطفة والمعتقدات الشخصية"، هكذا يعرف قاموس أكسفورد معنى "ما بعد الحقيقة"، حيث اختيرت كلمة العام في 2016، على رغم أن المفهوم نفسه قد يكون مطبقاً منذ زمن طويل، كذلك فإن إرهاصاته الأكاديمية كانت سابقة كما ظهر في كتابات المتخصصين في سبعينيات القرن الماضي، وكذلك أُعيد إحياؤه على استحياء مع الأزمة المالية العالمية 2008.
حينما استخدمته بعض المؤسسات في إلهاء الرأي العام عن إخفاقاتها عن طريق إلقاء اللوم على أطراف أخرى في الأزمة، لكنه بات مفهوماً "شعبياً"، متداولاً على ألسنة المسؤولين وقادة الرأي، حيث أدى تدفق المعلومات سواء عبر وسائل الإعلام التقليدية أو الميديا الجديدة المتمثلة في وسائل التواصل الاجتماعي، إلى تراجع الحقائق المجردة أمام التصورات العاطفية، وأصبح الإدراك مرهوناً بالتحيزات والأهواء، وبدلاً من أن تساعد فكرة سرعة وسهولة الحصول على المعلومة في فضيلة التدقيق والبحث، ما حدث هو العكس، وهو المساهمة في انتشار الإشاعات بل واعتناقها، بعد أن تراجعت المعايير الصارمة في عملية النشر الإعلامية لتصبح القضية برمتها رهناً للأهواء والدعاية المغلوطة.
وهي القضية التي تشغل باحثي الإعلام وعلم الاجتماع والسياسة بصورة متزايدة، في محاولات لتحليل سلوك تبني المعلومة المزيفة ومعاداة العلم، ومن أبرز من كتبوا في هذا الشأن، حتى قبل اعتماد أكسفورد للمصطلح بسنوات، رالف كيز، في كتابه "عصر ما بعد الحقيقة: التضليل والخداع في الحياة المعاصرة" 2004، محذراً من انتشار صناعة السراب المعلوماتي وتراجع مفهوم الوعي المبني على أسس.
وقد برزت أهمية دراسة المصطلح قبل نحو عشر سنوات حينما فوجئ العالم بتأثيرات هذه الصناعة في نهج الرأي العام، بعد انتخاب دونالد ترمب في الولاية الأولى وكذلك الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما عبّرت عنه كتابات الصحافي البريطاني ماثيو دانكونا، كذلك استعرض كتاب لي ماكنتاير "ما بعد الحقيقة" تفنيد أدبيات اللعب بالأفكار في هذا العالم، كيفية صنع حقائق بديلة يتم اتخاذ قرارات مصيرية بناءً عليها على رغم أنها غارقة في التضليل والدعاية السياسية والتجهيل المطلق وتفكيك الأسس الفكرية والمعلوماتية ذات البراهين لمصلحة تحقيق الأهداف، حيث تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دوراً مهماً هنا.
الشعبوية... الخطاب المفضل للساسة
يرتبط هذا المصطلح بشكل وثيق بلفظ الشعبوية، التي صعدت وباتت أيديولوجية تعتنقها كثير من الحكومات باعتبارها آلية عاطفية سهلة لاستقطاب الجماهير، وتُعتبر تأثيرات "ما بعد الحقيقة" إحدى أبرز أدوات الخطاب الشعبوي السائد بين الأحزاب ومؤسسات صنع القرار في عديد من الدول حتى التي توصف بأنها من أعتى الديمقراطيات، فاليمين المتطرف الذي يكسب أرضاً جديدة يوماً بعد يوم، بخاصة في أوروبا، يعتبر الشعبوية طريقة مثالية للوصول لأغراضه، وقد سيطر جدل هذا المفهوم على أدبيات السياسة في السنوات الأخيرة، كذلك يأخذ مساحات كبيرة من النقاش الإعلامي أيضاً.
اللافت أن المصطلح نفسه عُرف في القرن الثامن الميلادي في المنطقة العربية، ويعرفه مجمع اللغة العربية بمصر بأنه "حركة عنصرية فارسية ظهرت في العصر العباسي الأول، لرفع شأن الموالي والغض من محاسن العرب"، ولم يختلف المعنى كثيراً في ما يتعلق بممارساته الأكثر حداثة، حيث تغذية التحزبات وإشعال نزعة الأكثر جدارة واستحقاقية، فقد بدأ كمصطلح سيئ السمعة ارتبط بالاستعلاء الذي مارسه أهل الفرس على العرب، وترويج مشاعر القومية والتفرقة والتعصب، وانتهى به الحال على نفس الموال، لكن اللافت أن ملامحه اختلفت بعض الشيء حينما عاد للظهور في روسيا في القرن التاسع عشر، ثم في أوروبا في ثلاثينيات القرن الماضي، قبل أن تتلاشى أرضية الشعبوية تدريجاً، وأخيراً عادت بقوة في السنوات القليلة الماضية لتغزو الساحة السياسية العالمية بضراوة، وكأنها موضة العصر، وتنشر ثقافة الاستقطاب الحاد في المجتمعات وكأن العالم يعود قروناً للوراء.
ويرى أستاذ العلوم السياسية الألماني يان فرنر مولر أن الشعبوية ما هي إلا ديمقراطية معطوبة، وذلك في كتابه "ما الشعبوية" الذي صدر عام 2016، مشيراً إلى أنه فكرة تعتبر أن الشعب وحدة واحدة منسجمة، ولهذا هي تحمل عداء للاختلاف والتعددية، حيث يُعتبر من أبرز مؤلفات الشعبوية في العصر الحديث، بينما تبعه بعام كتاب "مقدمة مختصرة في الشعبوية" لكاس مود وكريستوبال روفيرا، الذي يرى أن الزعيم الشعبوي يعتبر نفسه مفوضاً لتمثيل إرادة الشعب الموحدة، ضد النخبة الليبرالية التي عادة ما يصفها بالفاسدة.
واللافت أن الأدبيات تختلف في طرح الشعبوية، فالبعض يعتبرها مجرد خطاب أو وسيلة دعائية يمكن أن يلجأ إليها سياسي مهما كان انتماؤه الفكري أو الأيديولوجي، وآخرون يرونها أيديولوجية سياسية قائمة بذاتها، في حين أن مخرجاتها وطرق تطبيقها تبدو بالنسبة لمتخصصي العلوم السياسية وعلماء الاجتماع، أحد مظاهر التراجع الديمقراطي، فيما اعتبرها الفيلسوف الأرجنتيني إرنستو لاكلو، أنها تسيد للقوة الاجتماعية التي تتحرر من القيود، وتلجأ لها الجماعات المهمشة لتحدي السلطة المهيمنة، وقد فجرت أفكار لاكلو نظريات أخرى متعلقة بالاقتصاد تحاول تفسير سلوك الحكومات بناءً على تلك التحليلات.
الصوابية السياسية... بين حلم العدالة وتقييد الحريات
تبدو الشعبوية ومشتقاتها مسيطرة على مفكري هذا العصر، حيث انبثق منها مزيد من الأفكار الداعمة، التي باتت محورية ومستقلة بدورها، على رغم أنها تتلاقى بشكل أو بآخر معها، ففي عام 2004 حذر المفكر والفيلسوف والأكاديمي البريطاني فرانك فوريدي من تفشي مفهوم الشعبوية، في ما يتعلق بالحقل الثقافي من خلال كتابه الشهير "أين ذهب كل المثقفين؟"، وفيه ينتقد فكرة استسلام هذه النخبة للثقافة الجماهيرية الشعبوية ومسايرة الذوق العام حتى لو كان خاطئاً، متخلين عن القيم العليا لمهنتهم، وقد استقبل الكتاب باهتمام بالغ واعتُبر من أكثر الأعمال مساهمة في فتح نقاش أكاديمي مهم حول تأثيرات الشعبوية على دور المثقف الحقيقي الذي من المفترض أن يقاوم فكرة الانقياد ويشجع الاستقلالية الفكرية.
ليعود فوريدي عام 2017 ويستكمل سلسلته بكتاب مهم آخر حول الأفكار السائدة في السنوات الأخيرة والتي تشكل الرأي العام، وهو "ماذا حدث للجامعة"، حيث ينتقد تغول فكرة الصوابية السياسية في المجتمع الأكاديمي، وعلى رغم أن الشعبوية والصوابية يبدوان متضادتين ظاهرياً، لكن الاختلاف بينهما يعزز حضورهما في نقاشات الفرق المتصارعة، إذ يشير الباحث البارز إلى أن الصوابية التي تُمارس في المؤسسات الأكاديمية تلقي بظلالها على المجتمع بأسره نظراً لأن أعداد الطلاب في التعليم العالي ضخمة وقد تصل لنصف المجتمع، إذ وصف ما يحدث باضطرابات توازي في تأثيراتها ما حدث في الجامعات في ستينيات القرن الماضي.
وتساءل فوريدي لماذا يجادل بعض الطلاب بأن الحرية الأكاديمية ليست بالأمر المهم؟ إذ يرى أن الحرم الجامعي بات خاضعاً لأفكار ذات مرجعية أخلاقية لها منظومة محددة فيما سمّاه بالحجر الأخلاقي الذي يتعامل مع الطلاب على أنهم أطفال غير جديرين باتخاذ قرار أو الدخول في مناقشات حرة، وحذر بشدة من التغييرات الجارية في الجامعات بسبب الحساسيات الزائدة بفعل أفكار الصوابية السياسية واليقظة.
ومصطلح الصوابية عُرف منذ أربعينيات القرن الماضي، لكنه بات محورياً في اللغة السائدة منذ 15 عاماً مضت تقريباً، ويُعتبر من أكثر الأفكار التي خضعت للتدقيق في الفترة الأخيرة بمؤلفات وحلقات نقاشية تحاول تحليله وتفنيده، ولم يتوقف الجدل حوله، ومنذ منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين أصبحت الصوابية محوراً أساسياً في النقاشات خارج وداخل المؤسسات الأكاديمية، ونُشرت كتب وأبحاث ودراسات حول تأثيراتها، ما بين مؤيد لها باعتبارها مجرد وسيلة لغوية وسلوكية لتحقيق العدالة، وبين من يراها وسيلة للرقابة الأخلاقية المفرطة المقيدة للحريات بحجة الخوف من الإساءة والتمييز ومراعاة الأقليات والمهمشين والنساء، مما يضعف التفكير النقدي.
ثقافة الإلغاء... أو سياسة العقاب الأبدي بلا رحمة
في إطار الحروب الثقافية أيضاً تحضر بقوة فكرة الإلغاء أو ما عُرف بثقافة الإلغاء العقابية، التي ارتبطت بحركة "أنا أيضاً" والهادفة إلى نبذ وإقصاء ومعاقبة المتورطين في اعتداءات ضد النساء واستغلال سلطتهم أياً كان نوعها لاضطهادهن وإخضاعهن، إذ جرت حركة تصحيح في مؤسسات السينما والإعلام أولاً، ثم تطورت ثقافة الإلغاء العقابية لتطاول المسؤولين والمستعلين بشكل عام وليس من يوجِّهون الأذى للنساء فقط، وكما هو واضح فالأمر مرتبط هنا بشكل وثيق لما تدعو إليه الصوابية، إذ يُحكم بالموت الاجتماعي على مرتكبي الأفعال غير المرغوبة وأغلبها متعلقة بالعنصرية والتمييز العرقي، واستحقار الآخر والاستقواء عليه، حتى لو كان تفسير تلك الأفعال غير قاطع.
ويُعتبر هذا المصطلح من أبرز الأفكار التي ترتبت على سيطرة مواقع التواصل الاجتماعي على حياة الجماهير، حيث ظهر بشكل واضح قبل نحو عشر سنوات تقريباً، مقترناً بدعوات افتراضية بنبذ من يثبت تبنيه لخطابات كراهية ضد الأقليات أو المتحولين أو الحركات النسوية، وبالطبع تزداد العقوبات المجتمعية كلما زاد حجم الجرم، إذ تعتبر وسيلة رادعة وناجحة للمجتمع بالموازاة مع مسار التقاضي لو كان الأمر يستدعي ذلك بالطبع.
وقد برزت بشكل واضح أيضاً مع تنامي صعود حركة "حياة السود مهمة"، في 2020، لكن بالمقابل فإن مناهضي هذا التوجه يعتبرون أن الدعاية السلبية ضد من يخرجون عن النص قد تعتبر هي أيضاً خطاب كراهية، بل قد تؤدي إلى أذى بدني ونفسي يستدعي العقاب، مستشهدين بالواقعة الشهيرة لانتحار الأكاديمي الأميركي مايك آدامز قبل نحو خمس سنوات لعدم تحمله حملات الهجوم ضده بسبب آرائه المناهضة للتحول الجنسي، حيث فُصل من الجامعة وتعرض لحملة مستمرة من النقد والسب، ويُعتبر من أشهر ضحايا هذه الثقافة.
وتحليل تلك الظواهر لم يقتصر على المتخصصين، إذ انتبه رجال السياسة لخطورتها، وبينهم باراك أوباما الذي دعا إلى التأني مذكراً بأن من يحكمون على البعض بالإقصاء من المؤكد أن لديهم زلات وعيوباً أيضاً، بينما اعتبرها ترمب صراحة نوعاً من الديكتاتورية والابتزاز، وتهدف إلى إسكات المعارضين ليس أكثر، حيث تسعى تلك العقوبات إلى المقاطعة الافتراضية والواقعية وتشويه السمعة، ويأتي ذلك تحت بند ما يسمى بالمساءلة والمحاكمة الرقمية أو الافتراضية، واتُّهم مروجوها بأنهم ينتمون لحركات يسارية تهدف إلى تقويض النقاش الديمقراطي.
وقد أثار انتشار هذه الثقافة تساؤلات حول العدالة الاجتماعية وحرية الرأي والتعبير والمسؤولية الأخلاقية، إذ يعتبرها البعض أنها تخرج من بند المحاسبة المحمودة والمساءلة الجماهيرية والنقد الشعبي إلى المراقبة الاجتماعية التي تؤدي إلى انتقام دائم وليس مجرد عقوبة موقتة، بل تكرس لمبدأ عدم التسامح الفكري وتنصب مشانق ومحاكم أخلاقية للمختلفين في الرأي، وتضرب الحريات في مقتل، وبينها حرية الفنون والأبحاث العلمية، ومن أبرز الأكاديميين والمهتمين بالشأن الثقافي الذين حللوا الظاهرة وفندوا الأيديولوجيات المرتبطة بها سلباً وإيجاباً، جوناثان هايدت وكيمبرلي فوستر وإيف نج.