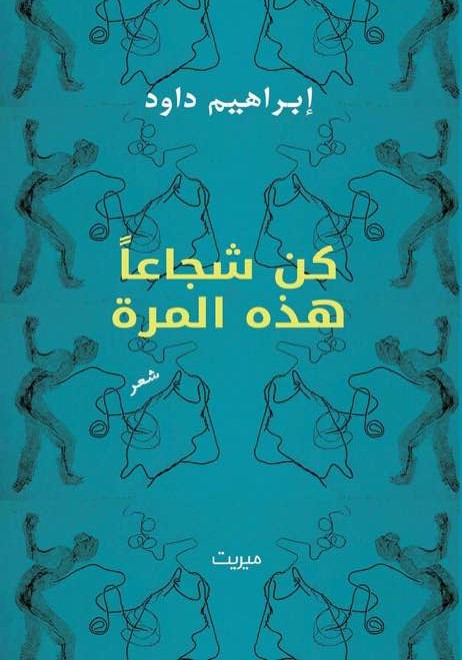يعد إبراهيم داود (1961) من أبرز شعراء جيل الثمانينيات في مصر، وقد صدر له العديد من الدواوين على مدار رحلته الشعرية، بدأها بديوانه اللافت والدال على جمالية شعره التى ازدادت مع الوقت تنوعاً وعمقاً، وهو ديوان "تفاصيل". ثم توالت أعماله: "مطر خفيف في الخارج"، "الشتاء القادم"، "يبدو أنني جئت متأخراً"، "أنت في القاهرة"، و"كن شجاعاً هذه المرة". ولم تقتصر كتابة داود على الشعر بل امتدت إلى كتابة الرواية والقصة في "الجو العام"، و"خارج الكتابة". بالإضافة إلى كتاباته المتميزة في الصحافة التي يغلب عليها طابع السرد ورسم الشخصيات واللغة الشعرية الحميمة، كما يبدو في "طبعاً أحباب – جولة في حدائق الصادقين". وقد حصل داود، الذي يشغل حالياً منصب رئيس تحرير مجلة "إبداع" القاهرية العريقة،على العديد من الجوائز، لكن تظل جائزته الكبيرة هي ذلك الإبداع المتنوع الفريد.
تعد تجربة إبراهيم داود من التجارب ذوات الخصوصية الواضحة من حيث اهتمامه بالتفاصيل الصغيرة واستبطان الذات واعتبار الشأن العام شأناً خاصاً. أو لنقل إننا أمام حالة من شخصنة العالم أو رؤيته من خلال زوايا الذات الحميمة. ويفسر ديوانه الأول هذا التوجه الجمالي الذي ظل داوود حريصاً عليه. هناك إذاً انكسار لنموذج الشاعر المتنبئ، أو حتى الطليعي الذي شاع في الموجة الأولى من الموجات الشعرية المعاصرة والتي مثلها شعراء جيلي الريادة والستينيات اللذين اشتركا في خصائص جمالية مايزت بينهما وبين الموجة الثانية التي اقتصرت على جيل السبعينيات، ثم الموجة الثالثة التي شملت الثمانينيات وما بعدها، وينتمي إبراهيم داود إلى تلك الأخيرة.
جماليات جيلين
وفي حوار أجريته معه بدأت بالسؤال: هل ترى فارقاً بين نشأة جيل السبعينيات وجيل الثمانينيات الذي تنتمى إليه؟ وكيف أثر هذا الفارق على جماليات الجيلين؟ فكان رده: "بالطبع يوجد فارق كبير، هوجيل الهزيمة الذى وجد نفسه وهو يبدأ الحياة مطالباً بالتعبيرعن نفسه بطرائق غير مألوفة، بدأ الحياة فى مناخ معاد للثقافة والشعر فقرر أن يعتزل الجمهور العام ويتعالى عليه، خاض أكثر من معركة فى وقت واحد، انشغل بالتنظير حول الشعر أكثر مما ينبغى. من الصعب إدانة شعراء هذا الجيل، لأنهم اعتقدوا أن معاركهم مع الشعر السائد هى معركة وطنية، وكان احتفاء الصحف العراقية والسورية والخليجية بتجاربهم بعد كامب ديفيد سبباً فى إيهامهم بأنهم رواد جدد فى الشعر العربى. لو تأملت مصائرهم بعد ذلك ، ستكتشف أن عدداً ليس قليلاً منهم تراجع عن قناعاته السابقة، وكتب شعراً فى غابة العذوبة، لأنهم اكتشفوا أن تجاربهم "المعملية" لم تصمد أمام التجارب التى جاءت بعد ذلك. أحب حلمي سالم وشطحاته، وأحب أيضا استطعامه للتجارب الجديدة، وأحب شعر أحمد طه رغم قلته، وأحب رحابة صدر محمد بدوى، وقصائد جمال القصاص وعبد المقصود عبد الكريم الأخيرة. أحب تجربتى محمد صالح وفريد أبو سعدة. الزمن غير فى الجميع حتى فى جيلى، اختفت "الميلشيات" الشعرية التى كانت رائجة فى السبعينيات والثمانينيات على هيئة جماعات شعرية لا تعترف إلا بإنجاز شعرائها، أومجلات محدودة التأثير. أما جيلى فهو جيل نجح فى الإنحياز للشعر والحياة، ليتغلب على صعوبات الحياة، فهو جيل كان غير مرحب به من الجيل السابق، ولا من المؤسسة الرسمية. ولم يرتبط بمصالح مع الأكاديميين والمستشرقين، ولم يشغل باله باعتراف كهنة الثقافة العربية أمثال جابر عصفور وأدونيس. وتلاميذه جيل أخلص للكتابة فقط، وأنتج أسماء رائقة أصبح لها حضور رائع، ليس فى الشعر فقط، ولكن أيضا فى العمل العام. وانحيازى لهذا الجيل ليس بسبب انتمائي اليه، ولكن لأنني مثل غالبيتهم. جئنا من بيئة متشابهة ولم يدع أحد االريادة، رغم الدور الكبير الذى لعبه هذا الجيل فى قصيدة النثر، وجعلها قصيدة مصرية عربية لا تستند إلى تجارب الآخرين فى لبنان والشام والشعرالمترجم. لم يتربح أحدنا من الكتابة ولم يبحث أحدنا عن مجد ما، كتبنا، ولكل واحد صوته الخاص، وطريقته فى القنص. توجد أصوات جميلة ظهرت بعد ذلك لا شك، ولكن إخلاص جيل الثمانينيات للشعر، رغم التجاهل النقدي من الحرس القديم، هو الذي جعله يستمر ويبدع فى مناخ غير شاعري بالمرة".
تأثير الكبار
قلتُ له: لماذا انحزت شعرياً إلى اليومي المعيش؟ هل كان ذلك بتأثير من شعر ريتسوس؟ قال: "منذ ديواني الأول "تفاصيل"، أطلق عليَّ بعض النقاد لقب شاعر التفاصيل الصغيرة، ولم أعلق ولم أعترض، لأن من حق أي شخص أن يقول ما يريد. ولكني إلى الآن أستغرب اللقب، كأن التفاصيل الصغيرة لم تكن موجودة في الشعر العربي منذ إمرئ القيس حتى أمل دنقل. اختيار التفاصيل الصغيرة ليس قراراً مسبقاً، أنا أكتب قصيدة تخصني، وتشير إليَّ وإلى زمني، تعبر عني، قصيدة أبحث بها عن أصدقاء، لأبدد وحشة هذا العالم. وإذا سألتني عن الذين أثروا فيَ من الشعراء الكبار سأقول لك: هم محمد الماغوط وأحمد عبد المعطي حجازي ونزار قباني وعبد الرحمن الأبنودي، وبدرجة أقل محمود درويش، وقبل الجميع محمود حسن اسماعيل، وأقدر الشعراء الكبار جميعاً، فمثلاً محمد عفيفي مطر كان من أقرب أصدقائي، وربما تأثرت باعتزازه بكونه شاعراً. وأحببت أمل دنقل وسركون بولص ووديع سعادة وأنسي الحاج، تماماً كما أحببت سعدي يوسف. وأحب من شعراء جيلي كثيرين، مثل علي منصور ومحمود قرني وفاطمة قنديل وإيمان مرسال على سبيل المثال. أما عن تأثري بالشعر المترجم، فأحببتُ كفافيس جداً، وريتسوس طبعاً ورامبو وأونغاريتي، وكانوا ملهمين لي في فترات من حياتي. وكما قلت لك أنا لا أعرف طريقة للكتابة غير التي أكتب بها، ولا أدعي أنني منفصل عما يحدث عربياً، وأعتقد أن الشعر العربي في كل الأقطار فى حالة جيدة جداً، ربما أفضل من فترات كثيرة سابقة. ولكننا كما تعرف في قطار يقوده أشخاص يرتابون في الخيال الجديد، ولا يريدون التعرف على شعراء صادقين".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
سألته: يبدو أنك ترفض الطابع المعرفى فى القصيدة، فهل كان ذلك هو سبب وصفك لأدونيس بأنه قيمة ثقافية كبيرة لكنه غير مؤثر في الشعر؟ فقال: "أنا لا أرفض الطابع المعرفي، ولكنى أميل أكثر الى الشعر الذى يهزنى كشخص عادى يحب الشعر الصادق الذى لا يدعي شيئاً، ولا أريد من الشاعر أن يعلمني، أريده صديقاً مهموماً بالبشر ومصائرهم، ويعبر عن البشرية فى هذه اللحظة. المعرفة متاحة فى الكتب، ولكن الشعر ينتجه الشعراء، أدونيس شاعر عظيم لا شك، ومؤثر فى الثقافة العربية منذ خمسين عاماً، ومثير للجدل دائماً، وأنا أقدره، وله قصائد أحببتها كثيراً، ولكنى لا أميل إلى تصوراته المسبقة قبل الكتابة".
طابع السرد
قلت له: يحمل شعرك طابع السرد، فلماذا كان اللجوء إلى السرد الروائي والقصصي؟ هل هو تأثر بمقولة "زمن الرواية"؟ فأجاب: "الحياة من وجهة نظري هى المصدر الأول للمعرفة، وحياتي مزدحمة بالتجارب، وطريقتي في الكتابة استفادت من خبراتي الشخصية مع البشر في المقاهي والأحياء الشعبية التي عشت وأعيش فيها طوال حياتي. يوجد شعر غزير في الحوارات الجانبية بين الناس، تلهمني أحياناً، أما عن الكلام الخاص بزمن الرواية الذي راج منذ عشرين عاماً أو يزيد، فهو كلام فارغ، أطلقه النقاد الكسالى الذين لا يوجد لديهم الوقت لمتابعة الشعر الجديد، الذي لا توجد له جوائز، مقارنة بجوائز الروايات. يستطيع الناقد أن يقرأ رواية ويكتب عنها مقالاً في ساعتين، متسلحاً ببعض القناعات الأيديولوجية أو النقدية، ليبدو مشتبكاً مع الواقع الثقافي، وأيضاً ليتم اختياره عضواً في لجان التحكيم السخية. ولكنك إذا نظرت إلى زمن الرواية هذا في عالمنا العربي، تستطيع أن تقول وأنت مطمئن، أنه توجد حالة روائية جيدة، ولا توجد رواية عظيمة، الرأسمالية في حاجة إلى حكايات، لكي يشعر المستهلكون في العالم كله أنهم يعيشون معاً، بعد أن فرضت التماثل الإجباري على الكوكب".
الهموم الفردية والعامة
سألته: تمزج برهافة بين الهموم الفردية والعامة فكيف استطعت تحقيق هذه المعادلة الصعبة؟ فأجاب: "أكتب لأنني لا أجيد شيئاً آخر، وأبحث كما قلتُ عن أصدقاء بالكتابة. أكتب لكي أسعد أصدقائي، أكتب لكي أتجاوز المطبات التي وضعها القبح في الطريق. أنا شخص وحيد وحزين وحالم، أواجه متطلبات الحياة بالعمل والركض وكتابة الشعر والمقالات. يزداد الشعر صعوبة يوماً بعد يوم، وكنت أتمنى أن أتفرغ لكتابته، أو للكتابة التي تخصني بشكل عام. همومي هي هموم الجميع، أنشد الألفة والعدالة والديمقراطية، وأعبرعن همومي بطريقتي خارج الكتابة، والتي أتفادى من خلالها الحديث عن الموضوعات الكبرى. وساعدتني قصيدة النثر بإمكانياتها العظيمة على التعبيرعن نفسي وعن زمني بلغة خالية من الشحوم البلاغية".
قلتُ: هل تشعر بتكرار بعض التيمات الموضوعية والجمالية في شعرك؟ فأجاب: "عالمى بسيط، ولغتي ومفرداتي وتكويني تعيش معي، قد يحدث تشابه في طرائق القنص، لأنني الشخص نفسه".
العمل في الصحافة
سألته: لماذا كانت المفارقة إحدى سمات شعرك الرئيسية؟ هل يعود ذلك إلى تمثلك للروح المصرية في رؤيتها للحياة؟ قال: "المفارقة تولد أحياناً شعراً، ولكنها لا تفعل هذا دائماً، وأنا كما قلت شخص عادي، يحب كرة القدم والغناء وفن تلاوة القرآن، ومشغول بفنون أخرى، وأعيش وسط بشر طيبين، أنحاز لأشواقهم، التي هي أشواقى. وأحاول أن أعبر عما بداخلي بطريقتهم، أحب أصدقائي خارج الوسط الثقافي، ويوجد عدد كبير منهم غير مهتم بالشعر أو الثقافة، ولا يقرأ ما أكتب، ولكن وجودهم في حياتي مصدر إلهام حقيقي".
قلت له: تمتاز لغتك بالبساطة والوضوح، فهل كان لاشتغالك بالصحافة دور في هذا؟ فقال: "أفضل فترات حياتي مع الكتابة، هي الفترات التي كنت مشغولاً فيها بالعمل الصحافي. أحببت هذه المهنة، وشاركت في تجارب مهمة، وكنت مسؤولاً فى أكثر من مكان، ولست مع القائلين إن الصحافة تعطل عمل المبدع. هيمنغواي كان صحافياً وماركيز أيضاً. هي مهنة تدربك على الاستجابة، وتشعر كأنك في وسط الأحداث طوال الوقت. وأعتبر أن الذين لم يمتهنوها، فاتهم إحساس عظيم. هي حالة سيئة في العالم العربي منذ سنوات، لأسباب يعرفها الجميع، وعودتها إلى لياقتها مفيد جداً لكل أشكال الكتابة".