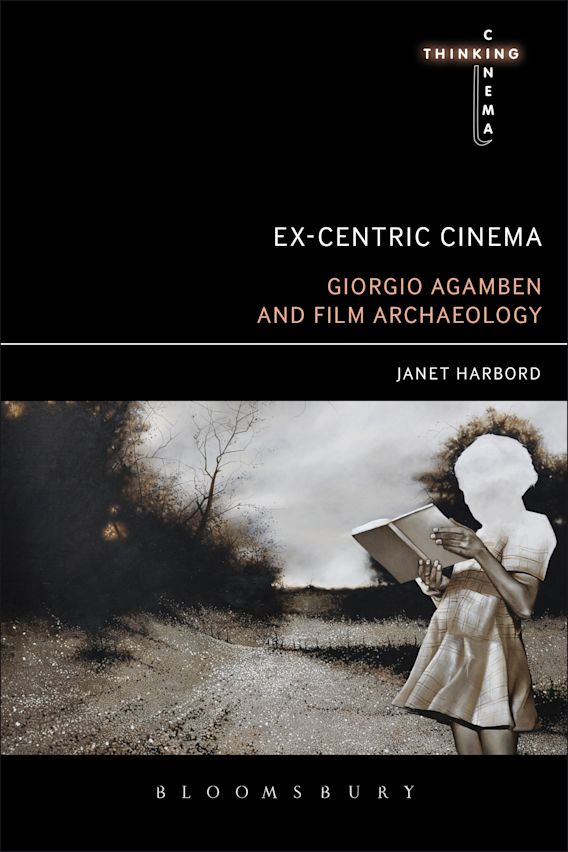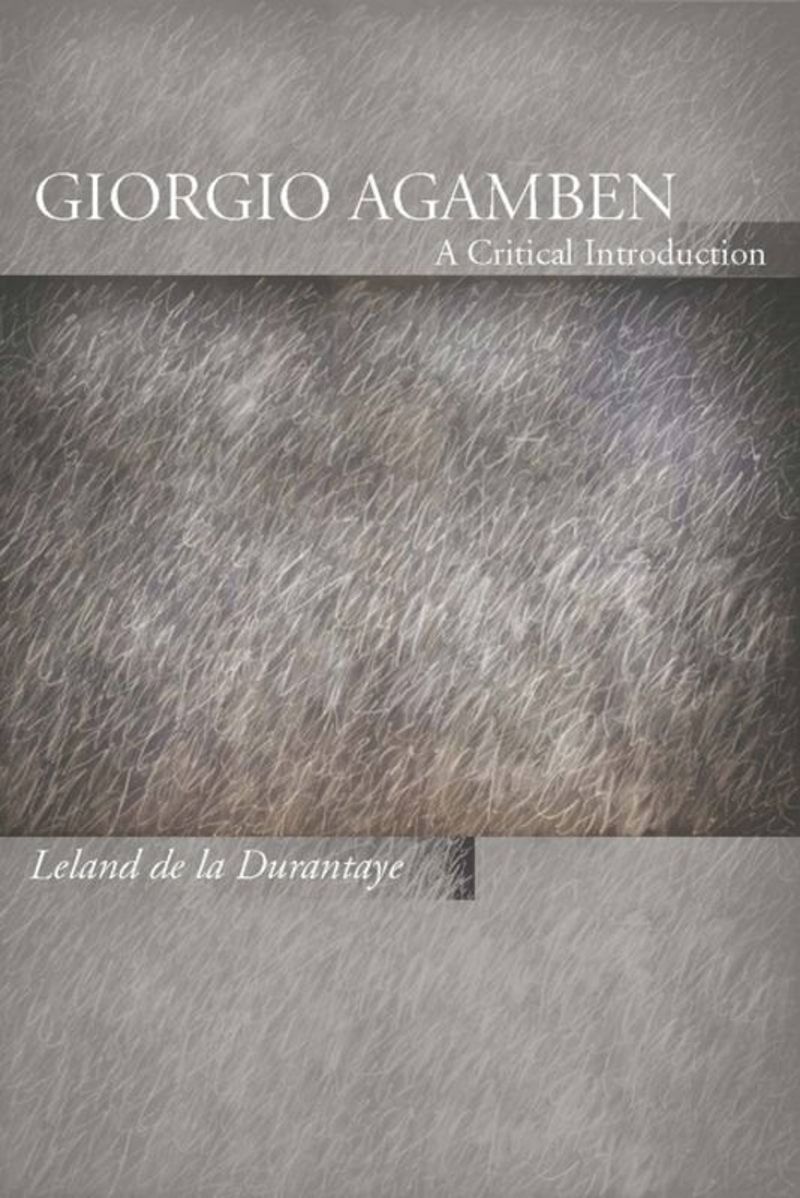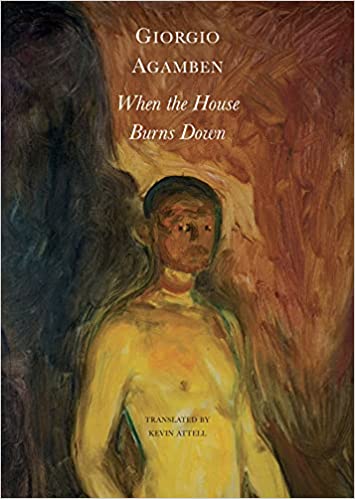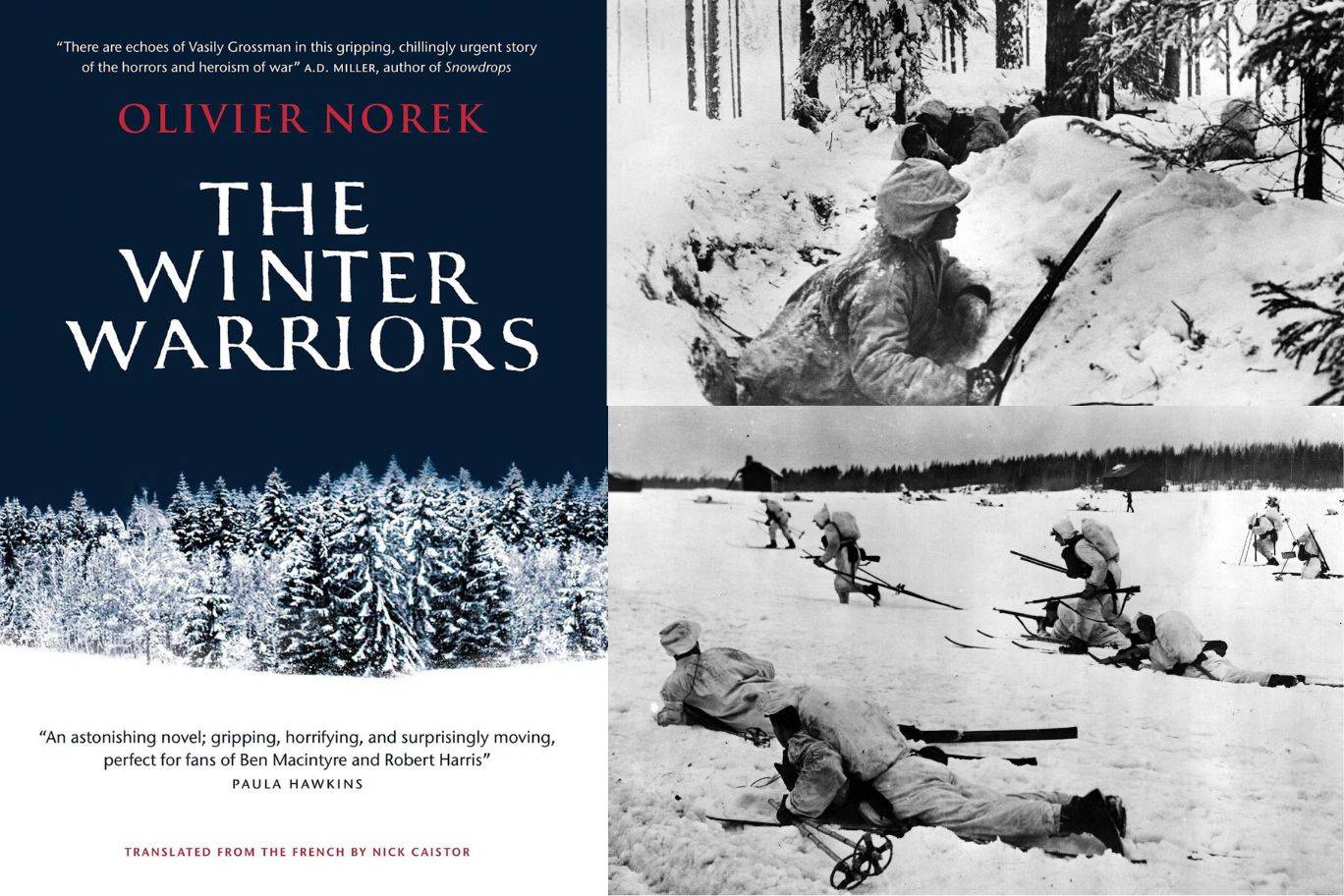جيورجيو أغامبن (1942) فيلسوف إيطالي يناصر النظرية السياسية الراديكالية التي تروم إعادة صوغ الفكر الإنساني وبناء الاجتماع المعاصر برمّته. بلغ أثره العالم الأنغلوساكسوني الذي اعتنى بترجمة أعماله وإذاعة مضامينها الثورية الراديكالية. ولد في روما ودرس في جامعاتها القانون والفلسفة، وأعدّ عام 1965 أطروحة الدكتوراه في فكر الفيلسوفة الفرنسية سيمون ڤايل (1909-1943) السياسي. وما لبث أن تابع حلقات البحث في مرحلة ما بعد الدكتوراه مستمعاً إلى محاضرات الفيلسوف الألماني هايدغر (1889-1976) ومشاركاً في حلقاته الدراسية التي تناولت عام 1968 هيغل وهيراقليطس. درس الفلسفة في جامعات إيطالية شتى، واضطلع بمسؤولية إدارة البرامج في معهد باريس العالمي (Collège international de Paris). دُعي إلى التدريس في بعض الجامعات الأميركية، لا سيما في جامعة نيويورك. من الأحداث الأمنية البارزة التي تكشف عن جذرية آرائه واقتناعاته أنه، إثر هجمات أيلول 2001 الإرهابية، رفض الخضوع للفحوصات البيولوجية والاستقصاءات السياسية التي كانت تفرضها دائرة الهجرة الأميركية من أجل منحه إشارة الدخول.
تنوعت المصادر الفكرية التي أثرت في بناء عمارته الفكرية. لا ريب في أن أعمال الفيلسوف الألماني ڤالتر بنيامين (1892-1940)، لا سيما "أصول الدراما التراجدية الألمانية (Ursprung des deutschen Trauerspiels) ونقد العنف" (Zur Kritik der Gewalt)، فتحت له آفاقاً رحبة من التناول الفلسفي النقدي الأصيل. لا بد أيضاً من ذكر الأثر العظيم الذي خلفته في وعيه أعمال أرسطو (384-322 ق. م.) وهيغل (1770-1831) وهايدغر. كان لإسهامات عالم اللسانيات الفرنسي إميل بنڤنيست (1902-1976) وفيلسوف السياسة الألماني الحقوقي كارل شميت (1888-1985) والفيلسوفة الألمانية هانا أرندت (1906-1975) الأثر الواضح في توجيه مباحثه واجتهاداته. فضلاً عن ذلك، ينبغي أن نشير إلى الأثر البليغ الذي تركه اثنان من المفكرين المتمردين: مؤرخ الفن الناقد الألماني أبي موريتس ڤاربورغ (1866-1929) الذي عمل أغامبن في المعهد الذي يحمل اسم هذا المؤرخ في مدينة ڤاربورغ (إقليم ڤستفالن الألماني)، والناقد الفني الماركسي الفرنسي غي دبور (1931-1994) الذي اشتهر بكتابه الثوري "مجتمع المشهد" (La société du spectacle) وأسهم في نشأة تيار الوضعيات الحياتية الثورية (L’Internationale situationniste)، داعياً إلى مناهضة هيمنة المنطق الاستهلاكي ومحرضاً الناس على تغيير العالم بواسطة نبذ الأشكال الفنية المألوفة المعتمدة في الحياة اليومية.
عجز اللغة شرط نشوء الخطاب
يتناول أغامين اللغة في قدرتها على استثارة أغراض المعرفة، فيذهب في كتابه "اللغة والموت" (Le langage et la mort) إلى أن ماهية الإنسان لغوية في صميمها، إذ إن اللغة تختبر الأشياء اختباراً وجودياً يجعل الإنسان يحس أنه قريب منها. ومن ثم، فإن اللغة لا تعترف بحدود تأسرها في قدرتها على التعبير، بل حدود اللغة ترسمها اللغة عينها من الداخل. لا يلبث أن يعود إلى مسألة اللغة في كتابه "الطفولة والتاريخ" (Enfance et histoire)، فيعلن أن الطفولة تختبر اللغة في غيابها وصمتها، أي تمتحن اللغة المفقودة المكتومة التي يستخدمها الرضع وحديثو السن. خلافاً لمنطق الأزمنة المعاصرة التي تخنق الاختبار الإنساني، لا سيما اللغوي، وتزجه في متاهة التفاهة والابتذال، تنبغي إعادة تأهيل الاختبار الإنساني في جميع أبعاده، واستنقاذ موقعه الأصلي في صميم التعبير اللغوي. ذلك بأن الاختبار يقترن باللغة، لا بالوعي، في المقام الأول، إذ إن الذات الإنسانية تجد في اللغة موقعها وأصلها وحيويتها.
سقطت مقولة الاختبار الإنساني في الأزمنة المعاصرة بسبب الفصل الحاد الذي أنشأه العلم الحديث بين الذات المختبرة وموضوع المعرفة. حتى الفلسفة الحديثة التي أعادت ترتيب موقع الذات، لا سيما في عمارة كانط (1724-1804) وهيغل، أفقدت الإنسان القدرة على اختبار الأمور اختباراً أصلياً مباشراً. يعتني أغامبن باختبارات الطفولة التي تشعر بالحياة وتدرك الموجودات على نحو عفوي من غير أن تستعين بمقولات اللغة. لا ريب في أن مثل الاختبارات العفوية هذه تدل على أن الإنسان يختبر الحياة اختباراً يسبق اللغة ويتقدم عليها، بحيث تصبح الحياة شرط نشوء اللغة وأساس حيويتها المتدفقة.
يعتقد أغامبن أن الميتافيزياء الغربية أوصلت الفكر إلى العدمية، إذ إنها أغرقت في تدبر السلبية الناشطة في معترك الواقع. فإذا بالميتافيزياء عينها تتحول إلى أنظومة أخلاقية ترعى مواضع العدمية في اختبارات الوعي الإنساني. ومن ثم، فإنه ينتقد الفكر الغربي ويعيب عليه أنه أضعف اللغة محدثاً فيها انفلاقاً حاداً، إذ استدل على مواضع العجز في التعبير وحدد أسباب اللاقابلية الإبلاغية. وما لبث هذا الفكر أن أعلن أن عجز اللغة عن وصف وقائع الاختبار الوجودي إنما هو السبب الأساسي والشرط الأول في نشوء أي خطاب لغوي. يدعو أغامبن هذا الشرط المكتوم في اللغة "الصوت" المهيمن سراً، فيعلن أن كل فلسفة تفكر تفكيراً خاضعاً لهيمنة هذا "الصوت" لا تستطيع أن تحرر الميتافيزياء من العدمية التي أفضت إليها. وحدها اختبارات الطفولة التي تسبق اللغة والتي لا تخضع لهيمنة هذا "الصوت" يمكنها أن تأتينا بالحل الشافي، إذ إن براءة الطفل الذي يختبر الحياة تجعله يحيا في اللغة من غير أن يستدعيه وينتهره أي صوت مكتوم مجهول النيات والمآرب، وتجعله يموت من غير أن يستغرقه الموت أو يقبض عليه. على هذا النحو، تستطيع البشرية أن تسكن الموطن الأخلاقي الذي يليق بها.
لغة الشعر ولغة الفلسفة
من جراء اعتنائه بلغة الشعر، أسهم في كتابه "ستانزاس "(Stanzas) في إنشاء تصور جمالي يستوحي أعمال هايدغر وأبي موريتس ڤاربورغ. بعد أن تأمل في التمييز الخاطئ الذي أثبته الفكر الغربي بين لغة الفلسفة ولغة الشعر، راح يبيّن أن المعرفة الإنسانية اصطدمت بإخفاق الفلسفة في إنشاء لغة إلهامية خاصة، وبفشل الشعر في بناء منهجية واضحة وتسويغ الوعي الذاتي السليم. لذلك على الإنسان الغربي اليوم أن يتوسل بالنقد المستنير حتى يعيد اكتشاف الوحدة العميقة التي تعصم كلمتنا من التبعثر وتحفظها من الضياع. من وظيفة هذا النقد أن يصون وحدة التعبير الكلامي، من غير أن يدعي القدرة على التصور الصائب أو المعرفة الدقيقة، ولكن بالاستناد إلى مغامرة معرفة عمليات التصور. ومن ثم، ينبغي له أن يعارض كلا الفلسفة والشعر، وأن يواجههما باختبار الابتهاج بما لا يستطيع الإنسان أن يملكه، واختبار امتلاك ما لا يستطيع أن يبتهج به.
العقل الميتافيزيائي الغربي يقسم الكائنات
في هذا السياق، يستعين أغامبن بنقدية الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا (1930-2004) الذي يربط الميتافيزياء الغربية بمقولة الحضور الذي يستطيع الإنسان أن يهيمن عليه. كل ما هو حاضر في الأشياء والوقائع والاختبارات والكلمات يصبح موضوع هيمنة العقل الميتافيزيائي. غير أن دريدا لم يبلغ أقاصي التفكيك والتجاوز، بل اكتفى بنقد مقولة الحضور في الميتافيزياء الغربية. لذلك يعمد إلى تعريف آخر يتناول الميتافيزياء في انحرافها وسيطرتها على معاني الأشياء. فاللوغوس الغربي، أي العقل والخطاب ومنطق الاستقصاء، يشبه التجاعيد المتراصفة التي تستجمع الأشياء بالإكراه وتستولد بينها القسمة والاضطراب من أجل أن تعيد ضمها في محضر تعسفي قاهر. المطلوب إذاً ضبط العملية التعسفية هذه، لا الاشتغال على أطراف النزاع.
اقتداءً بالنموذج النقدي هذا، أكبّ أغامبن في كتابه "فكرة النثر" (L’idée de la prose) على معالجة ضمة من المواضيع تناول فيها مشكلات اللغة وخصائص النثر والشعر وقضايا السياسة والعدالة وإرباكات الحب والعار. بسبب أصالة التعبير وجذرية الطرح، يعسر على القارئ أن يدرك مقاصد الفيلسوف في هذه التأملات. غير أن الواضح في تناولاته هذه رغبته بإلغاء الحدود الفاصلة بين الفلسفة والشعر بواسطة تفكيك بنى اللوغوس عينه. فإذا به يستثمر ضروباً شتى من الأساليب والتقنيات الأدبية، كالقصص الخيالية والألغاز والشذرات الإيحائية والروايات القصيرة، لكي يمارس النقد ممارسةً تجعل الفكر يتحول إلى اختبار نثري يوقظ الإنسان من رقاده، ويستحث الوعي على الاكتفاء بمعرفة متواضعة تقتصر على عملية التصور، ولا تدّعي القبض على مضامين ومحتويات وخلاصات وهمية.
تسلط التقنية المعاصرة
استناداً إلى معايناته الميتافيزيائية واستقصاءاته اللغوية، ينصرف أغامبن في كتابه "الإنسان المفروز: السلطة السيادية والحياة المعراة" (Homo Sacer. Le pouvoir souverain et la vie nue) إلى بناء نظرية في السياسة تعارض خلاصات فوكو (1926-1984) الذي كان يظن أن الحداثة الغربية نقلت السلطة من مفهوم السيادة على الذات إلى مفهوم السيادة على الحياة، إذ تحول الإنسان إلى رهينة يهيمن عليها السلطان السياسي الذي بات يدير تقلبات الحياة البيولوجية برمّتها. من بعد أن كان الإنسان كائناً حيّاً يمتلك القدرة الإضافية التي تؤهله للانتظام السياسي، أصبح في الأزمنة المعاصرة كائناً خاضعاً للسياسات التي تطرح وجوده كله على بساط المساءلة الكيانية الأخطر. خلافاً لفوكو الذي يصر على أن تعاظم السلطة على الحياة البيولوجية يطبع الحداثة الغربية كلها بطابعه الحاسم، يصرح أغامبن بأن التقنية الحديثة أغرقت الناس في مغاورها المظلمة، وبأن السلطة السيادية والسلطة على الحياة البيولوجية امتزجتا امتزاجاً خطيراً بحيث إن إنتاج الجسد الخاضع للأمر البيولوجي ينبثق أصلاً من ممارسة السلطة السيادية. ومن ثم، فإن ما يميز الديموقراطية الحديثة من نظام المدينة الإغريقية القديمة (البوليس) ليس استدخال الحياة البيولوجية في دائرة التدبير السياسي، بل بالأحرى قدرة الدولة الحديثة على ربط هذه الحياة بالسلطة السياسية ربطاً محكماً مصيرياً لا مهرب منه. الحقيقة أن الدولة الغربية الحديثة أسست كيانها على مفهوم الحياة المعراة التي أصبحت خاضعة لقانون التقنية الجارفة.
استغلال قانون الوضعية الاستثنائية
لا ريب في أن هذا الإخضاع مرتبط بقانون الوضع الاسثتنائي الذي يبيح استخدام القوة القاهرة، وفقاً لنظرية الفيلسوف السياسي الألماني كارل شميت. غير أن الوضعية السياسية الحديثة أضحت بمنزلة الاستثناء الدائم الذي يسوغ اللجوء إلى القوة المفرطة وتعليق القانون واستخدام سلطان الحاكم المطلق. وعليه، لم يعُد استخدام القوة مقتصراً على الوضع الإشكالي الاستثنائي، بل أضحى القاعدة الأساسية التي تسوّغ للحاكم أن يمارس سلطانه السيادي حتى على الحياة عينها. يصف أغامبن هذا الوضع بزمن التخلي الذي يصبح فيه القانون نافذاً بقوة الإكراه، ولكن من غير أن ينطوي القانون على أي مضمون تشريعي. ولا يلبث أن يستعين بصورة الإنسان المفروز (homo sacer) في الحضارة الرومانية، أي الإنسان المنبوذ من المدينة يجوز قتله، ولكن لا يجوز استخدامه قرباناً يُضحّى به تضحية التكفير والاسترحام. الإنسان المفروز كائن استثنائي خرج من دائرة القانون المدني والناموس المقدس، فسقط في منطق التوحش البري خارج منطق الشريعة المطلق. أما الخلاصة التي يفضي إليها أغامبن، فتقضي بأن الاستثناء الروماني القديم هذا لم يعُد مقتصراً على بعض الناس، بل أصبح بمنزلة الوضعية الطبيعية التي تصيبنا جميعاً في المدينة الإنسانية المعاصرة. ذلك بأننا أضحينا كلنا، احتمالياً، في وضع الإنسان المفروز.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في إثر هذا كله، يستعيد أغامبن صورة الحياة المعراة المجردة من كل قيمة، الخاضعة لسلطان الدولة الحديثة التي تمارس القهر على كل إنسان جاعلةً الاستثناء القاعدة الوحيدة المعتمدة. استناداً إلى التمييز الذي أنشأه أرسطو بين الحياة الطبيعية (zoe) والحياة المنسلكة في نطاق شريعة المدينة (bios)، يبيّن أن الحياة الطبيعية تسيست وتمنطقت وتمأسست وتأللت، أي جرى إخضاعها بالقوة للآلة التقنية المهيمنة. فإذا بالحياة عينها تكف عن الانتساب إلى الطبيعة وإلى المدينة، لتظهر في هيئة هجينة، هيئة العري المجرد الذي يعرّضها للموت المستولد بالسلطان السيادي. وكما فقد القانون مضمونه التشريعي الإنسي، كذلك فقدت الحياة ميزتها وفرادتها وخصوصيتها، بحيث أضحت خاضعة للجسد البيولوجي الذي يفرض قانونه على المسلك الإنساني.
خلاص الإنسان في التواصل
إذا كان الانتقال من الصوت إلى الكلام يجعل الإنسان، وفقاً لأرسطو، ينشئ المدينة الإنسانية وينتظم فيها انتظاماً يرعى أصول العدالة، يرسم أغامبن أن الحياة الطبيعية المعراة لا تقطن في المدينة الإنسانية إلا على قدر ما تحفظ للصوت الخفي المهيمن سراً قدرتَه على معارضة القهر الاستثنائي. في كتابه "وسائل لا غاية لها "(Moyens sans fins)، يستلهم ڤالتر بنيامين ليصرح بأن السياسة ليست غاية بحدّ ذاتها أو وسيلة معقودة على غاية. السياسة بالأحرى وساطة تواصلية محض لا غاية لها ترهق الناس في التخطيط والإنجاز. فكيف يمكن تصور الإنقاذ الذي يعيد إلى الإنسان قدرته الذاتية على ابتداع كيانه الخاص؟ يتصور أغامبن السياسة الخلاصية المقبلة قائمة على خلاصتَين: خلاصة هيغل الذي يعلن اكتمال التاريخ في تجلي الروح المطلق، وخلاصة هايدغر الذي يستعين بمفهوم الإرأيغنيس (Ereignis)، أي التأتي العفوي الذي يجعل الكينونة تأتي الكائنات من غير أن تفقد سر انحجابها الإلهامي، بحيث يختبر كل كائن التملك الذاتي على الخاصية اللصيقة به في صلته العميقة بحقيقة هذه الكينونة. بفضل تواطؤ الخلاصتَين، تنبثق حياة مزهرة وتنشأ سياسة جديدة تجعلان التاريخ والدولة الحديثة يبلغان أقصى طاقاتهما، فينطفئان ويذويان وينتهيان معاً. لا شك في أن النوع الجديد من السياسة التي لا تحيل على السيادة ولا تقترن بمفاهيم الأمة والشعب والديموقراطية يتطلب بناءً سليماً تقوم فيه الحياة السعيدة على التواصلية المجردة بين الناس.
معيار الأخلاق
ما دام قانون الاستثاء الإكراهي يسود الدولة الغربية الحديثة، فإن الأخلاق التي تليق بالإنسان المعاصر ينبغي أن تنعتق من ذهنية التشريع وتستند إلى روحية الشهادة المستلّة من معاينة التشوه الكياني الذي يصيب الإنسان في معتقلات الذل، ومنها معتقلات النازية الوحشية. لشدة ما ارتعد أغامبن من مشاهد العنف الوحشي الذي أصاب المعتقلات الأيديولوجية، أعلن أن الإنسان المذلول الذي يتألم في جسده وروحه فقد صفة الإنسانية، فأضحى في منزلة بين منزلتَين: الإنسانية التي شوهها عنف الاستبداد، واللاإنسانية التي ارتسمت على كيانه المشطوب من الوجود. الموزلمان (Muselmann) هو الاسم الذي أُطلق على إنسان المعتقلات النازية ليدل على مقام التحقير الذي جعل أغامبن يشك في صحة الانتساب إلى الإنسانية. بمعزل عن التأويلات التي عاينت أيضاً في هذا الاسم إشارةً إلى الإنسان المسلم المعذب، يرى أغامبن أن الذل الكياني في معتقلات الإجرام النازي قضى على أصول الأخلاق السائدة ومفاهيمها المعتمدة، من مثل الكرامة والقيمة الذاتية والاحترام والواجب، واضطر الجميع إلى التفكير في أخلاقيات جديدة لا تستند إلى مفهوم الكرامة الإنسانية.
في سياق مثل هذه الأخلاقيات، تظهر الذات المتكلمة الفاعلة في مظهر الأنا المكتومة الهوية والصوت. ذلك بأن الذي يتكلم لا يستطيع أن يحسم أمره ويجزم أنه قادر على الاضطلاع بمسؤولية كلامه الملقى في متاهات العالم الضائع. ثمة تعارض خطير ينشأ بين الذات التي تتكلم، والذات التي تحيا في قرائن الذل المهيمن. في صميم هذا التعارض تنشأ الأخلاقيات المبنية على الشهادة، يؤديها الإنسان الذي تعطلت قدرته على الكلام وعلى ربط كلامه بحياته المتبعثرة المتشتتة المضللة. ولكن ما معنى هذه الشهادة التي يعتصم بها أغامبن استنقاذاً للأخلاق الممكن تصورها في وضعية العالم المعاصر؟ لا تعني الشهادة أن يشهد الإنسان على حادث عاينه وتحقق منه، بل على ما هو غير قابل للمعاينة، على ما لا يمكن الإفصاح عنه، أي على استحالة الخطاب. الشهادة الأخلاقية الوحيدة الممكنة تقوم على مناصرة هذه الاستحالة. وحدها هذه المناصرة تتيح للمرء أن يحتمل بشاعة الإنسان وحقارته وصلفه ووحشيته. ليست الشهادة فعلاً خطابياً، بل إسكان الإنسان في موطن ذاته الحق. مثل هذا الإسكان يذكّرنا بعلاقة المسكن (oikos) بالإتوس (ethos) الإغريقي الذي منه اشتق مفهوم الأخلاقيات، لا سيما في التأويلات التي استودعها هايدغر رسالته في الإنسية.
لا ريب في أن فلسفة أغامبن النقدية تخالف ما ألفه الفكر الإنساني واعتمده في تناولاته واستقصاءاته وخلاصاته. لذلك يشعر المرء بأن ما يقترحه علينا من فتوحات أصيلة، إنما تنطوي على طاقات خطيرة من الإرباك الكياني الأقصى، إذ كيف يتسنى للإنسان المعاصر أن يدرك حقائق وجوده من غير أن يقوى على ضبط فكره في خطاب متزن متسق متماسك؟ وكيف يمكنه أن يسلك مسلكاً أخلاقياً يليق بذاتيته الخاصة من غير أن يلتزم مسؤولية الشهادة التي يؤديها عن كل ما يعاينه من وقائع الحياة؟ يبدو أن التحولات الجليلة التي أصابت الاجتماع الغربي المعاصر دفعت أغامبن إلى انتهاك كل المسلمات وابتداع أغرب الطرق الخلاصية.