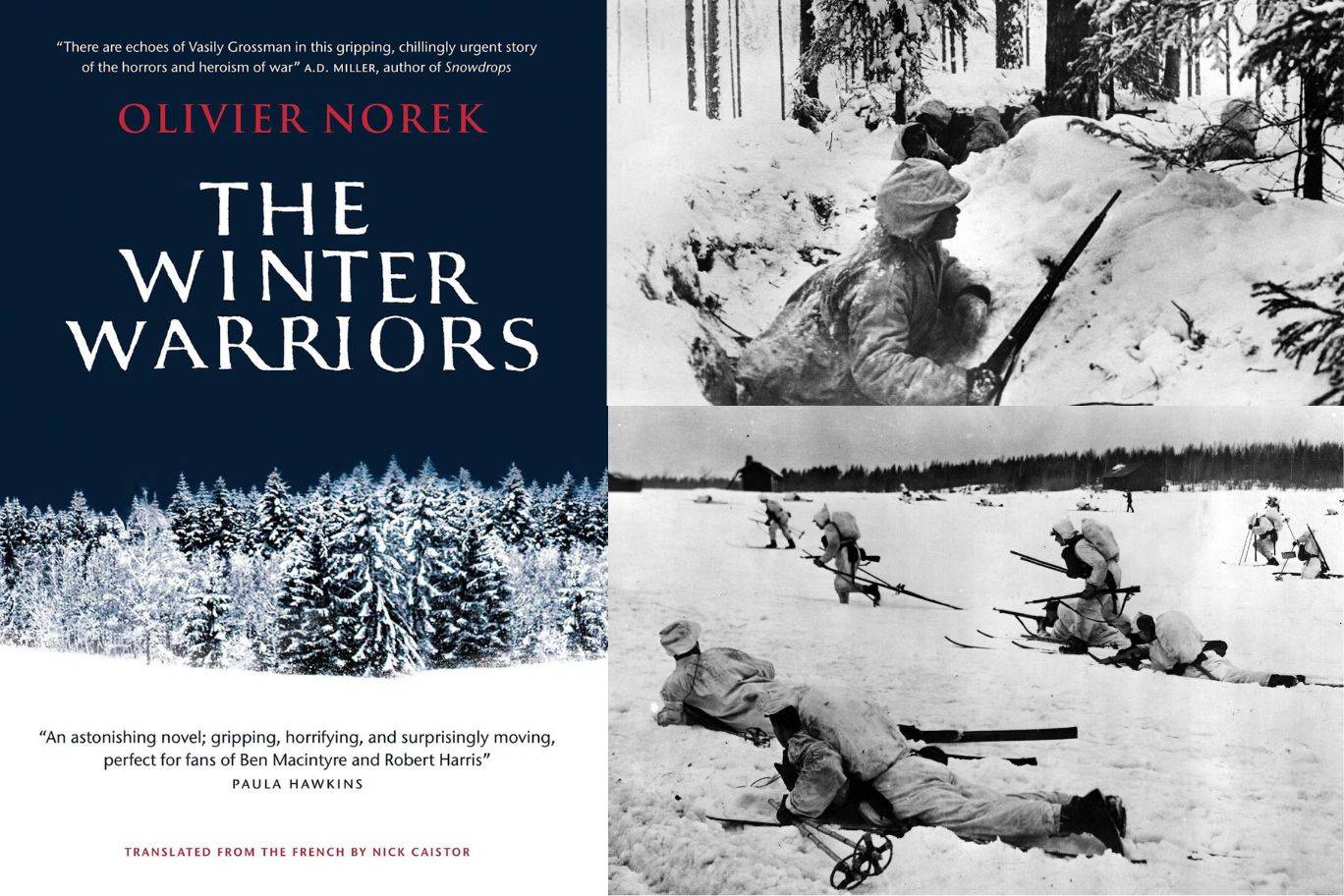ملخص
كثيراً ما ارتبط الفكر والأدب في الوعي الجمعي وفي المؤسسات التعليمية والثقافية عبر التاريخ بصورة ذكورية تكاد تُمحى معها آثار الإبداع النسائي، أو تختزل في زوايا هامشية. هذا الواقع ليس مجرد مصادفة تاريخية بل نتاج عملية طويلة من التهميش، تضافرت فيها عوامل اجتماعية وثقافية ومؤسساتية لإقصاء المرأة من فضاء الفكر والأدب، أو في الأقل لتقليص حضورها داخل المشهد الثقافي والفلسفي الذي يُعلم ويُدرس ويُحتفى به.
كانت الأسئلة الجوهرية التي يطرحها الباحثون المهتمون بالنتاج الأدبي والفلسفي الموقع بأسماء نسائية هي: كيف بني "المشهد الفكري والأدبي"؟ ومن يملك سلطة تحديد ما هو أدبي وفلسفي وما ليس كذلك؟ ولماذا تقلص حضور الأديبات والمفكرات في المشهد الثقافي العالمي؟
إن الجواب عن هذه الأسئلة يكشف عن شبكة واسعة من آليات الإقصاء، تبدأ من المدرسة وتنتهي بصفحات الصحف وأروقة الجوائز الأدبية.
تكشف الدراسات، على سبيل المثال لا الحصر، عن أن الكتب المدرسية في فرنسا تكاد لا تذكر أسماء الأديبات والمفكرات إلا نادراً. ففي تحليل شمل 17 كتاباً مدرسياً مخصصاً لتعليم الفلسفة والأدب الفرنسي، لم يتجاوز ذكر الأسماء النسائية ستة في المئة من مجموع الأدباء والفلاسفة الواردة أسماؤهم ضمن متن هذه الكتب. فقبل عام 2003 لم يكن اسم أية امرأة مُدرجاً في منهج الفلسفة داخل المدارس الثانوية، وأن هذا المنهج أصبح يشتمل اليوم على نصوص مختارة من كتابات بعض الفيلسوفات كهانا آرندت وسيمون دو بوفوار وسيمون ڤايل وجان هيرش وأيريس مردوك وغيرهن. لكن النصوص، موضوع الدروس والموقعة بأسماء أنثوية، لم تحظَ سوى بنسبة ضئيلة جداً مقارنة بالنصوص المذيلة بأسماء الأدباء والمفكرين الذكور، إذ غالباً ما اقترنت أسماء النساء بصلتهن بـ"الرجال العظام"، كأن تكون المرأة الأم أو الزوجة أو العشيقة أو حتى "الملهمة"، لكن هويتهن ككاتبات أو شاعرات أو مفكرات مبدعات كثيراً ما غُيبت.
علاقات ثنائية
ويكفي أن نشير في هذا السياق إلى جورج صاند التي ارتبط اسمها بألفرد دوموسيه، أكثر مما ذكرت ككاتبة وروائية بارزة، وسيمون دو بوفوار التي اشتهرت بعلاقتها بسارتر على رغم توقيعها عدداً من الروايات والمقالات والسير الذاتية ودراسات حول الفلسفة والسياسة والقضايا الاجتماعية، لا سيما كتابها "الجنس الآخر" وهو بمثابة نص تأسيسي للنسوية المعاصرة.
إن غياب أسماء الأديبات والشاعرات والمفكرات عن المناهج الدراسية الفرنسية ليس مجرد نقص معرفي، بقدر ما هو نتاج منهج يعمل على ترسيخ فكرة أن الفكر والأدب حكر على الرجال، وأن صوت المرأة لا يستحق أن يُدرس أو يُحتفى به.
وإن تجاوزنا فضاء المدرسة والمناهج الدراسية إلى فضاء الجوائز والأكاديميات، لوجدنا أن الصورة ليست أفضل حالاً. فمنذ تأسيس الأكاديمية الفرنسية على يد الكاردينال ريشوليو عام 1635، لم ينتخب حتى تاريخه من النساء أعضاء في هذه الأكاديمية العريقة سوى 11 امرأة فحسب، كانت الأولى منهن مارغريت يورسنار التي انتخبت عام 1980، تلتها جاكلين دو روميللي وإيلين كارير دانكوس وآسيا جبار، إلخ. أما الجوائز الأدبية الكبرى، مثل جائزة غونكور، فقد ذهبت بغالبيتها الساحقة إلى رجال، ولم تحظ النساء منها إلا بنصيب ضئيل جداً، على رغم كثرة الكاتبات وإبداعهن.
لا تقف المشكلة عند حد غياب التكريم، بل تتجاوزها إلى التمثيل الرمزي. فالمرأة حين تدخل هذه المؤسسات تُستقبل أحياناً بالسخرية أو بالاحتقار. ويكفي أن نذكر ضمن هذا الإطار تعليق الكاتب جول رونار حين انضمت الشاعرة والروائية والمترجمة جوديت غوتييه، ابنة الكاتب الفرنسي الشهير تيوفيل غوتييه، إلى لجنة تحكيم جائزة غونكور في بدايات القرن الـ20، إذ وصفها في دفتر يومياته بألفاظ مشينة قللت من قيمتها كامرأة وكأديبة، علماً أن عدد الروائيات والأديبات بدأ بالتزايد في فرنسا منذ أواخر القرن الـ19.
حضور خفر؟
كيف يمكن إذاً تفسير الحضور الخفر للنساء في المختارات الأدبية؟ وكيف يمكن مثلاً تفسير أن أعمال كوليت أو جورج صاند العديدة اختصرت في مجموعة من الروايات الموجهة إلى اليافعين، وأنه لم يحتفظ منهما سوى بحكايات مغامراتهما العاطفية أو بولعهما بالقطط والمربى؟ وكيف أمكن أن تصبح المرأة في الأدب، كما في مجالات أخرى عديدة، كائناً مخلوقاً، فيما الرجل هو الخالق؟
كان الجواب عن هذا السؤال أن الطبيعة لم تقدر النساء لأن يكن خالقات ومبدعات، وأن على كل فرد في هذا العالم أن يحتفظ بالمكانة التي فرضها عليه جنسه.
لقد تميز القرن الـ19 بهذا الهاجس المتمثل في البحث داخل الأجساد عن الفوارق بين الرجال والنساء، باعتبارها براهين بيولوجية لا تدحض. ومنح الخطاب الطبي طويلاً شرعية لهذه الرؤية في محاولة لتبرير هذا الإقصاء عبر الحجج البيولوجية أو الطبيعية. ففي القرن الـ19، شاع خطاب طبي وعلمي في أوروبا أكد أن المرأة، بسبب جسدها ودورتها الشهرية وحملها، عاجزة عن ممارسة نشاط فكري رصين. وذهب بعضهم إلى قياس جماجم النساء وأدمغتهن ليخلصوا إلى أنها أصغر وأقل وزناً من أدمغة الرجال، بالتالي أقل قدرة على الإبداع.
لم يكن هذا الخطاب بريئاً، بل كان وسيلة لتثبيت تقسيم صارم للأدوار: إن الرجل مبدع ومخترع وصانع للفكر والفن، أما المرأة فهي أم وأخت وزوجة، أو في أحسن الأحوال ملهمة للرجل. وإن أبدعت، فهي "خارج الطبيعة"، أو كما قيل في وصف "المرأة الأديبة" إنها "فوق الطبيعة والمجتمع".
لكن المسألة ليست فقط حرمان المرأة من التعليم أو من النشر أو من دخول عالم الأدب، بل تتعلق أيضاً بكيفية استقبال نتاجها الأدبي والفكري. إن الأعمال الممهورة بأسماء النساء كثيراً ما يُقلَّل من قيمتها، أو يُنظر إليها ككتابة عابرة لا تترك أثراً فنياً خالداً. حتى إن بعض الكاتبات أنفسهن استنبطن هذا الحكم، كلور شقيقة بلزاك التي كتبت الشعر لكنها رأت أن نشر قصائدها لا يليق بالنساء.
لكن العالم الثقافي اضطر أحياناً إلى الاعتراف بنساء مبدعات، فلجأ حينها إلى حيلة أخرى: اعتبارهن "رجالاً في زي امرأة". هكذا فعل إدمون دو غونكور حين ذهب حد الادعاء أن النساء المبدعات يمتلكن خصائص جسدية "ذكورية" تفسر تفوقهن. وهكذا تحول الاعتراف نفسه إلى صورة من صور الإقصاء.
مساحة أقل
لم يختف هذا التحيز اليوم كلياً. فما زالت بعض الصحف الكبرى والمجلات الأدبية تعطي مساحة أكبر للكتاب الرجال على حساب الكاتبات. وبيَّنت دراسة فرنسية حديثة أن نسبة المقالات النقدية المخصصة لأعمال النساء لا تتجاوز ثلث ما يُكتب عن أعمال الرجال، وأن المقالات التي تتناول كتبهم ودواوينهم الشعرية غالباً ما تكون أطول وأكثر بروزاً في الصفحات الأولى. ويتبين مما سبق أن "السمعة الأدبية والفكرية" لا تبنى فقط بالموهبة والإبداع، بل بصناعة إعلامية ومؤسساتية تصب دوماً لمصلحة الرجل.
إن القضية، في جوهرها، ليست مجرد إنصاف فردي للمفكرات والأديبات والشاعرات، بل قضية ثقافية كبرى تتعلق بثراء الرؤية الإنسانية. إن كل إقصاء لصوت أنثوي يعني خسارة منظور جديد وتجربة وجودية مختلفة. لقد حذرت فرجينيا وولف في كتابها "غرفة تخص المرء وحده" من خطورة أدب يكتبه الرجال وحدهم، لأنه يحرم الفتيات من إمكانية التماهي والتمثل، ويشوه صورة الإنسان حين يختزل في نصفه الذكوري. ولئن أصبح غياب النساء في عالم الأدب كما في غيره متجذراً، فإن أحداً لم يعد يلحظه. ومن ثم، فإن الخطوة الأولى تكمن ببساطة في التخلي عن الاعتياد على هذا الغياب، وتعلم رؤية ما هو غير مرئي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في فرنسا ثمة من يبحث اليوم عن نصوص خطتها أقلام النساء لإعادة تشكيل ما يسمى "المتريموان" أي التراث النسوي، على غرار "الباتريموان" في محاولة لتعويض تاريخ أدبي كتب هو أيضاً بصيغة المذكر. هذا ما أوصت به كريستين دو بيزان خلال القرن الـ15، التي بدأت بعد كثرة قراءتها للأدبيات المعادية للنساء تقتنع بأن هؤلاء الرجال العظام على حق. لكنها مع ذلك وقعت "مدينة السيدات"، وهو كتاب دافعت فيه عن النساء من خلال سرد مآثرهن.
لقد صار اليوم من الضروري إحصاء كل أعمال النساء الأدبية وإعادة اكتشاف نصوصهن المهملة وبناء تراثهن، لا سيما في عالمنا العربي. ليس الهدف من ذلك خلق أدب "نسوي" منفصل عن الأدب بعامة، بل دمج التجارب النسائية في النسيج العام للتاريخ الأدبي، بحيث يصبح أكثر إنصافاً وشمولاً.
إن استبعاد النساء من الأدب والفكر ليس قدراً، بل صناعة اجتماعية وثقافية تقوم على التكرار والإخفاء والتبرير. ويكفي أن أشير ضمن هذا السياق إلى أن حركة "طالبان" قررت منذ بضعة أيام سحب 140 كتاباً موقعاً بأسماء نساء من الجامعات الأفغانية، فضلاً عن إلغاء بعض المواد التي تتناول حقوقهن.
ولأن السمعة الأدبية لا تُمنح بل تُصنع، فإن تغيير هذا الواقع يتطلب مساءلة المناهج الدراسية وإعادة النظر في آليات الجوائز والتكريم، وتفكيك الصور النمطية الرائجة عن المرأة. فلا يمكن للأدب أن يكون مرآة صادقة للإنسانية ما لم تتجاور فيه أصوات النساء والرجال على السواء، ذلك أن الاعتراف بوجود المرأة في الأدب ليس مجاملة ولا استثناءً، بل استعادة لجزء مفقود من ذاكرة الثقافة الإنسانية.