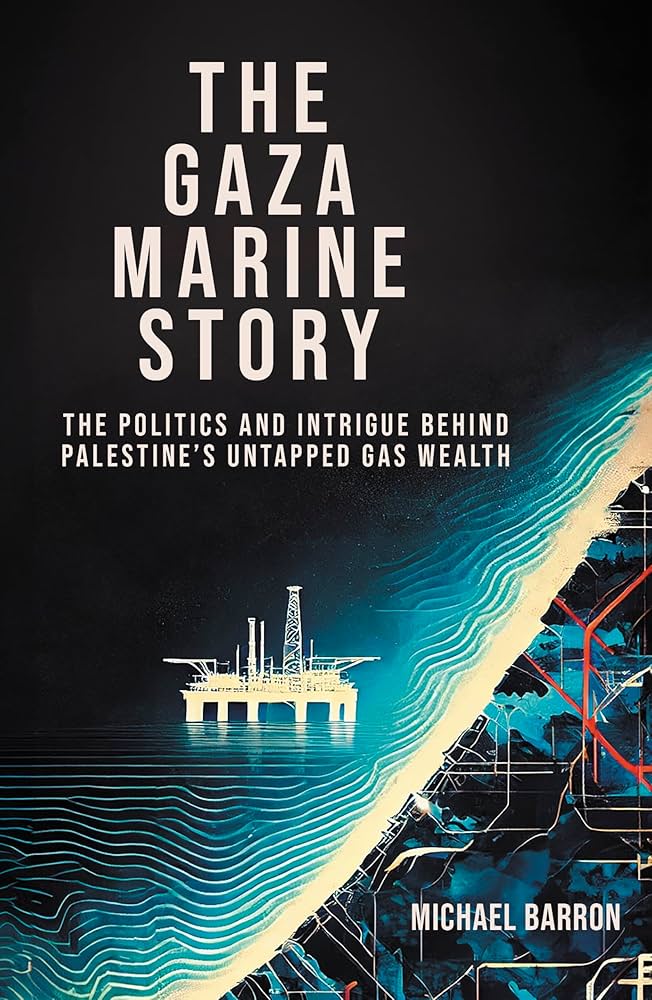ملخص
حقل "غزة مارين" الذي اكتُشف عام 2000 كان يمكن أن ينعش الاقتصاد الفلسطيني بعائدات ضخمة، لكنه ظل رهينة للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي والفساد والانقسامات الداخلية. وبعد أكثر من عقدين من التعطيل والوعود الدولية، ما زال استغلال ثروته الغازية مؤجلاً رغم محاولات حديثة لإحيائه.
عندما اكتشف الفلسطينيون في مطلع الألفية وجود احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة، اعتبر كثيرون أن هذا الحدث قد يشكّل نقطة تحوّل في مسار القضية الفلسطينية، فالمورد الجديد كان قادراً على إنعاش الاقتصاد بعائد يصل إلى 100 مليون دولار سنوياً، وكان سيمنح الفلسطينيين ورقة قوة في مواجهة إسرائيل. لكن مشروع تطوير ما عُرف بحقل "غزة مارين" ظل لعقود معلّقاً، وتحول من فرصة تاريخية إلى رمز للفرص الضائعة، خصوصاً أنه يعتبر أول حقل غاز يُكتشف في مياه شرق المتوسط، حتى قبل الحقول المصرية والإسرائيلية.
يقدم كتاب "قصة غزة مارين، السياسة والمكائد وراء ثروة فلسطين الغازية غير المستغلة" للباحث البريطاني مايكل بارون قراءة مستفيضة لماضي وحاضر المورد الطبيعي الأكبر لفلسطين، الذي ظل مهملاً لأكثر من ربع قرن لأسباب متعددة منها الفساد والصراع المستمر مع إسرائيل. ويفسر الكتاب تكاثر خطط السلام المتعلقة بغزة، من خطة الريفييرا التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وخطة ما بعد الحرب التي طرحها توني بلير وجاريد كوشنر، وصولاً إلى المقترحات الأخرى من القطاعين الخاص الأميركي والإسرائيلي.
كان السيد بارون جزءاً من مشروع حقل "غزة مارين" بين عامي 2003 و2014 بصفته مديراً للعلاقات الحكومية في شركة الغاز البريطانية، حيث عمل عن كثب مع المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين. يكشف كتابه الصادر عن دار "نومد" في 300 صفحة أرشيفاً من المفاوضات والصفقات التي تعكس تشابكات السياسة بالاقتصاد والفساد بالمصالح، مما أدى إلى بقاء ثروات الغاز الفلسطيني رهينة لصراع لا ينتهي.
مفاوضات عرفات السرية
الحكاية تبدأ من المفاوضات السرية لعام 1999، التي قرر بعدها الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات منح شركة الغاز البريطانية وشركة "سي سي سي" المملوكة لفلسطينيين عقداً حصرياً للبحث والتنقيب في سواحل غزة. كانت البيئة السياسية مهيأة للتنقيب البحري بعد التوصل لاتفاقات أوسلو (1993) التي منحت الفلسطينيين للمرة الأولى صلاحيات جزئية على مواردهم الطبيعية في غزة.
أقيمت مراسم توقيع الاتفاقات بين السلطة الفلسطينية وشركتي الغاز في لندن في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 1999 تحت إشراف رئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير. منحت الاتفاقات الشركتين رخصة للتنقيب في مساحة تبلغ نحو 1300 كيلومتر مربع، تمتد خارج المياه الإقليمية لغزة وخارج مناطق الأمن المحددة بموجب بنود أوسلو. في المقابل حصلت السلطة الفلسطينية على مكافأة توقيع متواضعة بقيمة 250 ألف دولار، وهي عادة متبعة في عقود الاستكشاف النفطي، تعكس الطبيعة عالية الأخطار للمشروع في بيئة سياسية معقدة. حُول المبلغ في 13 يونيو (حزيران) 2000 إلى حساب رسمي للسلطة، بعد التحقق من ضمان عدم انتهاك القوانين البريطانية المتعلقة بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال.
لم تستغرق الشركتان وقتاً طويلاً حتى أعلنتا في عام 2000 اكتشاف حقلين من الغاز على بعد 30 كيلومتراً من شواطئ غزة وعلى عمق 600 متر تحت سطح البحر. أطلق على الحقل الأول الواقع بالكامل في المياه الفلسطينية اسم "غزة مارين"، أما الثاني فسمّي "مارين 2"، ويقع ضمن المنطقة الحدودية البحرية بين قطاع غزة وإسرائيل. وحددت الشركتان الكمية الموجودة من الغاز في بحر غزة بنحو تريليون قدم مكعبة، أي = ما يعادل نحو 170 مليون برميل نفط، وما يكفي غزة والضفة الغربية لمدة 15 عاماً، بحسب معدلات الاستهلاك الحالية.
زلة بريطانية
مثّل توقيع الاتفاقيات لحظة فارقة للسلطة الفلسطينية، فمن جانب جلبت استثمارات من شركة عالمية، ومن جانب آخر فتحت الباب نحو اعتراف دولي بفلسطين، وفرصة لتأمين مصادر إيرادات مستقبلية تقلل الاعتماد على المساعدات. في الوقت نفسه، أسست شركة الغاز البريطانية حضوراً ميدانياً في الأراضي الفلسطينية، باستحداث مكاتب في رام الله وغزة لإدخال خبرتها الهندسية إلى الاقتصاد المحلي.
لكن في مارس (آذار) 2000، كادت زيارة الرئيس التنفيذي لشركة الغاز البريطانية إلى فلسطين أن تؤدي إلى إحراج وفشل للشركة، فالزيارة التي هدفت إلى إظهار التزام الشركة وتعزيز الدعم السياسي للمشروع، لم تأخذ في الاعتبار بعض البروتوكولات المتبعة.
في منزله ذي الحراسة المشددة في رام الله، قدّم عرفات للوفد البريطاني برئاسة الرئيس التنفيذي فرانك تشابمان أوسمة بيت لحم 2000 وهي من أرفع الأوسمة الفلسطينية، في حين لم تحضر الشركة أي هدية تذكارية. لكن تشابمان تدارك الموقف بذكاء وخلع شارة الشركة من زيّه وقدمها للزعيم الفلسطيني، الذي تلقّفها بسعادة وسرعان ما ثبّتها على ملابسه.
تلك اللفتة البسيطة والعفوية تحولت إلى عنوان بارز في اليوم التالي عندما ظهر عرفات مرتدياً شارة الشركة البريطانية أثناء المحادثات مع إسرائيل لإنقاذ عملية أوسلو. ونشرت صحيفة "فايننشال تايمز" صورة الزعيم الفلسطيني على الصفحة الأولى وهو يرتدي الشارة بوضوح، مما أثار سعادة مسؤولي الشركة الذين اعتبروا الحدث دعاية مجانية لا تقدر بثمن. غير أن الحادثة كشفت محدودية فهم الشركة للثقافة السياسية والتجارية في الشرق الأوسط، وأصبحت درساً لفريقها الإقليمي.
زيارة شارون المميتة
وُصف اكتشاف الغاز حينها بأنه "هبة من الله" لكن لحظة النشوة الفلسطينية لم تدم طويلاً، ففي اليوم التالي أشعل زعيم المعارضة آنذاك أرييل شارون شرارة الانتفاضة الثانية بعد زيارته المستفزة إلى الحرم القدسي، ودخلت معها فلسطين في دوامة عنف جعلت الاستثمار مستحيلاً. يرجح الكاتب البريطاني أن الزيارة لا علاقة لها بالاكتشاف وإنما تصادف توقيتها مع الإعلان عنه، لكنه يقر بأن شارون لم يكن ليشعر بخيبة أمل لو استحوذ خبر زيارته على صفحات الأخبار الأولى بدلاً من خبر ثروة الغاز المكتشفة.
أعاقت الانتفاضة الثانية الجهود المبذولة لإحراز تقدم في المشروع، لكنها لم توقف أنشطة التنقيب بالكامل، ولم تبدد شهية السياسيين والشركات في اقتطاع حصة من الحقل المكتشف في ضوء التقديرات بثروة تفوق الـ4 مليارات دولار، في حين حرص الفلسطينيون على التأكيد بأن حقل غزة مارين ملك للفلسطينيين ويجب أن يكون قرار تطويره أو استغلاله في المستقبل بيد حكومة فلسطينية، لمصلحة شعبها واقتصاده.
ورافق المشروع اتهامات بالرشوة وتضارب المصالح منذ بداياته، ومنها مزاعم عن دفع 40 مليون دولار كرشوة لتسهيل الحصول على ترخيص التنقيب. السلطة الفلسطينية نفسها لم تكن بمنأى عن هذه الاتهامات، فقد اعتُبرت بعض القيادات متورطة في صفقات غامضة أو استفادت من الأموال بصورة غير قانونية.
في الوقت نفسه، أدى الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي إلى تعطيل جهود التنقيب، وبين 2002 و2004 اتخذت حكومة شارون مواقف متقلبة ففي البدء أبدت انفتاحاً، ضمن مساعيها للتقرب من توني بلير الذي كان داعماً للتنقيب، لكنها وضعت شروطاً معقدة لتطوير الحقل حتى لا تذهب عوائده لـ"الإرهابيين".
لم يكن تطوير الحقل ممكناً من دون موافقة الحكومة الإسرائيلية وتعاونها المستمر، وهو ما لم يحدث إذ يكشف الكتاب أن المسؤولين الإسرائيليين اشترطوا في اجتماعات مع شركة الغاز البريطانية أن تستقبل إسرائيل جميع كميات الغاز المستخرجة إلى الأراضي الإسرائيلية، مما أثار تكهنات مستمرة حول مؤامرة إسرائيلية لسرقة الغاز الفلسطيني.
وأشار الكاتب إلى أن العامل الرئيسي في الموقف الإسرائيلي المناهض للتنقيب كان عداء شارون المطلق لعرفات، إذ كان يعتبره عدواً لا يمكن الوثوق به أو التوصل إلى اتفاق معه، مستشهداً بتردد شارون خلال محادثات السلام بين عامي 1996 و1999، في التعامل المباشر مع عرفات، ورفض مصافحته.
توترات اجتماع 2013
على رغم تعاقب السنوات بقيت التوترات السياسية بين فلسطين وإسرائيل تلقي بظلالها على مصير المشروع، كما يتجلى في اجتماع في تل أبيب عام 2013، بين ممثلين من السلطة الفلسطينية وإسرائيل وشركتي الغاز البريطانية و"سي سي سي" إضافة إلى سياسيين ومستشارين بريطانيين.
أبرز المشاركين في الاجتماع وزير بريطاني سابق لم يسمّه الكتاب، إضافة إلى المستشار الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي يتسحاق مولخو ونائب رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى (رئيس الوزراء الحالي)، ورئيس هيئة الطاقة الفلسطينية، ومسؤول من صندوق الاستثمار الفلسطيني.
يستذكر المؤلف الذي شهد على الاجتماع التوتر الواضح بين الطرفين على رغم محاولات ضبط النفس، إذ تجنب كل طرف استخدام عبارة إسرائيلي أو فلسطيني، إلا أنه مع مرور الوقت، بدأ المشاركون بالإشارة لبعضهم بالاسم، مما خفف التوتر قليلاً، لكن الاجتماع لم يسفر عن أي تقدم ملموس في تجاوز العقبات التي تواجه مشروعاً كان من الممكن أن يغيّر مسار الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وفق الكاتب.
ثروة غير مستغلة
مشروع حقل "غزة مارين" كان مغامرة محفوفة بالأخطار للشركة البريطانية بسبب التحديات السياسية والتكلفة المالية. للاستكشاف والحفر أنفقت الشركة نحو 25 مليون دولار، إضافة إلى 75 مليون لإيجاد سوق للغاز، وقُدرت تكلفة إنشاء البنية التحتية اللازمة بـ700 مليون دولار.
لكن ما أثار شهية الشركة البريطانية هي الإيرادات المتوقعة من المشروع التي تصل إلى 4 مليارات دولار، وكانت تنظر في إمكانية تصدير الغاز إلى مصر أو استخدامه لتوليد الكهرباء في غزة، أو إسرائيل أو الأردن. يبلغ نصيب السلطة الفلسطينية من الإيرادات نحو 100 مليون سنوياً طوال 15 عاماً، وهي مدة الإنتاج المتوقعة للحقل.
هذه الإيرادات لن تحول فلسطين إلى دولة غنية بالغاز مثل قطر أو سنغافورة، لكنها ستكون مصدر دخل إضافي لرفد الاقتصاد الفلسطيني المعتمد على المساعدات، ويمكن أن تسهم في إعادة بناء المنازل والمستشفيات والمرافق الأساسية التي دُمرت منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023 في قطاع غزة، وفق الكتاب.
ويوضح المؤلف أن كمية الغاز المكتشفة تجعل المشروع قابلاً للتنفيذ تجارياً، لكنها ليست كبيرة مقارنة بالمعايير الإقليمية أو الدولية. ومع ذلك فإن تزويد محطة الطاقة في غزة بالغاز، مع استثمار الإيرادات بحكمة، كان من الممكن أن يكون له تأثير حيوي على الاقتصاد الفلسطيني.
التناقض الإسرائيلي والتردد الفلسطيني
يقول المؤلف البريطاني الذي شهد بنفسه على المحادثات إن مشروع الغاز الفلسطيني يسلط الضوء على التناقض في السياسة الإسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، فمن جانب تسعى إسرائيل لفرض السيطرة على الفلسطينيين، ومن جانب تريد فصل نفسها عنهم. هذا التناقض أسهم في تعزيز اعتماد الفلسطينيين الاقتصادي على إسرائيل، وعوّق أي تعاون يمكن أن يعود بالنفع على الطرفين.
وأضاف بأن المشروع يكشف أيضاً عن تردد السلطة الفلسطينية في الدفاع الكامل عن مصالحها الوطنية، وهو تردد قد يكون نابعاً من اختلال موازين القوى بين الطرفين. لكن هذه الفجوة في القوة لا تُختزل في الموقف الفلسطيني وحده، بل تمتد لتشمل طبيعة الدور الذي تلعبه الشركات الدولية والأطراف الخارجية، فعلى رغم الاستثمارات الضخمة المهددة، فإن وجود هذه الشركات لم يكن كافياً لضمان نجاح المشروع، ما أظهر حدود تأثير اللاعبين الدوليين في هذا النزاع.
في غزة يتجلى التناقض الصارخ في السياسة الإسرائيلية بين السعي لفصل نفسها عن الفلسطينيين وبين رفض منحهم الاستقلالية اللازمة للنهوض اقتصادياً، فحتى قبل اندلاع الصراع الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023، كانت غزة رهينة إسرائيل بسبب اعتمادها عليها للتزود بالطاقة، فالمستشفيات مثلا تعتمد على المولدات التي تعمل بالديزل لكن كميات الديزل غير مضمونة وتعتمد على تقدير السلطات الإسرائيلية.
ومنذ عام 2006 فرضت الحكومة الإسرائيلية حصاراً على غزة، وسيطرت على جميع المعابر تقريباً، مما سهّل عليها الضغط على حكومة "حماس" بورقة الكهرباء عبر منع دخول شاحنات الديزل إلى القطاع. في الوقت نفسه اصطدمت عمليات تهريب الديزل من مصر عبر الأنفاق، بالجهود الإسرائيلية والمصرية لتدمير هذه الأنفاق، وفق الكتاب.
الحصار الإسرائيلي لفصل غزة عن إسرائيل لم يقتصر على تقييد حركة الفلسطينيين وبناء سياج كامل على طول الحدود، بل شمل فرض السيطرة على موارد الغاز، إذ منعت إسرائيل تطوير حقل غزة مارين وفرضت شروطاً على أي مشروع لتطويره، ومن بين هذه الشروط، أن تمر خطوط الغاز أولاً عبر الأراضي الإسرائيلية قبل غزة أو مصر، وأن يدخل السوق الإسرائيلية أولاً، مما يمنح إسرائيل التحكم الكامل في تدفق الغاز وإيراداته.
واقع حقل غزة مارين
كانت شركة الغاز البريطانية تمتلك 90 في المئة من رخصة التنقيب مقابل 10 في المئة لشركة "سي سي سي" الفلسطينية، وبعد استحواذ شركة "شل" على الشركة البريطانية، انسحبت "شل" من المشروع في 2018، وأصبحت الرخصة بيد الشركة الفلسطينية وصندوق الاستثمار الفلسطيني.
في الفصل الـ12 والأخير يوضح الكاتب أن حقل غزة مارين ظل يتأرجح بين الخيال والواقع. من جانب هناك خطط اقتصادية طموحة، ووعود دولية، ونظريات مؤامرة، أما في الواقع فهو حروب، وانقسامات فلسطينية، وقيود إسرائيلية. في 2019 خصصت إدارة دونالد ترمب مساحة لحقل "غزة مارين" في خطتها للسلام الاقتصادي Peace to Prosperitبتمويل قدره مليار دولار، لكن لم تُحدد آليات التنفيذ أو مصادر التمويل.
وفي يونيو (حزيران) 2023 وافقت إسرائيل على تطوير الحقل، وأعلنت أن تحالفاً تقوده الشركة المصرية القابضة للغاز "EGAS" هي من سيتولى تنفيذه، لكن اندلاع حرب غزة أوقفت عملية التطوير، وبات مستقبل الحقل غامضاً.
وأخيراً في 2024 تداولت وسائل إعلام أنباء عن سعي إسرائيل إلى إبرام صفقات مع شركات كبرى للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل غزة، وهو ما يرفضه الفلسطينيون، مؤكدين حقهم الكامل بثروة غزة البحرية، ومؤملين في أن يشكل الزخم الدبلوماسي للاعتراف بدولة فلسطين أساساً لاستغلال مواردها.