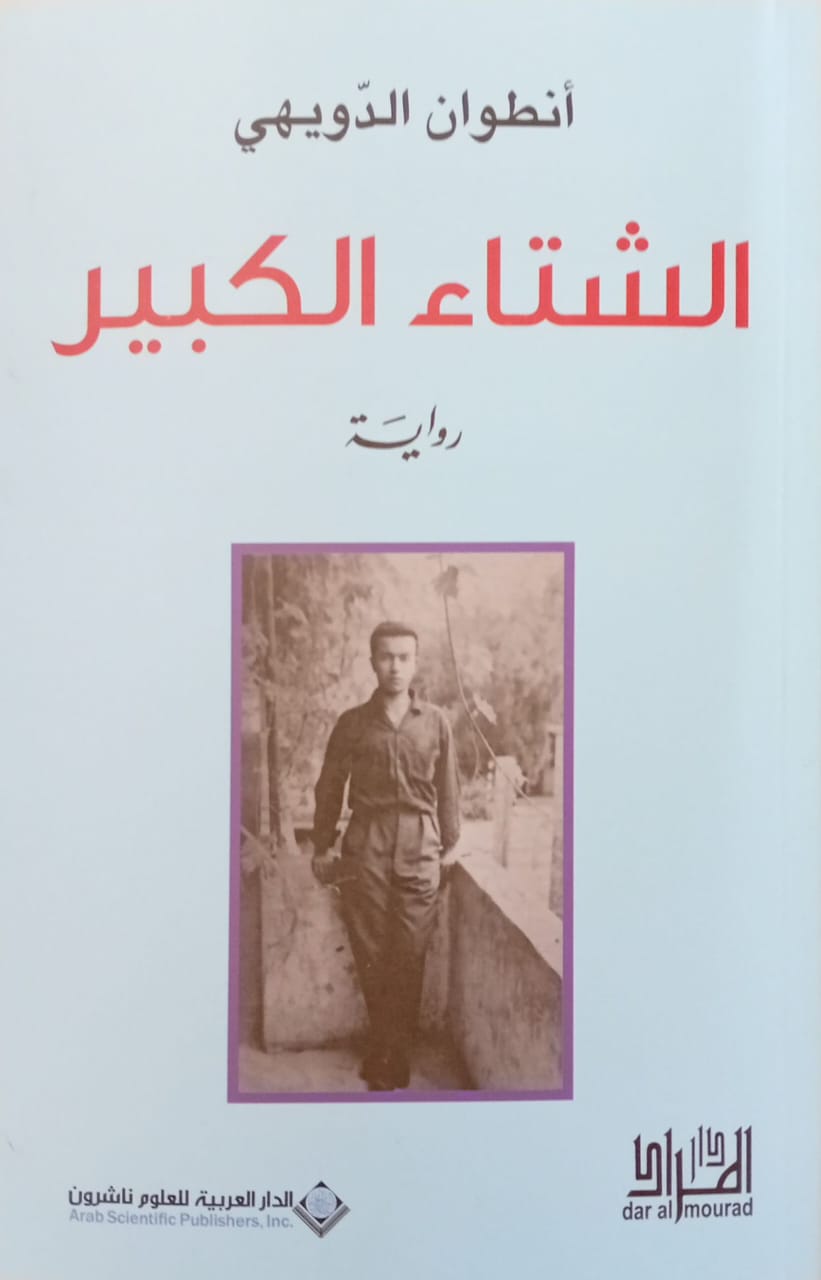ملخص
لا يزال الأكاديمي والكاتب اللبناني أنطوان الدويهي (1948) يضرب على وتر علاقة الذات بالطبيعة الريفية، في تصادمها مع ذات اجتماعية غارقة في وحول الواقع وصراعاته الأولية، بل القبلية بمفاعيلها العنفية القاتلة. ودائماً يختلط لديه خيطان لازمان في صوغه عالمه، هما النثر والشعر، وهو القائل إن "لا قيمة للأدب من دون الالتفات الى ما يشكل الشعري في جوهر الشيء أو المشهد".
في روايته الصادرة حديثاً بعنوان "الشتاء الأخير"، (دار المراد، والدار العربية للعلوم ناشرون)، يتبين من القراءة الأولى أن الكاتب يقصد، بالمقام الأول، النفاذ الى صميم معضلة أساسية، بل جوهرية في إحداث الصدع الكبير بين أبناء المنطقة نفسها والطائفة نفسها والدين نفسه، قبل ابتداع الانقسام العمودي بين الجماعات المختلفة عقيدة وتوجهاً، بسبب الحرب الأهلية الكبرى عام 1975، عنيتُ بها معضلة الثأر التي يجعلها مناخاً قاتماً عاماً يغلف الأحداث التي تجري وقائعها أواخر الخمسينيات من القرن الماضي.
لا تقوم بنية الرواية في "الشتاء الأخير" على محور من الأحداث متنامٍ ومطّرد، وإنما على محطات حدثية يستحضرها الراوي العليم (سمعان الرابع) من سيرته الذاتية المروية بصيغة المتكلم، يستلها تباعاً من دفتره يوم كان في الـ17 من عمره، عنوانه "يوميات الحياة الداخلية". وحدد الراوي إطاره الزمني أواخر الخمسينيات (1958-1959)، حين تفاقمت حالات الثأر بين عائلتين من منطقتين متجاورتين (اصطلح على تسميتهما موريا الغربية وموريا الشرقية) في بلدة من شمال لبنان (هي على الأرجح زغرتا)، وبلغ ضحاياها الـ170، إثر نزاع مسلح جرى داخل كنيسة (اصطلح على تسميتها بلدة غسقا) أودى بأكثر من 25 قتيلاً وعدد من الجرحى.
ولكن قصة الرواية الحقيقية، وإن تفرعت عن سياقها العام، هي حكاية الراوي، وكان لا يزال فتى في الـ17 من عمره، وهو يحاول النجاة بنفسه من خطر القتل بجريرة انتمائه إلى عائلة القاتل نفسها، وحتى لو لم تكُن له صلة مطلقاً بالقاتل، يحيا نائياً بنفسه ومتوارياً عن أنظار "عدوه العشائري" مع شخصيات قليلة (أمه وإرميا وكميل المهاجر إلى باريس)، ومستكشفاً مناظر ومتأملاً في العنف وفي نزعة الاشتباك وفي الضجر المفضي إلى العنف وفي الحب والعلاقة الوطيدة بالطبيعة وفي الموت وغيرها.
الثأر والسيرة
من الأمور اللافتة في كتابة أنطوان الدويهي السردية (ثلاث روايات من بينها عبور الركام وحامل الوردة الأرجوانية وآخر الأراضي)، بقاء السيرة مورداً أساساً، تصير بين يديه مادة خصبة وقابلة لمزيد من التوسيع التخييلي والتأمل والتعليل والتحليل المعمق. ولئن كانت معضلة الثأر في المجتمع اللبناني متداولة بين أدباء لبنانيين آخرين، سابقين للدويهي أمثال رشيد الضعيف وتوفيق يوسف عواد وغيرهما، لاعتبارها آفة واجب فضحها واستنكار مفاعيلها المسببة للحرب الأهلية لاحقاً والمانعة لنشوء دولة القانون والعدالة، فإن الكاتب أنطوان الدويهي يخرج من سيرته حينما كان يافعاً وشاباً، ما يتصل بمعاناته من شرور الثأر، فلا يكتفي بتظهيرها عبر سرد يومياته متوارياً عن أنظار أعدائه، ومحللاً دوافع القائمين بأعمال الاشتباك بين موريا الشرقية والغربية بالرشاشات وقذائف الهاون، وراصداً اندفاعة "الجماعة المسؤولة" إلى معاودة الاشتباك، على أنها "احتفال جماعي مأسوي خارج الوعي" (صفحة 71).
وفي هذا يؤازر الراوي العليم في سرده، الكاتب الأكاديمي العارف بدوافع الجماعات غير الواعية، بحسب يونغ وآدلر، وغيرهما يقول إن هذه الاندفاعة إلى الاشتباك، من على الأسطح والمواقع هي وليدة الضجر وغياب العلاقة الوطيدة بالطبيعة. يقول "أشعر أن استمرار التوتر والعنف والفتن والحروب في هذه الأنحاء، وتفاقم أزماتها، هي على علاقة وثيقة بغياب الطبيعة، أو حضورها الضعيف الباهت في الذات الجماعية" (صفحة 94).
سؤال إرميا
يلتفت القارئ والمتتبع لوقائع الرواية وأسماء شخصياتها، إلى اختيار الكاتب أسماء هؤلاء، ومن بينهم إرميا (الذي يحسب في التوراة بأنه "نبي العزلة" وناظم التنبؤات التي ينذر فيها شعبه اليهودي بالويلات بسبب انغماسهم في الفساد) الذي يجعله حضوره الروحي، إلى جانب الراوي، "وهو الذي لا يستطيع إلحاق الأذى بنملة" (صفحة 84) صديقاً ودوداً ومخلصاً، ومنعزلاً عن الناس، سوى عن أمه، يطرح سؤالاً نيابة عن كل الأبرياء الذين قد تطاولهم ردود أفعال المنتقمين من كلا الطرفين، "لماذا لا تطاول أفعال الانتقام من كان فاعلاً مباشراً لأعمال القتل، والثأر؟ ولماذا يقتل الأبرياء من دون المذنبين؟". وللإجابة عن هذا السؤال المؤرق، رأينا إرميا، على ذمة الراوي العليم، يقوم بجمع الوثائق والصور والأخبار المتعلقة بموضوع "غسقا" (أي مجزرة الكنيسة في مزيارة) على امتداد المشاهد المتاحة له. ولئن أشار إرميا، والكاتب من خلال خطابه، إلى مسؤولية الجماعة (الذات الجماعية) في اندلاع المواجهة الأولى داخل الكنيسة واستمرارها في حملات الثأر، فهو يلمح إلى المصالحات التي جرت وقائعها بين المتنفذين ومشايخ الأحياء الـ20 الذين أمكنه تعيينهم، من دون عامة الناس من الطرفين، في ما يعتبر استغلالاً لدماء هؤلاء وتلاعباً بمصائرهم بذرائع واهية.
بين التراجيديا والسحر
يجدر التنويه أيضاً، في رواية أنطوان الدويهي، أن سكة السرد الأفقية، وإن تباطأ جريانها تباطؤاً مستحسناً، فهي تسلم أمر سياقها لماضيع عدة، أو "موتيفات" ذات صلة، من مثل موت الأبناء قبل والديهم بفعل الاغتيال ثأراً، كما هو حاصل في موريا الشرقية والغربية على السواء. وبهذا الرفق والسلاسة، تتداخل اللحظات الحلمية في خاطر الراوي الفتى، عاشقاً طيف هند، مع هواجسه التي تملكته بفعل أنه مطارد غصباً عنه من قبل العائلة العدوة. عدا ذلك، ما كان يضطر إليه السكان المعنيون بالانتقام، ومن بينهم عائلة الراوي (سمعان الرابع)، فيهجرون على ظهر البغال، في الأودية وبين الفجاج، محتاطين أن يكون موضع إقامتهم قريباً من أي مستوصف، أو مستشفى، في حال إصابة أحدهم برصاص القناصة أو بشظية قنبلة هاون من تلك التي أفلحت العائلة المعادية في الحصول عليها. ولا يزال الراوي مواصلاً سرده المتقطع حتى يعرج على موضوع المجاعة الكبرى (1914-1918) التي عانى سكان جبل لبنان فظاعاتها وقضى ثلثهم جوعاً خلالها، والثلث الثاني هاجر إلى الأميركتين (الشمالية والجنوبية) طلباً للرزق والنجاة. وهي حال جدة الراوي التي قصدت أميركا بحثاً عن زوجها الذي توارى عن عائلته، ولكنها بقيت هناك ترسل إلى وحيدها مالاً يبقيه على قيد الحياة، إبان المجاعة الكبرى...
وفي المقابل، أتاحت عزلة الفتى الاضطرارية ونباهته وصلاته الوثيقة بالطبيعة أن يتواصل بحواسه المتقدة مع كائنات الطبيعة وينعم بسحرها وألوانها المتحولة ومناظرها التي لا يقوى العنف على محوها، أو إقصائها عن وجوده، ومعنى هذا الوجود، في ما يشبه الدعوة الرومنطيقية السالفة، ولكن بقدر أكبر من التفكر في الوجود ومسائله ومعضلاته. ويقول في هذا الشأن "في الفسحة الداخلية الشاسعة حيث أقيم، موصول أنا على الدوام، على نحو يصعب وصفه، بعوالم أشياء وأسرار لا نضوب لها ولا نهاية، فمن أين يصلني الضجر؟ ثم إن علاقتي المختصرة بالمجتمع يقابلها اندماجي في الطبيعة، وهي عالمي الخارجي الحقيقي. أعجب من الناس كيف لا يشعرون عميقاً بالمدى الخلاب المحيط ’بمدينة الصيف‘ جيناتا، على كتف الوادي الكبير، وبمدينة الشتاء موريا، فوق تلتها المحوطة بأنهرها..." (صفحة 90).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وإن تكُن شخصية كميل في سياق الرواية قليلة الحضور نسبياً، فإنها تحمل في طياتها خصائص وخطاباً هو خطاب الكاتب، صانعها أو مثبت حضورها، وفي الحالين معاً. لا يلمح القارئ كميلاً، هذا الصديق وتِربُ الراوي، والمنتمي إلى موريا الشرقية (العدوة المفترضة لموريا الغربية)، إلا عبر مراسلاته من مدينة النور باريس، حيث يتابع تحصيله العلمي. ويتضح من مضامين هذه الرسائل أن كميل ينأى بنفسه عن تفاهات جماعته وعداواتهم العبثية، وأنه يحرص دوماً على تشجيع صديقه للاقتداء به والمجيء إلى "المدينة الملكية المدهشة، التي هي عاصمة الثقافة والجمال في العالم" (صفحة 152)، فيما يرد الراوي عليه بما مفاده بأنه، لو خير بما يختص في مدينة باريس، لقال إنه يختار "التخصص السينمائي"، بيد أن هذا الاختيار كان مستبعداً لديه، ما دام شديد التعلق بموريا الغربية أو القديمة.
وإذ يستنطق الراوي الكاتب "يوميات الحياة الداخلية" التي خطها يوم كان في الـ17 من عمره، ويستحضرها اليوم بعد 50 عاماً، يقع على تصور مبكر حول "دعوته الأدبية" التي يقول فيها إنه عازم على أن يكون أديباً، لا يعبر عن ذاته الفردية فقط، "بل أيضاً من حيث أدري أو لا أدري عن وجدان شعبي، وعن روح أرضي" (صفحة 158) ومن ثم يعرف الكتابة الأدبية، في وقفة ميتا سردية نظرية، على أنها التقاط الجوهر الشعري في ما يسرد ويصف. "فالكتابة هي خلقُ عالم جديد، فريد، شعري الجوهر، بواسطة الكلمة، يكون على صورة الكاتب ومثاله..." (صفحة 159).