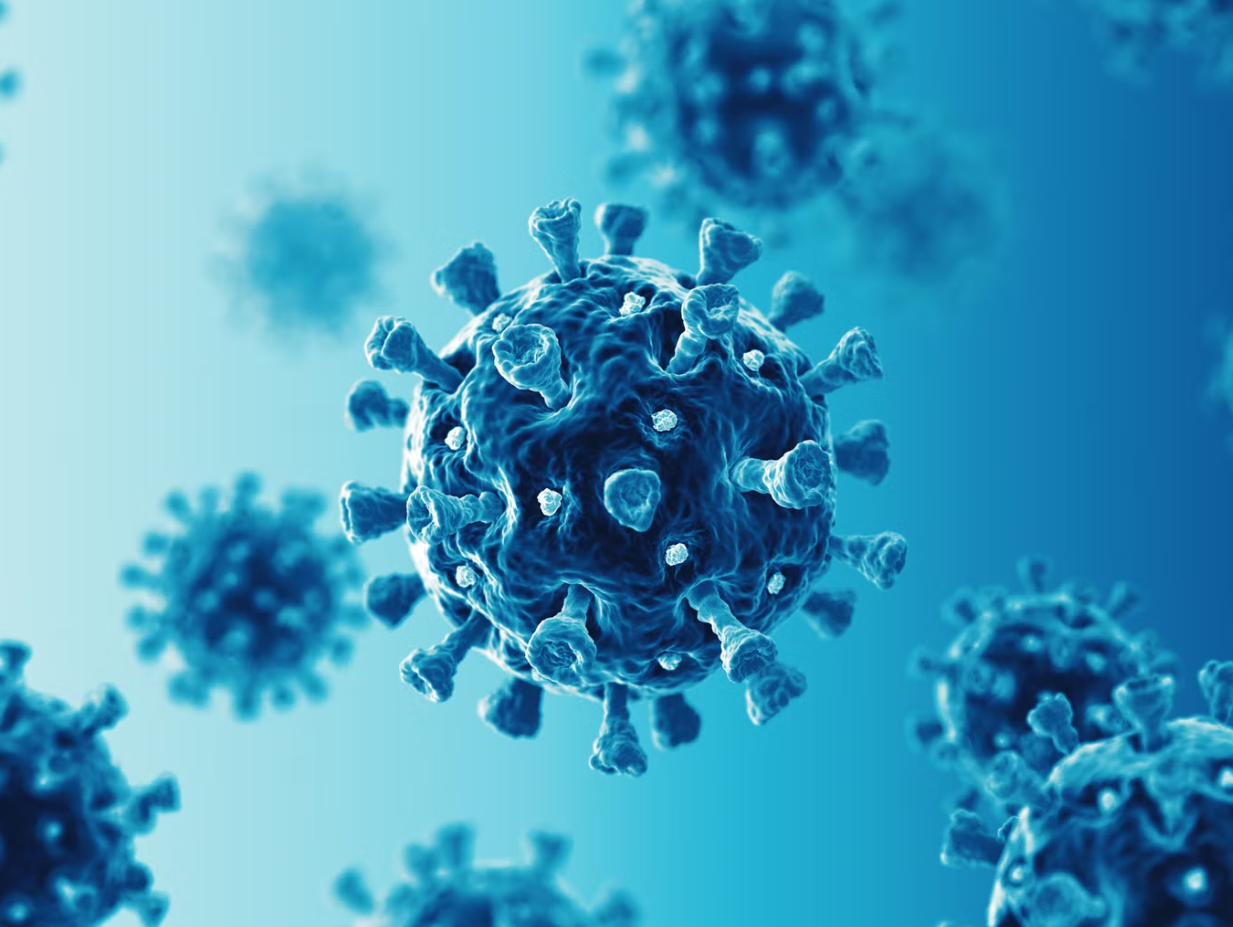بفضل التقدم الذي أحرزه الطب الحيوي، شهد مستوى الرعاية الصحية في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك البلاد الأكثر فقراً، أوجه تحسن كثيرة.
[يشار إلى الطب الحيوي Biomedicine في بعض الأحيان باسم الطب البيولوجي. ويشير إلى مسار طبي يعمل استناداً إلى التقنيات والبحوث المتعلقة بالبيولوجيا والجينات والكيمياء الحيوية، أكثر من تركيزه على العمل الإكلينيكي والعيادي المباشر].
وقد أدى ذلك التقدم إلى زيادة معدلات الأعمار. وعبر السنوات الخمس والعشرين الماضية، أضاف الإنسان العادي سبع سنوات إلى متوسط العمر المتوقع. يضاف إلى ذلك أن المكاسب تتخطى مجرد البقاء على قيد الحياة. فقد ارتفع أيضاً عدد السنوات التي يسعنا أن ننعم خلالها بالصحة في خضم جائحة "كوفيد- 19"، كان العلم خلاصنا. إذ طور العلماء اللقاحات المضادة للفيروس بسرعة غير مسبوقة، مع العلم أنه ليس في متناولنا حتى الآن، لقاح فاعل ضد فيروس نقص المناعة البشرية "أتش أي في" HIV [المسبب لمرض الإيدز]. ولكن، قد يجلب هذا الحقل الطبي للبشرية فوائد أكبر في المستقبل.
في الوقت نفسه، يؤدي هذا التقدم إلى انكشاف نقاط ضعف وإثارة معضلات أخلاقية. وقد بات من الواضح تماماً أن تقاسم الفوائد المستقاة من الطب البيولوجي لا يتسم بالتساوي، سواء داخل البلد الواحد، أو، وبصورة أكبر، بين الدول الغنية ونظيرتها الفقيرة. بالتأكيد، يعد الحد من تلك التفاوتات ضرورة ملحة. ولكن، للأسف، تسير الأمور الآن في الاتجاه الخاطئ. إذ ينصب كثير من التركيز على "أمراض الأغنياء" وليس الأمراض المعدية [التي تطال الناس كافة، خصوصاً الأكثر فقراً].
على مرّ تاريخ الطب، أظهر الناس ابتعاداً عن الابتكارات التي بدا أنها تتعارض مع الطبيعة، بما في ذلك التطعيم، وعمليات نقل الدم، والتلقيح الاصطناعي، وزرع الأعضاء، والتخصيب في المختبر. بالتالي، تُذكر حقيقة أنه لا يمكن الاعتراض على تلك الإنجازات اليوم، بأن الشعور بالقلق الشديد والحساسية تجاه الأشياء المبتكرة لا يبرر عدم الدفاع أخلاقياً عن الإنجازات الطبية التي تستحق ذلك. وتشمل التقنيات الحديثة التي ما زالت موضع خلاف، بحوث الخلايا الجذعية و"زراعة الميتوكوندريا" (ما يسمى بالأطفال الثلاثية الآباء). وفي الواقع، ستتعمق وتتبدل تلك الهوة بين ما يضعه العلم الطبي بين أيدينا، وبين ما يعد فعلاً رشيداً أو أخلاقياً، وفي حالات كثيرة، سيكون ردمها أمراً عسيراً. [توصف الـ"ميتوكوندريا" بأنها مصانع توليد الطاقة في الخلايا. وهناك أمراض تصيبها. ويكون علاج بعض تلك الأمراض بنقل "ميتوكوندريا" سليمة من شخص ما، إلى داخل خلية جذعية للمصاب. ثم تتطور الخلية الجذعية وتتكاثر لتولد خلايا فيها "ميتوكوندريا" سليمة. ولأن الخلية الجذعية تظهر في مرحلة مبكرة بعد تلقيح البويضة الأنثوية من حيوان منوي، توصف تلك العملية بأنها ثلاثية، لأنها تشمل نقل "ميتوكوندريا" من شخص ثالث].
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في سياق متصل، لقد انخفضت تكلفة التعرف إلى رموز التسلسل الجيني [الشيفرة الجينية] في الحمض النووي الوراثي "دي أن أي"DNA . وفي عام 2003، جرى التعرف إلى الشيفرة الكاملة للجينوم البشري، بفضل مشروع دولي بلغت ميزانيته ثلاثة مليارات دولار. واعتبرت تلك الخطوة تطوراً مثالياً ضمن ما يسمى إنجازات "العلم الكبير" Big Science. بعد ذلك، تراجعت تكلفة تسلسل الجينوم البشري إلى أقل من ألف دولار. وفي مستقبل قريب، سيصبح إجراء ذلك الفحص الطبي عملية عادية بالنسبة إلينا جميعاً. في الوقت نفسه، صار ممكناً استيلاد الجينات وحتى الجينومات البسيطة من مكونات أولية بسيطة.
ومع ذلك، يعرف معظم الناس الفارق بين تدخل من شأنه أن يشفينا مما يضر بنا، ويعد فعلاً مرحباً به، وبين تدخل آخر الغرض منه تعزيز ما نمتلكه أصلاً، لكنهم يخشون منه. سواء أكان هذا الاختلاف مهماً من الناحية الأخلاقية (أو حتى مجدياً، في كثير من الحالات) أم لا، فإن الاحتمال الفعلي لتعزيز قدرات الإنسان عبر التلاعب بالجينات، ما زال أمراً بعيد المنال. تنجم بعض الأمراض الوراثية، من بينها "مرض هنتنغتون" من جين واحد يمكن قصه باستخدام تقنية تعديل الجينات [أو مقص الجينات] "كريسبر كاس 9" CRISPR-Cas9. [يصيب مرض هنتنغتون الدماغ ويؤثر بشكل خاص في الجهاز الحركي بما في ذلك النطق].
وفي المقابل، يبقى معظم الأمراض، كالفصام [الشيزوفرينيا]، أو القابلية للإصابة بآلزهايمر أو السرطان، نتاج مئات أو آلاف الجينات، يؤثر كل منها، ولو بمقدار ضئيل، في احتمال إصابة الشخص بالمرض.
ربما ينطبق هذا الوصف بصورة خاصة على صفات ومواهب كالطول والذكاء والهوية الشخصية. وحينما تتوفر البيانات عن شيفرة الحمض النووي لدى ملايين من البشر، وكذلك تلك المتعلقة بصفاتهم، يصير ممكناً (باستخدام أنظمة التعرف إلى الأنماط بمساعدة نوع من الذكاء الاصطناعي) تحديد التوليفات المرغوبة من الجينات [بمعنى التعرف إلى التوليفات التي تتحكم بالصفات المرغوب فيها]. قبل بلوغ هذا الإنجاز، وكذلك النجاح في استيلاد الجينات بثقة من دون إحداث "تأثيرات سلبية" جديدة قد تتأتى منها، لن يصير "الأطفال المصممون" أمراً وارداً.
[يستعمل مصطلح الأطفال المصممون Designer Babies في الإشارة إلى فكرة التحكم بالمنظومات الجينية لدى البشر إلى حد استيلاد أطفال يتضمن الجينوم لديهم المواصفات التي يرغب فيها الوالدين كالذكاء ولون البشرة والخلو من الأمراض الوراثية وغيرها].
وفي المقابل، تسود مخاوف حقيقية بشأن المكان الذي ربما يحملنا إليه التطور الذي يشهده علم الوراثة. في الواقع، ثمة إحجام واسع النطاق عن مناقشة تلك المسألة على نحو صائب، إذ تفوح منها رائحة حركات تتبنى مفهوم تحسين النسل "يوجينيا" Eugenia الذي بات مكروهاً الآن بعد أن ظهر في النصف الأول من القرن العشرين. [تبنت الفاشية والنازية نظريات عنصرية تؤكد تفوق عرق أو أعراق محددة على غيرها، إضافة ضرورة تخلص تلك الأعراق المتفوقة من الأشخاص الضعفاء والمرضى فيها. بالتالي، رأت أنه يجب أن يجري التحكم في التكاثر لضمان تكاثر ما اعتبرته العرق الأفضل، وكذلك الأشخاص الأفضل ضمنه. عرف ذلك باسم يوجينيا وترجمتها الحرفية الجينات السوية. وشكلت جزءاً من تبرير الأعمال العنصرية للفاشية والنازية، بما في ذلك العداء للسامية والهولوكوست].
تجسد البحوث المتعلقة بالشيخوخة هذه المخاوف. ومن البديهي تحفيز التقدم بالبحوث العلمية التي ترمي إلى مدنا بسنوات إضافية من الحياة الموفورة بالصحة. في ذلك الصدد، لقد أنشئت مختبرات "ألتوس" Altos، المهتمة بمعالجة هذه المشكلات، في كاليفورنيا (في منطقة خليج سان فرانسيسكو وسان دييغو) وفي كامبريدج (المملكة المتحدة)، بتمويل من بعض الأميركيين أصحاب المليارديرات. وحينما كان أولئك الأشخاص في سن الشباب، تطلعوا إلى أن يكونوا أثرياء. وبعدما حققوا ثروات، باتوا راغبين في استرجاع شبابهم، لكنها ليست خطوة سهلة!
هل ستكون المنافع متواضعة وتصاعدية؟ أم أن الشيخوخة "مرض" يسعنا كبحه أو القضاء عليه؟ في البداية، سيكون التطور المذهل المتمثل بإطالة عمر الإنسان، إذا ثبت أنه ممكن أصلاً، امتيازاً مقتصراً على النخبة الثرية، ما يضعنا إزاء وجه جديد من عدم المساواة الأساسية. أما إذا صار واسع الانتشار، فسيكون بصراحة "ورقة خطيرة" حقيقية في التوقعات السكانية، مقروناً بعواقب اجتماعية مهولة الوطأة.
ثمة منحى اخر، فإضافة إلى التمييز بين التدخل الذي يجد العلاجات وبين ذلك الذي يعزز ما لدينا أصلاً، يرسم كثيرون خطاً للفصل بين التلاعب الجيني الذي تقتصر آثاره على الأنسجة الجسدية للأفراد، ونظيره الذي يصل إلى البويضات لدى المرأة أو الحيوانات المنوية لدى الرجل، ثم ينتقل إلى الأنسال. في الواقع، يجبرنا التلاعب في الخط التناسلي للأنواع الحية الأخرى على التفكير ملياً في حدسنا الأخلاقي. مثلاً، شهدت أجزاء من البرازيل ومناطق أخرى محاولة لتعقيم، بالتالي تقليل بل ربما إفناء، أنواع البعوض التي تنشر فيروسي "زيكا" و"حمى الضنك". وسجلت التجارب انخفاضاً بـ90 في المئة في أعداد هذا البعوض المحلية. هل من السيئ أن "نؤدي دور الخالق" بهذه الطريقة؟ ترمي تقنيات مقترحة مماثلة إلى الحفاظ على البيئة الفريدة التي تتسم بها جزر "غالاباغوس" من طريق استئصال الأنواع المؤذية التي غزتها كالجرذان السود.
إذا استمر تقدم التكنولوجيات المتصلة بهذه التدخلات، فثمة على ما يبدو أنه احتمال حقيقي طويل الأجل بالوصول إلى "تعزيز" البشر، أي أدمغتهم وأجسادهم، من طريق تحوير الجينات والتعديلات المتعلقة بتحويل شخص ما إلى "سايبورغ" Cyborg.
[جاء اسم سايبورغ من عالم الأدب لوصف كائن تتخطى قدراته الجسدية الحدود البشرية العادية نتيجة دمج عناصر إلكترونية وروبوتية وسيبرانية في جسمه]. علاوة على ذلك، ربما استلزم الأمر مرور قرون من الزمن كي يتبلور هذا التطور المستقبلي الذي يبدو كأنه من نوع "التصميم الذكي" العلماني الذي قد يقود حتى إلى ابتكار نوع حي جديد. في المقابل، استلزم حدوث التطور البيولوجي الطبيعي آلاف القرون، وفق نظرية داروين. [اعتقد داروين بأن جميع أنواع الكائنات الحية تنشأ وتتطور من خلال عملية الانتقاء الطبيعي للطفرات الموروثة التي تزيد من قدرة الفرد على المنافسة والبقاء على قيد الحياة والتكاثر].
بطبيعة الحال، من شأن هذا التطور السريع أن يقلب مسار الأمور. إذ يثير الأدب والقطع الفنية اليدوية التي نجت من العصور القديمة إعجابنا، نشعر بألفة وتقارب، عبر فجوة زمنية تمتد آلاف السنين، تجاه أولئك الفنانين القدامى وحضاراتهم. ولكن ليس لدينا أدنى قدر من الثقة في أن الذكاءات التي ستهيمن بعد مرور بضعة قرون، ستشعر صدى عاطفي تجاهنا، على رغم أنها ربما تحمل فهماً خوارزمياً لسلوكياتنا.
وعلى كل حال، لا يجسد التلاعب [التعديل] الجيني التحدي الأخلاقي الوحيد الذي سيزداد حدة مع تقدم علوم الطب الحيوي. كذلك ستواجهنا معضلات حادة بشأن علاج من هم في بداية حياتهم ومن بلغوا نهايتها. إذ يثمن الجميع فرصة التنعم بسنوات من الحياة ملؤها الصحة والعافية، في المقابل، يخشى معظم الناس احتمال أن يبقوا على قيد الحياة مع مكابدة أحوال من الألم أو الإعاقة الجسدية الخطيرة أو الخرف. لقد باتت المساعدة على الموت أو الموت الرحيم الاختياري، إجراء مشروعاً بحسب القانون، مع الالتزام بالتدابير المطلوبة، في عدد من البلاد الأوروبية، والولايات الأميركية.
في المملكة المتحدة، يؤيد 80 في المئة من الرأي العام إضفاء الشرعية على هذا الإجراء. وكذلك يتجه الرأي الطبي المهني نحو تأييده أيضاً. ويبدو الآن أن الموت الرحيم الاختياري يحظى بأصوات متكافئة بالنسبة إلى الرفض والقبول. ويمكن للمرء أن يجد حتى رؤساء الأساقفة على جانبي الجدال. وبالمثل، صحيح أن علاج الأطفال الخُدج يبدو معجزة حقيقية، لكنه ربما يقود أيضاً إلى إنقاذ أطفال لن ينموا ويتطوروا بشكل صحيح أبداً، ما يسفر عنه في المحصلة، حقل ألغام أخلاقي. إنها الحالات التي يبدو فيها ضبابياً ذلك الحد الفاصل بين المسائل التي يستحق فيها العلماء تنويهاً خاصاً بوصفهم خبراء من جهة، وبين المسائل الأخلاقية غير التقنية من جهة أخرى، حيث يتحدثون، مع البقية منا، باعتبارهم مجرد مواطنين.
في سياق مواز، تطرح البحوث حول الفيروسات كـ"كوفيد- 19" الشرير، معضلات نارية وموقوتة. في 2011، كشف باحثون في "جامعة إيراسموس" في هولندا و"جامعة ويسكونسن" في الولايات المتحدة أنه من السهل جداً التلاعب بفيروس "أتش 5 أن 1"H5N1 المسبب لإنفلونزا الطيور ليصير أشد ضراوة وأكثر قدرة على العدوى على حد سواء. وقد تحدى تأكيدهم الديناميكية التطورية التي تقول عادةً بأن إحدى تلك الميزات قد توجد لكنها تتطور على حساب ميزات أخرى لأن الفيروس الذي يقتل مضيفه لا يعود قادراً على استخدام ذلك المضيف كي ينتقل إلى آخرين ويعاود نشر نفسه. وتندرج تلك التجارب "الفاوستية" ضمن عمليات "اكتساب الوظائف". [يستخدم مصطلح اكتساب الوظائف في وصف البحوث الطبية التي تتضمن إدخال تغيير على المسببات البيولوجية للأمراض كالبكتيريا أو الفيروسات، بطريقة تزيد حدة المرض، أو قابليته الانتقال، أو الأنواع التي تصاب بها].
ولقد بُررت تلك التجارب بوصفها وسيلة لاستباق الطفرات الطبيعية التي تحدث بصورة دائمة، لكن من المستطاع استخدامها لتنفيذ مآرب خبيثة. وبعدما حظرت الحكومة الفيدرالية الأميركية تلك التجارب في عام 2014، عادت، لأسباب بدت غير واضحة نوعاً ما، إلى التساهل في هذه القواعد بعد مرور ثلاث سنوات على الحظر.
مع العلم أنني لست خبيراً، فلقد كتبت للمرة الأولى عن هذه المخاطر البيولوجية في 2003. ورأى بعض الزملاء الأوسع اطلاعاً أن الكارثة ستكون أكثر احتمالاً مما توقعت. على الموقع الإلكتروني "لونغ بتس" Long Bets الذي تديره مؤسسة "لونغ ناو" الخيرية، خضت رهاناً على أن "الإرهاب البيولوجي أو الخطأ البيولوجي سيقود إلى مليون ضحية في حدث واحد خلال فترة ستة أشهر تبدأ في موعد أقصاه 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020". لخير الإنسانية، كنت ولا ريب أتمنى بشدة أن أخسر هذا الرهان. ولم أفاجأ إذ قَبِل ذلك الرهان عالم النفس ستيفن بينكر، في 2017، بمبلغ قدره 400 دولار (ستذهب المكاسب إلى أعمال خيرية). كتب بينكر كتابين يوثقان التراجع التاريخي للعنف والفقر والأمية والمرض. وقارن بينكر البيانات المؤكدة حول تلك الاتجاهات الإيجابية مع كآبة المراقبين الذين كانت نظرتهم إلى العالم في رأيه منحازة نتيجة عينات غير عشوائية لأسوأ الأشياء التي تطرأ كل يوم، والتي تهيمن قطعاً على وسائل الإعلام.
واستكمالاً، لقد خلف "كوفيد- 19" دماراً أشد بأشواط من الحدث الذي كنت راهنت على أنه قد يطرأ بحلول 2020. ونتفق بينكر وأنا على أن الجوائح تشكل تهديداً دائماً، وربما خطراً متزايداً بسبب الازدحام السكاني وتفاقم انتشار الفيروسات من طريق الرحلات الجوية. لكنني صغت رهاني مستثنياً الأوبئة الناشئة بصورة طبيعية. آنذاك، تصورت حدثاً قد ينجم من "خطأ بيولوجي أو إرهاب بيولوجي". هل نحن متأكدون من أن "كوفيد- 19" كان جائحة من صنع الطبيعة؟ في الأسبوع الأول من عام 2021، حان موعد رهاننا، وقد شرحنا عبر البريد الإلكتروني كيف نرى أنه يفي بالغرض. توصلنا إلى اتفاق فوري. على رغم أن الإجماع يميل إلى اعتبار أن المرض حيواني المنشأ، بمعنى أنه انتقل من الحيوانات إلى البشر، ربما عبر مضيف وسيط (ما سيجعل بينكر الفائز)، اتفقنا على أنه لا يمكن استبعاد الاحتمال الذي يتحدث عن تسرب للفيروس من "معهد ووهان لبحوث الفيروسات" في الصين.
في الحقيقة، نظراً إلى اللايقين العلمي والغموض المتعمد من السلطات الصينية، ربما لا يحسم رهاننا أبداً. سيكون ذلك محبطاً ومثيراً للحنق، بالنسبة إلى العلم والصحة العامة أكثر منه بالنسبة إلينا، ولكنه لا يخلو من بعض العزاء. إذا توفر دليل على حدوث تسرب من المختبر، وفق ما أشار الباحث القانوني ستيفن كارتر، فإن ذلك "يعطي ملحمة الفيروس التاجي [العائلة التي ينتمي لها فيروس كورونا] كل ما ينقصها، أي الشرير، وكذلك الخوف المبهم الذي شل حركة معظم أرجاء العالم خلال العام ونصف العام الماضيين. ويضاف إلى ذلك، ظهور هدف محدد. وربما تتحد هذه العوامل جميعها معاً فتتحول إلى سخط شديد". كذلك من شأن تلك الأمور أن تقلب الناس ضد العلم وتستجلب قواعد تنظيمية معوقة واسعة النطاق، وتبطئ عجلة التقدم ضد المرض والوفاة والإعاقة.
في مقلب مغاير، بغض النظر عن منشأ "كوفيد- 19"، لا يمكننا استبعاد حدوث تسرب من المختبر في المستقبل (مع التذكير، مثلاً، أن انتشار الحمى القلاعية في المملكة المتحدة كان بسبب حادثة تسرب في مختبر "بيربرايت" في مقاطعة "سوراي" في عام 2007). ثمة بالطبع ما يدعو إلى تعزيز الأمن وعمليات الرصد المستقلة للمختبرات من "المستوى 4" [أي الفائقة التطور] حول العالم التي تتناول بحوثها مسببات الأمراض الفتاكة.
بالنتيجة، هل يمكننا استبعاد أي تسرب مستقبلي ربما يكون متعمداً وليس عرضياً؟ لا ريب أن الحكومات، وحتى الجماعات الإرهابية المحددة الأهداف، ستمتنع دائماً عن إطلاق أسلحة بيولوجية، لأن أحداً لا يمكنه أن يتنبأ أين وإلى أي مدى يمكن أن تنتشر. يتجسد الكابوس الحقيقي في أن يكون شخصاً منعزلاً ومختلاً ولديه خبرة في مجال التكنولوجيا الحيوية. ومثلاً، أعتقد أن الكوكب يفيض بعدد مهول من البشر، ولم يأبه من أصيب أو كم بلغ عدد الحالات. سيجمع السلاح البيولوجي النهائي بين القوة الفتاكة، وقدرة نزلات البرد على العدوى (أو متحورة "أوميكرون" من "كوفيد- 19") وفترة طويلة من العدوى الخالية من أي أعراض، ما يسمح بالانتشار الهائل للفيروس قبل اتخاذ الإجراءات المضادة.
في المقابل، أعتقد بوجود قلق خطير بشأن التطبيق العالمي الفاعل لأي قواعد تنظيمية قد يصار إلى فرضها، لأسباب احترازية أو أخلاقية. هل يمكن تطبيقها في مختلف أنحاء العالم على نحو أكثر كفاءة من القوانين الخاصة بالمخدرات، أو الضرائب؟ يستطيع شخص ما موجود في مكان ما إحداث الأمور الواردة أعلاه كلها. على النقيض من المعدات المتطورة والواضحة ذات الأغراض الخاصة اللازمة لصنع سلاح نووي، التي يتولى مراقبتها مفتشون دوليون، تنطوي التكنولوجيا الحيوية على تقنيات صغيرة الحجم وثنائية الاستخدام [أي إنها تصلح للأغراض سلمية وحربية] ستصبح متاحة على نطاق واسع. هكذا، سيكتسب عدد متزايد من الأشخاص الخبرة المطلوبة. في الحقيقة، تتعاظم القرصنة البيولوجية باعتبارها هواية ولعبة تنافسية.
في حقبة مستقبلية من التمكين الواسع للأفراد، سيكون من شأن عمل خبيث أو أحمق واحد، التسبب بعواقب كثيرة. إذاً، كيف لنا أن نحمي مجتمعنا المفتوح؟ بالتالي، فإن التمكين المتزايد للمجموعات (أو حتى الأفراد) البارعة في مجال التكنولوجيا، من طريق التكنولوجيا الحيوية ونظيرتها الإلكترونية، سيشكل تحدياً صعباً أمام الحكومات ويفاقم حدة التوتر بين الحرية والخصوصية والأمن.
مقتطف من "إن كان للعلم أن ينقذنا" If Science is to Save Us بقلم عالم الفلك الملكي مارتن ريس. يتوفر في المكتبات الآن، وقد صدر عن دار "بوليتي بريس"
نشر في "اندبندنت" بتاريخ 04 نوفمبر 2022
© The Independent