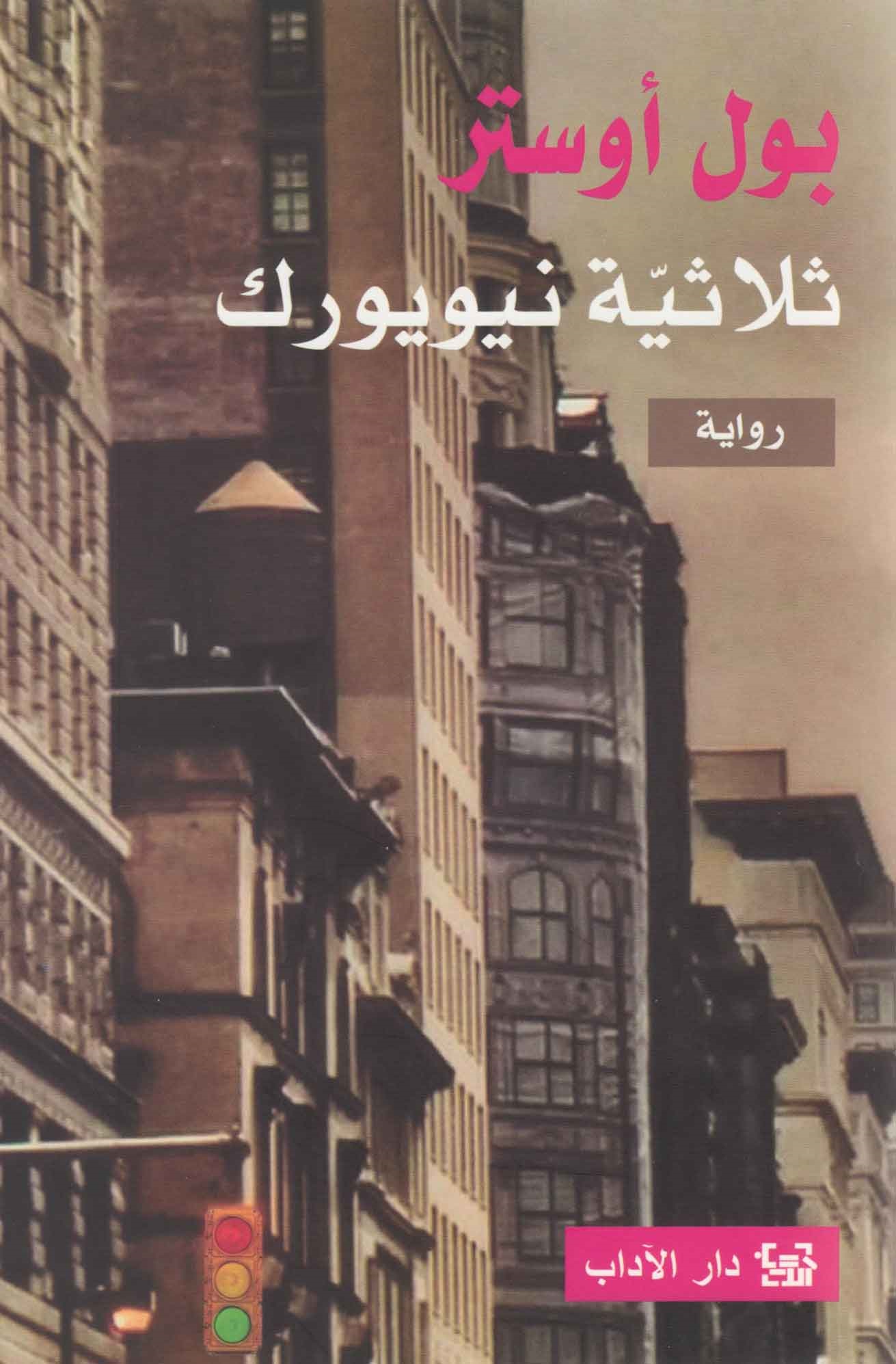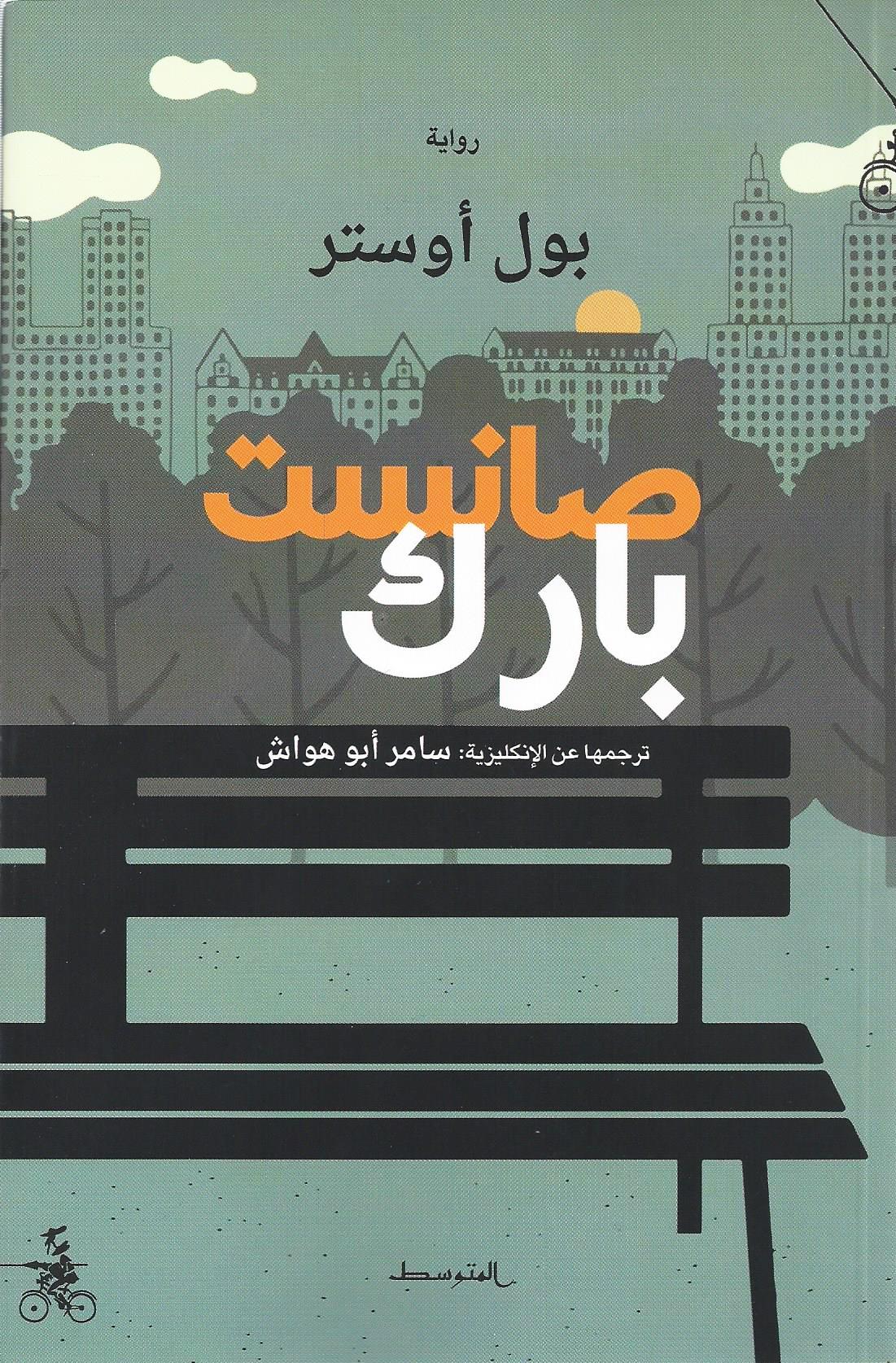يبرع الروائي الاميركي بول أوستر يبرع في فنّ حبك خيوط التاريخ بخيوط حيوات شخصياته. براعة تتجلى بقوة في روايته الأخيرة "4321" التي يلجأ فيها أيضاً إلى تلك المهارات الكتابية والمناورات السردية التي كرّسته كأحد أكبر كتّاب أميركا المعاصرين ومؤلّف روايات تقع عند تقاطُع الحكاية الفلسفية وفيلم المغامرات. كرواية متاهية، نتلقّى سردية "4321" على شكل فيلم تشويقي (thriller) ونكتشف فيها أربع حيوات مختلفة لشخصية واحدة وُلِدت في اليوم نفسه والسنة اللذين وُلِد أوستر فيهما، وفي المكان نفسه، أي بلدة نيوويرك في ضاحية نيويورك. رواية حيوية ومدهشة إذاً يطرح صاحبها من خلالها سؤالاً بسيطاً: ما كانت ستصبح حياتنا لو سلكنا هذه الطريق بدلاً من تلك، لو تزوّجنا من هذه المرأة وليس من تلك، لو توفّي والدنا ونحن في سنّ السادسة...؟ باختصار، إنها المفترقات والمنعطفات والخيارات وكل التفاصيل الصغيرة التي تتكوّن منها "موسيقى المصادفات" (عنوان واحدة من رواياته) وتشكّل مصدر افتتانٍ له. وسواء في هذه الرواية أو في سابقاتها، شخصياته هي نفسها، أيّ نساء ورجال يتخبّطون داخل أحداثٍ تتجاوزهم، غرقى يتصارعون مع أشباحهم، مسافرون بلا متاع ولا وجهة محدَّدة، متأمّلون في المطلق يصطدمون بألغاز لا حلّ لها، وجميعهم يعيش في بلد ــ أميركا ــ ما برح هذا العملاق يسبر تناقضاته، رواية بعد أخرى، مانحاً إيانا عملاً كتابياً يتمتّع بتماسكٍ وقوةٍ نادرتين.
أوستر هو أيضاً كاتب نيويورك الأول، ليس فقط لكونه عاش منذ صباه في مختلف أحياء هذه المدينة، بل أيضاً لاختياره إياها مكاناً للعديد من رواياته. وفي منزله الذي يقع حالياً في بروكلين، التقاه الناقد الفرنسي فرنسوا بونِل وحاوره في وضع أميركا اليوم، في دور الأدب وكتّابه، وطبعاً في عمله الكتابي. حوار صدر حديثاً في مجلة "أميركا" الأدبية الفصلية، وفي ما يأتي مقتطفات منه. ومعروف أن معظم روايات بول أوستر مترجمة إلى العربية ولها قراء كثر.
فصل العبودية
يتحدث أوسترعن حالته النفسية الراهنة حيال الأزمات التي تتخبط فيها أميركا والعالم قائلاً: "إنني قلِق. بصراحة، لم أختبر أبداً مثل هذا الشعور من قبل. منذ خمسين عاماً، في أوج حرب الفيتنام، كنت قلقاً، لكني كنت احتفظ بنوعٍ من التفاؤل لاعتقادي بقدرتنا، نحن الشبان والطلاب وكل من كان ضد هذه الحرب، على وضع حدّ لها. كنت مخطئاً، لكني كنت أعيش في الأمل. اليوم، شعوري مختلف. ولا أرى سوى وسيلة واحدة: علينا أن نبدأ ذلك الحوار الذي لم يحصل بعد في بلدنا. علينا أن نكلّم أولادنا عن فصل العبودية وأن نعلّمهم ما حصل خلاله. علينا أن نقول لهم إن أميركا هي بلد رائع، وفي الوقت نفسه، بلد مبني على جريمتين: إبادة الهنود الحمر واستعباد ذوي البشرة السوداء. حين كنت فتياً، كانوا يقولون لنا في المدرسة: "أنتم تعيشون في أعظم وأجمل بلد في العالم"، وإن كل شيء فيه يتّسم بالكمال. يا لهذه الكذبة! يجب أن نقول الحقيقة. إلى حد اليوم، لا يوجد متحف أميركي حول فصل العبودية".
ويعبر عن يأسه إزاء تراجع القراءة في أميركا واللامبالاة بالأدب: "ماذا يمكن أن تفعله رواية أمام لا مبالاة العالم؟ المشكلة الحقيقية تكمن في قلة الناس الذين يقرأون في هذا البلد، وفي العالم عموماً. في أفضل الأحوال، يمسّ كتاب مئتين أو ثلاث مئة ألف قارئ. لكن حتى لو مسّ مليون قارئ، يبقى الأمر ضئيلاً في أمّة تعدّ 320 مليون نسمة. الروايات غير قادرة على تغيير العقليات. ورغم ذلك ما زال للأدب أهميته، ولكن لحفنة قليلة من الناس فقط. كم من أولئك الذين يصرخون اليوم كراهيتهم للسود قرأوا أو سيقرأون توني موريسون أو فيليب روث؟ ربما واحد أو اثنان. نحن نعيش في ولايات غير متّحدة، في عالمٍ مصدّع حيث ثمة فريقان لا يتحدّثان اللغة نفسها، وعاجزان إذاً عن التواصل".
وفي العودة إلى الأدب، حتى لو أن الكتّاب يدركون أنهم لن يغيّروا العالم، ألا يمكنهم المشاركة في نشر الوعي من خلال كتبهم؟ يقول اوستر: "سؤال مسؤولية الكاتب يتسلّط عليّ منذ بداياتي. لكن جوابي عنه لم يتغيّر. لا مسؤولية للكاتب إلا تجاه ما يكتبه. ككاتب، لا يقتضي عملي أن أتحدّث باستمرار في المشاكل السياسية أو الاجتماعية في وسائل الإعلام، بل أن أكتب قصصاً. مهمة الروائي التحدّث عن الحياة الداخلية للبشر. المهم فعلاً في نظري ككاتب هو أن أبقى هنا، جالساً خلف طاولتي للكتابة. الفن موجود لأن العالم يفتقد للكمال. الفن لا يحلّ أي مشكلة من مشاكل العالم، بل يعبّر عن الألم والجمال والصعوبات... الكتب لا توقف إطلاق الرصاص ولا تمنع القنابل من الانفجار ولا تغذّي طفلاً جائعاً، لكنها تغذّي النفوس، وهذا الغذاء جوهري. لذلك، على الكاتب تكريس نفسه لفنّه. كان الشاعر جون أشبيري يقول إن عمله الشعري يتحلى بقيمة أكبر من أي نصّ ملتزم ضد الحرب. وفي ذلك هو محقّ. إن كتبتَ نصاً شعرياً ضد هذه الحرب أو تلك، لن يقرأه إلا أولئك المعارضون لها، ولن يكون له أي تأثير على مؤيّديها. الأدب ليس فن الاقناع، أي أنه غير قادر على تغيير موقف الناس. وإن تمكّن من تغيير شيءٍ ما، فبطريقة غير مباشرة، حميمية".
أثر دوستويفسكي
هذا ما يحصل لإحدى شخصيات رواية "4321"، فيرغوسون الرابع. ففي سن الخامسة عشرة، يقرأ دوستويفسكي فتغيّر هذه القراءة حياته. يقول: "نعم، قراءة دوستويفسكي قادرة على تغيير حياتك، لأنها تعمل في حميميتك. استقيتُ هذا التفصيل من تجربتي الخاصة، علماً أن التفاصيل السير- ذاتية قليلة في هذه الرواية. قراءة دوستويفسكي قلبت حياتي وساهمت بالتأكيد في دفعي نحو الكتابة. حين أتكلّم في السياسة، كما نفعله الآن، أتكلم كمواطن لا ككاتب، وأجوبتي عن الأسئلة التي تطرحها الحقبة الحالية هي إذاً أجوبة مواطن".
ـ لكن اوستر لم يمتنع عن كتابة روايات حول أحداث سياسية راهنة، كاعتداءات 11 سبتمبر 2011... يقول: "مرة واحدة، نعم، في "حماقات بروكلين". لكني عالجتُ هذا الموضوع بطريقة غير مباشرة، في نهاية الرواية. تتطلب كتابة رواية من كاتبها أن يأخذ مسافة من الحدث المقارَب. رواية "حرب وسلام"، مثلاً، كتبها تولستوي بعد خمسين عاماً من الأحداث التي يرويها فيها. كان السينمائي بيلي وايلدر يقول إنه فقط حين نكون سعداء وواثقين من أنفسنا علينا أن نكتب "تراجيديا"، وحين نكون مكتئبين، داخل ثقبٍ أسوَد، علينا أن نكتب "كوميديا". شخصياً، كنت في حالة نفسية يرثى لها حين كتبتُ "حماقات بروكلين"، وهي رواية كوميدية نيويوركية حول ملذات – ومتاعب- الحياة الصغيرة في تلك اللحظة التي تصطدم فيها طائرة بناطحة سحاب وتدمّرها".
ويقول عن رواية "سانست بارك" التي تشكّل أزمة 2008 المالية خلفية لها: "وضعتها في ظرفٍ خاص جداً ولتلبية رغبتي آنذاك في تأليف رواية حول زمننا الراهن. وبما أنني تابعتُ باهتمام كبير الأزمة المذكورة وتداعياتها على حياة كل فرد في العالم، اخترتها كموضوع لهذا العمل الذي كتبته بصيغة الحاضر، في ظرف ستة أشهر فقط، وخرجتُ منه منهكاً كلياً". ويضيف: "لكتابة رواية جيدة، يجب امتلاك قدرة على تعاطفٍ لا حدود له مع الشخصيات التي نبتكرها، بما في ذلك تلك غير الجديرة بالإعجاب، كالمجرمين أو المجانين. حين نفعل ذلك، نؤكّد للعالم أجمع بأن كل شخص هو إنسان ولديه حياة داخلية تستحق أن نرويها، حتى لو كان مجرماً أو مجنوناً. هكذا نصير كلنا متساويين. كتابة رواية هي المقاربة الأقل سلطوية للكائن البشري. وبهذا المعنى تصبح فعلاً سياسياً. بطريقة غير مباشرة، لكن قوية.
روائي بروكلين
يعيش بول أوسترفي بروكلين منذ 1980، وفي هذا منزله نفسه تحديداً كتب معظم رواياته، يتحدث عن كيفية كتابته: "عادةً، تحضر القصة أولاً، ثم يتبعها الشكل. لكن للمرة الأولى، حصل العكس في روايتي الجديدة، إذ حضر عليّ الشكل أولاً، أي فكرة سرد أربع حيوات موازية لشخصية واحدة. لكني لم أكن أدرك إطلاقاً أي قصة سأروي. ما أن أتتني هذه الفكرة حتى بدأتُ في الكتابة". وعن وضعه تصميماً للرواية يقول: "لا، ولا حتى الخطوط الكبرى. اعتمدتُ الارتجال. كان يتملّكني الشعور بالرقص طوال كتابتها، كما لو أنني كنت داخل دوّامة. كانت الكلمات تطفو فوق طاولتي. كل شيء كان حاضراً، وما كان عليّ سوى مدّ يدي، التقاط الكلمات ووضعها على الورقة. قد يبدو الأمر غريباً، لكني غير قادر على الكتابة وفقاً لتصميم. يجب أن يكون المجهول في انتظاري كل صباح.
لا يؤمن أوستر بما يسمى وحياً أو إلهاماً أدبياً ويقول:"أؤمن باللاوعي. لكن للعثور على شيء داخل اللاوعي، يجب أن نكون في حالة ذهنية خاصة، أي منفتحين جداً وبلا أحكام مسبقة. عندها، ندع الأشياء تحضر، بلا رقابة أو منع. أعتقد أن هذا هو الأهمّ: عدم ممارسة الرقابة أو الحظر على أنفسنا. الشيء الآخر المهم هو أن نعرف متى نتوقّف عن الكتابة. حين أنهي نهاراُ من العمل على رواية، أفعل بعد ذلك كل ما في وسعي كي لا أفكّر فيها. إن اشتغلتُ أكثر مما يجب، يتهددني الجفاف. عليّ أن أعود إلى الحياة العادية. غالباً ما أغادر طاولتي وأنا أمام مشكلة كتابية لم أستطع حلّها، فأتوجّه للنوم. وحين أستيقظ في اليوم التالي، يحضر الحلّ من تلقاء نفسه. إذاً، بدلاً من المكابدة، يجب ترك الأشياء تأتي إلينا بنفسها. هذا ما أؤمن به في الكتابة. حين أكتب، يتحوّل كياني إلى جرحٍ مفتوح، فأتلقّى كل ما يحدث في الشارع، في السماء، حولي، وأضعه في الكتاب الذي أعمل عليه. الكتاب هو أيضاً نوع من الارتجال".
وعن اسلوبه الذي طرأ عليه تغيّر في روايته الضخمة "4321"، التي يستشفّ منها عملية تشييد جديدة وجُمَل طويلة غير معهودة، يقول: "هذا صحيح. لم أرغب يوماً في كتابة الرواية نفسها مرّتين. أكتب كل رواية كما لو أنها الأخيرة، وهو ما يجدد حوافزي على الكتابة. إلى حد اليوم، ما زلت استكشف الأدب، لأنني في العمق لا أملك منهجاً محدداً. بالنسبة إلى "4321"، إنها المرة الأولى التي أكتب فيها رواية بهذا الحجم (866 صفحة)، ولذلك كنت في حاجة إلى إيقاعٍ جديد، والجُمَل الطويلة فرضت نفسها عليّ".
سؤال الموت
وعن ظروف ولادة هذه الرواية الفريدة في مساره يقول: "كنت جالساً هنا، على هذا المقعد، حين اتتني فكرة كتابة رواية أسرد فيها الحيوات التي كان يمكن لشخصية واحدة أن تعيشها لو سلكت هذه الطريق بدلاً من تلك، لو تزوّجت من هذه المرأة بدلاً من تلك، لو اختبرت وفاة أحد والديها بشكل مبكِر... أعتقد أننا، حين نتقدّم في السن، نعيد التفكير بماضينا مسائلين تلك اللحظات المهمة التي حدّدت وجهة مسيرتنا، ومتسائلين عمّا كانت ستكون عليه حياتنا وشخصيتنا لو اتّخذنا خيارات مختلفة فيها".
سؤال الموت يحضر بقوة في جميع روايات أوستر، ويأخذ في روايته الضخمة "4321" بعداً جديداً. يقول في هذا الصدد: "لقد بلغتُ سن السبعين. أعرف أن الجزء الأكبر من حياتي صار خلفي. تغيّرت مقاربتي لحياتي اليومية منذ أن أدركت أن الكثير من الأشخاص الذين كنت أحبّهم ماتوا. الأشباح باتت تتسلّط على حياتي، ولذلك كل شيء صار أكثر قيمةً. كل تجربة، كل قبلة، كل سهرة، كل كتاب، كل فيلم... أعرف أن النهاية قريبة، ولذلك أتذوّق كل هذه الاشياء بحدّةٍ أكبر ومتعةٍ أكبر وألمٍ أكبر. توفيّ والدي في سن السادسة والستين، وإنه لشعور غريب أن نتجاوز سنّ والدنا. كما لو أننا نعبر إلى الجهة الأخرى من ستارٍ خفي ونحطّ في مكانٍ تطغى عليه الغرابة. أنا مقتنع بأن لا حياة بعد الموت. أحاول إذاً أن لا أفكّر كثيراً في الأمر، بل في الحاضر. أتذوّق متعة بقائي على قيد الحياة وأعتبر ذلك هدية ونعمة، أتدري لماذا؟ لأنني أعرف أن كل شيء سينتهي قريباً. هذا لا يخفيني".
وعن السؤال التقليدي: لماذا تكتب؟" يجيب: "لا أعرف. ربما لأن الكتابة هي نوع من المرض، نلتقطه باكراً ولا نشفى منه".