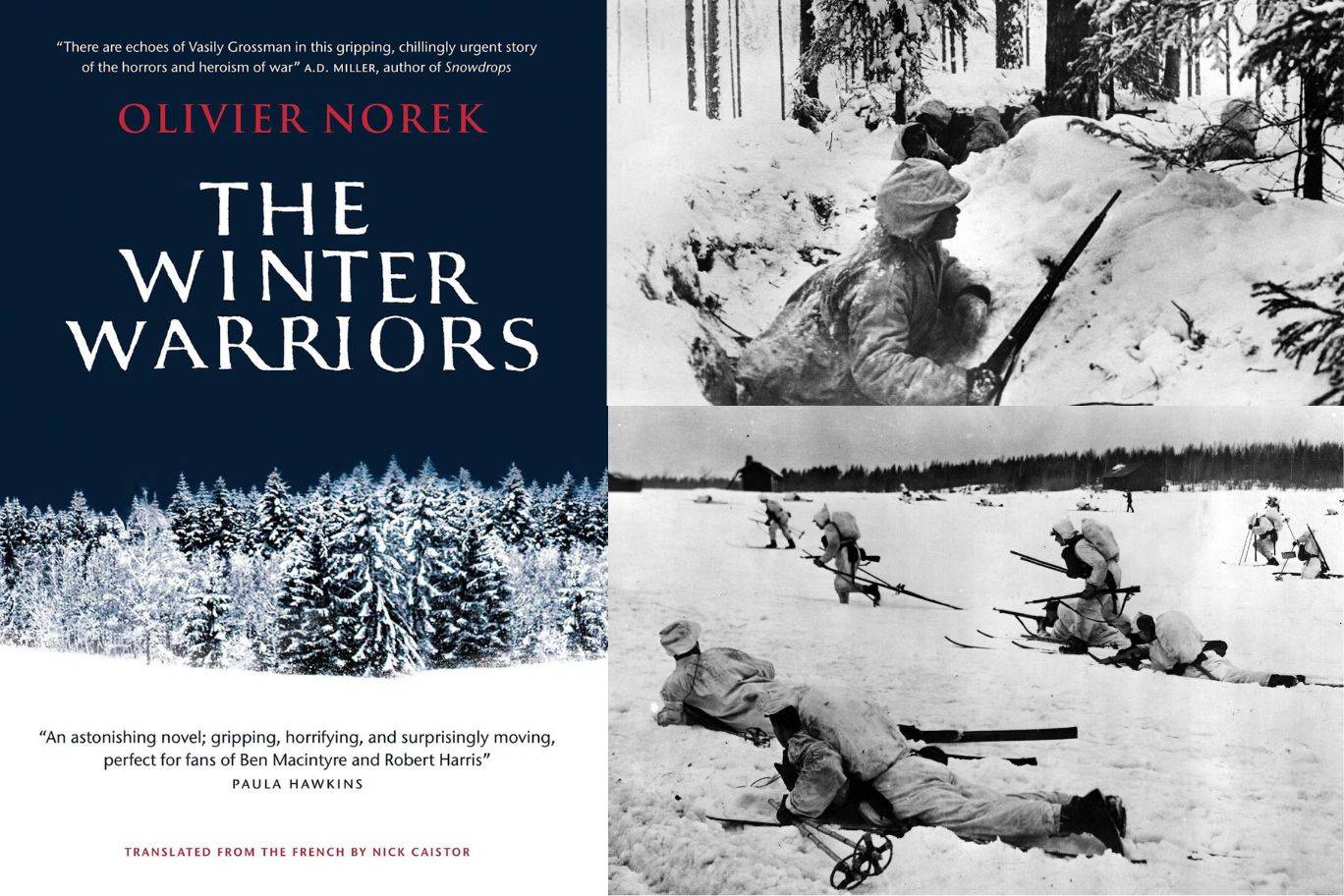ملخص
تقدم رواية "البند السادس من قانون التضحية"، للكاتب المصري علي قطب، رؤية فانتازية للواقع السياسي بعد ثورة 2011 المصرية، تُذكر بروايتي "مزرعة الحيوان" و"1984" لجورج أورويل، وتؤكد في الوقت ذاته أن الواقع المعيش أشد ديستوبية من الخيال.
يقارب الروائي المصري علي قطب في روايته "البند السادس من قانون التضحية" (بيت الحكمة) ثورة الـ25 من يناير (كانون الثاني) من منظور فانتازي يستدعي إلى الأذهان أجواء العالم الديستوبي عند جورج أورويل في "مزرعة الحيوان" و"1984. ويتجلى التشابه هنا في رصد أنظمة القمع التي تراقب من وراء الشاشات، وتعد أنفاس الناس وتسعى إلى تدجينهم وسحق نزوعهم إلى الحرية مع أول بادرة تمرد تلوح في الأفق.
تدور أحداث الرواية في عالم عدمي سوداوي يتبدد فيه اليقين، أبطاله محاصرون من قوى غامضة تطاردهم وتطالبهم بالتضحية بأنفسهم من دون سبب واضح. يتنقل السرد في أزمنة شديدة السيولة، تتأرجح بين حركة الـ23 من يوليو (تموز) 1952، وانتفاضة الخبز عام 1977، وأحداث يناير 2011، قبل أن ينفتح على عوالم أسطورية تستلهم أجواء "ألف ليلة وليلة"، وتتماهى مع عالم الأنيمي وأبطاله الخارقين. نسيج فوضوي تتداخل فيه الأزمنة والعوالم لتجسد فكرة الضياع الجمعي، التي يشير إليها الإهداء: "إلى عالم مشتّت وآمال باهتة"، عالم يختلط فيه الحلم بالواقع إلى حد يستحيل معه التمييز بينهما.
منظومة عبثية
هذا التداخل الزمني وتعدد الأماكن وتباعد الربط بينها والفوضى السردية، هو ما يصنع الجو الديستوبي الطاغي الذي يخنق أبطال الرواية الذين يعتريهم إحساس بالعدمية واللاجدوى في عالم تهيمن عليه الريبة والخوف من المجهول، وللتعبير عن هذا الإحساس يستعين قطب بما تجسده مقولة رولان بارت: "الرعب الحقيقي أن تركض من دون أن تعرف إن كنت تُطارد أم تُطارد". مقولة تصلح مفتاحاً لفهم البنية الوجودية للرواية، عندما يتحول الإنسان إلى كائن فاقد للمعنى وسط منظومة عبثية من المراقبة والعقاب.
تستحضر الرواية عالم الأنظمة الشمولية التي تحكم قبضتها على الناس من وراء ستار، تحت ذريعة حماية المنظومة العليا ومنع انهيارها. أناس لا يظهرون في العلن، يديرون كل شيء من خلف الكواليس عبر أدوات السيطرة والتخويف، "عالم جديد بُني بالخوف ويُدار بالحفظ ويتكرر كالصدى" (ص 256). في سبيل ترسيخ هذا الخوف تعتمد السلطة على كائنات يطلق عليها اسم «الخارقون» يجري اصطيادهم بواسطة «الهيئة الوطنية للصيد»، وهي مؤسسة تعمل وفق منطق الطاعة المطلقة، يولد أفرادها مبرمجين على الانقياد والطاعة العمياء. لا يملكون قرارهم، إذ تسري في عروقهم عقيدة قديمة تأمرهم بأن يفكروا كما أُمِروا فقط، وبعد إلقاء القبض على الخارقين تُمارس عملية تدجين ممنهجة لتحويلهم إلى أدوات في يد «المُستعبِدين» الساعين إلى احتكار العالم. لهم قوانين صارمة، من أبرزها «ألا يُترك خارق بلا قيد»، لأن القوة إذا اتجهت نحو الحرية قد تهدم النظام، فالحرية تعد في هذا العالم جريمة، لأنها تلد التمرد.
محو الذاكرة
إضافة إلى سلاح التخويف يعمل "المستعبِدون" على محو الذاكرة لمنع التمرد، إذ يرون أن النجاة الوحيدة أو بالأحرى نجاة النظام «تكمن في الطمس، نزع المعنى من الأصل، محو الحضور من الوعي الجمعي، لا جثة، لا اسم، لا أثر، فقط انقطاع» (ص 283)، فالذاكرة هي العدو الأخطر لهم، لأنها وحدها القادرة على استعادة المعنى، وقلب أركان المعبد الذي بني على قانونين جوهريين: الاستعباد والمصادرة. استعباد البشر وسلب مواهبهم ومقدراتهم، في سبيل إدامة سلطة لا تعترف بعالم عادل أو بحرية يتساوى فيها الجميع أمام القانون.
تقدم الرواية صراعاً وجودياً بين عالم الخارِقين، وعالم الأنظمة الشمولية، صراع محسوم سلفاً، بسبب غياب وعي الخارقين بقدراتهم من جهة، والخطط المحكمة التي تضعها السلطة لاصطيادهم وإخضاعهم للنظام من جهة أخرى. وتتجلى الفوارق بين الرؤيتين في شخصية الخارِق "بيكا"، الذي يحلم بعالم بلا فقر ولا جوع، عالم لا تبكي فيه أم بسبب الحرمان، يحاول أن يحقق حلمه عبر القدرة الخارقة التي وهبت له في حكاية ذات نَفَس أسطوري يذكر بحكايات "ألف ليلة وليلة"، فبعدما أنقذ حماراً من الضرب المبرح، يكافئه الحمَّار بأن يمنحه القدرة على التغوط ذهباً!
يستخدم "بيكا" هذه النعمة في البداية لإسعاد حبيبته، ثم لتوزيع الذهب على الجميع، فقراء وأغنياء، غير أن حلمه المثالي سرعان ما يتحول إلى كابوس واقعي حين يكتشف خيانة حبيبته له مع عدوه اللدود، وتكالب أهالي القرية على الذهب وصراعات التيارات السياسية من يساريين وسلفيين وليبراليين، بين النظر إليه على أنه بطل، أو أنه متآمر. تلفت قدرات "بيكا" انتباه "الصيادين"، فيلقى القبض عليه ويخضع لتجارب قاسية تستنزف قدرته، وسط عبارات تدعي حمايته: «نحن لا نؤذيك، بل نوفر لك راحة لم تحلم بها في حياتك... نمنعك من أن تُستغل في كل عالم فاسد، فكل طاقة نقية تصبح خطراً إن لم تقع تحت السيطرة» (ص 150).
وهكذا يجد "بيكا" نفسه في النهاية تحت آلة قمعية لا ترحمه، تُعامله كمنجم يُستنزف بلا توقف، في إسقاط رمزي على واقع الأنظمة التي تنهب مقدرات الشعوب وتحتكر ثرواتها، بينما يظل الناس حتى في لحظات الثورة غارقين في الهوس بالذهب والثراء، غير معنيين بالحرية أو التغيير الحقيقي.
ترفض الرواية فكرة التضحية المفروضة من الخارج، التي يكرسها المجتمع والسلطة فضيلة إنسانية، وفي جوهرها آلية قمعية صاغها "الصيادون" و"المستعبِدون" لضمان بقائهم، فالتضحية ليست خلاصاً أو فداء نبيلاً، وإنما أداة لاستنزاف الإنسان وتحويله إلى قربان دائم للنظام، «الخارقون، هل تعرف لماذا خُلقوا؟ ليكونوا فداءً لغيرهم» (ص 184)، لتفضح بذلك الخديعة الكبرى التي تبرر اضطهاد المختلفين، وسلبهم حقهم في الحرية بحجة أنهم خُلقوا ليضحّوا من أجل الآخرين.
صورة رمزية
يطرح العمل هذا التصور عبر شخصية "بيكا"، الذي يمثل الإنسان البسيط الذي أنقذ الحمار من الضرب المبرح وضحى بنفسه، فيستنزف في خدمة مجتمع لا يدافع عن حقوقه، ويتركه يقاوم وحده آلة القمع التي تستدرجه باسم الفضيلة إلى الفداء الإجباري.
ويمثل الشاب الفقير خريج قسم الوثائق والمكتبات الذي يعمل في مكتبة لبيع الأدوات المدرسية، ويكسب قوته من كتابة الواجبات ورسم اللوحات للطلاب مقابل أجر زهيد، صورة رمزية لجيل شباب الثورة في يناير، أولئك الذين حلموا بالحرية والعدالة الاجتماعية، فهو الخارِق "صفر"، الذي يخشاه "المستعبِدون" لأنه يهدد النظام القائم، على رغم أنه لا يمتلك أي قدرة خارقة. قوته الوحيدة تكمن في وعيه وذاكرته، ولهذا يطارده النظام ويطالبه بالتضحية بدعوى الحفاظ على استقرار المنظومة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يجسد "الخارق صفر" الإنسان العادي الذي لا يملك ما يخسره، ولذلك يصبح خطراً على السلطة التي تسعى إلى اصطياده وتدجينه حتى لا يتمرد، فذاكرته قادرة على فضح المخططات وكشف الزيف المتوارث، أما «الصيادون» فهم كائنات مزدوجة الجنس، ذكر وأنثى في الوقت نفسه، في إشارة إلى تقلبهم وتبدل ولائهم مع أي نظام قائم، فهم لا ينتمون إلى مبدأ، بل إلى السلطة ذاتها، أية سلطة كانت.
المستعبد الأول
تحمل الرواية إسقاطات سياسية مهمة لعل أبرزها الإشارة غير المباشرة إلى أن «المستعبِد الأول» هو جمال عبدالناصر، من خلال وصف يحيل إليه «في المركز يجلس رجل بشموخ في صمت، طويل القامة، بشرته تميل إلى لون القمح المحروق، وعيناه واسعتان، تنوءان بحزن مقطّر وصلابة خافتة، تنظران من داخل الأسطورة، حين يتحدث يكون صوته عميقاً خشناً، إنه المستعبد الأول، آخر من بقي من زمن النبوءة» (ص 295).
هذا التوصيف يطرح قراءة لمرحلة سياسية تحولت فيها النوايا النبيلة إلى أداة قمع مؤسس. وتعزز الرواية هذه الإحالة عبر استدعاء أغاني أم كلثوم التي تغنت بحركة يوليو، «الشعب قام يسأل عن حقوقه، والثورة زي النبض في عروقه»، لتكشف المفارقة المؤلمة حين تتحول الشعارات التحررية إلى أدوات للهيمنة والسيطرة، فالمأساة التي تشير إليها الرواية تكمن في أن الثورة التي بشرت بالحرية أصبحت بذاتها معبداً يُدفن فيه الشعب: «هل تعرف ما يؤلم أكثر؟ أن تصبح النوايا النبيلة أداة قمع، أن ترى الشعب يبني المعبد ثم يُدفن فيه».
وتكشف الأحداث أن "المستعبِدين"، على جشعهم، أكثر حرصاً على بقاء النظام من الأفراد، فهم لا يتورعون عن إزاحة أي عضو من مجلسهم المكوَّن من 12 فرداً، إذا ما بدا أنه يهدد تماسك النظام أو يلقي بظلال سلبية عليه، وبذلك يضحَّى بالفرد، حتى من داخل الدائرة الحاكمة، من أجل بقاء المنظومة السلطوية ذاتها. نجحت الرواية في تمرير هذه الرموز والإسقاطات السياسية عبر غطاء فني محكم، استعان فيه الكاتب بعناصر الفانتازيا والعبث وتشظي الحكي، مستلهماً أجواء ألعاب الفيديو والحكايات الشعبية بوصفها وسائط رمزية تتيح له فضاءً سردياً حرّاً للتعبير عن أسباب فنية واجتماعية شديدة التعقيد. عناصر مزجها قطب لتعبير عن مأسوية الوضع السياسي القائم في ظل منظومات تتغذى على الخضوع وتعيد إنتاج الاستبداد في صور متعددة، موضحاً أن الواقع المعيش ذاته بات أكثر ديستوبية من أي خيال أدبي.