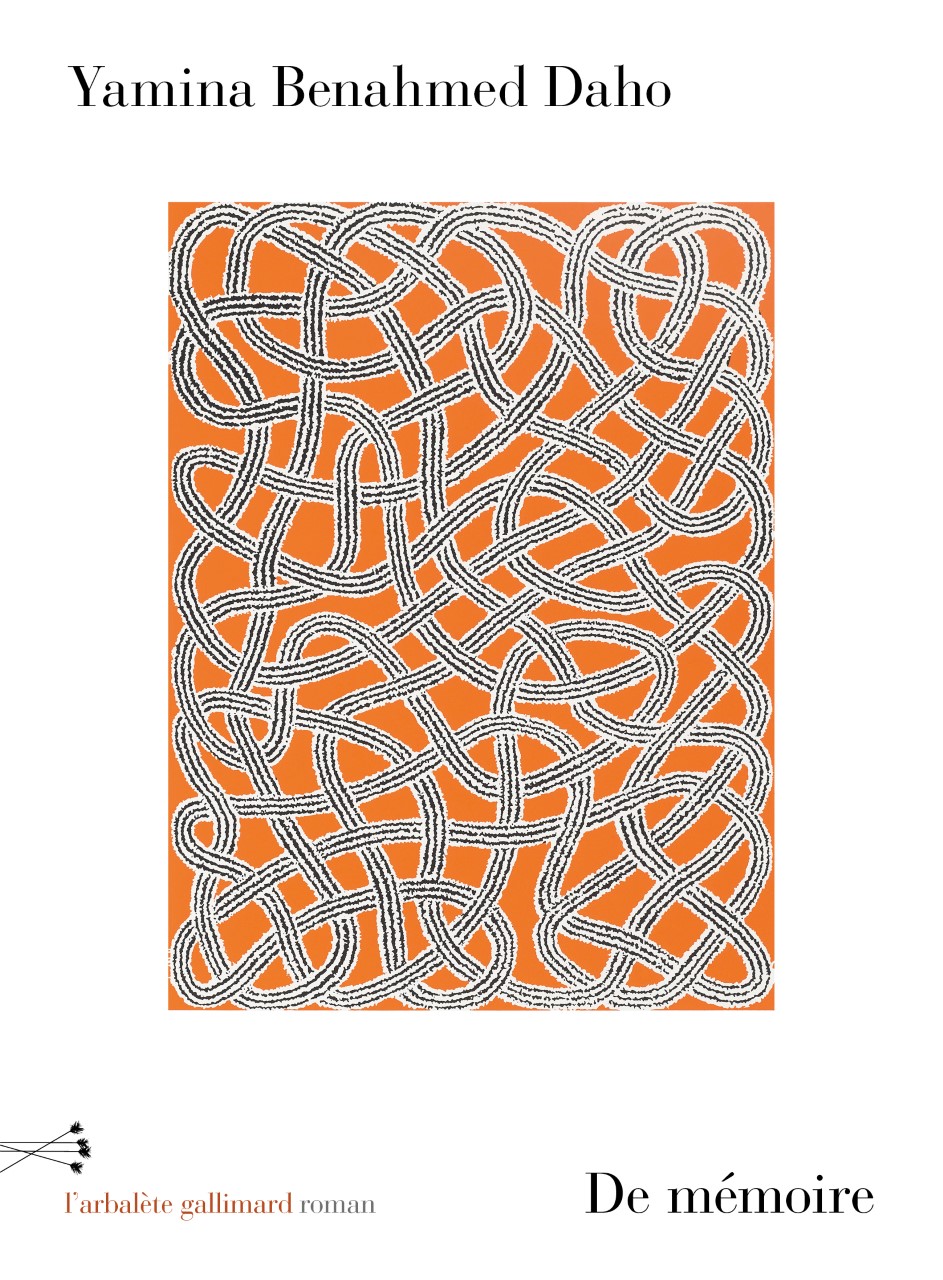"حصل ذلك أمس، بعد منتصف الليل، بينما كنتُ في طريقي مجدداً إلى دار صديقتي. حين كشفتُ لها عن الكدمات الزرقاء على فخذي، نصحتني باستشارة طبيب وعرضت عليّ مرافقتي. ترددتُ. أسكن على مسافة قصيرة من شقّتها، لكني ترددتُ طويلاً قبل أن أقصدها. أهاب الخروج من منزلي. والآن، أهاب العودة إلى إليه". هكذا تبدأ رواية الكاتبة الجزائرية الفرنكوفوينة يمينة بن أحمد داهو، "كما أتذكّر"، التي صدرت حديثاً عن دار "غاليمار"، ونصغي فيها إلى مونولوغ صاعق لشابة ــ علياء ــ تستعيد فيه تفاصيل حادثة اعتداء جنسي تعرّضت لها خلال ليلة رأس السنة، عام 2011.
صفحة بعد صفحة، علياء تروي. لعناصر الشرطة، للمحقق، للطبيب، للمحللة النفسية، للقاضي... أما ما ترويه فيتركّز على ما اختبرته خلال تلك الليلة المشؤومة ويمكن اختصاره على النحو التالي: في مدخل المبنى الذي تعيش فيه صديقتها، طرحها شخص مجهول أرضاً وحاول اغتصابها. بعد عراك طويل بينهما، تمكّنت من الإفلات منه، فغادر المكان كما لو أن شيئاً لم يكن. منذ تلك الليلة، توقفت هذه الشابة عن عيش حياتها ولم تعد تجرؤ على الخروج من شقّتها إلا للإدلاء بشهادتها لمحاوريها المذكورين أعلاه. ومن هذه الإدلاءات المتعاقبة، المتكرِّرة، تتشكّل مادّة هذا النص الحيّ والأليم الذي لا نخرج منه سالمين.
الأذى الجسدي والنفسي
وتجدر الإشارة هنا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقارب هذه الكاتبة فيها موضوع جسد المرأة في الفضاء العام. فسنة 2014، وضعت رواية أولى هي ثمرة فصل أمضته داخل فريق نسائي لكرة القدم. لكن وقع نصّها الجديد على قارئه أقوى بكثير من وقع نصّها الأول، ولا شك في أن ذلك يعود إلى أن يمينة كتبته انطلاقاً من تجربة شخصية: اعتداء جنسي أفلتت منه بأعجوبة. وبالتالي، ما ترويه فيه هو ما اختبرته أثناء تلك الحادثة، أي العنف الغاشم، ثم الشكوى وفحواها، فالمواعيد الطبية والاستدعاءات القانونية المتعددة، وصولاً إلى توقيف المتّهم وجلسات محاكمته.
على مرّ الصفحات، نعي مدى الأذى الذي سبّبه لعلياء الاعتداء الذي تعرّضت له، والذي قد يظنّ بعضنا بأن أضراره كانت محدودة لأن الاغتصاب لم يحصل. فهذه الشابة ستوقف دراستها الجامعية وتنعزل في شقّتها من دون أن تعرف الراحة أو الأمان، بل الخوف الدائم. الخوف من الاستسلام للنوم فيُفاجئها المجرم في عقر دارها لإتمام جريمته البشعة. وهذا الخوف تحديداً، بمختلف عوارضه، هو ما تسعى وتنجح يمينة في تصويره في روايتها.
في أحد الحوارات التي أجريت معها، تسرّ الكاتبة لمحاورها بأنها، منذ الاعتداء عليها، لم تعد تنظر إلى الحياة كما في السابق، حين كانت قادرة على العودة إلى دارها في ساعة متأخّرة من الليل من دون قلق أو مساءلة للذات: "أدركتُ فجأةً أنه أن نكون امرأة في الشارع خلال الليل هو مجازفة بحد ذاتها". والمثير هو أنها كانت في معرض كتابتها عن هذا الاعتداء حين ظهرت حركة "أنا أيضاً" (MeToo) في أوروبا التي شكّلت صدى جماعياً لخطابها، خصوصاً أن روايتها تتضمن كل المواضيع التي ستتم مناقشتها على مدى شهور ضمن هذه الحركة. تزامُن لم يحثّ الكاتبة إلى تغيير مشروعها أو طريقة كتابتها، بل عزّز داخلها فكرة أن ما كانت تكتبه يتجاوز وضعها الفردي لملامسة وضع نساء كثيرات. ولعل هذه الحقيقة هي التي دفعت بعض النقاد إلى وصف نصّها بـ "النسوي"، علماً أن يمينة، من دون اعتبار هذا الوصف خاطئاً، تفضّل صفة "سياسي".
مونولوغ مصدّع
مهما يكن، على الجانب السياسي أو "النسوي" لهذه الرواية أن لا يُنسينا بُعدها الجمالي. وفعلاً، تكمن أيضاً قيمة "كما أتذكّر" في بنيتها الفريدة وجملتها المحبوكة بعناية. عملٌ أدبي إذاً يتجاوز الشهادة ويقوم على خيار تشييد مونولوغ مصدَّع يتألف ممّا أسرّت به علياء لمحاوريها المختلفين. وهو ما استدعى كتابة عيادية تفلت من التفخيم الدرامي ورثاء الذات (pathos)، وتسمح بذلك الاجترار لحدثٍ واحد نتلقّى تفاصيله بشكلٍ دائري. هكذا تأخذ علياء شكلاً تحت أنظارنا، خصوصاً حين تُضاف إلى سردية الاعتداء المكرَّرة تفاصيل معبّرة حول ماضيها وعائلتها.
ولفهم مسعى يمينة الأدبي، لا بد من الإشارة إلى أنها درست الفلسفة والأدب في جامعة نانت الفرنسية، قبل أن تحصّل شهادة تعليم اللغة الفرنسية من دار المعلّمين. حياة قراءة وكتابة إذاً تفسرّ هاجس الشكل والبنية الثابت في عملها الكتابي: "حين أكتب، لا أسعى خلف سيرورة شفائية، بل خلق قيمة أدبية"، تقول الكتابة، ثم تضيف: "في روايتي الأخيرة، شعرتُ بأنني بلغتُ شكلاً أدبياً مناسباً لمقاربة الذاكرة المصدومة، موضوعي".
من هنا تلك المساءلة الثابتة، وبطريقة إكراهية، لهذه الذاكرة في الرواية. فمع أن علياء ترغب في نسيان ما اختبرته وفتح صفحة جديدة في حياتها، إلا أنها لن تتمكن من إنجاز ذلك لأنها ستُجبَر، بعد الشكوى التي قدّمتها، على الإدلاء مراراً بشهادتها، وعلى استشارة طبيب ومحللة نفسية، قبل أن تُستدعى للتعرّف إلى المتّهم ثم إلى جلسات المحاكمة. وبالتالي، تقع رهينة إجراءات قانونية وطبية تمتد داخل الرواية على مدى أربع سنوات. وحول هذه النقطة، تقول الكاتبة: "أردتُ هذا النوع من التشييد الذي تعكس السرديات المتراكبة داخله طريقة عمل الذاكرة. التشابك الزمني يهمّني لأنه يستدعي كتابة متشظّية حداثوية تناسبني".
لا بد إذاً الأخذ في الاعتبار هاجس الذاكرة المصدومة لدى الكاتبة لفهم عالمها الروائي، وأيضاً لاكتشاف تلك الرواية الأخرى داخل روايتها، التي تكمن في قصة عائلة علياء التي تبدأ هذه الشابة فجأةً في سردها للمحللة النفسية. قصة تنطلق أحداثها في الجزائر خلال حرب التحرير، مع والديها، وتنتهي في فرنسا حيث يواجهان صعوبات جمّة في التأقلم والعيش بكرامتهما. قصة ترصد يمينة لها صفحات جميلة ومؤثّرة تستحضر بكلمات قليلة لكن شديدة التعبير ألم الاقتلاع من الوطن الأم وعذابات المنفى.
وحين نقرأ هذه الصفحات، يتملّكنا الشعور بأن الكاتبة لم تقارب موضوعها الرئيس ــ حادثة الاعتداء ــ إلا لسرد تلك القصة الأخرى، تلك الصدمة الأكثر قدماً وعمقاً، صدمة حرب الحزائر ونتائجها على حياتها وحياة والديها. كما لو أن ذاكرتها الفردية المعنَّفة لا تلبث أن توقظ ذاكرة جماعية لم تلتئم جروحها بعد. ذاكرة تلقّتها على شكل نُتَف أو شذرات، ولم يكن بالتالي ممكناً مقاربتها إلا بالأسلوب والشكل اللذين اعتمدتهما في هذه الرواية.