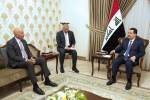حرص الرئيس الأميركي جو بايدن خلال الرحلة الأخيرة التي قادته إلى أوروبا، على التأكد من إيصال الفكرة الرئيسة لسياسته الخارجية وتوضيحها، فقد أشار إلى أن التنافس بين الولايات المتحدة والصين جزء من "صراع أوسع مع المستبدين" مداره على "ما إذا كانت الديمقراطيات قادرة على المنافسة في القرن الـ 21 سريع التغير. إن ما قام به لم يكن فورة خطابية، إذ لطالما كرر بايدن القول إن العالم قد وصل إلى "منعطف تاريخي حاسم" من شأنه أن يحدد ما إذا كان هذا القرن سيشكل عصراً آخر من الهيمنة الديمقراطية، أو عصر الصعود الاستبدادي. ورجح أن مؤرخي الغد "سينهمكون في كتابة أطروحات دكتوراه عن هوية الجهة الفائزة في هذا الصراع: الأوتوقراطية الاستبدادية أم الديمقراطية".
في الواقع إن بايدن لم ينظر دائماً إلى العالم على هذا النحو، ففي العام 2019 كان قد سخر من الإيحاء السائد بأن الصين تشكل منافساً جدياً للولايات المتحدة، ناهيك بكونها تتصدر طليعة التحدي الأيديولوجي في الحقبة المعاصرة، إلا أنه في المقابل اعتبر أن الصدام المركزي في عصرنا، المتمثل في التنافس بين أنظمة الحكم الديمقراطية وتلك التي تعتمد الأوتوقراطية السلطوية يبدو حقيقياً، وستترتب عنه تداعيات عميقة الأثر في السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للولايات المتحدة.
بالنسبة إلى إدارة بايدن، يجسد هذا المفهوم المحرك الرئيس الذي يقود علاقات الولايات المتحدة مع منافسيها الرئيسين، وجملة المسائل المهمة الأخرى التي باتت على المحك، فهو يربط بين التنافس القائم ما بين القوى العظمى ومساعي تعزيز نفوذ الديمقراطية الأميركية والجهود المستمرة لمكافحة الآفات العابرة للحدود الوطنية، كالفساد وفيروس "كوفيد-19"، ويدفع هذا المفهوم أيضاً بالولايات المتحدة إلى التركيز على اعتماد استراتيجية كبيرة لتحصين العالم الديمقراطي في وجه أخطر مجموعة من التهديدات التي يواجهها منذ أجيال.
لكن السؤال الذي يُطرح هو ما إذا كان في مستطاع الإدارة الأميركية أن تحول الآن هذه الرؤية إلى واقع. فقد حدد بايدن التحدي الاستراتيجي الحاسم الذي يقرر مصير القرن الـ 21، لكن المشكلات القائمة سواء تلك الكامنة أصلاً أو التي جلبتها الإدارة الأميركية لنفسها، خطيرة وحادة .
العالم أرض خصبة للاستبداد
قد يكون الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب هو الذي صوب البوصلة في اتجاه المنافسة مع القوى العظمى، إلا أن جو بادين أدرج هذه القضية في إطار استراتيجي أكبر، وبدا ترمب إلى حين تفشي الجائحة وكأنه ينظر في الغالب إلى التنافس بين الولايات المتحدة والصين على أنه في المقام الأول صراع قائم على شروط التبادل التجاري، لكن بايدن على نقيضه يعتبر أن المنافسة هي جزء من "حوار أساسي" بين الأطراف التي تعتبر أن "الاستبداد هو أفضل طريق للمضي قدماً"، وتلك التي تعتقد بأن "الديمقراطية هي التي ستسود وينبغي أن تسود".
ويجد مجتمع الدول الديمقراطية نفسه الآن في مواجهة مع ثلاثة تحديات مترابطة. الأول هو التهديد الذي تمثله القوى الاستبدادية مثل روسيا والصين على وجه الخصوص، فهاتان الدولتان هما في تنافس مستمر مع الولايات المتحدة على نفوذها في مختلف أنحاء العالم، وتهددان الدول الديمقراطية من أوروبا الشرقية إلى مضيق تايوان. ومع ذلك، فإن التحدي الذي يشكلانه هو أيديولوجي بمقدار ما هو جيوسياسي، ومن البديهي أن النماذج المختلفة التي تعتمدها الأنظمة في الداخل تؤدي إلى إنتاج رؤى مختلفة للأنظمة التي يتعين تبنيها في الخارج، فموسكو وبكين تريدان إضعاف النظام الدولي الراهن وتفتيته واستبداله، لأن مبادئه القائمة على الليبرالية تتعارض مع ممارساتهما الوطنية غير الليبرالية، وبالتالي فإن الخطر يكمن في اتجاه موسكو وبكين نحو إرساء عالم يشكل أرضاً خصبة لتغلغل الأوتوقراطية الاستبدادية على نحو يصبح فيه غير آمن للديمقراطية.
وفي هذا الإطار تستخدم روسيا الهجمات السيبرانية والمعلومات المضللة لزعزعة استقرار الأنظمة الديمقراطية، وتحريض مواطنيها بعضهم على البعض الآخر، في وقت بدأت فيه المجتمعات الليبرالية تتحول أكثر نحو تعميق النزعة الحزبية القبلية والاستقطاب السياسي، أما الصين فتستخدم قوتها في السوق لمعاقبة الانتقادات الموجهة إليها، أي حرية التعبير، في مختلف الأنظمة الديمقراطية المتقدمة امتداداً من أوروبا إلى أستراليا، وتقوم بتزويد الحكام المستبدين في أرجاء العالم بأدوات القمع وأساليبه، وعلاوة على ذلك تعمل أيضاً على إعادة صياغة قواعد المنظمات الدولية التي تكرس مبدأ الاستبداد، لا بل تمنحه امتيازاً أيضاً.
لكن ما هو أكثر خطورة من ذلك أن بكين تحرز تقدماً كبيراً في مجال التكنولوجيا منذ أجيال، كابتكار "الجيل الخامس" من الاتصالات 5G والذكاء الاصطناعي، بهدف نشر النفوذ الصيني الاستبدادي بما يتجاوز حدود منافسيها الديمقراطيين، والخلاصة هنا أن العالم الذي يطغى عليه نفوذ أنظمة استبدادية عدوانية، كما كان قد حذر منه الرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت، إنما يتحول إلى عالم "متداع وخطير" بالنسبة إلى الذين يقدرون قيمة الحريات.
أما التهديد الثاني الذي يواجهه مجتمع الدول الديمقراطية فيأتي من المشكلات العابرة للحدود التي تزداد خطورة نتيجة التنافس الدولي ما بين الأنظمة. إن "كوفيد-19" ليس مجرد وباء يحدث مرة كل قرن، فهو يمثل تحدياً لفكرة أن الديمقراطيات قادرة على الاستجابة بفاعلية للمخاطر الأكثر إلحاحاً التي تهدد مواطنيها. وفي المقابل، إن الفساد العابر للحدود ليس مجرد تهديد للحكم الرشيد وحسب، بل هو شر تستغله موسكو وبكين وغيرهما من العواصم المستبدة، لتوسيع نفوذها وإضعاف منافسيها، وبالتالي فإن الحد الفاصل ما بين تنافس القوى العظمى والمشكلات العابرة للحدود هو مصطنع، فالأنظمة الديمقراطية لن تفوز بالأولى ما لم تتمكن من معالجة الثانية.
ويكمن التهديد الثالث في تلاشي الديمقراطية من الداخل، ففي الأعوام الأخيرة شهدت الولايات المتحدة انتخاب رئيس غير ليبرالي بلا حياء أو خجل، وجهوداً عنيفة لقلب نتائج انتخابات ديمقراطية، وبلغت المشاعر المعادية للديمقراطية في مختلف أنحاء العالم الليبرالي، والشعور بعدم الرضا عن المؤسسات التمثيلية، مستويات لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية. هذه الاتجاهات في حد ذاتها تنذر بالخطر، كما أنها تجعل الولايات المتحدة وحلفاءها أكثر عرضة للافتراس الاستبدادي، ولا شك في أن أزمة الحكم الديمقراطي في الداخل مرتبطة بأزمة النفوذ الديمقراطي في الخارج.
عقيدة بايدن
هذا التحدي الثلاثي يتطلب استجابة ثلاثية يمكن تلمس بعض عناصرها في التحركات المبكرة التي قامت بها إدارة بايدن. وانطلاقاً من ذلك يتعين على الولايات المتحدة أولاً أن تعزز تماسك المجتمعات الديمقراطية ومرونتها، لتمكينها من الصمود في وجه منافسيها الأوتوقراطيين، وأن تسعى إلى استقطاب تضامن الديمقراطيات على المستوى العالمي، نظراً إلى أن جوانب التهديد المختلفة تتطلب استجابة عالمية. ثانياً يجب على الولايات المتحدة أن تقود الأنظمة الديمقراطية في العالم في التعامل مع المشكلات العابرة للحدود، التي لا تستطيع أي دولة حلها بمفردها. إضافة إلى ذلك عليها أن تنشىء "مركز قوة" للمنافسة العالمية، من خلال إعادة الاستثمار في قدرتها التنافسية، وإثبات أن الديمقراطيات ما زالت قادرة على تحقيق تطلعات مواطنيها.
الرئيس الأميركي جو بايدن، المرشح الديمقراطي آنذاك، يتحدث في كليفلاند، أوهايو، نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 (رويترز)
انطلاقاً من ذلك، ركزت السياسة الخارجية لبايدن على تطبيق هذا المفهوم الشامل للاستراتيجية الأميركية الذي يستند إلى حقيقة لا مفر منها مفادها أن سيادة الديمقراطية هي عرضة للخطر أكثر من أي وقت مضى على مدى أجيال. وفي الوقت الذي كان عدد من أسوأ العلاقات الدولية في عهد ترمب يطاول أقرب الحلفاء للولايات المتحدة، وضع بايدن مهمة إصلاح تلك التحالفات في صدارة أولوياته، كي تشكل دروعاً للديمقراطية العالمية. وسعى في هذا الإطار إلى تسوية الخلافات الديبلوماسية والتجارية مع أوروبا لإنشاء جبهة موحدة أقوى، تقف في وجه روسيا والصين، وعمل مع حلفاء في أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ على الإشارة إلى أن الاعتداء على تايوان قد يكلف "الحزب الشيوعي الصيني" ثمناً باهظاً. وأعطت الجهود الأميركية لعقد قمة مبكرة لـ "مجموعة الدول الصناعية السبع" G7 ثمارها، بحيث أنتجت لهجة مشتركة تكشفت في تصريحات الدول الأعضاء حيال التهديد الصيني، وفي إطلاق خطة لتعزيز البنية التحتية في الدول النامية، وبناء مشاريع عالية الجودة تتسم بالشفافية - في رد ديمقراطي على "مبادرة الحزام والطريق" Belt and Road Initiative التي أطلقتها بكين.
وفي سياق مواز، عملت الإدارة الأميركية أيضاً على تأسيس مراكز للتعاون الديمقراطي في مواجهة التحديات العالمية الرئيسة، وفي ظل قيادة بايدن أعلنت دول "الحوار الأمني الرباعي" Quadrilateral Security Dialogue (QUAD) (الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند) و"مجموعة السبع"، عن خطط لتوزيع نحو ملياري لقاح "كوفيد-19" على الدول النامية. وتحضر الإدارة حملة متعددة الأطراف لمكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة التي أحسن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدامها بمهارة كبيرة، من ضمن حكام مستبدين آخرين. وعلى الرغم من أن بايدن كان قد تحدث في وقت سابق عن عقد "قمة للديمقراطيات" العالمية من أجل التعامل مع هذه القضايا وغيرها، إلا أنه اعتمد حتى الآن على مجموعات قائمة أصغر حجماً، يمكنها تحقيق تقدم ملموس في هذه المرحلة، وربما تمهد الطريق لمساع أكبر في وقت لاحق.
بايدن حدد التحدي الأساسي للقرن، لكن القضايا الشائكة ما زالت قائمة
اعتمد بايدن التكتيك نفسه في سباق التكنولوجيا، ففي الوقت الراهن يبدو أن إدارته لا تتجه نحو دعم إنشاء تكتلات على غرار مجموعة "الديمقراطيات العشر" D-10 ("مجموعة السبع" تُضاف إليها أستراليا والهند وكوريا الجنوبية)، أو مجموعة "الديمقراطيات التكنولوجية الـ 12" T-12 (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وفنلندا والسويد والهند وإسرائيل)، أو أي تحالف ديمقراطي رسمي كبير آخر لمواجهة التأثيرات المترتبة عن الاستبداد من روسيا والصين الذي يهدد التكنولوجيا، إلا أنها بدلاً من ذلك تعمل مع دول ومجموعات مختارة مثل كوريا الجنوبية في ما يتعلق بمسألة أشباه الموصلات وتكنولوجيا "الجيل الخامس" 5G و"الجيل السادس" G6 للاتصالات، ومع الاتحاد الأوروبي بشأن مواءمة التكنولوجيا والسياسة التجارية، ومع اليابان من أجل تأمين شبكة إنترنت عالمية مفتوحة. إضافة إلى ذلك تتعاون أيضاً مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مواجهة الهجمات الإلكترونية والمعلومات المضللة، وذلك بهدف بناء تعاون ديمقراطي تصاعدي متكامل.
وفي الوقت نفسه، كانت الإدارة الأميركية تواجه في كثير من الأحيان وعلى نحو متعدد الأطراف أكثر أشكال القمع السلطوي والافتراس وحشية، وبحسب ما تواتر، فإن الرئيس بايدن هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعواقب وخيمة إذا ما استمرت الهجمات الإلكترونية الروسية ضد البنية التحتية الحيوية. وانضمت واشنطن إلى الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على بيلاروس بعدما أرغمت حكومة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو طائرة كانت تنقل منشقاً مطلوباً على الهبوط في مثال على القمع الذي تمارسه روسيا والصين وغيرهما خارج الحدود الإقليمية وغيرهما من الأنظمة المستبدة، لمطاردة منتقديها وترسيخ حكمها.
وتعاون فريق بايدن مع كندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني المتورطين في عمليات القمع المروعة في شينجيانغ، الأمر الذي أسهم في إفشال ديبلوماسية "المحارب الذئب" Wolf Warrior (أسلوب عدائي انتهجته الديبلوماسية الصينية في القرن الـ 21 تحت قيادة الزعيم الصيني شي جينبينغ، عبر شن حملات للرد على الانتقادات الموجهة إلى بكين، مما أفضى إلى نسف اتفاق استثمار كانت وقعته الصين مع بروكسل قبل أشهر فقط.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أما في الداخل، فسعى بايدن إلى الاستثمار في البحث العلمي والتطوير، وفي البنية التحتية الرقمية والمادية، وفي غيرهما من المجالات لتحسين القدرة التنافسية ورأب الصدع بين الطبقتين العاملة والمتوسطة، وأراد بايدن من خلال وعده بتبني سياسة خارجية لمصلحة الطبقة الوسطى، إظهار أن المشاركة العالمية يمكن أن تعود بالنفع على الأسر العاملة. وبحسب مسؤولي إدارته، كان يأمل من خلال مساعيه بفرض الحد الأدنى من الضرائب العالمية، أن يحمل الدول الديمقراطية على زيادة الاستثمار في مواطنيها. وتمثل هذه الإجراءات من وجهة نظر بايدن خطوات أولية نحو اعتماد نهج على شكل عمليات التجديد والإصلاح المحليين التي أسهمت سابقاً في فوز القوى الديمقراطية في منافسة أخرى ما بين الأنظمة خلال الحرب الباردة.
التحدي الصعب
على الرغم مما تقدم، وفيما أخذت الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية تتبلور وتتضح أكثر، بدأت أيضاً تتكشف جملة التحديات المرافقة لها وأوجه القصور التي تنطوي عليها، لكن اللافت أن مقاربة بايدن قد تلقى قبولاً لدى فئات معينة أكثر من أخرى، إذ تقوم هذه الاستراتيجية على فكرة أن الولايات المتحدة قادرة على أن تحتوي بشكل أفضل تنامي الأنظمة الاستبدادية من خلال توثيق التعاون مع ديمقراطيات راسخة والتضامن معها، إلا أن محاولة تطويق القوة الروسية والصينية، سواء من الناحية العسكرية أو الديبلوماسية، تتطلب أيضاً التعاون مع حكومات شبه استبدادية أو أوتوقراطية محضة، في بلدان تمتد من بولندا وتركيا وصولاً إلى فيتنام والفيليبين، ويُفترض ألا تكون هذه مسألة خطيرة، لأن واشنطن سبق أن أقامت، ضمن الاستراتيجية التي اتبعتها خلال الحرب الباردة، تحالفات مع ديمقراطيات ذات اتجاهات متشابهة، فيما عمدت في الوقت نفسه إلى بناء علاقات مثمرة في إطار تبادلات تجارية مع أنظمة شبه ديمقراطية وذات طابع استبدادي محض، لكن المؤكد هو أن ما من آلية واحدة تناسب الجميع عندما يتعلق الأمر ببناء التحالفات، وأن الاستراتيجيات المبدئية لا تزال تتطلب تقديم تنازلات براغماتية.
حتى في ظل وجود حلفاء ديمقراطيين أساسيين، قد يكون الحفاظ على الوحدة ورص الصفوف أصعب مما تتوقعه الإدارة الأميركية، فبايدن يستطيع أن يجني بسرعة مكاسب من إنهاء الحروب التجارية بين الأشقاء، أو وقف كيل المديح لديكتاتور روسي والثناء على مواقفه. فمع أوروبا هناك مجال واضح للتعاون في بعض المسائل مثل تقويم الاستثمارات investment screening (إجراء يشمل التدقيق فيها ووضع شروط لها ومن ثم الترخيص لها وفق معايير الأمن والنظام العام). وعلى الرغم من كل ذلك يبقى التوصل إلى حشد تحدياً قائما حتى بالنسبة للحلفاء الديمقراطيين المقربين من الولايات المتحدة، فالمصدرون الأوروبيون يراهنون في فترة التعافي من الوباء على الدعم الذي توفره مشتريات الصين من سلعهم، وفي المقابل ما زالت الانقسامات مستمرة عبر الأطلسي على مسائل تتعلق بالخصوصية وحماية البيانات وما إلى هنالك من قضايا تكنولوجية أخرى.
وقد يكون من السهل نسبياً إصدار تصريحات متناسقة واتخاذ مواقف مشتركة تعبر عن القلق من عدوان صيني محتمل على تايوان، أو من تهديد اقتصادي لأستراليا، لكن بلورة استجابات ملموسة إزاء سياسات بكين متعددة الأطراف ستكون مسألة أكثر صعوبة. وفي الواقع فإن التحركات الرامية إلى مساندة العالم الحر للوقوف في وجه تهديد واحد قد تفضي إلى إضعافه في مقابل تهديد آخر، فقد تخلت إدارة بايدن عن معارضتها لمد خط أنابيب "نورد ستريم 2" Nord Stream 2 (خط أنابيب مزدوج بطول 1230 كيلومتراً سيضاعف قدرة روسيا على ضخ الغاز من حقولها إلى أوروبا تحت البحار) على أمل ضم برلين إلى جبهة المواجهة ضد بكين، لكن من خلال قيامها بذلك سمحت لموسكو بأن تضاعف النفوذ الذي تمارسه على الديمقراطيات الضعيفة في منطقة أوروبا الشرقية.
في المقابل، يمكن أن يؤدي التركيز على الصراع الأيديولوجي والتكنولوجي بدوره إلى صرف انتباه الإدارة الأميركية عن المخاطر العسكرية الداهمة، وفي نهاية المطاف هنالك احتمال بأن تخسر الولايات المتحدة المنافسة نتيجة فشلها في احتواء المعتدين الاستبداديين، وفي الدفاع عن البؤر الديمقراطية في أوروبا الشرقية وفي منطقة غرب المحيط الهادئ.
وفي العام 2018 حذرت لجنة مختصة في استراتيجية الدفاع الأميركية تضم ممثلين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، من أن الولايات المتحدة لا تملك القوة العسكرية اللازمة للوفاء بالتزاماتها ضمن النطاق المحيط بمنطقة أوراسيا (تضم دول قارتي أوروبا وآسيا، وتُعد أكبر نطاق جغرافي في العالم). إضافة إلى ذلك، تعاني وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) من بعض مواطن الضعف في سياستها المتعلقة بمضيق تايوان، ومع ذلك لم تتخذ الإدارة الأميركية مواقف ذات طابع ملح من الناحية العسكرية، بحيث جاء الطلب الأول لموازنة البنتاغون محدوداً، مما أضعف من احتمال اتخاذ أي إجراءات على المدى القريب من شأنها أن تسهم في تعزيز موقف الولايات المتحدة في المحيط الهادئ. إن التنافس الحقيقي اليوم يتخطى حدود منطق القوة العسكرية، لكن القيم الديمقراطية لن تنقذ العالم الحر بمجرد خوض مبارزة بالأسلحة النارية.
أخيراً لا بد من الإشارة إلى أن العلاقة بين المكونات الخارجية والمحلية لهذه الاستراتيجية ليست بالسلاسة التي تدعيها الإدارة الأميركية، فمن وجهة نظر بايدن أن تحسين الثروات الاقتصادية للطبقة الوسطى في الولايات المتحدة يبقى بمثابة ضمانة تحول من دون انبعاث "الترمبية" من جديد، ووسيلة لتمتين الأسس الداخلية للديبلوماسية الأميركية.
لكن من النتائج العملية، كان الأمر التنفيذي الرئاسي الذي صدر تحت شعار "اشتر منتجات أميركية" Buy American (وقعه بايدن ويفرض على جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية أن تشتري منتجات مصنعة محلياً) والذي يشبه شعار "أميركا أولاً" America first (عنوان أطلقه دونالد ترمب على سياسته الخارجية خلال حملته الانتخابية في العام 2016). وقد جاء بخصائص ديمقراطية تنطوي على سياسة تجارية مخيبة، مما دفع بعدد من الدول ولا سيما في آسيا إلى التساؤل عما إذا كانت الولايات المتحدة قد عادت حقا إلى ما كانت عليه في السابق، وإذا كانت استراتيجية بايدن لا تشتمل على آفاق واسعة ومفاهيم طموحة لتحقيق الازدهار، فإنها لن تستطيع أن تحقق النتائج المرجوة لجهة الحفاظ على قوة العالم الحر وتماسكه.
خلاصة الأمر، لا يمكن إنكار ما توصل إليه بايدن حتى الآن، فقد حدد على نحو صحيح التحدي الحقيقي الرئيس للعصر، لكن الرهان الصعب أن يتمكن من صياغة استراتيجية حقيقية، وأن يترجمها على أرض الواقع.
* هال براندز: أستاذ كرسي في القضايا العالمية بمركز هنري كيسينجر في جامعة "جونز هوبكينز للدراسات الدولية المتقدمة"، ومن كبار الباحثين في معهد أميركان إنتربرايز، وكاتب رأي في بلومبيرغ
مترجم من فورين أفيرز، يونيو (حزيران) 2021