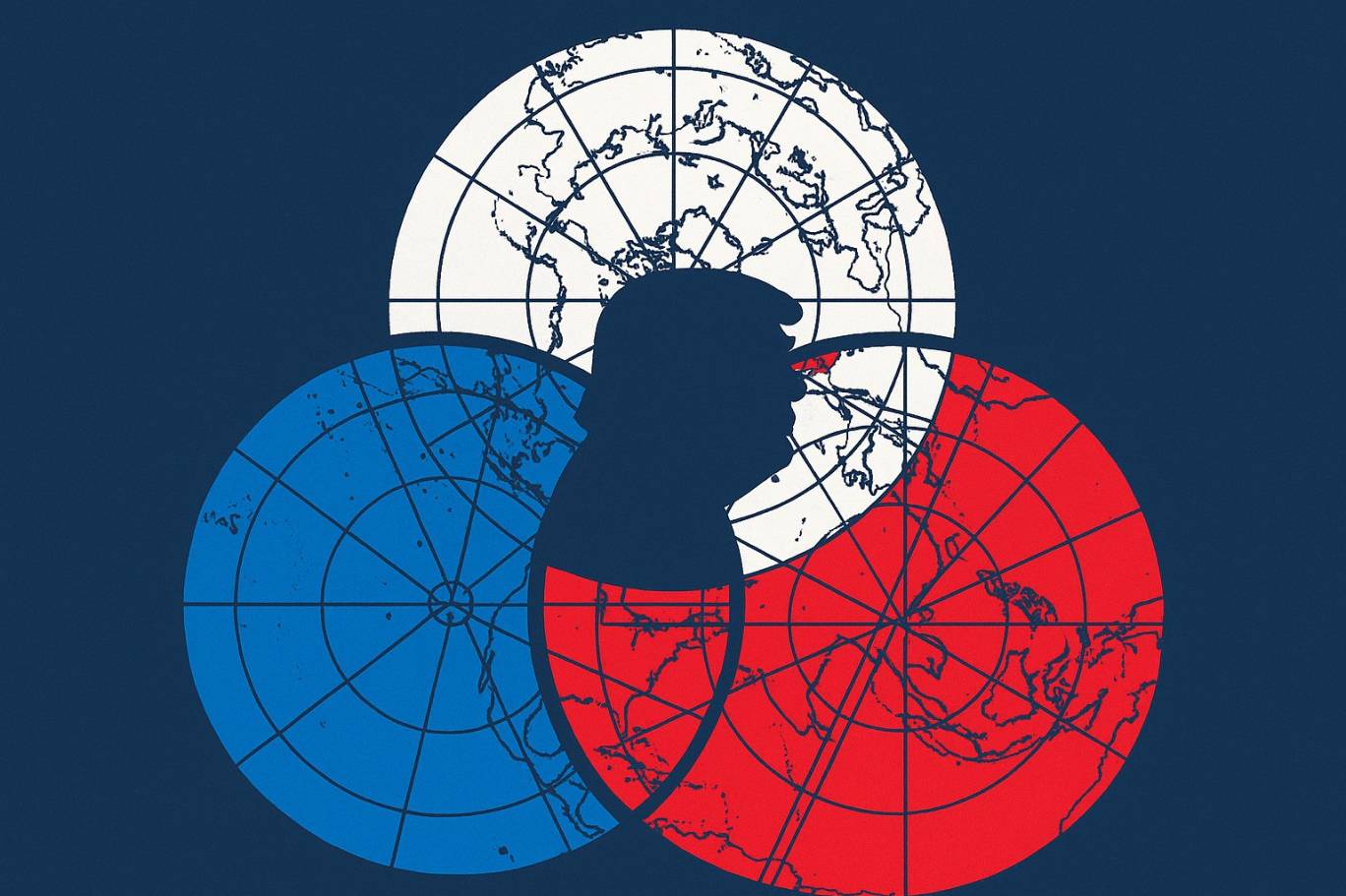ملخص
بدءاً من غزو العراق في عام 2003 كأحد تبعات هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، وما حمله حينها التحالف الدولي بقيادة واشنطن من "ذرائع للتدخل"، رُسخ اصطلاحاً في الأدبيات السياسية بـ"أزمة النموذج الغربي" تأخذ أبعاداً أكثر عمقاً وانكشافاً لاحقاً فيما عرف في منطقة الشرق الأوسط بـ"الربيع العربي" مع اكتمال العقد الأول من الألفية الجديدة، لا سيما مع الأحداث الدامية التي شهدتها بلدان مثل سوريا وليبيا، إلى أن وصلنا إلى خمس سنوات كانت أشد "تأزماً" بالنسبة إلى القيم والمفاهيم الغربية، بدأت بأزمة وباء كورونا، ومن بعدها اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022 التي لا تزال متواصلة، وأخيراً الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة التي استمرت عامين (2023 - 2025)، وذلك في وقت بدت فيه قوى من خارج المنظومة الغربية ترسخ وجودها وحضورها على الساحة الدولية كما الحال بالنسبة إلى الصين. فهل أصبح أفول النموذج الغربي حتمياً؟
لم يكن يدرك المنظّر والفيلسوف الأميركي الشهير فرانسيس فوكاياما، حين طرح نظريته حول "نهاية التاريخ" في عام 1992 بأن "الديمقراطية الليبرالية وقيمها عن الحرية والفردية والمساواة والعولمة والليبرالية الاقتصادية تشكّل ذروة التطور الأيديولوجي للإنسان بعد إجماع معظم الناس على صلاحيتها وعدم وجود بديل أفضل" مبشّراً في أطروحته بـ"هيمنة وانتصار النموذج الغربي"، بعد سقوط جدار برلين و"إمبراطورية الشر" (الاتحاد السوفياتي السابق) على حد وصفه، أن مفاعيل الأحداث وطبيعة وشكل التعاطي الغربي معها على مدار العقدين ونيف الأولى في الألفية الجديدة، قد تدفع كثيرين من أقرانه إلى إعادة النظر في "الهيمنة الغربية برمتها" وأفكارها.
من يتتبع المحطات الكبرى على مدار الربع قرن الأخير، التي تداخل فيها الغرب أو كان أحد أطرافها الرئيسة، يجد أنها أحدثت بديناميكيتها هزات كبرى لقيمه ومفاهيمه بوصفه حامياً لمفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك بعدما تجلّى ما عـُرف اصطلاحاً بـ"أزمة ازدواجية التطبيق وانتقائها"، ما زاد من حدة السجالات بشكل تصاعدي حول قدرة وبقاء "هيمنة النموذج الغربي" ما بعد انتهاء الحرب الباردة، على العلاقات الدولية وتفاعلاتها البينية على مستوياتها الإقليمية.
وفق ما رصده كثير من المفكرين والباحثين فإن "النموذج الغربي" واجه اختبارات كبرى خلال العقدين ونيف الأخيرين، بدأت من تبرير غزو العراق بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001 تحت ذريعة "أسلحة الدمار الشامل"، التي ثبت عدم صحتها لاحقاً، فضلاً عن "التخاذل الكبير" أمام الأحداث الدامية التي شهدتها سوريا على مدار أكثر من عقد من الزمان، مروراً بمحطة "وباء كورونا" الذي ضرب العالم، وخلّف ملايين القتلى في عام 2020، كاشفاً عن وجه غربي آخر، إضافة إلى المحطتين الأبرز أولاهما الحرب الروسية - الأوكرانية التي اقتربت من إتمام عامها الرابع، وثانيتهما الإسرائيلية المستعرة على قطاع غزة، على مدار عامين بما حملته من انتهاك وتجاوز لكل الأعراف والقيم والقوانين الدولية والإنسانية التي صاغها الغرب بنفسه على مدار عقود بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.
المحطات السالفة الذكر وما تخللها من أحداث فواصل جعلت الساسة وصنّاع القرار حول العالم وكذلك المفكرون والمنظرون يضعون علامة استفهام كبيرة تسأل عما إذا كان النموذج الغربي "بقيمه وأطروحاته" لا يزال قادراً على تصحيح ذاته رغم الأزمات المتتالية التي وقع فيها، أم أن العالم بات على وشك تحولات تاريخية عميقة تعيد صياغة المعادلات والنظام الدولي برمته، لا سيما أمام صعود شرقي بقيادة الصين وروسيا منح العالم مزيداً من الخيارات؟
اختبارات وأزمات تعمّق "الجرح الغربي"
مرة أخرى، وعلى رغم نبوءة كثير من المنظرين والفلاسفة الغربيين طوال تسعينيات القرن الماضي ما بعد انتهاء الحرب الباردة، بـ "هيمنة وانتصار" النموذج الغربي بسردياته وأفكاره، بدت الأحداث الكبرى التي شهدها العالم طوال الربع قرن الماضي، تشي بأن "صراعات العالم ما بعد سقوط الاتحاد السوفياتي" لم "تكن مواجهات حضارية لأسباب دينية وثقافية" وفق ما بنى صاموئيل هنتنغتون سرديته الشهيرة بكتابه "صدام الحضارات: إعادة تشكيل النظام العالمي الجديد"، إذ عكست سياقات وظروف الصراعات التي اندلعت خلال العقدين ونيف الأخيرين مزيجاً من تداخل العوامل السياسية والاقتصادية والأيديولوجية، كانت مضامينها اختبارات صعبة ودقيقة لـ"النموذج الغربي" بقيمه وأطروحاته.
وبدءاً من غزو العراق في عام 2003 كأحد تبعات هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، وما حمله حينها التحالف الدولي بقيادة واشنطن من "ذرائع للتدخل"، بدايات تأزم القيم والمفاهيم الغربية، المرتكزة على العدالة والمساواة وحقوق الإنسان وغيرها، ثم بدأ ما رسخ اصطلاحاً في الأدبيات السياسية بـ"أزمة النموذج الغربي" تأخذ أبعاداً أكثر عمقاً وانكشافاً لاحقاً فيما عرف في منطقة الشرق الأوسط بـ"الربيع العربي" مع اكتمال العقد الأول من الألفية الجديدة، لا سيما مع الأحداث الدامية التي شهدتها بلدان مثل سوريا وليبيا، إلى أن وصلنا إلى خمس سنوات كانت أشد "تأزماً" بالنسبة إلى القيم والمفاهيم الغربية، بدأت بأزمة وباء كورونا، ومن بعدها اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022 التي لا تزال متواصلة، وأخيراً الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة التي استمرت عامين (2023 - 2025)، وذلك في وقت بدت فيه قوى من خارج المنظومة الغربية ترسخ وجودها وحضورها على الساحة الدولية كما الحال بالنسبة إلى الصين.
في حالة اجتياح وباء كورونا في العام 2020، كشف أزمة الفيروس الذي عمّ أرجاء العالم وخلّف ملايين الضحايا، هشاشة النظام "النيوليبرالي" وقطاعه الصحي والعولمة المتوحشة، بعد أن طال المرض الجميع، وبدت معه الدول الغربية في كثير من محطاته "منغلقة على ذاتها" محاولة لملمة "منظوماتها الصحية" لمواجهة ذلك العدو الشرس.
وعودة إلى الحرب فإنه ليس من مبالغة القول إنه أمام اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، بدأت تحدث كثير من التغيرات البنيوية في النظام العالمي، لا سيما بعد أن مثلت تلك الحرب اختباراً حاسماً لذلك النظام الذي ولد على أنقاض الاتحاد السوفياتي (المنهار في تسعينيات القرن الماضي). فمن جانب روسيا لم تكن الحرب إلا محاولة لتصحيح ما تعتبره "انكساراً جيوسياسياَ" أصابها منذ نهاية الحرب الباردة، بعد فقدان مجالها الحيوي في شرق أوروبا، فضلاً عن تحركها إلى "كسر الأحادية العالمية والهيمنة الغربية"، أمّا أوكرانيا فتسعى للانفكاك النهائي من جاذبية المدار الروسي، وتحقيق حلم الانتماء الكامل إلى الغرب. وفي المنتصف، تقف الولايات المتحدة وأوروبا أمام انقسام تاريخي حول تحديد الأولويات وتعريف الضرورات الأمنية لكل منهما.
ومنذ بداية الحرب أيضاً، راهن عديد من العواصم الغربية على أن مزيجاً من العقوبات الاقتصادية الصارمة، والدعم العسكري السخيّ لأوكرانيا، إلى جانب وحدة الموقف في حلف الناتو، ستكون كفيلة بردع موسكو ودفعها إلى التراجع، أو على الأقل استنزاف قدراتها الاستراتيجية. غير أن مجريات الحرب، وما تبعها من تحولات ميدانية وسياسية، كشفت عن محدودية هذا الرهان، وأظهرت قصور الغرب عن تحقيق انتصار حاسم.
وبعد أكثر من ثلاثة أعوام، ومع ما أظهرته موسكو من قدرة ملحوظة على الصمود والمرونة في التكيف مع حرب طويلة الأمد، في مقابل انقسام وفشل العالم الغربي في الموازنة بين إمكاناته الهائلة وقدرته على تحويلها إلى نتائج ملموسة على الأرض، أصبح واضحاً أن أسباب هذا الإخفاق لا تقتصر على العوامل العسكرية أو الميدانية، بل تعود إلى منظومة أعمق وأكثر تعقيداً، تشمل الأبعاد الجيوسياسية والديموغرافية والاستراتيجية داخل المنظومة الغربية ذاتها.
تلك الحرب، ووفق توصيف لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، مثلت محاولة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لممارسة "نوع من صراع الحضارات مع أوكرانيا"، بهدف تشكيل عالم روسي مواز، خارج الهيمنة الغربية. موضحة أن بوتين بنى افتراضه على أن "الغرب فاسد للغاية، وأن من السهل شراءه، للحد الذي ستمر معه نوبات الغضب ويستأنف علاقته المعتادة معه من دون أي عواقب طويلة المدى"، فضلاً عن إدراكه بأن "عصر قيادة أميركا للعالم في نهايته لا محالة، وأن بعض الجدران التي فرضها وباء كورونا ستبقى في كل مكان، وأن الهدف خلال الـ 50 عاماً المقبلة هو تعزيز ما يمكن تعزيزه من الموارد والمواهب والشعوب والأراضي داخل أسوار حضارتك القديمة"، على حد وصفها.
جدلية العلاقة بين الشرق والغرب تلك التي فضتها الحرب الروسية - الأوكرانية بمضامينها وتفاعلاتها، كتب عنها الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد بجامعة "أي بي سي" البرازيلية، جورجيو رومانو شيوته، قائلاً "كشفت (الحرب) عن عدد من الحقائق المُرّة، فقد أثبتت أن قادة أوروبا وقادة الرأي فيها ليس لديهم مطلقاً أي فكرة عن وجهات نظر العالم غير الغربي المعروف الآن باسم الجنوب العالمي". معتبراً في تحليل له حمل عنوان "الغرب لا يفهم الجنوب"، نشر في أبريل (نيسان) 2023، أن عدم اتباع دول كبرى في الجنوب العالمي مثل الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا وغيرها "بشكل أعمى لروايات وسياسات دول الناتو وحلفائها لا ينبغي أن يفاجئ أحداً".
وبحسب شيوته، ففي الوقت الذي يصف فيه الدول الغربية ومراكز صناعة القرار فيها بعض دول الجنوب بانتهاج "سياسة غير أخلاقية"، إذ على سبيل المثال اتهام الهند باستغلال أوضاع حرب أوكرانيا وزيادة وارداتها النفطية من روسيا بأسعار رخيصة، تجني في المقابل شركات النفط الغربية أرباحاً قياسية. مشيراً إلى اتهام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، شركات غربية كبيرة بتحقيق "أرباح غير أخلاقية على ظهور أفقر الفقراء". ناهيك بالمكاسب التي يجنيها الاقتصاد الأميركي من فائض أرباح المجمع الصناعي العسكري في الولايات المتحدة، على حد وصفه، ما يضع النموذج الغربي "في أزمة المصداقية".
ويضيف رومانو شيوته، "إذا كانت الحرب في أوكرانيا تمثل بالنسبة إلى دول غربية نقطة تحول"، فهي ليست كذلك بالنسبة إلى جنوب الكرة الأرضية. معتبراً أن "الغرب لا يمكن أن يقدم نفسه كقدوة أخلاقية للعالم، بينما هو مسؤول تاريخياً عن حروب استعمارية وعن غزو بلدان في العالم الإسلامي". مشيراً إلى أن الفجوة بين نظرتي الغرب ودول الجنوب تمنح السياسة الخارجية الروسية إيجاد مسوغات لتمرير خطابها لدى دول الجنوب المتذمرة من السياسات الغربية وازدواجية معاييرها.
يقول الباحثان الجنرال الأميركي المتقاعد جون آر. آلين ومايكل ميكلاوسيك، وهما زميلان في جامعة الدفاع الوطني الأميركية في تقرير نشرته مجلة "ناشونال إنتريست" الأميركية، "لا يبدو أن أعداء الولايات المتحدة، وأساساً روسيا والصين، يخافون من خطر الفشل في تحقيق أهدافهم أو الخوف من التعرض للانتقام". معتقدين أن الردع يتطلب مصداقية، وهذا ما يفتقده الغرب بوجه عام والولايات المتحدة بوجه خاص، بسبب النهج الاستراتيجي الغامض والمتردد، في حرب أوكرانيا وفي مواجهة المبادرات الصينية في مضيق تايوان.
ومن الحرب الروسية الأوكرانية إلى الإسرائيلية في قطاع غزة، التي عُـدت وفق كثر "اختباراً حقيقياً لمواقف عدد من الدول في الانتصار للقيم الإنسانية الكبرى في الحرية والعدالة والمساواة"، مما غذَّى المنظور السائد بالانتقائية في التضامن والتعاطف، وازدواجية المعايير في الحكم والموقف من الأحداث التي تجري في الشرق والغرب (الحالة الأوكرانية نموذجاً)، إذ يكون الحافز فيها، عادة، خاضعاً للمصالح على حساب المبادئ، تلك المبادئ والقيم التي تعتبر دستور العصر في تقرير المصير وحقوق الإنسان.
وعلى مدار أشهر وأسابيع الحرب، انكشف حجم التناقض في المنظومة القيمية الغربية، وبدت الدول الغربية برمتها أمام سؤال "ازدواجية المعايير" في التغاضي عن الوحشية الإسرائيلية المفرطة وغير المسبوقة في العصر الحديث تجاه "الإنسان الفلسطيني" في قطاع غزة، فضلاً عن انحيازهم المطلق لإسرائيل دون أي اعتبارات أخلاقية وقيمية أقرها الفكر والمواثيق الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وصل حد استخدام حق النقض الفيتو في أكثر من مناسبة لعدم وقف الحرب أو حتى الوصول إلى هدنة إنسانية في غزة، الأمر الذي عمّق "الأزمة التي بات يعانيها النموذج الغربي"، لا سيما بعد أن قارنه كثر بالحالة الأوكرانية، التي تجسّدت في بداياتها "تكتلاً غربياً" صلباً لرفض استهداف المدنيين من قبل روسيا، وإمداد كييف بأقوى الترسانات العسكرية وحشد الدعم الدولي ضد روسيا ورئيسها بوتين الذي جرت ملاحقته في المحاكم الدولية، ما رسّخ لدى الجميع كيل الغرب بمكيالين، وازدواجية.
تلك "الازدواجية" وأزمة الحضارة الغربية من منظور الحرب في غزة، ناقشها المفكر والكاتب الهندي الشهير بانكاج ميشرا في كتابه: "العالم ما بعد غزة: تاريخ مختصر"، متعاطياً مع أكثر الأسئلة الشائكة التي طرحتها الحرب الإسرائيلية المستعرة على المستوى العالمي، حول ما إذا كانت "بعض الأرواح أهم من غيرها حول العالم"، وانقسام الاستجابة الغربية والعالمية حول تلك الحرب وتداعيات ذلك الأخلاقية والجيوسياسية.
وفي رأي ميشرا، فإن "النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، في نواح كثيرة منه، قد تشكّل استجابة للمحرقة النازية (الهولوكوست) وفظائع الحروب الأهلية النهائية التي أصبحت في الوجدان السياسي والأخلاقي الغربي، معياراً للفظائع والإبادة الجماعية النموذجية، وتسيطر ذكراها على كثير من تفكير الغرب، لكن الأهم أنها شكّلت مبرراً أساسياً لحق إسرائيل في الوجود والدفاع عن نفسها، وهو ما ارتكبته بشكل أكثر فظاعة في حق الفلسطينيين".
ويركز الكاتب الهندي على ما سمّاه "حرب الإبادة في غزة والاستقطاب في ردود الفعل تجاهها"، كنقطة انطلاق لإعادة تقييم واسعة لسرديتين متنافستين. معتبراً أنه "في حين يتحوّل توازن القوى في العالم، ولم يعد الشمال العالمي يتمتع بمصداقية أو سيطرة مطلقة، من الأهمية فهم كيف ولماذا فشل شمال العالم وجنوبه في التحدث مع بعضهما، إضافة إلى أنه مع انهيار الأساسات والمعالم القديمة، لا يمكن إلا لتاريخ جديد بتوكيدات حادة الاختلاف أن يعيد توجيه العالم، وتظهر الآن وجهات نظر عالمية إلى النور".
وفي أطروحة موجزة ومحددة، يتعامل ميشرا مع الأسئلة الأساسية التي تطرحها أزمة الحرب في غزة التي أبرزها: "هل بعض الأرواح أهم من غيرها؟ ولماذا يجري تبني سياسات هوية مبنية حول ذكريات المعاناة واسعة النطاق؟ ولماذا تتكثف العداوات العنصرية عشية اندلاع موجة اليمين المتطرف بالغرب، مما يهدد باندلاع حريق عالمي؟". مستنداً إلى ما يعتبره "شرور الاستعمار الغربي التي تشكل أساس هذا التحليل"، قائلاً "جميع القوى الغربية عملت معاً لإقامة ودعم نظام عنصري عالمي، حيث كان من الطبيعي تماماً أن يُباد الآسيويون والأفارقة، ويُرهّبون، ويُسجنون، ويُنبذون"، كما كانت النازية، من هذا المنظور، مجرد امتداد للاستعمار، استقدمه هتلر من ممارسات الاستعمار الأوروبي إلى أوروبا القارية، وتدفقت المحرقة بشكل طبيعي من الإبادات الجماعية الأخرى التي ارتكبها البيض بأنحاء العالم.
يقول ميشرا إن الذاكرة الجماعية للهولوكوست التي ارتكبها النظام النازي "لم تنبع عضوياً مما حدث بين عامي 1939 و1945 فحسب، بل بُنيت متأخرة، وبشكل متعمد للغاية غالباً، ولأغراض سياسية محددة". والآن، يرى كثيرون أن ذكراها "حرِفت لتمكين القتل الجماعي" الإسرائيلي ومنح إسرائيل الحصانة. مشيراً إلى أن "دائرة متزايدة الاتساع" من الناس بأنحاء العالم "باتت ترى إسرائيل استعماراً استيطانياً قاسياً ونظاماً عنصرياً يهودياً يدعمه سياسيون غربيون من اليمين المتطرف ورفاقهم من الليبراليين".
وفي ختام كتابه، أشاد ميشرا "بطلاب الجامعات الغربية والشباب" المشاركين في الاحتجاجات المناهضة حرب الإبادة في غزة، الذين مثلوا صحوة عالمية كبرى شملت العالم الثالث والجنوب العالمي، بخاصة عواصم وحواضر أوروبا وأميركا الشمالية. معتبراً أن "غزة دفعت كثيراً من الناس إلى الاعتراف بحقيقة المشاكل المتجذّرة في مجتمعاتهم (الغربية)"، وأظهرت مواقف هؤلاء الطلاب ونشاطاتهم أنهم ربما أفضل من فهم ما وصفه ميشرا أنه "قطيعة نهائية مع التاريخ الأخلاقي للعالم منذ ساعة الصفر في العام 1945". كما أشار في الوقت ذاته إلى أن العالم بعد غزة هو "عالم مفلس ومنهك"، وسياسات إسرائيل هي نذيره، وطرد الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية لا يمكن وقفه. ومع ذلك، فإن التضامن العالمي خفف من "الوحدة الكبيرة التي يعيشها الفلسطينيون"، وهو ما يبعث الأمل على الأقل، على حد وصفه.
تلك الأطروحة ذاتها، ركـّز عليها عالم الأنثروبولوجيا الفرنسي الشهير ديدييه فاسان، في كتابه "التنصل الأخلاقي: كيف فشل العالم في تدمير غزة"، حين قال إن "التسامح في تدمير غزة أو دعم تدميرها سيترك أثراً لن يُمحى في ضمير المجتمعات المعنية، باعتباره تنصلاً وفشلاً أخلاقياً". مضيفاً أن "ما سيبقى بلا شك في الذاكرة لأطول وقت، وربما حتى في إسرائيل أيضاً، هو عدم المساواة في الحياة التي جرى عرضها على مسرح غزة". مؤكداً أن "الدول الغربية التي أسهمت في تدمير غزة فقدت أي مصداقية للحديث عن حقوق الإنسان".
معضلة "الشقاق" بين واشنطن وأوروبا
جانب آخر من أزمة النموذج الغربي بأفكاره وأطروحاته تجلى وفق كثير من المفكرين والباحثين، في ما بدا من "اتساع الهوة واختلاف السياسات والأولويات" داخل الكتلة الغربية ذاتها، لا سيما بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية الرئيسة، وذلك بعد أن شكّلت لسنوات طويلة مرتكزاً رسّخه الطرفان على "القيم والمصالح المشتركة" منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وحتى على صعيد الدور الذي أدته واشنطن في إعادة بناء تلك الدول التي دمّرتها الحرب، وجهودها لتعزيز التعاون الاقتصادي سبيلاً لوضع حد للصراعات القومية في القارة العجوز خلال تلك الفترة.
المتتبّع تاريخ التحالف الغربي بين واشنطن والدول الأوروبية، يجد أن خصوصيتها مثلت إحدى الركائز الأساسية التي أسهمت في تشكيل النظام العالمي إبان مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك ما أثبتته من فاعلية خلال الحرب الباردة بين القوتين الكبريين في ذلك الوقت (المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة والشرقي بقيادة الاتحاد السوفياتي)، إذ مثل التكامل والتشارك القيمي بين واشنطن وأوروبا حائط الصد حينها في مواجهة ما اعتبروه "تهديدات أمنية واستراتيجية يفرضها الخصم السوفياتي وأتباعه إزاء الكتلة الغربية".
ومع سقوط الاتحاد السوفياتي في بداية تسعينيات القرن الـ20، وما تبعه من انهيار للأنظمة الموالية له في أوروبا الشرقية، والإيذان بانتهاء حقبة الحرب الباردة، بدا أن النموذج الغربي في طريقه للهيمنة العالمية، بصورتها السياسية على صعيد نظام الحكم ونشر ثقافة الديمقراطية، والاقتصادية في شكل الرأسمالية الليبرالية كأفضل ما أنتجه الفكر الاقتصادي العالمي.
بتعبير فرانسيس فوكاياما، صاحب الكتاب الشهير "نهاية التاريخ والإنسان الأخير" الصادر عام 1992، فبسقوط الاتحاد السوفياتي انتهى عصر الأيديولوجيات، وأن "مرحلة جديدة من شكل نظم الحكم يجب أن تسود"، مرتكزاً في فرضيته الأساسية على "الديمقراطية الليبرالية" كأعلى نموذج ينتجه الفكر السياسي، و"الرأسمالية" كأعلى نموذج ينتجه الفكر الاقتصادي، مشيراً إلى أن نموذج الليبرالية الرأسمالية المرتكزة على الفهم الأميركي والغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان هو الذي سيكون له الغلبة، فهو ينظر إلى الديمقراطية الليبرالية بوصفها نقطة نهاية التطور الأيديولوجي الذي يجب أن تنتهي إليه الإنسانية، فهي الصورة المثالية لنظم الحكم. معتبراً أن دورة التاريخ ستكون اكتملت ووصلت إلى نهايتها بـ"سقوط الديكتاتورية والاستبداد وانتصار الديمقراطية الليبرالية، وتغلب الرأسمالية على الاشتراكية"، ومتى توافقنا على ذلك، فقد وصلنا إلى نهاية التاريخ، على حد وصفه. كما وصف الولايات المتحدة بأنها دولة "ما بعد تاريخية"، مُفترِضاً أنها أنهت منذ تطورها السياسي زمناً بعيداً، وأنها الآن تنتظر الصين ودولاً أخرى كي تتراجع عن الطريق التاريخي المسدود للسلطوية المتبعة بها.
لكن، خلال السنوات الأخيرة، بات العالم أمام سجال أميركي - أوروبي، تجاوز حدود الأولويات السياسية والاقتصادية وطال حد مفاهيم الديمقراطية، فضلاً عن استهداف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب العائد للبيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025، لحلفاء بلاده التقليديين، التي انعكست في لهجته الحادة تجاه أوكرانيا، وتزايد الخلافات مع معظم الدول الأوروبية في شأن تسوية الحرب الأوكرانية، وإبقاء الأوروبيين على مسافة من المفاوضات بين موسكو وواشنطن، وتفكيكه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو أس إيد) مما سيسمح بإفساح المجال للصين للتدخل، فضلاً عن تهديده بـ"رفع الحماية الأمنية والعسكرية عن القارة العجوز"، والتلويح بالخروج من حلف شمال الأطلسي، وحرب تجارية مع أوروبا، تنذر جميعها وفق كثر بأن تغيراً في شكل النظام القائم منذ الحرب العالمية الثانية قد أخذ في الظهور.
في قراءتها لذلك السجال، تقول صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، تحت عنوان "واشنطن تقسّم أوروبا بعدما كانت موحدة لها لعقود"، إن تصريحات الإدارة الأميركية وتوجهاتها تحت رئاسة دونالد ترمب أضحت مثيرة للانقسام في القارة الأوروبية، إذ يقول أنصار شراكة واشنطن التي استمرت أجيالاً مع الديمقراطيات الأوروبية إن فريق ترمب سرعان ما أصبح قوة تعمل من أجل نشر الفوضى، كما يقول المنتقدون إن الرئيس الأميركي يحاول تمزيق أوروبا، وتشجيع الكرملين وزيادة خطر إعادة رسم الحدود بالقوة مرة أخرى، وذلك على عكس ما جرى قبل أكثر من ثلاثة أعوام "حين غزت روسيا أوكرانيا، إذ ساعدت الولايات المتحدة في دفع أوروبا إلى رد موحد قوي ضد الغزو". ونقلت عن وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز، قوله "نحن في حاجة إلى العمل معاً ضد الديكتاتوريين لا القتال فيما بيننا في شأن الديمقراطية، ويجب أن نظهر الوحدة والقوة".
كذلك نقلت "واشنطن بوست"، عن السيناتور آندي كيم (ديمقراطي من نيوجيرسي)، الذي عمل في وزارة الخارجية قبل أن يتجه إلى السياسة قوله "لقد كان هناك قرن من الزعامة الأميركية حيث تمكنا من تحقيق نظرة أوروبية إلينا باعتبارنا قوة تدعم الاستقرار، وهذا لا يتلاشى وحسب، بل إنه يتحرك في الاتجاه المعاكس". مضيفاً "لقد أصبحنا مصدراً لعدم الاستقرار ومصدراً للقلق، حتى بين حلفائنا. الآن لا يعتقد الناس أنهم يستطيعون الاعتماد على واشنطن، حتى لو حصلوا على اتفاق".
من جانبه، كتب ألكسندر وورد، في صحيفة "وول ستريت جورنال" يقول إن الرئيس الأميركي يشكّل نظاماً عالمياً جديداً "يخيف الحلفاء". موضحاً أن الانتقادات التي وجهها الرئيس ترمب لنظرائه الغربيين هي "بمثابة إعلان عن تشكل نظام عالمي جديد يقلب النظام الذي ولد بعد الحرب العالمية الثانية رأساً على عقب"، معتبراً أن أحداً لم يكن يتوقع أن يقوم ترمب بهذه التغييرات الشاملة في السياسة الخارجية الأميركية بهذه السرعة بعيداً من المسار الذي رأى النور بعد عام 1945.
ونقل وورد عن نائبة رئيس الأمن القومي والسياسة الخارجية في المؤسسة البحثية المحافظة هيريتيج، فيكتوريا كوتس، قولها "الأمر ليس أن ترمب تخلى عن نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية، بل الحقيقة أننا لم نعد نعيش في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وعلينا أن نقبل أن المشهد الجيوسياسي تغير"، مشيراً إلى تصريح الرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية والمسؤول البارز في الإدارات الجمهورية السابقة، ريتشارد هاس بأن ما يجري جعل سمعة الولايات المتحدة تتعرض لهزة كبرى في عيون الحلفاء، كما نقل عن السيناتور الجمهوري السابق الذي خدم في منصب وزير دفاع في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، تشاك هيغل، قوله إن ما يجري "هو تحد خطر لأساس النظام العالمي الذي تشكّل بعد الحرب العالمية الثانية"، مضيفاً "لم أشعر قط بمثل هذا القدر من القلق في شأن مستقبل هذا البلد والعالم كما أشعر بذلك الآن".
على وقع القلق الأوروبي المتصاعد إزاء تحولات السياسة الأميركية تحت رئاسة ترمب، واعتبار كثير من قادة القارة العجوز أن فترة حكمه الحالية "تبدو مختلفة" عن أعوام ولايته الأولى (2017 - 2021)، يتجاذب تياران رئيسان قراءة التحولات الدراماتيكية التي قد تسفر عنها سياسات الإدارة الأميركية الجديدة بالنسبة إلى التحالف التقليدي مع أوروبا، بين من يرون أن الحديث الصارم والصريح بين الأصدقاء هو أفضل طريقة لإثارة الإنفاق الدفاعي الأوروبي وإعادة بناء الشراكة، وآخرون يرون في سياساته "المفككة" للجهود الرامية إلى التعاون وحتى المحاولات الصادقة لبناء علاقات مع إدارته التي قوضتها "قراراته المتغيرة"، لكن وأمام تلك الأطروحتين، تكمن المخاوف الأكبر في شأن التحالف "القيمي والأخلاقي والتاريخ المشترك" بين الطرفين، وما إذا كان سيشهد تغيراً كبيراً في الأعوام المقبلة.
ووفق ما كتبه الرئيس التنفيذي لمجلس شيكاغو للشؤون العالمية وسفير الولايات المتحدة السابق لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) إيفو دالدر، والزميل الأقدم والمميز في مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن، في مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، جيمس ليندسي فإن النظام الدولي القائم على القواعد قد "مات" مع بدء ولاية ترمب الثانية. معتبرين أنه لطالما أكد الرئيس الأميركي أن لهذا النظام مساوئ أضرت بالولايات المتحدة من خلال تحميلها عبء مراقبة العالم وتمكين حلفائها من التلاعب بها واستغلال سذاجتها، وتأكيداً لهذا الاستنتاج قالا إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو صرّح سابقاً بأن "النظام العالمي لما بعد الحرب العالمية الثانية لم يعد مجرد نظام عفا عليه الزمن، بل أصبح الآن سلاحاً يستخدم ضدنا".
وبحسب دالدر وليندسي، فإن ترمب لا يرى أن للولايات المتحدة مصالح مهمة كثيرة خارج نصف الكرة الغربي، ويعتبر التحالفات استنزافاً للخزانة الأميركية، ويعتقد أن على واشنطن الهيمنة على دول الجوار. مشيرين إلى أن هذه نظرة للعالم تستند إلى قول مؤرخ الحرب البيلوبونيسية الإغريقي ثوكوديدس إن "الأقوياء يفعلون ما يشاءون، والضعفاء يقاسون بقدر ما يفرض عليهم من معاناة".
ومن بين مظاهر الشقاق التي تجلّت بين واشنطن وحلفائها الغربيين في الشهور الأخيرة، كانت تصريحات نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، خلال حضوره مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير (شباط) الماضي، عندما انتقد ما سمّاه "تراجع الديمقراطية وحرية الرأي في الدول الأوروبية"، الأمر الذي قرأته عديد من التحليلات والكتابات بأنه أحدث هزة في العلاقات عبر الأطلسي، وأظهر أن "الانقسام بين أوروبا وواشنطن عميق، وأن القطيعة قد تكون تاريخية"، مشددة على أنه يتعين على الأوروبيين الآن أن يعترفوا بأن أمن قارتهم لم يعد يعتمد إلا عليهم.
وفي ضوء احتمالات حدوث تحولات في التحالف الأميركي - الأوروبي "التقليدي" على وقع السياسات "غير المتوقعة" من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تجادل كثير من القراءات والتحليلات في شأن السيناريوهات التي قد تكون مترتبة على مثل هكذا تحول.
من جانبه كتب ديفيد فرينش، في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، قبل الذكرى الثالثة من الحرب الروسية - الأوكرانية، إن سياسات الرئيس ترمب تجاه كييف "قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار العالمي وإضعاف مكانة أميركا العالمية وتقوية خصومها، ما قد يدفع حلفاءها إلى الالتفات للسلاح النووي بديلاً من الضمانات الأمنية الأميركية". موضحاً أن تعامل ترمب مع أوكرانيا وروسيا "أكبر دليل على نهج إدارته السياسي المتناقض، الذي يتسم بالجلافة والحزم تجاه حلفاء الولايات المتحدة، والضعف والإذعان تجاه خصوم الغرب المسلحين نووياً، وعلى رأسها روسيا".
وتابع فرينش أن تصرفات الرئيس الأميركي تجاه أوروبا وأوكرانيا تبعث برسالة واضحة مفادها أن "ترمب غير مستعد للوقوف في وجه العدوان الروسي"، وقد يظهر ذلك للعالم انهيار النظام الدولي القائم على التحالفات منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، ويدفع بدول لطالما قاومت التسلح النووي لإعادة النظر في موقفها. لافتاً إلى أن جميع بلدان العالم تترقب نتيجة الحرب الأوكرانية - الروسية للإجابة عن هذا السؤال، وإذا ما فشلت أوكرانيا في ردع عدوان روسيا النووية بسبب ضعف دعم الولايات المتحدة، فقد تسعى مزيد من الدول إلى استخدام الأسلحة النووية لضمان أمنها.
هل اقتربت نهاية "النموذج الغربي"؟
منذ سقوط الاتحاد السوفياتي، يهيمن الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأميركية على المشهد العالمي بفلسفته النيوليبرالية، وأصبحت شرطي العالم كله، فلم تعد هناك أي أيديولوجيا في نظر الغرب قادرة على أن تواجهها، لكن النكسات بدأت في الظهور بعدما توالت واحدة تلوى الأخرى ومن خلال التمرد والعصيان الدوليين على الشرطي الأميركي، وعلى مدار السنوات الماضية شهد العالم وأروقة البحث والفكر حتى في الداخل الغربي جدلاً واسعاً حول ما بات يعرف اصطلاحاً "نهاية النفوذ الغربي"، وذلك على وقع تطورات حرب أوكرانيا والأزمة مع الصين، ولاحقاً الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
بعد سردية صاموئيل هنتنجتون عالم السياسة والاجتماع الأميركي الشهير في أوائل تسعينيات القرن الماضي، بشأن "أيديولوجية العالم الحديث" حينها، بدا أن الولايات المتحدة والنظام الغربي في مركزية العالم وذلك بعد السقوط المدوي للاتحاد السوفياتي، إذ ركّـز حينها في كتابه "صراع الحضارات وإعادة تشكيل النظام العالمي"، على أن الصراعات بعد الحرب الباردة لن تكون بين الدول القومية واختلافاتها السياسية والاقتصادية، بل ستكون النزعات الثقافية هي المحرك الرئيس للخلافات والسبب في اشتعال المعارك بين الخير والشر. مشدداً على أن "الصدوع الثقافية لا الأيديولوجية أو القومية يجب أن تقبل نظرياً باعتبارها بؤرة الحروب المقبلة"، وقد جادل طويلاً بالقول إن الاختلافات أو الخصائص الثقافية لا يمكن تغييرها كالانتماءات الأيديولوجية، ذلك أن بإمكان المرء أن يغيـّر انتماءه من شيوعي إلى ليبرالي، لكن لا يمكن للروسي مثلاً أن يصبح فارسياً.
لكن، سريعاً وعلى وقع التطورات والأحداث التي شهدها العالم خلال الربع قرن الأخير، بدت النقاشات والجدالات أكثر عمقاً بشأن "مدى بقاء مركزية الغرب وهيمنته على النظام العالمي"، إذ تعددت الكتابات والتحليلات حول كيف أثر تعاطي الغرب مع الأحداث الكبرى التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة في إمكانية بقائه ومصداقية نموذجه لقيادة العالم.
في رؤيته حول "مأساة السياسة بين القوى العظمى" يقدم عالم السياسة الأميركي الشهير جون ميرشايمر، سرديته حول شكل النظام الدولي المستقبلي انطلاقاً من التطورات والتفاعلات التي شهدها في السنوات الأخيرة، قائلاً "تطور الصين دليل على أن سُنن النظام العالمي التي ما انفكت تتكرر منذ مئات السنين تعاود عملها المأسوي المعتاد". موضحاً "الصين بوصفها قوة صاعدة ستخلق لا محالة حقبة جديدة من التاريخ تشوبها الحروب والمواجهات الدامية، فنادراً ما تكون تحولات الهيمنة سلمية على حد قوله، أي إنه عندما تبدأ قوة صاعدة في مقارعة القوة المهيمنة، فإن الحرب هي نقطة التحول الحتمية لإعادة تعريف موازين القوى.
وفقا لميرشايمر في الوقت نفسه، فإن "الأنظمة الدولية المتعددة الأقطاب يمكن أن تكون أكثر استقراراً من نظام أحادي القطب إذا أُدير تنافر المصالح بين أقطابها بما يحفظ مصالحها، لا سيما إذا جسّدت احتمالية الحرب خطراً قد ينسف هذه المصالح. فقد كانت الحرب الباردة بمنزلة سلام ممتد، وإن جادل بعض المفكرين من العالم الثالث بأنها لم تكن سلاماً إلا في الكتلتين الغربية والشرقية لا في دول جنوب العالم. معتبراً أن التنازل عن الهيمنة الأميركية في آسيا قد يكون أهون من حرب عالمية ثالثة، من منظور واقعي.
ونظر ميرشايمر، إلى "ما وراء الليبرالية والعولمة وأدرك أن الدوافع غير الاقتصادية ستظل قوية، وأن السياسة لا يُمكن اختزالها في التفاعلات الاقتصادية، وهو ما تُثبته أزمة العلاقات الأميركية - الصينية الآن رغم تشابك اقتصاد البلدين كما لم يشتبك اقتصادان عالميان من قبل"، مشيراً إلى أهمية ما يصفه بـ"الكرامة الأخلاقية والهوية"، إذ لا تضمن التجارة والقانون فقط السلام العالمي.
من جانيه وفي تحليل مشترك، كتبه عالم السياسة الأميركي الشهير جوزيف ناي، وروبرت كيوهان، أستاذ فخري للشؤون الدولية في "جامعة برينستون" تحت عنوان "نهاية القرن الأميركي الطويل"، في مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، يونيو (حزيران) الماضي، تجادل الكاتبان بشأن السياسات الأميركية التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترمب ومراهنتها على القوة الصلبة والابتزاز التجاري لتكريس هيمنة أميركا. معتبرين أن واشنطن تتجاهل "أن قوتها الحقيقية تكمن في شبكة الاعتماد المتبادل التي بنتها منذ الحرب العالمية الثانية. وأن هذا النهج يقوّض القوة الناعمة والنظام الدولي الذي خدم الولايات المتحدة طويلاً، ويهدد بانحدار تاريخي في مكانتها العالمية".
بحسب تعبير ناي وكيوهان، فإن "سعى الرئيس دونالد ترمب في آنٍ إلى فرض حضور الولايات المتحدة على العالم وإلى النأي بها عنه، بعد أن استهل ولايته الثانية بالتلويح بالقوة الصارمة الأميركية، مهدداً الدنمارك في شأن السيطرة على غرينلاند، ومشيراً إلى نيته استعادة قناة بنما، واستخدام التهديد بفرض رسوم جمركية عقابية لابتزاز كندا وكولومبيا والمكسيك في ملفات الهجرة، كما انسحب من "اتفاق باريس" للمناخ و"منظمة الصحة العالمية".
وفي أبريل (نيسان) الماضي أربك ترمب الأسواق العالمية بإعلانه فرض رسوم جمركية شاملة على دول عدة، قبل أن يتراجع جزئياً عن تلك الخطوة مع الإبقاء على التصعيد التجاري مع الصين، الخصم الرئيس لواشنطن والجبهة المركزية في حملته الحالية، يستند في كل هذه التحركات إلى موقع قوة، فمحاولاته لاستخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط على شركاء الولايات المتحدة التجاريين تعكس قناعته بأن أنماط الاعتماد المتبادل في عالم اليوم تعزز قوة بلاده، فالدول الأخرى تعتمد على القوة الشرائية الهائلة للسوق الأميركية وعلى ثبات القدرات العسكرية الأميركية، وهذه المزايا تمنح واشنطن هامشاً واسعاً لفرض إرادتها، وتنسجم مواقف ترمب مع ما كنا قد طرحناه قبل نحو 50 عاماً، وهو أن الاعتماد المتبادل غير المتكافئ يمنح الأفضلية للطرف الأقل اعتماداً".
ويتابع الباحثان، رغم تنديده المستمر بالعجز التجاري الأميركي أمام الصين فإنه يدرك في الوقت ذاته أن هذا الخلل يمنح واشنطن نفوذاً هائلاً على بكين، ورغم أن ترمب يدرك مكامن قوة الولايات المتحدة لكنه يوظفها بطرق تضر بها في نهاية المطاف، فبمهاجمته مبدأ الاعتماد المتبادل يهدم الأساس الذي ترتكز عليه القوة الأميركية، فالقوة الناشئة عن التجارة هي شكل من أشكال "القوة الصلبة" ترتكز على القدرات المادية، غير أن الولايات المتحدة راكمت على مدى الـ 80 عاماً الماضية قدراً كبيراً من "القوة الناعمة" المبنية على الجاذبية والإقناع لا على الإكراه أو فرض الأعباء، ومن الحكمة أن تواصل السياسات الأميركية تعزيز أنماط الاعتماد المتبادل لا تقويضها، لما لها من دور في ترسيخ القوة الأميركية، سواء الصلبة منها المتأتية من العلاقات الاقتصادية، أو الناعمة المبنية على الجاذبية، أما استمرار نهج ترمب الحالي في السياسة الخارجية فسيؤدي إلى إضعاف الولايات المتحدة وتسريع تآكل النظام الدولي الذي خدم كثيراً من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
ويقول الكاتبان، "يقوم النظام الدولي على ثلاث ركائز: توازن مستقر في توزيع القوة بين الدول، ومعايير تضبط سلوك الدول والجهات الفاعلة وتضفي عليه الشرعية، ومؤسسات تكرس هذا الإطار، وقد هزت إدارة ترمب هذه الركائز جميعاً وربما يكون العالم بصدد الدخول في مرحلة من الفوضى لن تنحسر إلا بتغيير البيت الأبيض نهجه، أو ترسيخ منظومة جديدة في واشنطن". معتبرين أن "التراجع الراهن قد لا يكون مجرد انتكاسة عابرة بل انحدار حاد نحو مستقبل غامض، وفي محاولته المتخبطة والمضللة لتعظيم نفوذ الولايات المتحدة فقد يكون ترمب بصدد إنهاء مرحلة الهيمنة الأميركية"، أو ما سماه الناشر الأميركي هنري لوس ذات يوم بـ "القرن الأميركي"، من دون أي مظاهر تليق بنهايتها.
أطروحة "انهيار النظام الدولي" القائم من نهاية الحرب العالمية الثانية، كتب عنها تشو شوتشون، الباحث الأول في معهد مراقبة الصين، في أبريل (نيسان) الماضي، تحت عنوان "أفول المركزية الغربية.. نهاية حتمية أم بداية عالم متعدد الأقطاب؟"، في صحيفة "ديلي تشاينيا" الصينية، يقول إن "فكرة الغرب لفظت أنفاسها الأخيرة بالفعل، كما توحي الخطابات الدولية المتداولة هذه الأيام؟ وربما تحتاج الإجابة إلى مزيد من المراقبة والتأمل، لكن المؤكد أن التطورات العالمية الأخيرة وضعت فكرة المركزية الغربية، وهي فكرة لطالما أثارت الجدل، تحت اختبار صارم، ولعل في ذلك ما يبشّر بعالم أكثر توازناً وشمولاً"، على حد وصفه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكر شوتشون، أن مؤتمر ميونخ في وقت سابق من العام الحالي، شكّل "لحظة فارقة" إذ حفزت موجة من الأسى الأوروبي وصفتها وسائل الإعلام بأنها "جنازة الغرب"، وذهبت بعض العناوين الصحافية إلى اعتبار خطاب الزعيم الأميركي (جي دي فانس) هناك بمنزلة "علامة على انهيار التحالف عبر الأطلسي"، معتبراً أن "الشقاق التاريخي الآخذ في الاتساع بات واضحاً للعيان، سواء على صعيد المصالح العملية أو القيم. وأن الفجوة بين أوروبا والولايات المتحدة أصبحت جلية، ولا يُتوقع رأبها بسهولة. والانفصال، بشكل من الأشكال، يبدو أمراً حتمياً. أوروبا الطرف الأقل استقلالاً في التحالف الغربي، توصف اليوم بأنها أولى ضحايا أفول الغرب، بما يعني نهاية حقبة دامت ثمانين عاماً، هيمنت فيها الولايات المتحدة بوصفها قائداً بلا منازع للمنظومة الغربية"، على حد وصفه.
ووفق شوتشون، فإنه "من منظور شرقي، لا مبرر للتشفي في تفتت الغرب، لكن أفول المركزية الغربية يُعد تطوراً إيجابياً في سياق بناء نظام عالمي أكثر عدالة. وقد تكون التحولات في العلاقات عبر الأطلسي معقدة التأثيرات عالمياً، لكنها في نهاية المطاف تضعف مركزية الغرب، وهو أمر يحمل دلالات تاريخية تقدمية. فإذا كانت المنظومة الغربية التقليدية في طريقها إلى الزوال، فإن المركزية الغربية تسير، لا محالة، نحو المصير ذاته، وربما يكون ذلك إحدى النتائج غير المقصودة لسياسات إعادة أميركا عظيمة مجدداً".
والمركزية الغربية، بوصفها تياراً فكرياً حديثاً، لم تُصَغ كمصطلح إلا في القرن الماضي، لكنها تستند إلى حقيقة تاريخية، مفادها أن أوروبا وأميركا الشمالية كانتا أول من أنجز الثورة الصناعية، وتلا ذلك التوسع الرأسمالي العالمي. وعلى مدى قرون، بدأ ما يُعرف بالغرب الجغرافي في احتلال مركز النظام الاقتصادي العالمي، وأدى دوراً محورياً في نقل البشرية نحو الحضارة الصناعية والحداثة، وإن كان ذلك قد جرى تحت ظلال استعمارية دامية ومظلمة، على حد وصف شوتشون.