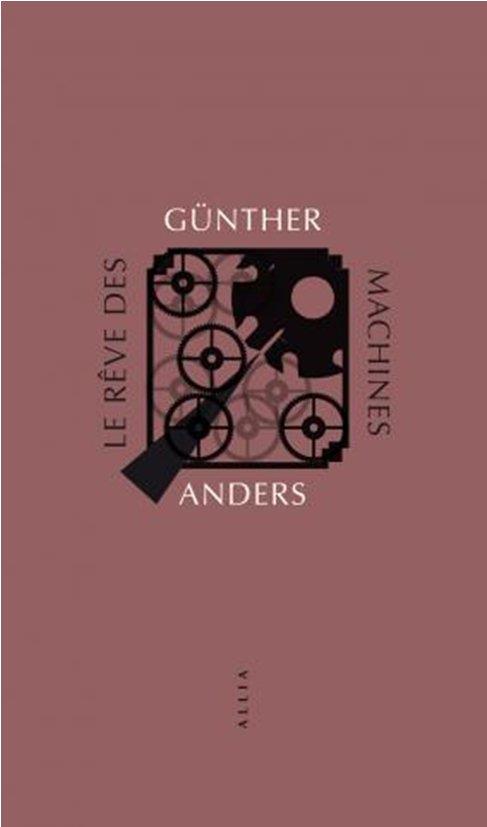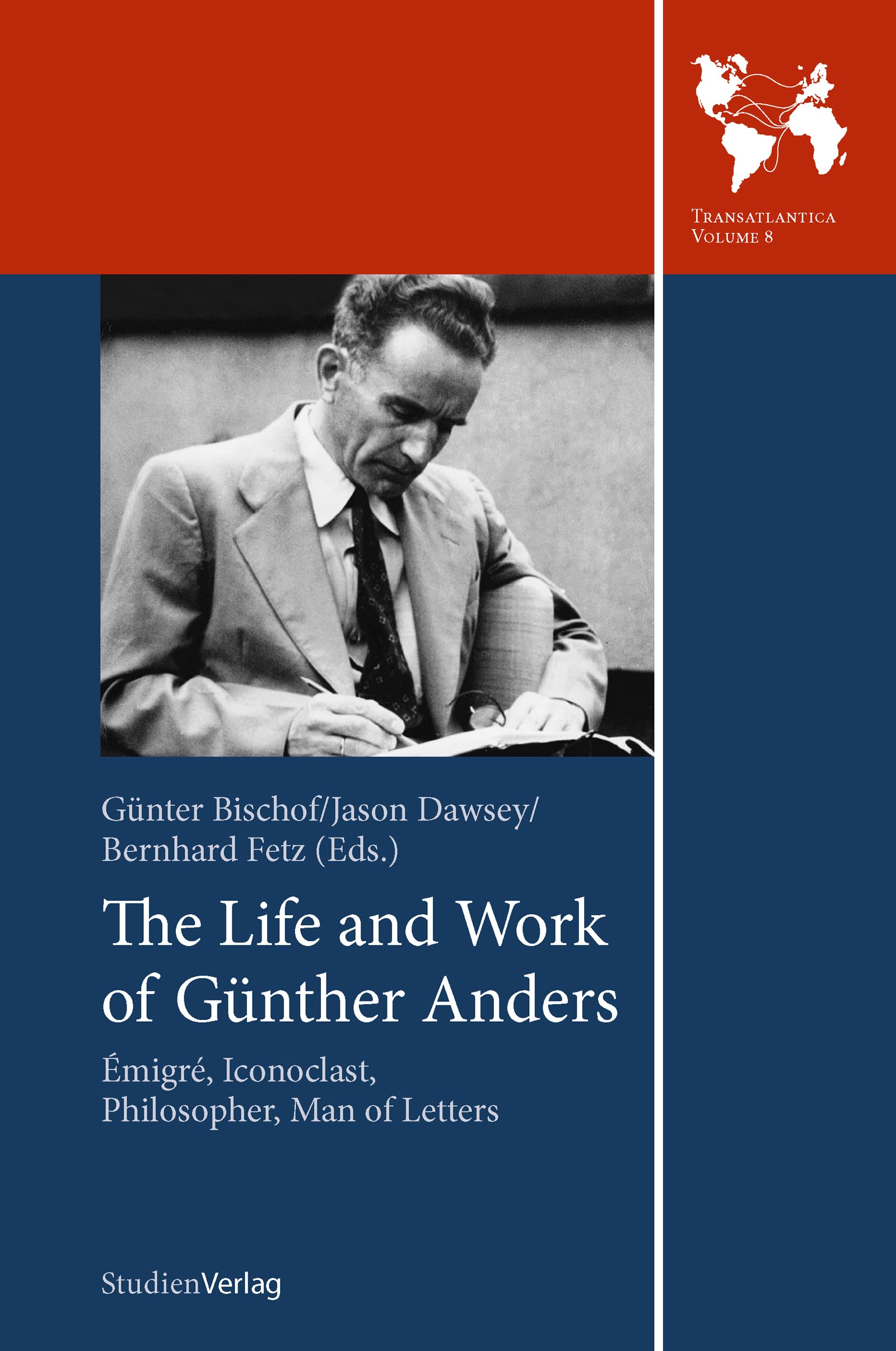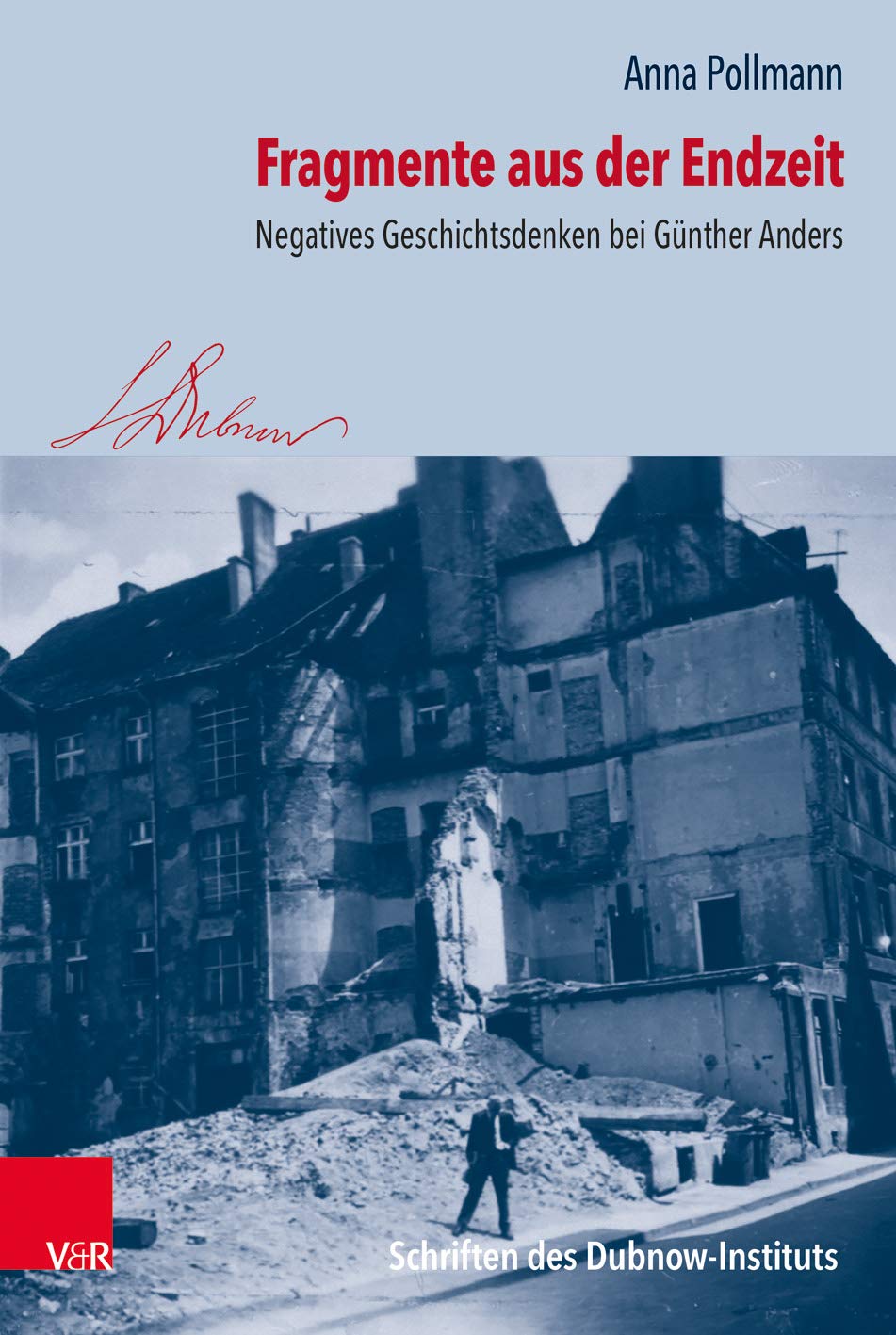نشأ الفيلسوف الكاتب الصحافي الأديب الألماني - النمساوي غنتر زيغمونت شترن المعروف باسم غنتر أندرس (1902-1992) على حب الفكر النقدي الذي أتقن آلياته وعملياته في مدرسة فرانكفورت النقدية. درس الفلسفة على هوسرل (1859-1938) وهايدغر (1889-1976)، وتزوج هانا أرندت (1905-1975)، غير أن زواجهما لم يصمد إلا بضع سنوات (1929-1937)، فافترقا بسلام. أكسبته اختباراته الوجودية حساً نقدياً رهيفاً، فطفق يناصر دعاة السلام، ويؤازر الفيلسوف البريطاني برتراند راسل (1872-1970) في سعيه إلى محاكمة جرائم الحرب ومجرميها. أما أبرز موضوعاته الفلسفية، فالتفكر الاستباقي في تهافت الإنسانية وتدمرها الذاتي. ومن ثم، كان غالباً يصرح بأن "المهمة الأخلاقية الأخطر اليوم تقضي أن نجعل الناس يدركون أنه يجب أن يقلقوا، وأن يفصحوا علناً عن خوفهم المشروع هذا".
الفلسفة في صميم الصحافة
من بعد أن أبدى الفيلسوف الألماني أدورنو (1903-1969)، عضو لجنة التحكيم الدكتورالية، استياءه من الخلاصات التي أفصى إليها غنتر أندرس في الأطروحة الثانية التأهيلية التي كان يمكن أن تفتح له أبواب التدريس الجامعي، عثر له الكاتب المسرحي الشاعر برتولت برشت (1898-1956) على وظيفة صحافية في مجلة نمساوية في فيينا. فطفق يحرر المقالات الفلسفية اليومية في شؤون حياتية شتى، يضيف إليها بين الحين والآخر قصائد مستوحاةً من معاناة زمنه العصيب. غير أن إدارة المجلة طلبت منه أن يغير اسمه شترن (Stern) الواسع الانتشار في الأوساط الألمانية - النمساوية يستخدمه كثير من كتاب المجلة، واقترحت عليه صفة أندرس (Anders) التي تدل على الاختلاف. فأخذ منذ ذلك الحين يعتمد هذه الكنية في توقيع كتاباته ونصوصه.
في إثر اعتقال صديقه برشت، هرب إلى باريس خوفاً من الإذلال النازي. فالتقى هناك ابن عمه الفيلسوف الألماني فالتر بنيامين (1892-1940)، وتعرف إلى الكاتب المسرحي الروائي شتفان تسفايغ (1881-1942). ومن ثم، يمم شطر الولايات المتحدة الأميركية، ونزل ضيفاً على هربرت ماركوزه (1898-1979) بمدينة سان دييغو (كاليفورنيا)، ذلك بأنه كان منتسباً إلى مدرسة فرانكفورت النقدية يطور على طريقته منهجيات التحليل المتواطئة على تغيير وقائع العالم، ما إن عاد إلى أوروبا عام 1950 حتى دُعي إلى التدريس في جامعة هاله (ألمانيا الشرقية آنذاك)، بيد أنه رفض العرض، وآثر أن يقيم في النمسا بالقرب من مدينة سالتسبورغ.
التفكر الاستشرافي في الكارثة
كان غنتر أندرس شغوفاً بمسألة تغيير حياة الإنسان وتطوير طاقاته تطويراً يجعله يحيا في وئام إبداعي مع الطبيعة ومع الآخرين، لذلك كان يجتهد في تصويب مسار الفلسفة حتى تكف عن الاعتناء النرجسي بذاتها وتنفتح على العالم وهمومه ومشكلاته. لا يليق بالفلسفة أن تنطوي على ذاتيتها وتعالج مشكلاتها المعرفية الداخلية، بل يجدر بها أن تعاين مآسي الوجود الإنساني، لا سيما الكوارث والحروب والإبادات على أنواعها، وفي مقدمتها كارثتا أوشفيتس وهيروشيما. لا شك في أن هاتين الكارثتين تجعلاننا نرتاب في سوية الجنس البشري واتزانه العقلي، إذ تدلان على الانحراف الذي أصاب الحداثة حين فصلت بين قضيتين جوهريتين: قدرة الإنسان التقنية المتفلتة، وقدرة العقل التفكرية الرقابية. لا يمكن الحداثة الغربية أن تستقيل وتترك الميدان العلمي التقني الصناعي الإنتاجي من دون مواكبة وتدبر ورعاية، وحجتها في ذلك أن العقل الأداتي يتمتع بالسيادة الاختصاصية المطلقة على ذاته.
في كتاب "هيروشيما في كل مكان" (Hiroshima ist überall)، يحاور أندرس الطيار العسكري الأميريكي كلود إيثرلي (Claude Eatherly) الذي قاد طائرة الاستطلاع من أجل ترصد الأحوال الجوية المواتية قبل إفراغ إسقاط القنبلة النووية الإجرامية على رؤوس أهل مدينة هيروشيما. من خلاصات هذه المحاورة أن الضمير الإنساني عاجز عن تصور مقدار القوة التدميرية الهائلة التي تنطوي عليها التقنية المعاصرة في حقول شتى من الصناعة العلمية المتقدمة. حقيقة الأمر أن التقنية المعاصرة هذه تحمل إلى البشرية من جليل المخاطر الإبادية ما يعجز العقل عن إدراكه ويقعد عن تدبره. فكما أن الوعي لا يستطيع أن يلتقط إشارات التأثيرات النفسية الدقيقة، العديمة الهيئة، الغائرة القوام، المتوارية المضمون (subliminaux)، كذلك لا يستطيع أن يلتمس رسائل الخطر التقني الأعظم الذي يحدق بنا من كل حدب وصوب، ويوشك أن يهلكنا جميعاً في اختلال كوني فظيع. الرسائل الأول تتجاوزنا في القعر، في حين تتخطانا الرسائل الأخرى في العلو (surliminaux).
انتهاء صلاحية الإنسان
أما في كتاب "زمانة الإنسان" (Die Antiquiertheit des Menschen)، فإنه يبين لنا أننا نحيا حياة البطل الإغريقي الأسطوري بروميثيوس الذي سرق نار المعرفة الإلهية ونقلها إلى البشر، ولكن الإله زيوس (جوبيتر الروماني) استشاط غيظاً، فسمره على صخرة العذاب الأبدي تنهش الطيور الكواسر، لا سيما نسر القوقاز، كبده الذي يعود فينبعث بعد كل التهام مؤلم. يفسر غنتر أندرس هذه الأسطورة رابطاً إياها بمحنة الإنسان المعاصر الذي يروم أن يتجاوز حدود إمكاناته، فينشئ لذاته معرفةً خطيرةً تجعله يتيه في شعاب الابتكار الإهلاكي، ذلك بأن صنائعه تتجاوز مخيلته، فيقع في المحظور وينتج عالماً تقنياً لا يقوى على استطلاع هيئاته المتوالدة، وآثاره المتراكمة، وعواقبه المتفاقمة، لذلك تنقلب الآية، فيصبح الإنسان يحيا في عوالم طوبوية متناقضة، إذ عوضاً عن أن يتصور عالماً جديداً لا يستطيع بعد أن يصنعه، طفق يصنع عالماً مرعباً لا يقوى على تصوره. وعليه، تصبح الزمانة صفة الإنسان الذي شاخ وهرم، فذوى عوده وذهبت طراوته، وبرى الدهر صلاحيته وجرفته عتاقة الأيام، فخرج خروجاً مأساويا من ميدان الفعل التاريخي الملائم. تجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الترجمات الأوروبية تستخدم عديلاً آخر للعنوان الألماني، فتعبر عنه في اصطلاح بليغ (L"obsolescence de l"homme) يدل على الاهتراء الكياني هذا.
في تضاعيف هذا الكتاب أيضاً تتجلى وضعية الإنسان المعاصر الذي يحيا خارج الزمان، من بعد أن فقد معنى الفعل الإبداعي السليم. ينطوي التأمل الجليل في مسرحية الروائي الإيرلندي صمويل بيكيت (1906-1989) "في انتظار غودو" على معاينة حصيفة تتناول عطالة الإنسان المسلوخ عن مسار الزمان، المقيد بسلاسل الكائنات المصطنعة. أما خاتمة الكتاب، فتحذر الناس من مغبة الأعراض عن المسؤولية التاريخية التي تستوجب انتزاع الأرض من وضعية المختبر الصناعي الذي طفق يهيمن على جميع ميادين الوجود. فالحياة الإنسانية المعاصرة أضحت مختبريةً تحليليةً اصطناعيةً بضاعيةً تخضع لقانون الإنتاج الأعمى، في حين فقد الإنسان القدرة على استشراف طبيعة المخاطر الإبادية التي تحدق بوجوده. ومن ثم، هيهات أن يكفينا التفجع على مصائر الإنسانية، من بعد أن شارفنا على الزوال، حتى نؤمن بضرورة الفعل الإنقاذي المستنير!
عجز الإنسان عن الثورة من أجل تغيير العالم
لشدة أهوال الكارثة التي حلت بالبشرية، أضحى الإنسان في حال مقلقة من الضياع، لذلك أنشأ غنتر أندرس يقول في عام 1956 إن النظام السياسي الليبرالي المبني على التقنية الإنتاجية المحض لا يتيح للإنسان المعاصر أن يثور ثورةً جذريةً استثنائيةً، ذلك بأن المجتمع المعاصر أخذ يروض الإنسان ترويضاً لطيفاً هادئاً، من غير أن يستخدم الأساليب العنفية الساقطة التي لم تعد تليق بصورة الإعلام الحديث ومتطلباته التزيينية البراقة. يكفي اليوم أن تنشأ في حياة الناس وضعية حيادية لا مبالية تهمل فكرة الثورة وتحرمها من كل مسوغاتها الجذابة.
ومن ثم، كان غنتر أندرس يعتقد أن التقنية المعاصرة تعكف على برمجة الناس منذ ولادتهم، جسدياً وذهنياً ونفسياً، بحيث تحصر إمكانات تطورهم وقابليات أفعالهم في ما تريده لهم من مسلك، لذلك يعمد الاجتماع المعاصر إلى تبديل السياسات التربوية حتى تتحول إلى مجرد سبيل تقني يؤهلهم للانخراط في سوق العمل وحسب. حين يضيق أفق الإنسان المعاصر ويقتصر امتداد وعيه على الانشغالات المادية التافهة، يفقد القدرة على تصور الأفضل والأرقى، ويكتفي بالواقع القائم، ويكف عن طلب التغيير. أما التربية الإنسانية الشاملة، فيحظى بها أبناء النخبة المصطفاة التي تهيمن على المصائر. بذلك تتسع الفجوة الفاصلة بين الشعب المسود المقهور، وطغمة العلماء المقتدرين الذين ينقلون إليه ما يطيب لهم من إخبار العلوم وما يحلو لهم من تصورات الكون والتاريخ والحياة والوجود. فتتخدر في الناس أحاسيس الانتفاض والتطلب والتجاوز، لا سيما حين يمنعون من الفلسفة التي تصبح مجرد ملهاة عديمة الفائدة. أما أفضل الوسائل التي تحتقر الفلسفة والتفكير الذاتي النقدي المتطلب، فالإغراق في تسفيه منصات الإعلام المقروء والمسموع والمرئي وتلويثها بالمبتذلات العاطفية الفارغة، والاستثارات الغرائزية الحيوانية الفتاكة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من أنجع الوسائل، والحال هذه، أن تشتغل الأذهان بتوافه الأمور، وتستغرق في التسلية الجوفاء. فتتعاظم مقادير الثرثرة الإعلامية، وتطغى الموسيقى الصاخبة في كل أرجاء الوجود الفردي والجماعي، بحيث يستحيل على الفرد أن ينكفئ إلى عزلة التأمل والتفكر والتدبر. في خضم السياسة الإعلامية الانحرافية هذه، يضحي الجنس معبود الجماهير الذي لا منازع له، إذ يظن الناس أن الإغراءات الجسدية أمتع بضاعات الدنيا، وأن ممارسة الجنس عين السعادة وقمة اكتمال الرغبة الكيانية. في سياق هذا الإغواء، يجري إبطال البعد الرصين في الوجود الإنساني الذي يتحول إلى لعبة عبثية ينبغي مجانبتها قبل أن تقضي علينا. إذا كانت الحياة لا تنطوي على أي قيمة ذاتية، فإنه من الحكمة إهمال كل مسعى أخلاقي ارتقائي. الأفضل أن يكف الإنسان عن طلب القيم العليا، وأن يكتفي بمناصرة مبدأ خفة الحياة وطيشها العفوي، بحيث تصبح ابتهاجات الإنسان بمنجزاته الاستهلاكية معيار السعادة ومثال الحرية الممكنة.
على هذا النحو، تنجح البرمجة الذهنية في تحريض الناس على الانتماء إلى الأنظومة الفكرية التافهة السائدة، وتزرع فيهم الخوف من فقدان الرغبة في صون هذا الانتماء. من جراء هذا كله، ينتج المجتمع المعاصر إنسان الجماهير المغفلة التي لا هوية لها: إنه الكائن الاستهلاكي الخاضع لضرورات السوق الهوجاء والمستعد للمراقبة الإذلالية التي تجعله شاةً يسوقها العقل التقني المدبر. ومن ثم، تتضح معايير التمييز في حقل السياسة الاجتماعية التربوية بين المسعى الصالح والمسعى الفاسد: ينطوي الأول على كل ما يعطل عقل الإنسان ويشوش ذهنه ويربك حكمه، في حين يحرض الثاني على مناهضة كل المساعي التي يمكنها أن تسهم في إيقاظ الإنسان وصحوته ونهوضه. ومن ثم، فإن معايير الصلاح والفساد تقررها تصورات التفاهة السائدة في مجتمع الاستهلاك الفارغ. ومن ثم، فإن كل عقيدة إصلاحية صادقة تروم أن تسائل هذه الأنظومة وتنتقدها وتفضح مضامينها المنحرفة ينبغي أن يشهر بها، وأن يحكم عليها بالانحراف والتضليل والإرهاب، حتى تقصى من المجتمع إقصاءً إعلامياً صارماً لا هوادة فيه.
الخلاص فعل جماعي تضامني
لا بد، في الخاتمة، من الاستدلال على معاني العجز الإنساني المعاصر عن تغيير وقائع العالم. إذا كان المجتمع المعاصر قد سلبنا القدرة على الثورة والتغيير، فإن اعتصامنا بالوعي المستنير أصبح فعلاً عقيماً لا يأتي بالتحولات المنشودة. الواضح أن الناس ما برحوا يرومون التغيير، ولكنهم فقدوا القدرة على الفعل البنيوي الصائب الملائم الحاسم. عوامل شتى تمنعهم من الإصابة المحكمة. من أبرزها تعقد الوقائع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية التي تتجاوز حدة تشابكاتها الشائكة وعي الإنسان الفرد، وخطة المؤسسة الخاصة، وتصميم المجتمع الواحد، لا بل تتخطى حتى استراتيجيات البلد المنعزل، ما دامت حلقات العلماء والسياسيين والاقتصاديين والقانونيين والفلاسفة والحكماء تتواجه وتتصارع وتتنابذ، فلا أمل في استنقاذ البشرية والأرض من براثن الالتهام الوحشي الذي يصهر الجميع في أتون التسفيه المطلق، ويرمي بالإرادات الفردية الصالحة في لجة الظنون الفتاكة.