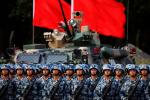على مدى العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين، لم يعد هناك من حديث يعلو صوتاً على حديث القرن الآسيوي بزعامة الصين، تلك التي رأى القاصي والداني أنها باتت القوة القطبية المقبلة، التي ستحتل مكانة الولايات المتحدة الأميركية قبل منتصف القرن الحالي.
مضت تلك السردية في الآفاق وتكررت على الألسنة طويلاً، غير أن تحولاً ما بدأ يظهر في العلن لا في السر، بخاصة في العامين الأخيرين، حيث ساد يقين بأن الصين لا تزال دولة شمولية، وأن كتم الأنفاس هو ما أدى إلى انتشار فيروس "كوفيد- 19"، ذاك الذي غير الأوضاع وبدل الطباع، إلى أمد غير محدود.
اعتبر العالم أن السمعة الأخلاقية للصين قد أصيبت بشكل كبير، وأن ضرراً بالغاً لحق بالفعل بكافة مشروعات الصين حول العالم، لا سيما الهدف الاستراتيجي الأكبر المعروف بطريق الحرير.
كانت الصين قاب قوسين أو أدنى من تحقيق هيمنة ناعمة على غالبية أطراف الكرة الأرضية، لا سيما في أوروبا، القارة العجوز التي تعوزها أموال الصين الساخنة، وبالفعل بدأ قبل بضعة أعوام سقوط ثمار أوروبية مثل إيطاليا التي كانت تفارق الوحدة الأوربية روحاً.
امتد النفوذ الصيني إلى مربعات قوة تقليدية للولايات المتحدة كما الحال في الهند وباكستان، ومضت القروض المليارية لتفتح الطريق في أفريقيا، ولتمتد إلى أميركا اللاتينية.
أخيراً بدأت إشكاليات عميقة تطرأ داخلياً، بدءاً من تهاوي أكبر شركة عقارات في البلاد، وصولاً إلى نقص الطاقة الكهربائية، ووصولاً إلى السير في اتجاه مضاد لرغبة العالم في استنقاذ الكرة الأرضية، ذلك أنه وفيما قمة غلاسكو في اسكتلندا منعقدة، كانت الصين تضاعف استخدامها للفحم، ما يعني عدم اكتراثها بالكوكب وساكنيه، وليذهبوا ما شاء لهم الذهاب، فما يهم الحفاظ على استراتيجية الردع النقدي، التي تواجه بها الولايات المتحدة وقواها النووية.
هل بدأ الوقت ينفد بالفعل من الصين، وهي في طريقها لإعادة تشكيل العالم، واحتلال المربع رقم واحد على كافة الأصعدة الحياتية؟
التباطؤ الاقتصادي بداية الانحدار
تولد الإمبراطوريات عادة من رحم القوة الاقتصادية، ذلك أنه حين يشتد عود أي دولة وتتوافر لها فوائض المال والقوة، تسعى دوماً إلى التمدد خارج حدودها الجغرافية، وتبقى هناك إلى أن يحين زمن ما يعرف بـ"فرط الامتداد الإمبراطوري"، أي الوقت الذي تضحي فيه غير قادرة على دفع أكلاف البقاء بعيداً من الوطن الأم، وساعتها يتحتم عليها الرضوخ للأصوات الانعزالية والعودة إلى الداخل.
في قراءة معمقة للمشهد الصيني قام عليها البروفيسور هال براندز أستاذ كرسي هنري كيسنجر في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة "جونز هوبكنز" الأميركية بالشراكة مع البروفيسور مايكل بيكلي، من معهد أميريكان إنتربرايز، نجد أن هناك ازدواجية غير ظاهرة للعوام تحلق فوق الصين في الأعوام الأخيرة.
نجحت الصين في رفع ناتجها الإجمالي بمقدار 40 ضعفاً منذ 1978، وباتت تمتلك أكبر احتياطيات مالية في العالم، وفائضاً تجارياً واقتصادياً يقاس من خلال التعادل في القوة الشرائية، وقوة بحرية تقاس بعدد السفن.
لكن تلك المشاهد الظاهرية، تخفي تباطؤاً اقتصادياً خطيراً، وانزلاقاً إلى نظام شمولي هش. كذلك تعاني البلاد ندرة حادة في الموارد وتواجه أسوأ انهيار ديموغرافي في زمن السلم عبر التاريخ، وليس آخر الأسباب أن الصين تفقد إمكانية الوصول إلى ذلك العالم الذي رحب بها ومكنها من التقدم.
هل تعاني الصين بالفعل من نقص في الموارد والإمدادات؟
يمكن أن يكون ذلك كذلك بالفعل، فقد اختفت نصف أنهارها، وترك التلوث 60 في المئة من مياهها الجوفية غير صالحة للاستعمال الآدمي، باعتراف الحكومة نفسها. كذلك جعلها التطور الذي حدث بسرعة خطيرة، أكبر مستورد للطاقة عالمياً.
وفي مقابل الصعود الملاحظ من العالم، تبدو هناك حقائق بعينها لا يمكن إنكارها، فالصين دمرت 40 في المئة من أراضيها الزراعية من خلال الإفراط في الاستخدام، وأصبحت أكبر مستورد للمنتجات الزراعية في العالم. ومع ندرة الموارد، صار النمو مكلفاً للغاية، إذ بات تحقيقه يستلزم من الصين أن تستثمر ثلاثة أضعاف رأس المال البشري الذي استثمرته في السنوات الأولى من القرن العشرين، ما يشكل زيادة تفوق بكثير ما يكون متوقعاً لدى نضوج أي اقتصاد.
هناك جزئية أخرى تلفت الانتباه إلى المصاعب التي تواجهها الصين، تلك الخاصة بعلاقتها بالدول النامية من جهة، والديون العالمية من جهة ثانية.
اعتبرت الصين في السنوات الأخيرة قاطرة النمو الاقتصادي بسبب نمو الديون، والصين على الرغم من أنها على عكس البلدان الفقيرة، يمكنها الاقتراض من الغرب، إلا أنها تطبع النقود بنسب هائلة، وبهذا يحفزون الطلب بنفس الطريقة، ويتزايد التخلف عن سداد القروض، وهو ما يعني أن المخاطرة كبيرة جداً بالنسبة إلى الاقتصاد الصيني.
التدهور الديموغرافي والنمو الاقتصادي
عرفت الصين كيف تقدم نموذجاً خلاقاً تجير فيه الزيادة السكانية لصالح العملية التنموية والإنتاجية، ومن هذا المنطلق اعتبرت أن الأيدي العاملة المتوافرة بكثرة عنصر قوة، كما أن رخص أثمانها مقارنة مع أسواق العمل الدولي مكنتها من استجلاب الاستثمارات من كافة أرجاء الكرة الأرضية، الأمر الذي دعا غالبية كبريات الشركات العالمية لأن تولي وجهها شطر الصين وتقيم على أراضيها مشروعاتها.
هذا الطرح ينقده بل يهدمه، مايكل شومان، الكاتب المتخصص في الشؤون الآسيوية، عبر تقرير نشر في مجلة "أتلانتيك" الأميركية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم، تحدث فيه عما أسماه فشل العبقرية الصينية، التي يضرب العالم المثل بها، في حماية المجتمع الصيني من الشيخوخة.
بحسب شومان، هناك حالة غامضة في ما يتعلق بالكارثة السكانية الوشيكة المحدقة بالصين، حيث تشيخ الدول بسرعة، إذ يكبر سكانها عمرياً، ما يهدد تقدمها الاقتصادي. ليست تلك المشكلة بجديدة، إذ يدق الخبراء ناقوس الخطر منذ سنوات، وقد يظن المرء أن صناع القرار الأفذاذ في الصين سيتعاملون مع هذا التحدي بالطريقة نفسها التي بنوا بها القطارات فائقة السرعة أو هزموا بها التفشي المتكرر لـ"كوفيد-19"، وبالهمة نفسها، وبما يناظر الوزن الثقيل للدولة الصينية. بيد أن ذلك وللمرة الأولى، ليس ما يحدث، إذ يبدو الحزب الشيوعي الصيني عاجزاً عن الاستجابة لقطار الشيخوخة السريع المتجه نحوه.
هل حاولت الصين الأيام الماضية الهروب من ذلك الفخ الذي نصبته لنفسها ولم ينصبه لها أحد ما؟
بالقطع هي فعلت من خلال رفع الحد الأقصى المقرر لعدد الأطفال لكل زوجين من طفلين إلى ثلاثة، غير أن فعالية هذا القرار تحتاج من عقدين إلى ثلاثة عقود لتحويل دفة الصعود الديموغرافي في اتجاه إيجابي يخدم صالح البلاد اقتصادياً.
وعلى صعيد التفكير التنموي المالي والاقتصادي، لم تصخ الصين السمع لخبراء الاقتصاد الذين حذروها من اعتمادها الكبير على الاستثمارات في البنى التحتية والمجمعات السكنية والمصانع في خضم سعيها نحو نمو مستديم. فقد أضرت الديون والأموال المهدرة الناتجة من ذلك تقدم الاقتصاد، بيد أن الحزب الشيوعي تباطأ في تحركاته لإصلاح تلك المسألة، مدفوعاً بهوس تحقيق أهداف النمو المرتفعة.
وفي مجالات أخرى، لم تستطع القيادات السياسية الصينية الخروج عن ممارسات راسخة على الرغم من ظهورها بجلاء بوصفها ممارسات عفا عليها الزمن.
على سبيل المثال لا الحصر، لا يزال صناع القرار يحافظون على نظام تسجيل الأسرة، المسمى "هيوكو"، الذي يربط الأشخاص بمسقط رأسهم لإتمام أبسط الخدمات، على الرغم من أن ذلك النظام يعوق الخدمات المقدمة للقوى العاملة المتنقلة عبر البلاد، ويعوق الأداء الاقتصادي للشعب كله.
يرى عدد من المراقبين للشأن الصيني، أنها عرفت طريق الصعود جيداً خلال العقود الأربعة الماضية، لكنها الآن تواجه اتجاهين يمثلان نهاية نهوضها، هما تباطؤ النمو، والتطويق الاستراتيجي.
ماذا عن إشكالية النمو في الداخل الصيني اليوم؟
باختصار غير مخل يمكن القطع بأن الاقتصاد الصيني دخل فترة التباطؤ الأطول أمداً في حقبة ما بعد ماوتسي تونغ. أولاً انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الرسمي للصين من 15 في المئة سنة 2007 إلى ستة في المئة سنة 2019، قبل أن يؤدي فيروس كورونا إلى انخفاض النمو إلى ما يزيد قليلاً على 2 في المئة سنة 2002... هل هذه الأرقام دقيقة؟
غالباً مبالغ فيها، إذ تظهر الدراسات الدقيقة أن معدل النمو الفعلي للصين يمكن أن يكون بمقدار نصف الرقم الذي صرحت به الحكومة الصينية.
هل عجل كورونا بنهاية التجربة؟
يحاجج المتخصصون في الشؤون الصينية على الصعيد الدولي بأن الفيروس الشائه الذي أصاب العالم، سيكون السبب الرئيس في التعجيل بنهاية التجرية الصينية المتميزة لا سيما في عالم النمو الاقتصادي.
في خريف العام الماضي، أقام قادة الصين احتفالاً بمناسبة ما أسماه الرئيس الصيني شي جين بينغ "اجتياز اختبار تاريخي واستثنائي"، في طريقة تعامل البلاد مع فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن الصين تقود العالم في رحلة التعافي الاقتصادي ومكافحة الفيروس... إلى أي مدى صدق الرجل في مقولته، وبأي ثمن وصلت الصين إلى ذلك الإنجاز الذي أثبتت التجربة أنه واه، وبخاصة بعد عودة الإصابات إلى البلاد مرة جديدة؟
الشاهد أن الصين تمكنت من احتواء الفيروس، من خلال مجموعة من عمليات الإغلاق، والقيود الصارمة المفروضة على السفر، وأيضاً باستخدام سياسة التهديد ضد المواطنين المخالفين للقوانين، وحتى من خلال عدم التصريح بالأرقام الحقيقية للوفيات، لكن في النهاية، أثبتت هذه الطريقة قوة الدولة الشيوعية وتفوقها في المجال الطبي، ما جعل المسؤولين يروجون لرواية نجاح البلاد في التغلب على الفيروس.
هل وقعت الصين في فخ الغرور الإمبراطوري، ذاك الذي يصيب عادة القوى الكبرى عند ذروة سيطرتها على المقدرات العالمية تاريخياً؟
ترتفع بعض الأصوات لتذكر بما قاله كارل ماركس ذات مرة من أن "كل نظام ومادة تحمل بذور فنائها"، وهذا ما شاهده العالم في تجربة الاتحاد السوفياتي.
بعد نهاية أزمة كورونا، إن كان لها نهاية واضحة قريبة، سوف تواجه الاقتصاد الصيني تحديات عدة، منها استعادة حالة الثقة في المنتجات الصينية وما إذا كانت خالية من بقايا الفيروس، كما أن عديداً من الدول المستهلكة باتت تنتظر الخروج من الأزمة، لاستعادة استقلالها التجاري وعدم الارتباط ببكين وهو ما سيؤثر على المكانة الاقتصادية للصين على الصعيد العالمي.
هل الولايات المتحدة الأميركية ستكون أول من يوجه طعنات إلى قلب التجربة الصينية اقتصادياً متى قدر للعالم الشفاء والتعافي من كورونا؟
حكماً ذلك كذلك، فقد تعلم الأميركيون الدرس جيداً، بل إن الرأي العام الأميركي قد بدأ بالفعل في طرح تساؤلات جوهرية عن كيفية إقامة سلاسل التوريد الدوائية لغالبية الشركات الأميركية على الأراضي الصينية، وقد كان الجواب مخجلاً، ذلك أن الشركات الاستثمارية الكبرى في الداخل الأميركي لم يعد يغريها سوى الأرباح السريعة، حتى وإن أثر ذلك في مستويات الأمن والسلامة للشعب الأميركي.
هنا تبدو الصين قد بدأت تحيد عن شعار الحلم الهادئ، وبات يغريها الحلم الصيني الكبير، وتماماً، كما كانت حال الإمبراطوريات السابقة، أصبحت تسعى لتحقيق نفوذها الاقتصادي والسياسي عبر العالم، غير آبهة بالمشكلات الداخلية وامتعاض الطبقة الوسطى المطالبة بالانفتاح، وانتشار النزعات الاستقلالية، فالتعاون الذي كان سمة علاقات الصين السابقة، تحول إلى منافسة، سيما مع الولايات المتحدة.
تدفعنا السطور المتقدمة إلى دائرة أخرى من دوائر تسليط الضوء على ما يجري في الصين، وهل بدأ زمن الفوقية العسكرية التقليدية للإمبراطوريات والقوى العظمى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الأسلحة النووية... الدرع الصيني الواقي
طويلاً جداً استخدم المراقبون والمحللون للشأن الصيني تعبير الردع الصيني النقدي، كان المقصود هو أن بكين لا تسعى في التعاطي مع الولايات المتحدة إلى تكريس نفسها كقوة نووية، بل كقوة نقدية مالية، قادرة على مواجهة واشنطن بطريق سلمي، من غير اللجوء إلى أسلحة الدمار الشامل بكثرة، على الرغم من امتلاكها بضعة مئات من الرؤوس النووية.
على أن ما كشفته الأقمار الصناعية أخيراً من سور نووي صيني يجري الإعداد له تحت الأرض، قد غير المشهد الصيني بالمرة.
القصة تقول إن الصينيين يعمدون إلى بناء عشرة آلاف رأس نووية تكون بالنسبة لهم حائط الصد ضد أي هجمات أميركية متوقعة.
يعكس التفكير الصيني على هذا النحو رغبة في الصدام والتصارع على امتلاك أدوات القوة، بأكثر من الفلسفة الصينية الكونفوشيوسية التقليدية، تلك التي تؤمن بأن العالم كيان واحد أنطولوجي، يمكن فيه الاختلاف لكن في إطار الكل ومن غير حاجة للمواجهة أو الحروب والموت والدمار.
شدد الزعماء الصينيون دائماً على أهمية الأسلحة النووية الحرارية والصواريخ الباليستية، وتركز بكين على تطوير عدد قليل من الأسلحة النووية الحرارية ذات القدرات العالية.
تتكون القوات النووية الصينية حالياً من رؤوس حربية نووية حرارية ذات قدرات كبيرة وهي بقوة عدة ملايين من الأطنان.
منذ سنة 1964 اعتمدت الصين على رادع نووي من صواريخ باليستية أرضية تحت استخدام فيلق المدفعية الثاني، ومنذ أواخر الخمسينيات سعت الصين إلى تطوير صواريخ باليستية بعيدة المدى من أجل توصيل ترسانة مبرمجة من رؤوس حربية انصهارية ذات قوة من عدة ملايين الأطنان.
السؤال الجوهري في هذه الجزئية: هل نجحت الولايات المتحدة في الإيقاع بالصين في فخ سباق التسلح، ذاك الذي أودى بالاتحاد السوفياتي من قبل؟
الثابت أن بكين زادت إنفاقاتها العسكرية بنسبة تفوق 10 في المئة لسنوات عدة، ومع برنامجها الجديد للسور النووي تحت الأرض، حكماً فإن ذلك المسعى سوف يجيئ على حساب عوامل التنمية الداخلية، وخصماً من مقدرات الأجيال الصينية المقبلة.
حصار الصين عسكريا وسياسيا
تبدو الصين محاصرة في الأوقات الراهنة من قبل الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها التقليديين، حصاراً يمضي في اتجاهين الأول عسكري، والثاني سياسي.
أما الاتجاه الأول فتمثل جلياً في حلف أوكوس، بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، وهو تحالف عسكري لا شك، حيث ستمضي أميركا في تزويد أستراليا بصفقة غواصات نووية متقدمة للغاية من نوعية فيرجينيا، تطال صواريخها النووية حواضر الصين.
هذا التوجه ترك تأثيراً واضحاً على الصينيين وصل إلى حد التهديد باستخدام القوة النووية ضد أستراليا، وهو تهديد واه لا فائدة منه ولا طائل من ورائه، ذلك لأنه يعني حرباً عالمية نووية، لن تقدر خلالها الصين على مجابهة أو مواجهة واشنطن وحلفائها.
يدرك البيت الأبيض أهمية أستراليا، ويدعم أستراليا صراحة كبار دبلوماسيي الرئيس جو بايدن. قال كورت كامبل، منسق البيت الأبيض لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في مارس (آذار) الماضي، إن الإدارة أبلغت الصين أن الولايات المتحدة لا يمكنها تحسين العلاقات في سياق ثنائي ومنفصل عما يتعرض له حليف وثيق من إكراه اقتصادي، وأضاف أن "الولايات المتحدة لن تترك أستراليا وحدها في الميدان".
هل تبين للصينيين أهمية أستراليا وخطورة التفكير في الاقتراب منها؟
على الجانب الآخر تبدو الولايات المتحدة فاعلة في حصار الصين سياسياً من خلال مجموعة "كواد"، التي تقول واشنطن إنها تمثل ديمقراطيات متقدمة، قوامها الهند واليابان وأستراليا بجانب أميركا نفسها.
تغزل واشنطن على العداوات التاريخية بين الصين والهند بنوع خاص، وتحاول وضع العصا في دواليب العلاقات ما بين بكين ونيودلهي، وربما تعيد تفجير الملفات الخلافية التاريخية الساكنة خائنة الأعين وخبايا الصدور.
تدرك الصين أنها محاصرة وأن الحصار هذه المرة يتفاعل رويداً رويداً من خلال آليات متغيرة عما جرت به المقادير في العقود السابقة، وجزء كبير منه دعائي، ولهذا مضت أخيراً في طريق الحديث عن نموذجها الديمقراطي الخاص، الذي ضمنته ما أطلق عليه، الكتاب الأبيض، وفيه الحديث عما يسمى "الصين... ديمقراطية تعمل".
هذا الكتاب – التقرير، جاء ليستبق المؤتمر الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن أيام 9 و 10 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، حول الديمقراطية، الذي واجه اعتراضاً صينياً واسعاً، لإدراك الصينيين أنه ستكون له تبعات تختصم من حضورهم ومن مربعات نفوذهم حول العالم.
اعتبر الصينيون أن القمة الأميركية الديمقراطية تقسم بلدان العالم وتوجه أصابع الاتهام إلى دول أخرى، وفي كل الأحوال فإن دعوة بايدن التي لم توجه بالفعل إلى الصين، قد تركت هزة عميقة في الداخل الصيني، تضاف إلى هزات أخرى قائمة ومقبلة، الأمر الذي أدى لشعور الحزب الشيوعي الصيني بالتهديد، وبأنه مضطر لإعادة التأكيد على أنه يضع الشعب أولاً، وهو قول مشكوك فيه في ظل عديد من علامات الشمولية الداخلية.
هل من خلاصة ؟ ما تقدم غيض من فيض ، فالحديث عن الصين يحتاج إلى شرح مسهب ومطول، غير أن الخلاصة المؤكدة هي أن الصين وإن أنكرت علناً إلا أنها باتت تدرك سراً حدود قوتها والعقبات الكثيرة التي تواجهها، فلكي تصبح دولة ما قوة عظمى، لابد لها من الإجابة عن سلسلة من الاسئلة المتصلة حول القدرات والنيات والإرادة.
فشلت الصين أخيراً في كسب معارك أخلاقية عدة، منها على سبيل المثال معركتها مع مسلمي الإيغور، ومعركتها مع الشفافية التي ولدت تبعات كورونا الكارثية.
الصين في حالة حيرة، فقد فشلت دبلوماسياً في الوصول إلى حلم النموذج التنموي العالمي من جهة، وها هي تجرب الطريق العسكري من جهة ثانية، وبينهما تتحرك الولايات المتحدة بخطى حثيثة لتأكيد مكانتها القطبية، وتوجيه الطعنات للحلم الصيني من خلال مزيد من الكوابح الخارجية، واستغلال الرياح المعاكسة الصينية الداخلية... وفي النهاية فإن الصين لا تزال قوة بعيدة من كونها قوة عظمى.