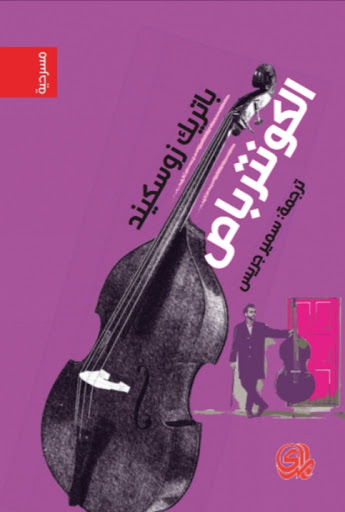من البديهي أن تسعى الذائقة العربية إلى تلقف الجديد، وأن تواكب الترجمات من اللغات الأجنبية كل عمل أدبي نال صيرورة وانتشاراً مثل الأعمال الروائية والقصصية التي أبدعها الكاتب الألماني المقل باتريك زوسكيند (1949). وفي مناسبة صدور الترجمة العربية لنص "كونترباص" عن الألمانية، على يد المترجم المصري سمير جريس عن دار المدى، يتعين علي الالتفات إلى مضمونها، في ما يأتي من كلام، بعد التعريف بأهم عمل روائي أنجزه الكاتب الألماني، وعنيتُ به " العطر" والذي سبق أن نقله إلى العربية المترجم السوري نبيل الحفار.
ولكن لمَ هذا الاهتمام العالمي بأدب زوسكيند الذي لا يتميز بالغزارة، بل لا تكاد أعماله تبلغ أصابع اليد الواحدة؟ من الدواعي للاهتمام بأدب زوسكيند أن الأخير أفلح في الانطلاق من وجهة نظر فريدة، لم يسبق أن تطرق إليها كتاب الأدب البوليسي أو التاريخي، منذ القرن الـ 18 وحتى القرن الـ 20، زمن كتابة الرواية، وتتمثل في ربط الجريمة بميل متطرف إلى جمالية في التعطر، تذهب بالمجرم إلى استخلاص عطر ضحاياه من النساء، بأن يخنق كلا منهن ويجمع السوائل التي ترشح من جسومهن بصفتها مادة عطره الأساسية.
ومفاد حكاية "العطر" الأساسية أن الطفل الوليد، ويدعى جان باتيست غرونوي، وهو الشخصية المحورية في الرواية، وإذ تُتهم والدته بمحاولة قتل وليدها، والزمن عام 1738، في فرنسا، يحكم عليها بالإعدام، فتتولى رعايته امرأة لا تلبث أن تتخلى عنه حالما يتبين لها أن الطفل هو من دون رائحة تميز جسمه، فتوجست شراً منه. عندئذ، وضع الطفل لدى سيد يدعى غريمال، في ما يشبه المدرسة الداخلية، إلى أن صار فتى قادراً على العمل. وفي غضون ذلك، تعرض الطفل لأسوأ أنواع المعاملات، ربما كانت سبباً في سيرته المنحرفة. أصابه المرض، فكاد يهلكه، ولكنه نجا منه. وما أن تعافى حتى اكتشف في نفسه قدرات على الشم عالية، وسعياً إلى تقصي العطور ومكامنها لدى النساء، فمضى يفيد من تجواله في شوارع باريس، في خمسينيات القرن الـ 18 متسكعاً فيها، يتتبع بعض النساء الشهيرات اللواتي كن يضعن عطوراً أخاذة، فكانت له أمرأة شابة، الضحية الأولى، بعد أن أغواها بما لديه من مواهب.
وبينما كان الشاب باتيست يفلح في إنقاذ أحد أبرز صانعي العطور في باريس، ويدعى السيد جيوزيبي بالديني، من انهيار حرفته، بإحيائه عطري آرمور وبيسيشي، ينهار بناء المحترف، ويتوفى بالديني. وعلى إثر ذلك، يواصل الشاب باتيست تسكعه في المدن الفرنسية، بعد عزلة دامت سبع سنوات، ويستأنف جرائمه واستحواذه على عطور النساء، حتى بلغت ضحاياه 23 امرأة مقتولة خنقاً، وعارية تماماً، وحليقة الرأس.
ولئن اكتُشف أمر باتيست، واعتقل، وأعدت له أدوات الإعدام، فإن صرخات تعالت من بعض المتجمهرين مطالبين بتبرئته من التهم المنسوبة اليه بعدما سحر الجميع بالعطر الذي صنعه وأطلقه من الزجاجة في الهواء الطلق. وللحال يسود الهرج والمرج في ساحة الإعدام، مما أتاح للجاني باتيست الهرب من جديد، والتماس سبيل جديد لمواصلة خطته الجهنمية السالفة.
المسرحية الرائجة عالمياً
بالعودة إلى مسرحية "الكونترباص" التي ترجمها إلى العربية من الألمانية الكاتب المصري المتمرس في اللغتين سمير جريس، تعتبر واحدة من المسرحيات الأكثر رواجاً في العالم، وعمل على اخراجها كبار المخرجين المسرحيين، على خشبات كبرى المسارح الوطنية والخاصة، غربا وشرقا. وعلى الرغم من أن المسرحية، ذات الممثل الوحيد، قصيرة للغاية، وتكاد تبلغ 43 صفحة (مع احتساب صفحات التمهيد والتعريف والإهداء وغيرها)، فإن المؤلف ارتقى فيها إلى ذروة ما يمكن أن يطمح إليه أي كاتب مسرحية. ولعل من المفيد التذكير بالنقاط المضيئة والشديدة الجذب في هذه المسرحية، أولها تسليط الكاتب الضوء على شخصية "عازف الكونترباص"، ومعالجته مجمل العلائق الصراعية التي تحكم صلته بآلة الكونترباص، ومجمل الظروف الإنسانية التي تحيا في ظلها هذه الشخصية. وهذا ما لم يسبق إليه في الأدب المسرحي الغربي. ثانيها أن الكاتب حطم في هذه المسرحية بنية المسرح التقليدية، جاعلاً منها عرضاً حراً ودافقاً بالمشاعر، وإن يكن على حساب صورة الدراما الكلاسيكية، المستعادة منذ عهد الجوقات والمدائح التي كان يؤديها الممثل الفرد، في القرن السادس قبل الميلاد، ومروراً بعهد آخيل، وانتهاء بتسعينيات القرن الـ 20، زمن كتابة هذه المسرحية.
ولمن أراد السؤال عن حبكة المسرحية (كونترباص)، فلا حكاية، ولا حبكة تنظم أحداث المسرحية، بل ولا أحداث، إنما ثمة عرضٌ متواصل لأحوال عازف الكونترباص، ومجمل المشاعر التي يكنها العازف للآلة المذكورة في خلال أدائه مهنته كعازف كونترباص في الفرقة الرسمية التابعة للدولة. فيتشكل من ذلك التناوب، بين المرجعين الماثلين على خشبة المسرح (العازف، وآلة الكونترباص)، قطبان يتيحان بخلق فضاء مسرحي فعال ومتفاعل، في آن. ولكن التساؤل الأهم الذي يحسن بالقارئ أو المتتبع طرحه، وهو كيف أمكن لكاتب المسرحية، باتريك زوسكيند، أن يضمن تفاعل الجمهور المتواصل مع النص المسرحي؟ للإجابة عن هذا التساؤل، أقول بأن عبقرية زوسكيند وإبداعيته تتجليان في هذا الأمر. ولو شاء المراقب تفصيل ذلك، لقال إن المؤلف حشد، في مسرحيته المونولوغية ما لا يحصى من الموتيفات، والمواقف، والآراء، والحوادث المستلة من سيرة الشخصية الوحيدة على المسرح، والتحليلات العميقة، والمعارف الموسيقية المجهولة من قبل الجمهور الأوسع، إضافة إلى آرائه "المتفردة" في الفن، والغناء، والرسم والنحت والموسيقى وعلاقتها بالسياسة (تفضيل هتلر موسيقى فاغنر مثلاً)، وفي الفلسفة وغير ذلك.
الممثل الوحيد
إذاً، لما كانت مسرحية "كونترباص" تتشكل من مشاهد كثيرة، متفاوتة في الطول، ولما كان ثمة تحد جوهري أمامها، وأمام المؤلف، يكمن في خلو المسرحية من قضية إنسانية أو حدث صادم أو مسألة معينة، وبالتالي أن يبقي جذوة التشويق دائمة، فقد أوجب على الممثل الوحيد الظهور، الاشتعال، وخيط التفاعل مشدود بين خشبة المسرح والجمهور، فكان ابتكاره لكل مشهد مدخلاً أو فكرة أو معلومة مرتبطة ارتباطاً قريباً أو بعيداً بآلة الكونترباص، بحيث تتشعب المواضيع إلى حد يحمل البعض من القراء (والجمهور الحاضرين) على التساؤل عما إذا كان ما يعرض أمامهم يُنمى إلى المسرح التقليدي، أو إلى فن الحكاية الرصين أو إلى فن العرض الحر، أو إلى فن المداواة عبر المسرح أو غيره، والواقع أن مسرحية "الكونترباص" هي كل هذه الفنون مجتمعة، مضافاً إليها، معارف موسوعية، في مجال الموسيقى والمؤلفين الموسيقيين وفي الأنثروبولوجيا الموسيقة، وربطها بالمواقف السياسية المعارضة، وقدرة على دحض الآراء السائدة في الحداثة وفي الحب والتراتبية الاجتماعية وغيرها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن هذا القبيل، شروع الكاتب في المشهد الأول بالكلام على أهمية آلة الكونترباص في الأوركسترا الغربية، منذ نشوئها في القرن الثامن عشر إلى اليوم. وفي المشهد الثاني، يختار بسط آراء فلسفية في الآرض، والموسيقى، والسلطة التراتبية داخل الأوركسترا، والحب، والعشق والعشيقة، وإشارة إلى مغنية السوبرانو، ووصف لمكونات آلة الكونترباص وقطع الغيار فيها. وفي المشاهد التي تلت، عرض مستفيض للموسيقى، وللاتجاهات الموسيقية الكبرى، ولعلاقة الموسيقى بالثورة، وإشارة إلى الإضرابات إبان الثمانينيات من القرن الـ 20، في فرنسا وألمانيا، بالتزامن مع صدور المسرحية. كما خص كلامه، بالحديث عن الفرتيوزو، أو المؤدي البارع الذي كان له مقام في بعض الموسيقات الفذة، في مقابل هبوط العديد من الموسيقات، برأيه، مثل تلك التي ألفها برليوز، أو فاغنر، أو غيرهما. وفي مشاهد أخرى يحسم المؤلف (ومن ورائه الممثل) في وصول علم النفس إلى حائط مسدود، ويعلن أنه ضد الحداثة وأنه مع النزعة الكلاسيكية القديمة وشعارها الثلاثي "الخير والحق والجمال" وغيرها من الآراء الجريئة. هذا من دون الكلام على النبرات التصاعدية، بحيث تنتهي المسرحية بصرخات، يعبر فيها الكائن عن عميق أزمته، بوجود آلة الكونترباص وبغيابها على حد سواء.
وإذ أوردتُ، في ما سبق، بعضا من هذه الأفكار المحورية، بل نقاط الجذب المتتالية، لأخلص إلى أن وجهة النظر النفاذة التي ينطلق منها المؤلف (باتريك زوسكيند)، شأنه في روايته "العطر"، تتمثل، هذه المرة، في توصيف وضع الإنسان المعاصر، وإعادة تقويم صلته مع محيطه وأدواته، وأفكاره ومسلماته التي يجبره محيطه على تبنيها. أليس هذا هو جوهر الأدب مسرحاً وشعراً ورواية، وأليست تلك هي مهمته في إعانة الإنسان على "إعادة تقويم حياته الداخلية المستقبلية" على حد تعبير رينه شار؟