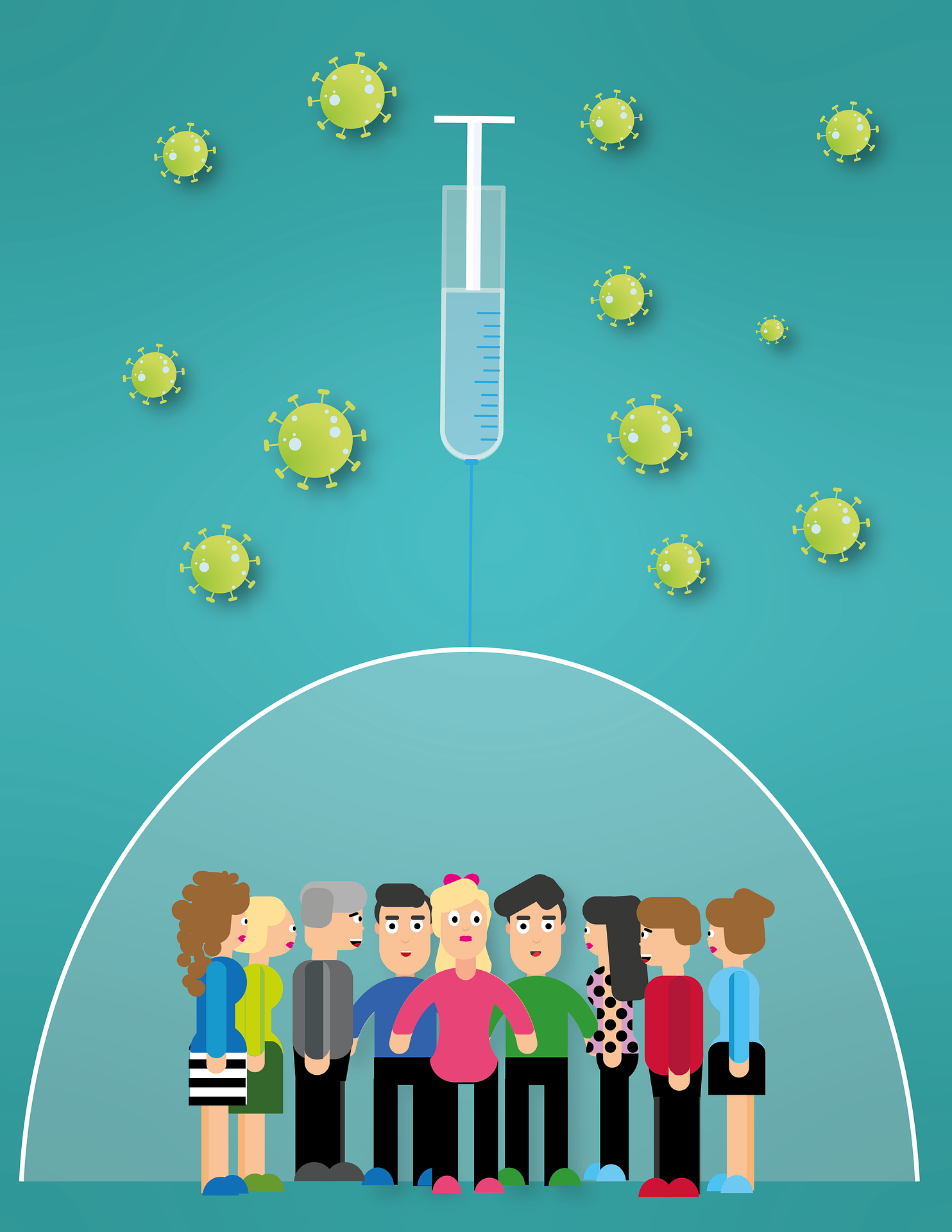مجدداً، يجدر عدم التوقف عن تنبيه حشود باتت السوشيال ميديا تُشتت وعيها على مدار الساعة، إلى أهمية الإنجاز العلمي الضخم الذي حققته عقول العلماء باكتشاف لقاح ضد كورونا خلال السنة الأولى من انتشاره في جائحة عالمية لم تحصل منذ قرن، وقد ذكرت بالخيالات المأثورة عن تاريخ الطاعون وغيره من الأوبئة التي اعتادت أن تحصد أرواح البشر بشراسة، حين لم يكن لديهم ما يقيهم غائلتها ويصدها عنهم.
الأرجح أن البشرية ستنظر بفرح وفخر إلى تلك العقول التي عملت بلا كلل ومن دون ضجيج، كي تبتكر لقاحاً لم تصنع البشرية نظيراً له من قبل، وبوسائل لم تكن متوقعة أو مرتسمة قبلاً.
من كان يتوقع أن يأتي الحل للجائحة الفيروسية الأولى في القرن 21 (لنأمل أنها الأخيرة لكن ذلك يحتاج مسارات عدة)، على يد علماء يعملون في الأورام الخبيثة، حيث اليد العليا هي للتركيز على كل مريض بمفرده؟ ومن كان يتوقع أن تقنيات طُورت أصلاً للتعامل مع المريض بشخصه وتفصيل تركيبته الوراثية، وهي تقنية الحمض النووي المرسال "آر أن إيه" mRNA، ستستعمل في إيجاد حل لمرض يسري على مستوى الجموع، بل المليارات التي تؤلف سكان الكرة الأرضية؟ الأرجح أن البشر الذين يعيشون أسارى لحظة الوباء يذهب معظم تفكيرهم وتركيزهم إلى الخلاص، مما يبعد عنهم فكرة التأمل في تألق الإنجاز العلمي الذي أتاح خلاصهم. الأرجح أن ذلك مفهوم تماماً.
في المقابل، ما بدا مخيباً تماماً تمثل في السوشيال ميديا، وتلك الاندفاعة المفاجئة لآراء مضحكة مبكية لعشرات من "المتخصصين المفاجئين" ممن تركوا على حين غرة منصات الغناء والرقص والتلاعب بالغرائز الجنسية والثراء، من انحدار الثقافة إلى مجرد ثقافة متعة سلعتها الجسد، كي يعطوا "تقويمهم" (هنيئاً لهم بالمتابعين وسيول الـ "لايك") للأدمغة العلمية المتألقة التي تعمل استناداً إلى تراكم علوم البشرية كلها منذ فجرها، كي تنقذ البشرية من وباء مدمر.
تبدد أحلام تواصل العقول
استكمالاً، لا يتمثل المضحك المبكي في هذا الملمح في التدهور العلمي لما نشر على السوشيال ميديا عن الوباء واللقاح، بل في ذلك النشر بالتحديد. وتذكيراً، حين ظهرت وسائل التواصل الاجتماعي استناداً إلى الانتشار المذهل للإنجاز العلمي المتجسد في الإنترنت، ساد توقع متفائل بأن تحقق تلك الوسائط حلماً راود المفكرين أزماناً.
إنه حلم التواصل بين عقول البشر وثقافاتهم وأفكارهم وتطلعاتهم وتوثباتهم وإرادتهم وأديانهم وتراث حضاراتهم، باعتبار أن ذلك التواصل من القوى التي تستطيع إعطاء دفعة نوعية للتقدم في حضارة البشر بمناحيها كلها.
بديهي القول أن شيئاً كثيراً من ذلك قد تحقق، ولا تعمينا بضع شجيرات التخبط في السوشيال ميديا، عن رؤية الغابة الخصبة من التواصل الإنساني الفريد عبر الإنترنت، وهو أيضاً ما لم تشهده البشرية قبلاً، لكنها حلمت به طويلاً.
من جهة ثانية، بدا محبطاً أن تتحول تلك الأداة الجبارة إلى مسارات أخرى، من بينها صراعات الدول والاستخبارات والمؤسسات، وتشمل أيضاً انخراط الجمهور في تحويل أداة تسهم في رفع وعيه كونياً، إلى أداة تضلل ذلك الوعي نفسه حيال وباء يتهدد الوجود البشري كله.
الأرجح أن الكلمات السابقة فرضت نفسها في ظل نقاش "ساخن" عربياً على السوشيال ميديا عن اللقاحات، وكذلك يضحك ويبكي أن قلة من العرب تنبهت إلى ضآلة ما قدمته شعوبنا لوسائل الخلاص من الجائحة، إن لم نقل انعدامه تقريباً.
وبالعودة إلى مسار العلم، يجدر تذكر كلمات البروفيسور الأميركي أنطوني فاوتشي بأن "أفضل لقاح هو ذلك الذي تستطيع الحصول عليه". ومن بين أسباب ذلك القول، يبرز أن اللقاح إنما يعمل على مستوى الجموع، مما يعني أن نقاش فاعليته على الفرد الواحد يجب النظر إليها ضمن ذلك السياق، إذ يعمل اللقاح على إيصال الجموع إلى "مناعة القطيع" التي تشكل القلب الفعلي لمسألة التعايش مع الأوبئة بعمومها، ويعني ذلك أن انتشار مناعة ضد عنصر وبائي بين أجساد مجموعة بشرية، إلى مستوى يتكفل بكسر حلقات انتشار الوباء فيها.
ويتوافق علماء الأوبئة على أن انتشار المناعة ضد جرثومة أو بكتيريا أو فيروس طفيلي معين في أجساد ما يتراوح بين 60 و65 في المئة من مجموعة سكانية محددة، يكفي لحدوث مناعة القطيع فيها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مناعة القطيع ومخازن الفيروس
استطراداً، شكلت مناعة القطيع جزءاً من تفسير انطفاء الأوبئة وانكسار موجاتها طبيعياً، إضافة إلى عناصر بيئية وطبيعية واجتماعية أخرى مثل تبدل الطقس والمناخ (لنتذكر أن الإنفلونزا العادية تنطفئ طبيعياً مع دفء الربيع والصيف)، أو تبدل حلقات نقل الوباء كأن يجف مستنقع تعيش عليه أسراب البعوض الناقل للملاريا، أو أن تتبدل أنماط الحياة والعمران لمجموعات سكانية بطرق تؤثر في علاقاتها الأساسية مع البيئة ومعطياتها الواسعة أو غير ذلك.
ثمة أمثلة لا تحصى عن ذلك. تعيش مجتمعات البشر في حال تعايش مع مجموعة لا تحصى من الأوبئة المستقرة فيها، لكنها تعيش في حماية اللقاحات والأمصال والأدوية المختصة بتلك الأوبئة، فمثلاً، جرثومة الكزاز ["تيتانوس" Tetanus] موجودة في كل مكان، لكنها لم تعد تفتك بالأرواح والأجساد بفضل برامج التلقيح ضدها، ولأن المصل المضاد للكزاز متوفر في كل مكان، وبسعر لا يستعصي على معظم البشر.
ومنذ تطور اللقاحات وعلومها وصناعتها، تتعايش الإنسانية بنجاح مع عدد من الأمراض الوبائية، بفضل برامج تلقيح واسعة، ومن الأمثلة الشهيرة على ذلك أن لقاح "دي بي تي" DPT يشكل جسر التعايش مع أوبئة الخانوق (دفتيريا) Diphteria والشاهوق (السعال الديكي) Pertussis والكزاز Tetanus، وكذلك تتعايش البشرية مع الأوبئة التي يحميها منها اللقاح الثلاثي الشهير "إم إم آر" MMR الذي يعطي مناعة ضد الحصبة Measles (Rubeola) والنكاف (أبو كعب" بالعامية اللبنانية) Mumps والحصبة الألمانية Rubella.
وبديهي القول إن برامج التلقيح الواسعة تؤدي إلى صنع "مناعة القطيع" في المجتمعات، ليس عبر التعرض "الطبيعي" للأوبئة، بل بفضل المناعة المُركزة والمحددة التي يعطيها اللقاح، بمعنى أن كل لقاح يعطي مناعة ضد مرض محدد.
إذاً، الأرجح أن البشرية دخلت مرحلة الخلاص من جائحة كورونا، وانتقلت إلى مرحلة التعايش مع ذلك الفيروس، بمعنى أنه سيكون موجوداً دائماً لكنه لن يعود مقلقلاً للأجساد والأرواح والعيش اليومي، على غرار ما فعل ويفعل حتى الآن.
وفي ما يخص عائلة فيروسات الإنفلونزا التي ينتمي إليها كورونا، ثمة علاقة خاصة مع الخزان الحيواني، فهناك حاجز طبيعي يحول من دون انتقال أوبئة كثيرة من الحيوانات إلى البشر، وعندما يتجاوز عنصر وبائي ذلك "الحاجز الطبيعي بين الأنواع"، تحدث الأوبئة.
في حال عائلة الإنفلونزا، طري في الذاكرة وجود مجموعة من الأوبئة التي حدثت بالترافق مع انتقال فيروسات الإنفلونزا إلى البشر، قادمة من الخزان الحيواني.
وفي الغالب، أطلقت على تلك الموجات أسماء الخزان الحيواني الذي أتت منه على غرار "إنفلونزا الطيور" التي تعني أن الطيور تعيش فيها فيروسات الإنفلونزا، وتصيبها بالمرض، لكن نوعاً منها حدث فيه تغيير في تركيبته أعطته القدرة على الانتقال من الطيور إلى البشر. وينطبق وصف مماثل إلى حد كبير، على "إنفلونزا الخنازير" و"سارس الإبل" و"إنفلونزا الدجاج" وغيرها.
تجربة الـ "مينك" تذكر بالكلاب!
استناداً إلى تلك الصورة، يرجح ألا يحسم أمر طبيعة التعايش المقبل مع فيروس كورونا بصورة تامة، إلا إذا حُسم أمر خزانها الحيواني، ويعني ذلك أن تقصي أصل الفيروس في الصين، سيعطي معلومات مهمة عن تلك المسألة. وفي المقابل، ربما لم يأتِ كورونا من مصدر حيواني أو لم يأت منه بصورة طبيعية، وثمة احتمال أنه تسرب من إحدى المختبرات الكبرى المتخصصة في الاشتغال العلمي على الفيروسات، على غرار "مختبر ووهان" مثلاً، لكن ليس حصراً، وهناك إمكان أن يكون التسرب حدث عبر أحد العاملين، أو ربما من حيوانات تستخدم في تجارب علمية.
في سياق الجائحة، تخلصت الدنمارك من حوالى 17 مليون حيوان "مينك" [يشبه الكلاب] وحظرت تربيتها حتى نهاية 2023. وكذلك ظهرت بحوث متناثرة ليست كثيرة العدد، عن إمكان أن تكون الكلاب أو القطط خزاناً للفيروس الذي تسبب بجائحة كورونا. ثمة ترسيمة متداولة عن انتقاله من خفافيش ميتة أكلتها كلاب مخالطة للبشر، سواء أكانت كلاباً شاردة أو مستأنسة.
واستطراداً، ربما لم يأت فيروس جائحة كورونا من الكلاب، لكن البشر قد ينقلونه إلى تلك الحيوانات التي تصبح لاحقاً خزاناً تخرج منه الفيروسات لتصيب البشر! ثمة حلقة من العدوى والانتقال ليس أمرها واضحاً حتى اللحظة، ويلفت أن موقع "منظمة الصحة العالمية" ينصح بمعاملة الكلب المنزلي على غرار معاملة بقية أفراد الأسرة، بمعنى إجراءات النظافة، وخصوصاً التباعد الاجتماعي. وعلى الرغم من بعض الصور الأنيقة، إلا أن طريقة الكلاب في التنفس لا تمكّن من اعتماد الكمامة وسيلة للوقاية في صفوفها، فيجدر التزام التباعد مع ذلك الحيوان المنزلي.
إذاً، هل يتبين أن أجساد البشر وحدها خزان مستمر لكورونا، على غرار ما تفعله مع الإنفلونزا الموسمية، أم يتبين أن الكلاب والقطط أو حيوانات أخرى، هي الخزان الفعلي لفيروس كورونا؟ لننتظر ولنرى.