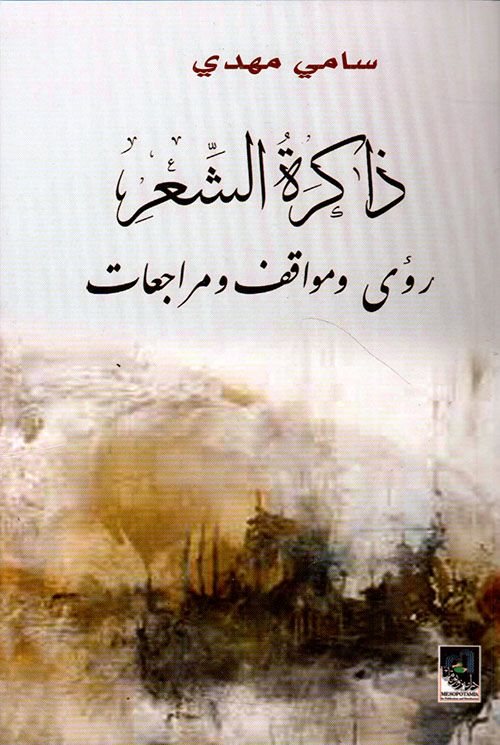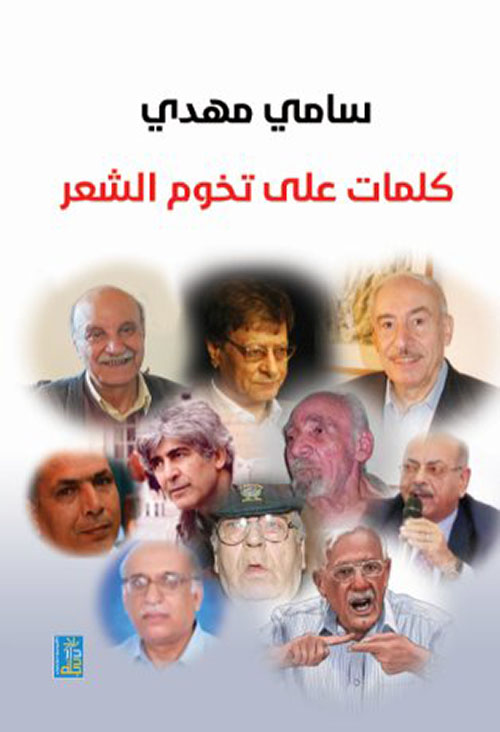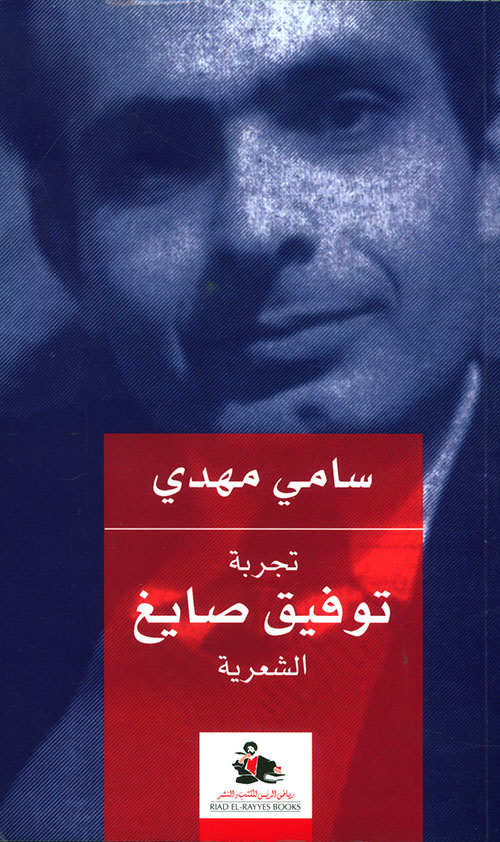لم يحظ رحيل سامي مهدي، على الرغم من مكانته الأدبية، باهتمام معظم الشعراء العراقيين، بل جنح البعض منهم إلى الحفر في ماضيه مذكراً بعلاقته بالنظام السابق، وعمد البعض الآخر إلى التهوين من شأن قصائده واعتبرها "تفتقر إلى الجذوة والروح"، ومضى فريق ثالث يستدرك على أعماله في النقد والترجمة.
قلة قليلة أشادت بتجربة الرجل وانعطفت عليها بالنظر والتحليل ودعت إلى الفصل بين شخصيته السياسية وشخصيته الأدبية، منوهة بأعمال الرجل في مختلف المجالات الأدبية، مشيدة على وجه الخصوص بتجربته الشعرية التي تتسم بالجدة والجرأة. لقد ظل سامي مهدي شاعراً مثيراً للجدل، لم يحظ، على أهمية تجربته، باحتفاء النقاد والأدباء العراقيين الذين ظلوا يخلطون، عن وعي عامد، بين أدواره السياسية ووظيفته الأدبية، كما ظلوا ينظرون إليه بريبة وتوجس.
هذه الريبة وذاك التوجس أفصح عنهما جان دمو، الشاعر العراقي المعروف، في أحد المرابد، حين تقدم من سامي مهدي، وهو في حال توتر وانفعال، ومضى يكيل له التهم تلو التهم أمام الشعراء العرب، مردداً ما كان يتداوله المثقفون العراقيون من اتهامات، غير مبال برجال الاستخبارات وقد أحاطوا به من كل الجهات، فيما ظل سامي مهدي ساكناً هادئاً، بل أمر رجال الأمن بإخلاء سبيل جان دمو، حين أرادوا طرده من الفندق وربما اعتقاله. هذا الموقف "المتوتر" من سامي مهدي استمر بعد موته، فنشر عدد من المثقفين العراقيين بعد رحيله نصوصاً تنتقد الرجل نقداً لاذعاً، وتؤاخذه على تورطه في السياسة ومساندته النظام السابق، مذكرين بقصائده الطويلة مثل "الصعود إلى سيحان"، في تمجيد الحرب الإيرانية العراقية، والاحتفاء بمعاركها الدامية.
الشاعر الستيني
كل هذه المواقف الانفعالية لا ينبغي أن تحجب عنا مكانة هذا الشاعر في مدونة الشعر العراقي الحديث، والدور الذي نهض به، مع عدد من الشعراء الستينيين، في تأسيس موجة "الحداثة الثانية" التي أرادت أن تتلافى نقائص الحداثة الأولى، وتتجاوز أسئلتها القديمة، عاقدة العزم على قتل الأب الرمزي، وهو جيل الحداثة الأولى، محولة هذا القتل إلى طاقة تفعيل لمبدأ الاستخلاف الشعري، على حد عبارة الناقد بن عيسى بوحمالة.
وقد قسم النقاد شعراء هذا الجيل إلى مجموعتين، مجموعة الداخل وهم الذين مكثوا داخل العراق مثل سامي مهدي وحميد سعيد وحسب الشيخ جعفر وعبدالرحمن طهمازي وعبدالأمير معلة وياسين طه حافظ. وأما المجموعة الثانية فأطلق عليها اسم "جيل الشتات" بعد أن غادر شعراؤها وطنهم، وتضم كلاً من فاضل العزاوي وسركون بولص وعبدالقادر الجنابي وفوزي كريم ومؤيد الراوي وسواهم.
كان هؤلاء على انتمائهم إلى اليسار، واصطفافهم وراء أيديولوجياته المختلفة، وحماستهم للأسئلة الاجتماعية والسياسية، مهمومين بتطوير خطابهم الشعري، تواقين إلى تجاوز طرائق التعبير القديمة، ومسترفدين المنجز الشعري الغربي، يمد نصوصهم بطاقات استعارية جديدة. استبد بهذا الجيل إحساس قوي بأن قصيدة الرواد جف ماؤها، وانطفأ بريقها، ولم تعد قادرة على قول اللحظة الراهنة بكل ما تنطوي عليه من إخفاقات وتطلعات. ومن هنا كان الإصرار على الإفادة منها ثم تجاوزها، على استيعابها ثم نسيانها .
ولعل أول ما أنجزه السستينيون القطع مع النزعة التفاؤلية التموزية الساذجة التي عبرت عنها الحداثة الأولى، والإقبال على صياغة رموز جديدة مفعمة بمعاني الشك والتساؤل والألم، مبتكرين لغة مختلفة، لا عهد للشعر الحديث بها من قبل، لغة تميل إلى السرد، وتستخدم تعدد الأصوات، وتقوم على التضاد والمفارقة. في هذا المناخ الأدبي والشعري ظهر سامي مهدي بقصائده القصيرة، ولغته الكثيفة، ورموزه الشفيفة، ومعجمه اليومي، لينحت لنفسه مكانة مخصوصة داخل هذا الجيل وليكون أحد رواد الحداثة في الستينيات مع حسب الشيخ جعفر ويوسف الصائغ وفاضل العزاوي.
مفهوم الشعر
عمد سامي مهدي خلال مباحثه ودراساته التي تأملت لغة القصيدة الحديثة وأساليبها إلى تعريف الشعر بطرائق شتى. وهذا التعريف لا يشرح طبيعة الشعر بقدر ما يكشف عن تصور سامي مهدي لفعل الكتابة، فالشعر عنده مزيج من الرؤية والحلم والذاكرة، وكتابة القصيدة مزيج من الوعي واللاوعي. وهذا التعريف، كما هو واضح، جمع بين تعريفات كبيرة أراد أن يصالح بينها: التعريف الرومانسي والسوريالي والرمزي، لكن سامي مهدي، وهو الرجل السياسي، استبعد كل التعريفات الأيديولوجية، ونأى بالشعر عن المقاصد السياسية. فالشعر خطاب فردي، يقول تجربة ذاتية، ويعول على ما اختزنته الذاكرة من مشاهد ومواقف. ثم يعرج على طريقة تخلق القصيدة عنده ومراحل نموها فيقول، "القصيدة تبدأ عندي بفكرة تلمع في الذهن مثل لمع البرق بفعل مشهد أو حادثة أشهدها أو تجربة أعيشها أو حكاية أسمعها أو قضية أفكر فيها أو قراءة أقرأها".
أقتنص من هذه الشهادة عبارات المشهد والحادثة والحكاية التي تعبر عن حقيقة القصيدة عند سامي مهدي، فقارئ قصائد هذا الشاعر لا بد أن تلفت انتباهه قدرة الشاعر المذهلة على "تسريد" الشعر أي على تحويله إلى خطاب سردي، مع كل ما ينطوي عليه هذا الخطاب السردي من مقومات مثل الحوار والشخصيات. سامي مهدي شاعر في ثوب حكاء أو حكاء في ثوب شاعر. كل قصائده تجمع بين صيرورة القص وكينونة الشعر. فهو، كالحكواتي القديم، يغني ويروي، ينشد ويسرد. وليس هذا بغريب عن شاعر شغف بـ"ألف ليلة وليلة"، وكتب عنها عملاً نقدياً يتأمل حكاياتها ويؤصلها في أديم الثقافة والتاريخ العراقيين.
بلاغة الوضوح
إذا كان أدونيس يخلع على نفسه في كثير من قصائده صفة "الغامض"، فإن سامي مهدي ما فتئ يصف نفسه بالواضح، مشيراً إلى تجنبه كل عبارة أو تركيب يعوقان القارئ عن التفاعل مع القصيدة. إن غاية سامي مهدي تتمثل في كتابة قصيدة جديدة تستند إلى شاعرية النثر وإيقاع الكلام اليومي. هذه الشاعرية تخرج من مكان غير معلوم حاملة معها تراكم التجارب الإنسانية وهي تتدافع في الحياة اليومية.
هذا الجنوح إلى الوضوح ربما ارتد إلى تأثره بشاعرين اثنين أولهما الشاعر الفرنسي جاك بريفير. فالشاعر العراقي قد ترجم عدداً كبيراً من قصائد هذا الشاعر وعبر عن إعجابه بالبساطة العميقة التي يتسم بها شعره. وأشاد باستخدامه لغة قريبة المأخذ، واضحة المقاصد، لغة تحول الخطاب اليومي إلى مصدر من مصادر شعرية النص، أي إلى مصدر إيحاء وتخييل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ثانيهما الشاعر الإنجليزي إليوت، وقد تأثر سامي مهدي بدعوته إلى استخدام "اللغة اليومية". وقد لا نعدو الصواب إذا قلنا إن الشاعر العراقي كان من أكثر الشعراء استجابة لخطاب إليوت الداعي إلى استلهام "لغة الحياة التي نستعملها ونسمعها". فهذا الشاعر قد انتهى بعد قراءة متأنية للشعر الإنجليزي إلى صياغة قانونه الذي ينص على "أن الشعر يجب ألا يبتعد ابتعاداً كبيراً عن اللغة العادية اليومية"، فإذا ابتعد عنها فقد تأثيره في النفوس والأرواح، هذا القانون نفسه ردده يوسف الخال ونحا به منحى آخر مختلفاً.
تحاشي الاستعارات
إن قصائد سامي مهدي تحاشت الاستعارات البعيدة والرموز الغامضة، وفرضت على المتقبل أن يحملها على ظاهرها، فلا يعدل بها عنه. فالألفاظ قريبة، والمعاني مكشوفة، والرموز، إذا جاز لنا أن نتحدث عن رموز، من اللوازم القريبة للكلمات. فالشاعر كان أشد اتكاء على العبارات المألوفة وأقل عناية بطاقات اللغة الاستعارية.
لكن القصيدة ليست في نظر سامي مهدي لغة فحسب، فهي رؤية وموقف أيضاً. في هذا السياق تحدث عن "كيمياء القصيدة"، ويعني بذلك تفاعل عناصرها تفاعلاً وظيفياً أشبه بتفاعل العناصر في مختبر كيماوي. والمعطى النهائي الناجم عن هذا التفاعل هو الذي يحدد شعرية القصيدة، هذا التفاعل يتجلى بوضوح في هذه القصيدة التي تختزل عديداً من قصائده: "إذا ما صغرت غداً/ فسأهرب من طيش أمي/ وتقوى أبي/ وسأغدو إلى حارة/ ليس فيها رجال كدودون/ أو نسوة كالرجال/ ولن أتعلم في أي مدرسة/ بل سأبحث عن لدة لم أغرر بها ذات يوم/ وعن لعبة فاتني الدور فيها/ فإن فاتني الدور ثانية/ فسأسرق كيس الملبس من بيت عمي/ وآكل حتى الملال/ وأنثر ما يتبقى على العابرين/ وأفزعهم. وسأضحك/ أضحك حتى أموت".
من يتمعن في هذه القصيدة يلحظ أنها تنطوي على جدلين اثنين: جدل داخلي خاص بها، وجدل خارجي مع الواقع الذي صدرت عنه. أما جدلها مع نفسها فيتمثل في الحوار الذي عقدته مع اللغة، التي تسعى باستمرار إلى تطويعها لتقول تجربتها. أما جدلها مع الواقع فيتمثل في الحوار الذي تعقده مع الأحداث، فتتشرب جوهرها العميق وتتخلى عما عداه. فالشعر، ليس تعبيراً عن حقائق الروح فحسب وإنما هو أيضاً تعبير عن حقائق التاريخ.