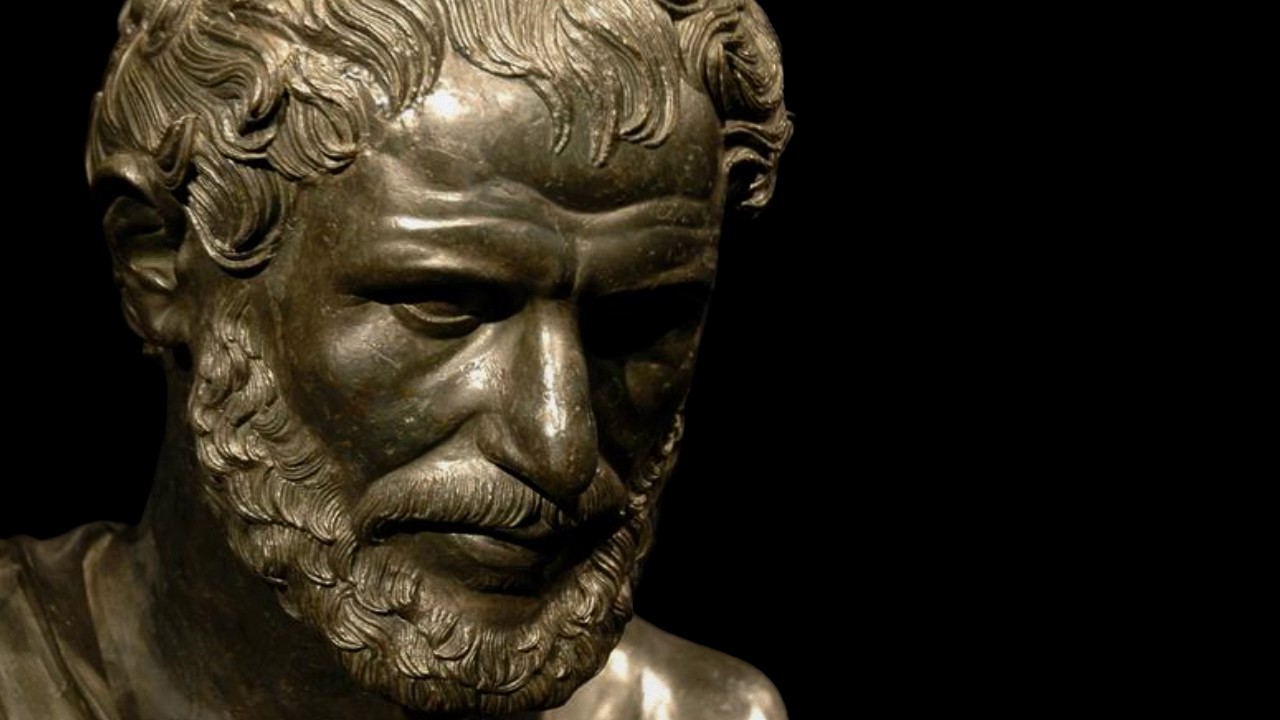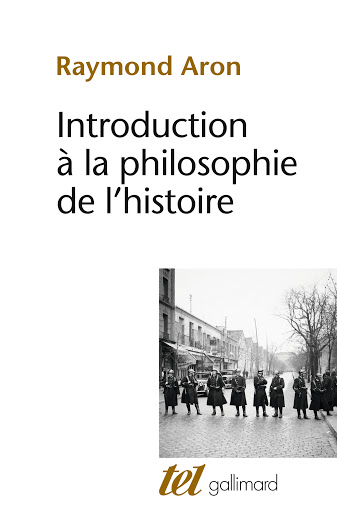يعاين بعض الناس التاريخ خاضعاً لمشيئة القدر، مسيراً بدواعي الزمان، مأسوراً بمفاعيل الدهر. أما بعضهم الآخر، فيتأمل في الدنيا مسجداً لعقلاء الفكر، ومهبطاً لإلهامات العقل، ومسرحاً لإبداعات النفس، حتى إذا ضرب المرء بطرفه حيث شاء من جوانب الحياة، أبصر تدبيراً كونياً ناشطاً، ومخططاً صالحاً، وغاية شريفة. وقد يظن بعضهم أيضاً أن الوجود الإنساني برمته أضحت تدب في جسده جراثيم الفساد والركاكة، وتسري في شرايينه أسباب التفكك والانحلال. لا بد للفلسفة، والتنازع في الآراء على أشده، من أن تستصفي من ذلك كله الحكمة الرشيدة وتخرج بالخلاصة الهادية، على قدر ما تستطيع إلى ذلك سبيلاً، في مراعاة الحدود الواقعية المضروبة على الحياة.
شهيرة هي المناظرة التي تواجه فيها الفيلسوف الفرنسي فولتير والأديب اللاهوتي الفرنسي بوسيه (Bossuet) في مسألة معنى التاريخ، إذ أعلن فولتير أن التفكر في التاريخ من مسؤولية الفيلسوف الذي لا ينتمي إلى أي مذهب ولا يناصر أي عقيدة. في بحث موجز عنوانه "فلسفة التاريخ" (1756)، يعلن أنه من واجب الفيلسوف أن يحلل التاريخ تحليلاً موضوعياً يستند فيه إلى الأسباب العلمية والدوافع الطبيعية التي تحرك الأحداث وتؤثر في مجرى العلاقات والمعاملات. وما لبث الفيلسوف واللاهوتي والأديب يوهان غوتفريد هردر (Herder) أن عرف فلسفة التاريخ بالاجتهاد الذي يبحث في مجرى الأحداث، ومخططات الحقبات المتعاقبة، وما يحتشد فيها من عوامل التغيير والتطور. لكل زمن منطقه وناموسه وحراكه. لذلك ينبغي أن ينظر المرء في خصوصية كل حقبة من الحقبات يستخرج منها مغزاها ومقصدها. في مطلق الأحوال، يعاين هردر في النشاطية التاريخية صناعة متدرجة تجعل الإنسانية تحقق قوامها ودعوتها، أي قابلياتها وماهيتها المنغلة فيها.
التصور التصاعدي
غير أن التاريخ ما برح يستعصي على تناولات الفكر وتحليلاته. تنطوي المناقشات الفلسفية التي تنظر في حركة التاريخ الإنساني على توجهات شتى، يمكن المرء أن يستخرج منها ثلاثة تصورات أساسية. يعاين التصور الأول في التاريخ مسرى من الأحداث والأفعال يتجه اتجاهاً تصاعدياً نحو غاية قصوى يختلف مضمونها باختلاف المذاهب التي تعتمدها. ينضوي إلى هذا التصور اجتهادان، ديني وفلسفي. في الاجتهاد الديني، يتصور المؤمنون غاية التاريخ في اكتمال المخطط الإلهي المرسوم منذ الأزل، في حين أن الاجتهاد الفلسفي المحض يرصد غاية التاريخ إما في اكتمال إنسانية الإنسان، على نحو ما كان يذهب إليه الفيلسوف الألماني كانط، وإما في تحقق الروح المطلق في تضاعيف الزمان، على غرار ما كان ينادي به الفيلسوف الألماني هيغل، وإما في تطور الوعي الإنساني وانتقاله من حال إلى أخرى، على منوال ما كان يعلنه الفيلسوف الفرنسي أوغست كونت (Comte).
يسمي كونت الحال البدائية الأولى الزمن اللاهوتي الذي يجعل الناس يفسرون ظواهر الحياة وأحداث التاريخ تفسيراً ميثولوجياً أسطورياً. أما الحال الثانية، فيدعوها الزمن الميتافيزيائي الماورائي الذي يمنح العقل القدرة على تجريد الوقائع الحسية تجريداً نظرياً محضاً. في الحال الثالثة، يعتلن الزمن الثالث، الزمن العلمي الوضعي الذي يؤهل العقل لتحليل الظواهر تحليلاً مستنداً إلى قوانين الطبيعة. إذا تناولنا مسألة الانعطاب الإنساني، تبين لنا، بحسب أوغست كونت، أن التفسير الميثولوجي الأسطوري ينسب الانعطاب إلى مشيئة الآلهة، والتفسير الميتافيزيائي الماورائي يعلله بمفهوم الانعطابية المجرد، في حين أن التفسير العلمي الوضعي يسوغه بالتركيبة الفيزيولوجية المرتبطة بأسباب الولادة والنمو والنشوء والترهل والانحلال والموت في الكائنات الطبيعية.
التصور التكراري
يتميز التصور الثاني بالدوران والعود والتكرار، ويرقى في نشأته إلى حضارات بلاد ما بين النهرين، لا سيما علماء بابل الذين كانوا يراقبون دورة المجرات والكواكب والنجوم، ويترصدون أزمنة ظهورها واختفائها، ويستخرجون الخلاصات والحكم من تعاقب الظواهر الفلكية واقتران التعاقب السماوي بتعاقب الأحداث الأرضي. فإذا بهم يصوغون فكرة العود الأبدي يفسرون بها رجوع الظواهر المنتظم المتكرر. سار الإغريق في إثرهم، فاستخدموا مفهوم "تجدد الولادة" (palingénésie). تأييداً لهذا التصور، انبرى الفيلسوف الإغريقي هيراقليطوس ينسب إلى النار القدرة على صهر الكون كله في أتونها، وإعادة تكوينه على صورة مثاله الأول. إذا كان الكون كله مفطوراً على التناقض والتعارض والتجابه، فإن انسجام الوجود ينشأ من توازن الإفناء والإبداع على تراخي الزمان. لا شك في أن جوهر العناصر لا يتغير، في حين أن الأحوال والعوارض تتبدل على إيقاع الاحتدام الكوني. جرى الفلاسفة الرواقيون على هذا المنهاج، فاعتبر زينون على سبيل المثال أن النفوس حين تخرج من الأبدان تحيا لفترة وجيزة، ولا تلبث أن تنصهر في أتون الولادة لتنبعث في هيئة جديدة وحلة صافية، متوثبة لاختبار ناموس التعاقب الزمني المحتوم.
لا عجب، من ثم، أن يطرب فيلسوف رهيف الإحساس كنيتشه للابتداع الفكري هذا، فيعمد إلى مناصرته وتسويغه، معلناً أن الإنسان، حين ينقضي أجله، ينصهر في كتلة الكون الرحيب التي تستولد من رحمها المضطرم عوالم جديدة تعيد بعضاً من الحياة إلى الكائنات الإنسانية الفانية المنغلة فيها. لذلك ينسب نيتشه إلى زرادشت حكمة العود الأبدي: "سأعود صحبة هذه الشمس وهذه الأرض، وهذا النسر وهذه الحية، لا من أجل حياة جديدة، أو حياة أفضل، أو حياة مشابهة؛ سأعود أبداً من أجل هذه الحياة المطابقة عينها، متجلياً في الأكبر وفي الأصغر، حتى أرشد من جديد إلى عود الأشياء كلها عوداً أبدياً" (نيتشه، "هكذا تكلم زرادشت").
التصور التعرجي
أما التصور الثالث، فيشبه الحركية التي يرسمها الإهليلج في تعرجاته والتواءاته وتمايلاته. قد تكون الفلسفات الشرقية الأقرب إلى تصور التاريخ على هذه الهيئة. ذلك بأن الفلسفة الهندوسية، على سبيل المثال، لا تعترف بمركزية مطلقة في مسرى التاريخ، ولا تبني الأحداث على منطق عقلاني متدرج يصعد بالإنسان نحو خاتمة ظافرة. جل ما في الأمر أن الإنسان ينتقل من عبودية إلى أخرى، ومن انعتاق إلى آخر، حتى يفوز ببعض من السلام الداخلي والطمأنينة النفسية، وذلك من بعد أن يجول جولات اختبارية شتى في الوجود. من تكاثر تجليات الألوهية في التاريخ ينبثق اضطرام جدلي يمنح الإنسان القدرة على تجاوز آلام الاضطرابات الحياتية التي تنهكه جسدياً ونفسياً وروحياً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إلى هذا المذهب ينتمي الفيلسوف الألماني شوبنهاور الذي يرفض تصورات هيغل ومناوراته في استنقاذ منطق التاريخ العقلاني. حين يعلن هيغل أن تناقضات الوجود تشبه حيل العقل الذي يسعى إلى غايته القصوى، مستعيناً بالتواءات المسلك الإنساني وكوارث المشهد الطبيعي، يبتسم شوبنهاور ابتسامة ساخرة وينعت هذه الاجتهادات بالتضليل الخطير. فالفلسفات العقلانية، وفي مقدمتها فلسفة المطلق الهيغلية، تفرض على مسرى الأحداث التاريخية قوانين وقواعد وأحكاماً منطقية صارمة، في حين أن الوجود الإنساني لا يشبه، بحسب شوبنهاور، أي نموذج عقلاني على الإطلاق. الحياة كلها نسيج غريب عجيب من المصادفات العبثية، والموافقات الاعتباطية، والتواترات التعسفية. لذلك كانت العبثية العنوان الأمثل والأنسب في استجلاء لغز الوجود.
ما من معنى لصيق بانبساط الحياة في تضاعيف التاريخ. أما التاريخ عينه، فيخبط خبط عشواء، منتقلاً من طور إلى آخر، متوثباً على غير هدىً، محتدماً في غير مغزىً.
البحث عن الحكمة الناظمة
لا ريب في أن التصورات الثلاثة هذه تختصر معظم الاجتهادات الفلسفية التي تروم أن تستجلي طبيعة التاريخ، وتستبطن معناه، وتستطلع وجهته. بين التصور التقدمي التطوري التوقلي الموجه الذي تنادي به الأديان التوحيدية وبعض الفلسفات الروحية العقلانية، والتصور الدوراني التعاقبي التكراري التماثلي الذي نشأ في حضن الفلسفة الإغريقية واعتمده غير فيلسوف من فلاسفة الحكمة العبثية، والتصور الإهليلجي الالتفافي الالتوائي الترددي الذي ترتاح إليه الفلسفات الشرقية، وجوه من التقارب والتباعد شتى. غير أن الثابت فيها كلها عزمها على تعليل النشاطية الإنسانية والحيوية العقلية في معترك الحراك التاريخي. لذلك انبرى بعضهم يعيبون على هذه التصورات إصرارها المستميت على استخراج الخيط الناظم أو الناموس الحاكم، ولو اتشح بوشاح العبثية الفارغة.
في كتاب الفيلسوف الألماني أودو ماركار (Odo Marquard) "صعوبات مع فلسفة التاريخ" (Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie)، تظهر النزعة التأويلية التشكيكية التي ترفض أن ينطوي التاريخ على معقولية ذاتية. ينبغي للناس أن يكفوا عن تسويغ مجرى الأحداث تسويغاً منطقياً، إذ إن فلسفة التاريخ، على حد تعبيره، سم زعاف ينبغي للفكر أن يبعده عن وعي الإنسان المعاصر.
عوضاً عن افتراض وحدة قصدية ثابتة في صميم الوجود الإنساني، ينبغي بالأحرى الانصراف إلى اختبار جمالات الحياة اختباراً حراً عفوياً طبيعياً خلاقاً. سواء كنا في زمن الحداثة أو دخلنا زمن ما بعد الحداثة، فإن وجودنا التاريخي لا يحمل في مطاويه قانوناً شاملاً قاهراً. وليس فينا الطاقة التي تؤهلنا لضم شتيت الاختبارات التاريخية كلها وصهرها في تصور تفسيري واحد محكم متماسك. حري بنا، والحال هذه، أن نعود إلى رعاية أنثروبولوجيا الهناء الوجودي في نطاق المحدودية التاريخية التي جبلنا عليها. أما أفضل السبل إلى ذلك، فإتقان الطب الوجودي الأشمل، ورعاية الطبيعة التي منها تستل كل إلهامات الفنون الإبداعية.