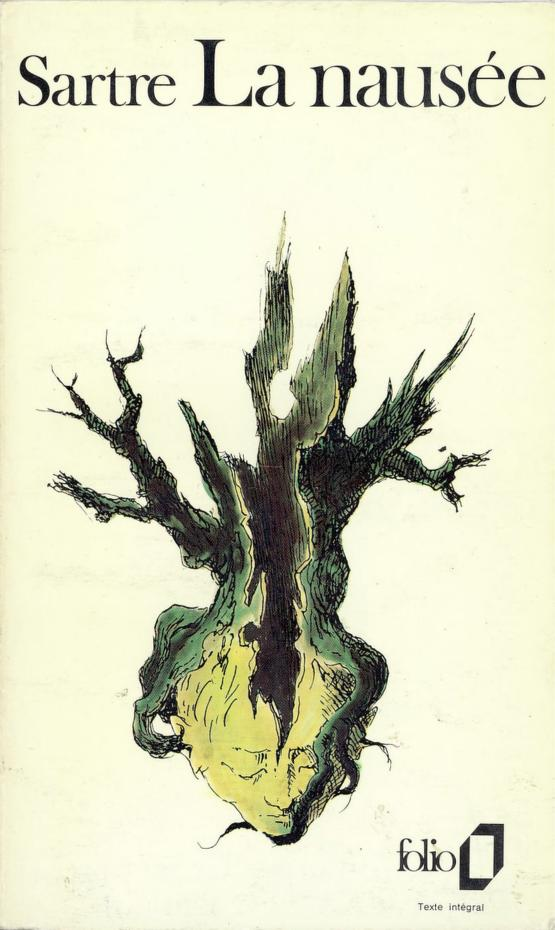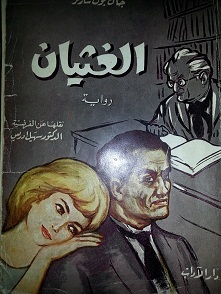كيف نقرأ اليوم، رواية جان بول سارتر "الغثيان" في زمن الكورونا وما نجم عنه من أحوال اضطراب وقلق وخوف بل و"غثيان" في المعنى الفيزيقي والنفساني؟ ألا تختلف قراءتها في هذه اللحظة التاريخية الحرجة التي تعتريها خيبة "كونية"، عن قراءتها في السنوات السابقة التي أعقبت صعود موجات فكرية وفلسفية ومنها وجودية سارتر؟ لو أن بطل "الغثيان" أنطوان روكانتان، يعي في مستهل الرواية أن وباء غامضاً يضرب العالم ويوقع ملايين الضحايا بلا رحمة، فهل كان ليصاب بـ"الغثيان" نفسه؟ هل يكون كورونا مماثلاً لما شعر به البطل في الرواية، عندما أدرك أن أمراً يحدث خارج المألوف، فيواجهه من دون أن يتمكن من تبيانه، ثم يدرك أنه يقع خارج ذاته بل في العالم، فيقرر مواجهة هذا العالم. لنتصور روكانتان واضعاً الكمامة على فمه، وعازلاً نفسه داخل المكتبة التي يداوم فيها، يراقب العالم ويتساءل حول معناه أو جدواه، قائلاً كما في الرواية": إنني أعيش وحيداً، وحيداً كل الوحدة، إنني لا أتحدث مع أحد".
طبعاً لا تمكن المقارنة بين أزمة الوجودية الفلسفية التي عاشها بطل سارتر والأزمة "الوجودية" الكونية التي سببها مرض كورونا، ودفع المفكرين والعلماء والمثقفين إلى إعادة النظر في معطيات العصر ورهاناته المتعددة. شاء سارتر أن يجعل من روكانتان الناطق الأول بـ"البيان" الوجودي قبل أن يمنهجه فلسفياً ونظرياً، فكان بطله في آن واحد، من لحم ودم ومن أفكار ومفاهيم، يروي ما يشبه السيرة الذاتية ويضمر معالم فلسفة هي في أول بزوغها. بل عاش البطل تجربته الوجودية بصفتها إدراكاً حسياً ورؤية ميتافيزيقية في وقت واحد. ولعل معاناته الفراغ الداخلي ولا جدوى الحياة والقلق، تختلف عن المعاناة التي سببها كورونا بصفته "قلق الحضارة" (بالإذن من فرويد) الحديثة، فكرياً وعلمياً وطبياً وبيئياً... سعى روكانتان إلى التبشير بأفكار سارتر الأولى ومنها مثلاً: الوجود يسبق الماهية، الإنسان موجود أولاً، الإنسان يخلق نفسه بنفسه، الإنسان موجود لذاته وسواها.
عندما بلغني خبر صدور ترجمة عربية جديدة لرواية سارتر "الغثيان" في القاهرة عن هيئة قصور الثقافة، أنجزها فتحي العشري تخيلت على الفور حقبة صعود تيار الوجودية السارترية، وبلوغ هذا التيار العالم العربي في الستينيات وكيف كانت بيروت سباقة في ترجمة كتب سارتر أو نشرها. وكانت دار الآداب لصاحبها الروائي سهيل إدريس هي موئل الوجودية السارترية العربية، فترجمت معظم كتبه النظرية والإبداعية وقدمته إلى القارئ العربي، وكان الفيلسوف المصري عبد الرحمن البدوي هو الذي ترجم الكتاب السارتري التأسيسي "الوجود والعدم"، وتصدى إدريس لرواياته وقصصه ومنها "الغثيان". لكن موقف سارتر من الصراع العربي – الإسرائيلي وانحيازه إلى إسرائيل ودعمه لها أحدث خيبة كبيرة في وجدان السارتريين والمثقفين والقراء العرب. وهذه قضية تحتاج الى مقال منفرد.
مقاربة جديدة
كان لا بد من أن تصدر ترجمة جديدة لـ"الغثيان" بعد الترجمة الوحيدة التي أنجزها إدريس وصدرت مطلع الستينيات (لم أجد ترجمة أخرى بحسب الإنترنت وبعض المراجع). فالكتاب يحتاج إلى أن تعاد ترجمته بعد مرور سنوات بل عقود على ترجمته الأولى، وهذه قاعدة متعارف عليها، فلا يظل وقفاً على ترجمة واحدة مر عليها زمن. وقد يكون ممكناً أيضاً القيام بمقارنة بين الترجمتين انطلاقاً من النص الأصلي، مساهمة في ترسيخ الترجمة بوصفها اقتراحاً ومقاربة غير نهائية. لم أستطع الاطلاع على الترجمة الجديدة التي أنجزها فتحي العشري ولم أقرأ من ترجمة إدريس المتقنة لغوياً سوى مقاطع، وأعتقد أن من يقرأ النص الأصل بالفرنسية لا يمكن إلأ ان يفتتن برواية سارتر ولغتها العذبة والبسيطة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تظل رواية "الغثيان" حدثاً بارزاً في تاريخ الأدب الفرنسي والعالمي وفي الحركة الروائية المعاصرة. واللافت في هذه الرواية قدرتها على فرض سحرها على الأجيال التي تقرأها تباعاً وكأنها تكتشفها من جديد، بل كأن كل جيل يكتشفها على طريقته. ومع أن بعض النقاد والفلاسفة سعوا إلى نعي ظاهرة سارتر معتبرين أنها انطوت في انطواء القرن العشرين ودخلت متحف التاريخ، لكن قراء سارتر الروائي خصوصاً، لا يجدون أنفسهم معنيين بما دار ويدور من نقاش وسجال حول سارتر الفيلسوف أو المفكر السياسي أو الكاتب المناضل والملتزم الذي لم تخل مواقفه من التناقض في أحيان كثيرة. وروايتان مثل "الغثيان" و"كلمات" ما برحتا تصدران باستمرار في طبعات الجيب، نظراً لرواجهما الشعبي.
ليست "الغثيان" رواية فلسفية صرفة ولا رواية في المعنى التقليدي والمتعارف عليه للفن الروائي. إنها يوميات كتبها البطل نفسه روكانتان فيما كان يفترض أنه مكب على كتابة سيرة المركيز رولبون الأرستقراطي الفرنسي الذي عاش في نهاية القرن الثامن عشر. وخلال إقامته في المدينة البحرية المتخيلة، منصرفاً إلى الكتابة عن هذا الأرستقراطي، يكتشف هباء ما يقوم به. وكان روكانتان سافر فترة وخاض بعض المغامرات لينتهي وحيداً وغريباً في هذه المدينة بلا عائلة ولا أصدقاء ولا امرأة. وفي غمرة الملل العميق يشعر أن "وجوده" يفترسه ويوقعه في شركه ويحل به كمرض بطيء.
كان سارتر في الثالثة والثلاثين حين أصدر روايته الأولى تلك وغدا بطله أكبر منه آنذاك بما يقارب العامين. فالكاتب الذي انصرف إلى تدوين يومياته كان في الخامسة والثلاثين لكنه كان يحيا هذه السنوات كما لو أنها مرحلة الشيخوخة: لقد انتهى كل شيء أمام عينيه. حتى الحياة نفسها انتهت، الصداقة، الحب، المثل... كل هذه القضايا لم تستطع أن تنقذه من عزلته ومن وجوده الخاوي، ومن السأم العميق الذي حل به. وكان يظن أن ما أصابه هو الجنون، لا سيما حين راحت تخالجه حالة "الغثيان" في المقهى أو في الحديقة، كأن يقول: "ثم راح الغثيان يحاصرني، تهالكت على مقعد، لم أعد أعرف مكان وجودي، راي الألوان تدور حولي ببطء، أردت أن أتقيأ". قد تظهر في مثل هذا المونولوغ ملامح من كافكا أو يونسكو وسواهما من العبثيين، الذين سبقوا سارتر أوجاؤوا من بعده.
العالم يتغير
لا تحمل أولى يوميات البطل روكانتان تاريخاً، وفيها يؤكد أن الأشياء من حوله تغيرت وأضحت تثير فيه حالاً من التقزز والاستلاب. وسرعان ما يسعى خلال اليوميات إلى أن يوضح طبيعة هذا التغير الذي يشعر شعور اليقين، أنه حصل في ذاته. وكذلك إلى معرفة كيف حصل له ذلك التغير. ويروح يؤدي دور من يراقب كل ما من حوله: الأشياء والناس على السواء. أما عالمه فيمكن اختصاره في جغرافية واقعية ضئيلة: المكتبة، المقهى، الحديقة العامة... أما الأشخاص الذين صنعوا حياته فقلة قليلة: عشيقة عابرة، حبيبة لم يستطع أن يرجع إليها وأن يستعيدا معاً حياتهما الماضية، صديق هو عبارة عن قارئ نهم في المكتبة ظل يشك في صداقته.
ليس من المستهجن أن يكون روكانتان شخصاً وحيداً كل الوحدة. فالوحدة هي التي دفعته إلى اكتشاف وجوده العدمي واللامجدي. وقد شاءه سارتر نموذجاً للكائن الذي يعيش في العدم بعدما فقد إيمانه أو عقيدته وأضحى لا عائلة له ولا حياة ولا هدف... أما الغثيان الذي كان ينتابه حيناً تلو آخر فلم يكن يوقفه سوى الموسيقى. الموسيقى نعم ولكن كفعل إبداعي يمثل مأساة التناقض بين الواقع والمطلق! فالموسيقى "لا توجد" على غرار بقية الأشياء ذلك لأنها حضور "المتخيل" في العالم، تماماً كالكتابة.
لم تكد تصدر رواية 'الغثيان" في عام 1938 حتى استحالت حدثاً أدبياً وربما فلسفياً. حينذاك لم يكن سارتر أصدر كتابه الشهير "الوجود والعدم" الذي كان بمثابة بيانه الفلسفي الطويل والعميق. والصدمة التي أحدثتها لم تكمن في ما حملت من نزعة ميتافيزيقية وإنما في ثورتها على الشكل الروائي والبنية الروائية. فهي تكاد تكون نموذجاً لما يسمى "اللارواية". إلا أن تجربة سارتر ظلت شبه يتيمة سواء في هدمها الفن الروائي أم في جعلها التأمل الفلسفي مادة سردية أو خلفية روائية. وقد بدت "الغثيان" خلواً من الأحداث والشخصيات أو شبه خالية منها. فلا شيء يحدث في الرواية تقريباً. وربما الأحداث الوحيدة تتمثل في انكفاء روكانتان عن كتابة سيرة الأرستقراطي الفرنسي أو هجره المدينة أو فشله في إحياء حبه القديم وفي ترسيخ علاقته العاطفية العابرة. الأحداث هنا سلبية بامتياز. والطابع السلبي هذا يخلع عنها مواصفات الأحداث. لكن البطل (السلبي بدوره) سوف ينجز أمراً عظيماً: لقد أدرك ما هو الوجود، بل أدرك "وجوداً" يفوق الوصف ويتخطى كل ما يمكن أن يقال فيه. إنه الوجود الذي ينبثق "هنا" من دون سبب، كالمعجزة تماماً. لكن روكانتان لم يكتشف هذا "الوجود" إلا عبر التجارب المريرة التي خاضها: تجربة الوحدة، تجربة الغثيان، تجربة التأمل في وجهه أمام المرآة، أو التأمل في يده الملقاة على الطاولة... ولعل هذه التجارب أو الاختبارات هي التي "كشفت" الوجود كزمن حاضر، كزمن يحتاج الكائن أن يعيه. فالشيء لا يوجد إلا تحت نظر الكائن. يقول روكانتان: "الأشياء كلها هي تلك التي تظهر إذ أن لا شيء وراءها". وقد تلخص هذه الجملة معالم فلسفة وسمت مرحلة من القرن العشرين.