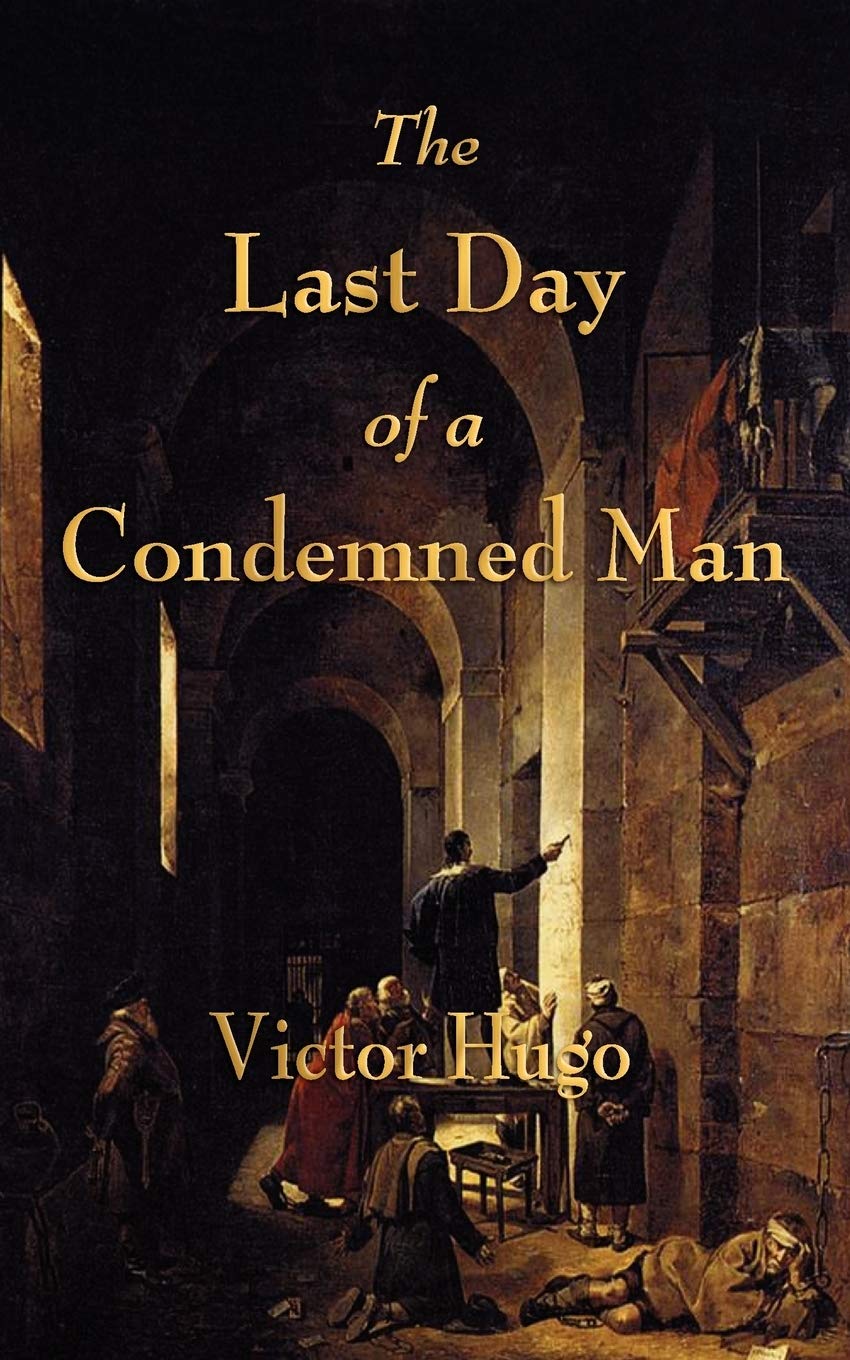تبدأ الحكاية في ساحة وسط العاصمة الفرنسية تدعى "ساحة الإضراب" ذات يوم من بدايات الربع الثاني من القرن التاسع عشر. في تلك الساحة، كان يعبر كاتب يتأمل ما حوله بنوع من الحياد حين لفت نظره جلاد مكبّ على صقل وتلميع المقصلة القائمة في المكان، بجد ولا مبالاة. أثار المشهد رعب الكاتب الشاب إذ أدرك أن الجلاد يحضر مقصلته لإعدام محكوم في ذلك اليوم بالذات كما جرت العادة. فمنذ زمن طويل، كانت الساحة بمقصلتها وجلادها يفعلان ذلك بشكل يومي تقريباً. ومن الرعب إلى الحماسة، فإلى الريشة والورق منذ مساء ذلك اليوم لينجز الكاتب خلال أيام قليلة واحداً من نصوصه الأكثر دلالة في مضمار التعاطي مع الشؤون الاجتماعية والقضائية. عنون الكاتب نصه "آخر يوم في حياة محكوم"، لكنه حين نشره آثر ألا يحمّله توقيعه، كما آثر بالطبع ألا يكون للمحكوم الذي تابع النص يومه الأخير في هذه الحياة الدنيا لا اسم ولا هوية بل حتى جعل جرمه الذي أعدم من أجله خفيّاً. لقد أراد التعبير عن نوع من التعميم رآه جديراً بالمناسبة. لكن ذلك سيكون موضوع النقد الواسع الذي جابه النص عند صدوره في طبعته الأولى.
من الفن إلى الواقع
كان الكاتب فيكتور هوغو، وهو أصدر الكتاب في الشهر ذاته الذي أصدر فيه واحداً من أكثر كتبه التزاماً بمبدأ "الفن للفن" أي ديوان "الشرقيات"، ما شكّل حين "انكشف" اسم مؤلف "آخر يوم..." تناقضاً لافتاً بين نص يعبّر عن نقاء الفن وآخر يعبّر عن "التزام المبدع" في وقت واحد تقريباً. ولكن بمقدار ما أُثني على "الشرقيات" يومها، كان الشجب من نصيب الكتاب الملتزم إلى درجة أن وصفه أحد النقاد بأنه "300 صفحة من نكد لا طائل من ورائه" حتى إن كان كتّاب كبار من طينة سانت بوف وألفريد دي فينيي قد احتفلوا بالكتاب حتى قبل أن يعرفوا من هو كاتبه، وحتى إن كان مبدعون ومفكرون كبار آخرون قد تبنّوا قضيته تماماً. مهما يكُن، منذ الطبعة الثانية التي صدرت بعد أشهر عُرف اسم الكاتب الذي سيعود منذ الطبعة الثالثة بعد سنتين أو أكثر قليلاً (1832) ليكتب مقدمة جديدة صاخبة أعلن فيها أبوّته للكتاب صراحة، بل رسم صورة قلمية لئيمة ساخرة لحوارات تدور في أوساط المثقفين البورجوازيين الباريسيين تتناول كتابه. وهكذا بات ثمة في الحياة الثقافية الفرنسية حينها ما يمكن اعتباره "قضية جديدة من قضايا فيكتور هوغو" في انطلاقة لنضالات اجتماعية تلامس الشؤون القضائية لن تتوقف حتى تبدّلت الأوضاع في فرنسا بعد ذلك بقرن وأكثر!
رواية أم نص وثائقي؟
ولكن يبقى هنا السؤال الفني حول ما إذا كنّا أمام هذا الكتاب في حضرة رواية أو في حضرة بيان سياسي – اجتماعي؟ إذ حتى لو كان هوغو حسم الأمر وحدد أن نصه نص روائي، فإن كثراً اعتبروه بياناً وأنكروا عليه البعد الروائي. لكننا إذ نقرأ نحن اليوم هذا الكتاب على ضوء التطور الذي طرأ على فن الرواية في أزمنتنا الحديثة على أيدي كتّاب من طينة جون دوس باسوس ونورمان ميللر وترومان كابوتي ومن سار على خطاهم بحيث باتت الحدود معدومة تقريباً بين ما هو توثيقي وما هو تخييلي، سنجدنا بكل بساطة نصنف الكتاب رواية إنما رواية ذات قضية. ففي نهاية الأمر، من الواضح أن بطل هذا "اليوم الأخير..." الذي يروي حكايته بنفسه بلغة مريعة وأسلوب مرعب متعمقاً في تفاصيل كل دقيقة من دقائق ذلك اليوم، مطلاً بين الحين والآخر على ماضيه، متوقفاً عبوراً عند عائلته (أمه وزوجته تحديداً)، هذا البطل شخص تصوّره الكاتب في خياله غير مستند إلى محكوم عرفه حقاً كما حال محكومي ميللر أو كابوتي. ومن هنا، نجد هذا الذي يروي لنا حكايته غير مهتم بأن يقول لنا شيئاً عن الجرم الذي اقترفه وسيعدم بسببه. كل ما في الأمر أنه يقرّ بذنب ما يستحق عليه الإعدام، لكنه يفيدنا بأنه يأمل حتى لحظاته الأخيرة في عفو ملكي يبدّل إعدامه بسجن مؤبد ولو مع الأشغال الشاقة.
... والجمهور يهلل صاخباً
بيد أن ذلك العفو لن يأتي وها هو الكاتب يصف لنا، وبالتأكيد على لسان صاحب العلاقة لحظة الإعدام، لينتقل منها إلى وصف مرعب بدوره للجماهير التي أحاطت تلك اللحظة بالمقصلة وانطلقت تهلل صاخبة حين انقضّ سكين هذه الأخيرة على رقبة المحكوم، تهليلاً يصوره هوغو همجياً لا يليق بأي شعب متحضر، مستخلصاً بأن هؤلاء إنما "يرتكبون بتواطئهم نفس ما ارتكبه المحكوم في حق من كانوا ضحيته". فما الفرق إذاً بين المجرم وهذا الجمهور الذي يصفق لإعدامه؟ يتساءل الكاتب في النص ولكن أيضاً في تقديم الطبعة الثالثة التي ينظر نقاد كثر إليها باعتبارها لا تقل أهمية عن النص بعينه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
حوارات الصالون البائسة
ولعل من الملائم هنا أن نتوقف بعض الشيء عند تلك المقدمة التي اعتبرها هوغو نفسه وفي معرض تخيّله للسجالات الصالونية التي دارت من حول "روايته" وكتبها إلى حد ما على شكل مسرحية حوارية، اعتبرها "كوميديا بصدد تراجيديا"، واصفاً فيها ما تصوره من أحاديث تدور حوله في غيابه بلغة كاريكاتيرية ساخرة لئيمة، ما ينضح بقدر كبير من الهجوم العدواني ضد ذلك المجتمع "الصائب سياسياً" – ونستخدم هنا بالطبع تعبيراً حديثاً، لكن هوغو استخدمه ولو بشكل غير حرفي – المجتمع الذي وصفه بكونه محافظاً متحذلقاً عديم الأحاسيس. ومن المؤكد أن هذا التوصيف، إذ أتى بقلم كاتب كان لا يزال حينها في الثلاثين أو أكثر قليلاً من عمره، شكّل إرهاصاً بالمشاكسة التي سوف تكون عليها حياة هذا الكاتب وكتاباته في العقود الطويلة المقبلة. بل حتى مهّد لانشقاقاته الصاخبة التالية التي نعرف أنها سوف تقوده بعد نحو 20 عاماً من كتابته تلك المقدمة إلى سلوك درب المنفى. ومن المؤكد أن ذلك كله سيكون هو ما جعل منه لاحقاً الكاتب المفضل لدى الفرنسيين لما لا يقل عن قرن ونصف القرن من السنين وحتى اليوم. بل جعل متحف غريفين للشمع في الجادات الكبرى وسط العاصمة الفرنسية وفي معرض الاحتفال بنهاية القرن العشرين قبل عقدين ونيّف من الآن، يختار تمثاله هو بالذات ليحرّكه وينطقه بذلك الخطاب التقدمي البديع الذي يتحدث فيه عن مجيء الأزمان الجديدة، أزماناً إنسانية مؤكدة.
لو يعود من قبره
وطبعاً نعرف أن فيكتور هوغو لو عاد اليوم من قبره، سيفضّل أن يعود إليه وهو يشاهد الإنسانية تُنحر يومياً في حروب تعبّر عن عودة العصور الشيطانية، بل عن وضعيات جديدة تحيّر المراقب المحايد حين يجد نفسه أمام جرائم يرتكبها إرهابيون ومغتصبون وقاتلو أطفال، ويتوجب عليه أن يقرر بينه وبين نفسه ما الحل؟. وبقي أن نذكّر هنا بأن فيكتور هوغو عاش بين ولادته في بيزانسون الفرنسية عام 1802 ورحيله عام 1885 حياة صاخبة متقلبة، لكن محورها الأساسي هو ذلك الإبداع الذي رافق حياته ومنذ شبابه المبكر إبداعاً طاول مختلف أنواع الفنون من كتابة الروايات والمسرحيات إلى الأشعار والدراسات، مروراً بممارسة الرسم في لوحات لا تزال في حاجة إلى أن تُكتشف وتكتشف قوتها التجديدية في كل مرة من جديد. لكنه في المقابل، عاش حياة من شعاراتها الجنون الذي أحاط بكثر من أفراد عائلته المقربة وبالموت الذي كثيراً ما زاره وحرمه من أحبائه، وبالخيبات السياسية والاجتماعية التي أخفقت على أية حال في تدميره، تماماً كما أخفقت في ذلك مآسيه العائلية التي كان يجابهها باندفاع نحو الحياة والإبداع، بل حتى نحو مواصلة علاقات غرامية وإنسانية ونحو خوض نضالات لا تتوقف، كانت هي الأخرى عماداً لحياته المدهشة.