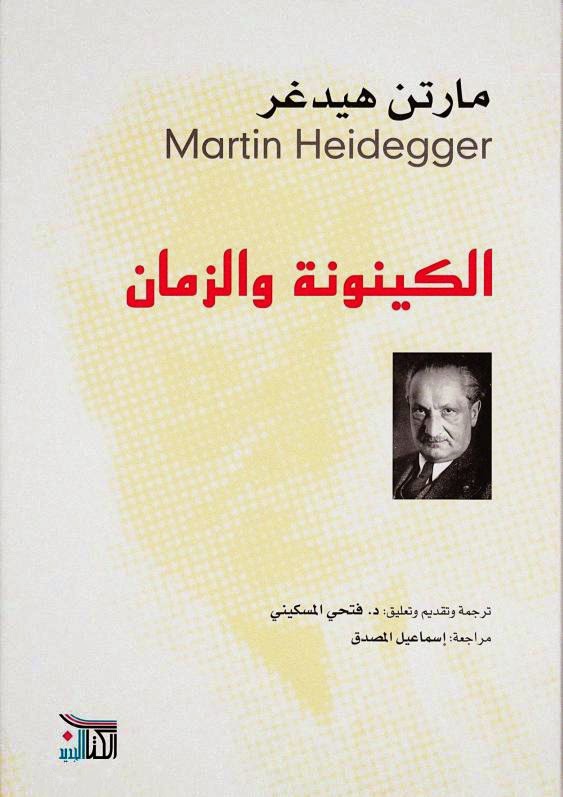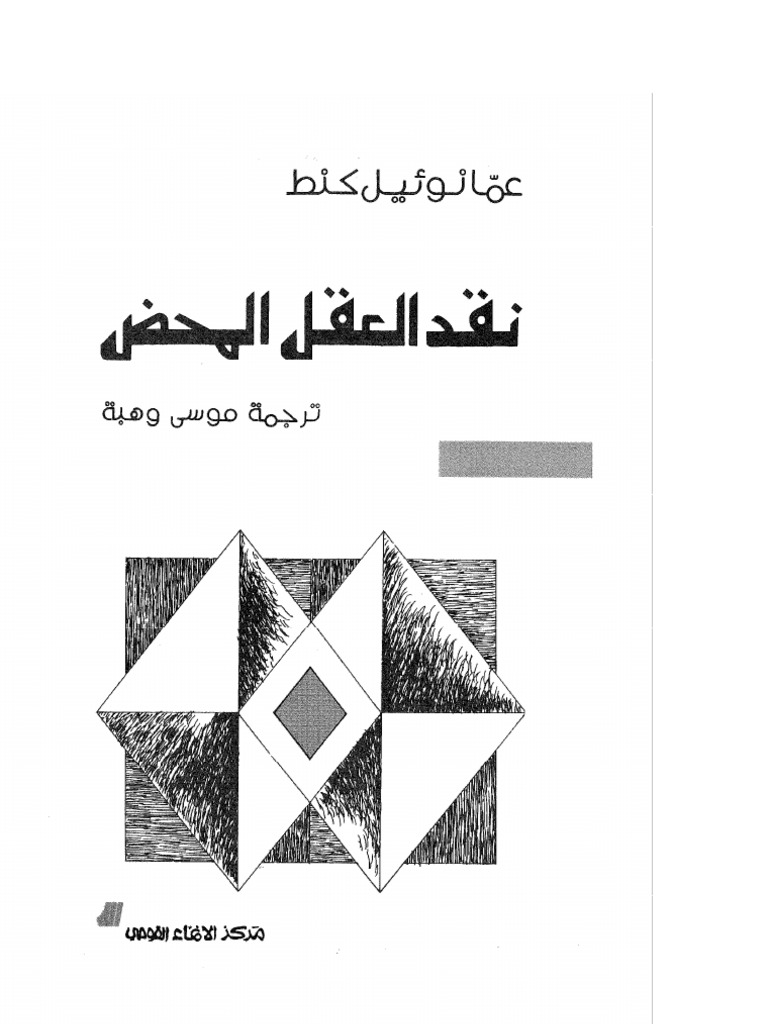لا يخفى على أحد أن الترجمة من أعسر الصناعات وأضناها وأعقدها وأعوصها. يجمع العارفون على القول بأن الترجمة تعاني أقصى إرباكاتها هذه في حقلين من الحقول الثقافية: الشعر والفلسفة. الشعر حقل عصي على الترجمة لأسباب شتى، أبرزها أن الشاعر ينتهر اللغة انتهاراً، ويعنف الكلمات تعنيفاً إبداعياً حتى تبوح بمكنوناتها المنحجبة، فيفجر في الكلمات قابليات من التعبير لم يألفها المرء من قبل، مستلا منها أقصى وعودها التعبيرية الكامنة فيها، لذلك يعسر نقل مثل هذه القابليات نقلاً أميناً سلساً بليغاً، أما الفلسفة فتغرق في انتزاع الموجودات من بيئتها المحسوسة، فتجردها من ارتباطاتها المطمئنة بالواقع المنظور، وتغور بها في أعماق التحليل والتنقيب والتمحيص.
من المعلوم أن الترجمة تنجح حين يوفق المترجم في نقل المضمون الفكري نقلاً أميناً من غير أن يشوه عبقرية اللغة القابلة، غير أن المضامين غالباً ما تلتصق بالإشارات والكلمات بحيث يغدو الشكل الخارجي أو القالب التعبيري هو نفسه نواة المضمون الفكري. في الفلسفات التفكيكية التي توسع بها بعض الفلاسفة الفرنسيين المعاصرين، وهم يحذون حذو هايدغر، يصعب الفصل بين الجهد اللغوي والمضمون الفكري. المثال الأبلغ التمييز الذي أثبته جاك دريدا بين الاختلاف (différence) والتخيف (différance) في الجذر اللغوي الواحد، إذ اكتفى بتغيير حرف واحد في الاصطلاح (e, a) ليحصل على مضمون فكري مختلف، فالاختلاف تباين في حين أن التخيف عصيان في المعنى المنشود وتحير وتردد وإرجاء اضطراري للدلالة وتعليق صبور لها.
القاموس العربي
التعريب فعل فلسفي جليل، إذ إن المعرب يبتكر بنية فلسفية جديدة في اللغة العربية، ويمارس التفكر الفلسفي النقدي البنائي استناداً إلى لغته الأم. لذلك قال الفيلسوف اللبناني موسى وهبه (1941-2017) إن الفلسفة العربية المعاصرة الوحيدة الممكنة اليوم هي التعريب الفلسفي. وهو محق في ذلك على قدر ما يشعر الفلاسفة العرب المعاصرون أن المضامين الفلسفية العالمية ما برحت غائبة عن القاموس الفلسفي العربي الأصيل. الحقيقة أن الفيلسوف يفكر استناداً إلى بنية لغته الأصلية التي تحكم عملية التصور الذهني الذاتي، أو استناداً إلى لغة أجنبية تمكن منها فأضحت له بمنزلة اللغة الأم، ويحمل في فكره جهد الاستعادة النقدية وجهد التوسعة في المضمون. فإذا به يفكر باللغة أي بواسطتها، وفي اللغة أي في موضوع اللغة، ومن اللغة أي منطلقاً من معطيات اللغة الذاتية. لذلك تأتي بناءاته اللغوية ممهورة بختم المباني التعبيرية التي تنطوي عليها لغته. في هذه الحال، لا يستقيم التعريب إلا إذا استكشف في اللغة العربية ما يوافق المباني اللغوية الأجنبية في المضمون، من غير أن يناسبها في الشكل. المثال الأدبي الأبلغ المعروف أن يكون مرادف التعبير الفرنسي (faire chaud au cœur) أثلج صدره، لا أدفأ قلبه، إذ إن الذهنية الفرنسية تعتبر الدفء نعمة في مناطقها الباردة، في حين أن الذهنية العربية تستطيب البرودة في صحاريها الحارة.
ومن ثم، يجدر الرجوع إلى تنويعات الجذر العربي "عرب" الذي منه يستل الإعراب والتعريب والعبور والتعبير، فالتعريب عبور من ضفة إلى ضفة يستصفي المضمون الأنسب ليعبر عنه تعبيراً لائقاً يراعي قابليات الاقتبال والاستدخال والاستيعاب.
نشأت الفلسفات الغربية في بيئة ثقافية إغريقية أنتجت ضمة من الاصطلاحات الخاصة بها وبمزاجها، وبطبيعة تفكيرها وبنيتها الذهنية وتصوراتها الكبرى، منها المنطق والعقل والفكر والفيزياء والطبيعة والكينونة والإنسان والإنسانية والسياسة. هذه كلها مقولات لها جذورها الثقافية العميقة في التربة الحضارية الأوربية اليونانية واللاتينية. يختصر الباحث المتخصص بالدراسات الصينية ماتياس أوبرت (Mathias Obert) مشكلة الانتقال من بيئة إلى أخرى بعبارة "اختبار العالم اختباراً بنيوياً وإنجازياً". معنى هذا التصريح أن كل بيئة ثقافية تختبر العالم اختباراً ذاتياً ينطوي على خصائص تعبيرية فذة. فالإنسان، بحسب هايدغر، كائن منغرس في العالم (in-der-Welt-Sein)، ومن ثمرة انغراسه تنشأ خصوصيته التعبيرية.
إبتكار الإصطلاحات
إذا كان الأمر كذلك، ينبغي الاستفسار عن سبل التعريب الفلسفي الأقوم والأنجع والأبلغ. لنبدأ بالأصل، ونهنئ الفلاسفة العرب السابقين الذين ما استنكفوا قط عن تعريب الاصطلاح اليوناني (philosophia) بابتكار اصطلاح عربي ورثناه حتى اليوم. ما خطر على بال هؤلاء أن يكتفوا بتعريب حرفي (حب الحكمة) يثقل عليهم تصريف الاستخدام المتنوع (فيلسوف، تفلسف، فلسفي، فلسفيات...). إذا صح ما قاله هايدغر في أن "الفلسفة في صميم ماهيتها إغريقية"، فإن التعريب الفلسفي ينبغي أن يبدأ بإتقان اللغة اليونانية. بيد أن مشكلة اللغة العربية أنها نشأت في حضن الشعر والمعلقات، ولم تحتضن إبداعات الفلاسفة الإغريق إلا في القرن التاسع بفضل النوابغ من أمثال أبي يوسف يعقوب بن اسحق الكندي (805-873) وأبي بشر متى بن يونس (توفي حوالى 939) معلم الفارابي. انتصبت اللغة العربية في قوامها المستقل من غير أن تختبر المطلب أو السؤال الفلسفي. فكانت أقرب إلى المعاينة الحسية يصورها الإنسان تصويراً منبثقاً من الوجدان المتأثر بعوامل البيئة الخارجية والوضعية المعيشية الترحالية. حتى الصورة الشعرية العربية تظل مقترنة بالأوضاع المادية الحسية الملموسة، تستنهض المخيلة استنهاضاً يكرر في الكائنات والموجودات والأشياء عينها عشرات الصفات المتواردة المترادفة.
إذا ثبت ما خلصت إليه المناظرة الشهيرة في محضر الوزير ابن الفرات بين الفيلسوف متى بن يونس واللغوي أبي سعيد السيرافي، فإن المعاني يصيبها التحول عند نقلها من لغة إلى أخرى. السبب في ذلك أن للاصطلاح الفلسفي تاريخاً من النشوء والتكون والترسخ اختبره على تعاقب المباحثات التي تناولته. حين ينقله المعرب، يفقده المحضن النشوئي الذي يكسبه من الدلالات والإشارات ما يفوق دلالة العديل أو المقابل العربي. أضف إلى ذلك مسألة الحقل الدلالي الأوسع الذي ينسلك فيه الاصطلاح الفلسفي وتطور استخداماته المتشعبة. في القرن السادس عشر، كان الفيلسوف الفرنسي مونتنيه (Montaigne) يعتمد على استخدامات اصطلاح الزمن، ومنها على وجه الخصوص، الفرصة أو السانحة. فالعبارة الفرنسية (prendre le temps) كانت تدل على اغتنام الفرصة، في حين أنها أصبحت تشير اليوم إلى التريث والتأني.
حين عرب جورج زيناتي كتاب دكارت "انفعالات النفس"، كان موفقاً في التعبير عن المضمون الفكري، إذ إن كلمات الشعور والعاطفة والهوى والعشق تلغي دلالة التألم التي يحتملها الأصل اليوناني (pathein). يرسم دكارت أن الجزء المفكر في النفس يظل متأثراً بعوامل الانفعال (passion) التي تصيبه من جراء التحامه بالجسد. أما روسو، فكان يعتقد أن الإنسان، في الحال الطبيعية الأولى، يتملك عليه انفعالان، التعاطف وحب الذات. في مثال آخر، يسأل المرء هل يعبر اصطلاح العقل العربي عن النوس (nous) الإغريقية والراسيو (ratio) اللاتينية؟ يدل الاصطلاح العربي (عقل) على اجتهاد الربط والإحكام، في حين أن الاصطلاح الإغريقي يدل على التفكر والإدراك والفهم، والاصطلاح اللاتيني يشير إلى الحساب والمحاسبة. حقيقة الأمر أن اللغة العربية ليست لغة التجريد، ولو أن غناها الاصطلاحي قد يتفوق على أكثر من لغة. زد على ذلك أن المعاني العربية الأصلية يستلها المعرب من الأدب وعلوم الفقه والتفسير والكلام.
الأيس والوجود
من الضروري في هذا السياق استرجاع الجهد الذي بذله الفيلسوف اللبناني الأب فريد جبر (1921-1993) حين أبان أن الاصطلاح العربي القديم لا ينطوي على لفظ فلسفي يؤهله لنقل المضامين الفلسفية اليونانية. من الاصطلاحات الغائبة الكينونة (einai) في اصطلاحها اليوناني القديم. حاول العرب أن يستخرجوا لها عديلاً ظنوا أنهم عثروا عليه في الأيس (الكندي) أو الوجود (الفارابي وابن سينا). فالعربية لا تستخدم في الجملة الاسمية رابط الكينونة بين المبتدأ والخبر، وشأنها في ذلك شأن اليونانية واللاتينية. غير أن هاتين اللغتين استفاضتا في تجريد الرابط من صلة الحامل والمحمول، فصاغتا منه مفهوماً فلسفيا مستقلا أفضى إلى مبحث الكينونة أو الأنطولوجيا. وهو مبحث يسميه جبر الأيسيات، مع أنه يدرك أن الفلاسفة العرب الأوائل اعتمدوا لغة المتكلمين، فآثروا الوجود على الأيس. مشكلة الوجود أنه يرتبط بالذات الإنسانية، ولا يعبر عن كينونة مستقلة ناشبة في صميم الكائنات. أضف إلى ذلك مشكلة الخلط بين الوجود في الفلسفات الوجودية والوجود في الأنطولوجيا. من هنا خصوصية اللغة اليونانية التي تستطيع أن تفصح عن الكينونة في وجوه شتى لم تألفها اللغة العربية. فالوجود يضاف إلى الوقائع في العربية الفلسفية، في حين أنه من صميم الوقائع في العبقرية الفلسفية اليونانية.
من الاصطلاحات الغائبة أيضاً مفهوم السبب في مدلوله الفلسفي اليوناني الأصلي الذي يشير إلى العلة التي تحدث الوقائع إحداثاً مباشراً. أما السبب في مدلوله الكلامي العربي، فيشير إلى المناسبة أو الوسيلة. منشأ الاختلاف الدلالي أن الفكر العربي الإسلامي لا يعترف إلا بسببية إلهية حصرية. من الاصطلاحات الغائبة أيضاً مقولة الذات (subjectum)، وهي تعني أصلاً بالعربية الامتلاك أو الحيازة. ليس من ذات مستقلة في اللغة العربية، إذ إن الذات المستقلة الوحيدة هي الذات الإلهية، بحسب ما يذهب إليه جبر: "تعني الذات شيئاً موضوعيا عينيا، لا شيئاً نفسانيا يتصوره الإنسان من عند ذاته". والحال أن الفلسفة الغربية كلها، لاسيما في حقبتها الحديثة والمعاصرة، تقوم على مبدأ الاعتراف بالذات الإنسانية كياناً عاقلاً حرا مستقلا فاعلاً يحدث التغيير الممكن في نطاق الواقع المتاح.
التفكير الكوني
من الواضح أن الثغرات الاصطلاحية هذه لا تعسر التعريب الفلسفي فحسب، بل توشك أن تعطل التفكير الإنسي الكوني. في التعريب الفلسفي، يعاين جبر الاختلاف بين اصطلاح الانتزاع (نزع) الذي استخدمه الفارابي، واصطلاح التجريد الذي أضافه ابن سينا إلى النزوع، وكلا الاصطلاحين يشير إلى المفارقة. يتوسع جبر أيضاً في تحليل الاصطلاحات الفلسفية العربية التي لا تلائم الأصل الأجنبي. فالاصطلاح الأجنبي (conscience) لا يفصح عن مضمونه مفهوم الوعي، بل التعقب الذي ينشئ في الوعي حالة من البحث والتحقق والتحري الناشط. والاصطلاح الأجنبي (évidence) لا تناسبه البداهة التي تدل على سرعة إدراك المعارف، بل نظرة العقل. ثمة اجتهادات ثمينة أفرجت عنها عبقرية فريد جبر حين اقترح عديلاً للاصطلاحات الأجنبية تكافؤ الأدلة (antinomies de la raison)، وتنقيح المناط (méthode des résidus)، واذتهان (abstraction)، وعندية المشتقة من عبارة "من عند نفسه" (subjectivisme)، وتمريسية (praxéologie)، والتذاوت (intersubjectivité)، وسواها من المبتكرات المستلة من عيون علمي الكلام والتصوف.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أختم بالتعريف النبيه الذي ساقه جبر، إذ اعتبر أن التعريب "ليس بأن ننقل المعاني الفلسفية، ثم نجد لها صوغاً، مهما حسن في لغتنا وحسب، بل أيضاً وبخاصة أن نكتشف معانينا الفلسفية منطلقين من لغتنا وأسرار بيانها. كذلك فعل مفكرونا الأوائل: كانوا أمراء البيان، فتمت لهم الإمارة في ابتكار المعاني" (فريد جبر اللعازري في فكره الفلسفي، تحقيق وتعليق جيرار جهامي، دار المشرق، بيروت، 2017، ص 211). محق جبر في القول بضرورة الاستناد إلى العلوم الإسلامية الكلامية الأصيلة من أجل نبش الاصطلاحات التي تناسب المضمون الفلسفي الدخيل. في نظره، هذه الضرورة تصون عبقرية اللغة العربية. غير أن الاختبار الثقافي الفكري المنبثق من الذهنية العربية الأصلية ربما لا يطابق الاختبار الثقافي الفلسفي الذي انبثقت منه الاصطلاحات الفلسفية الغربية. يصون جبر في مشروعه الأمانة للتراث العربي ولعبقرية الاصطلاح العربي الأصيل، ولكن الاصطلاح العربي الأصيل ربما لا يلائم مضمون الاختبار الثقافي الذي أفضى إلى صوغ الاصطلاح الفلسفي الغربي. لذلك يجب أن ينتهج التعريب سبلاً أخرى جريئة من مثل النحت والاشتقاق.