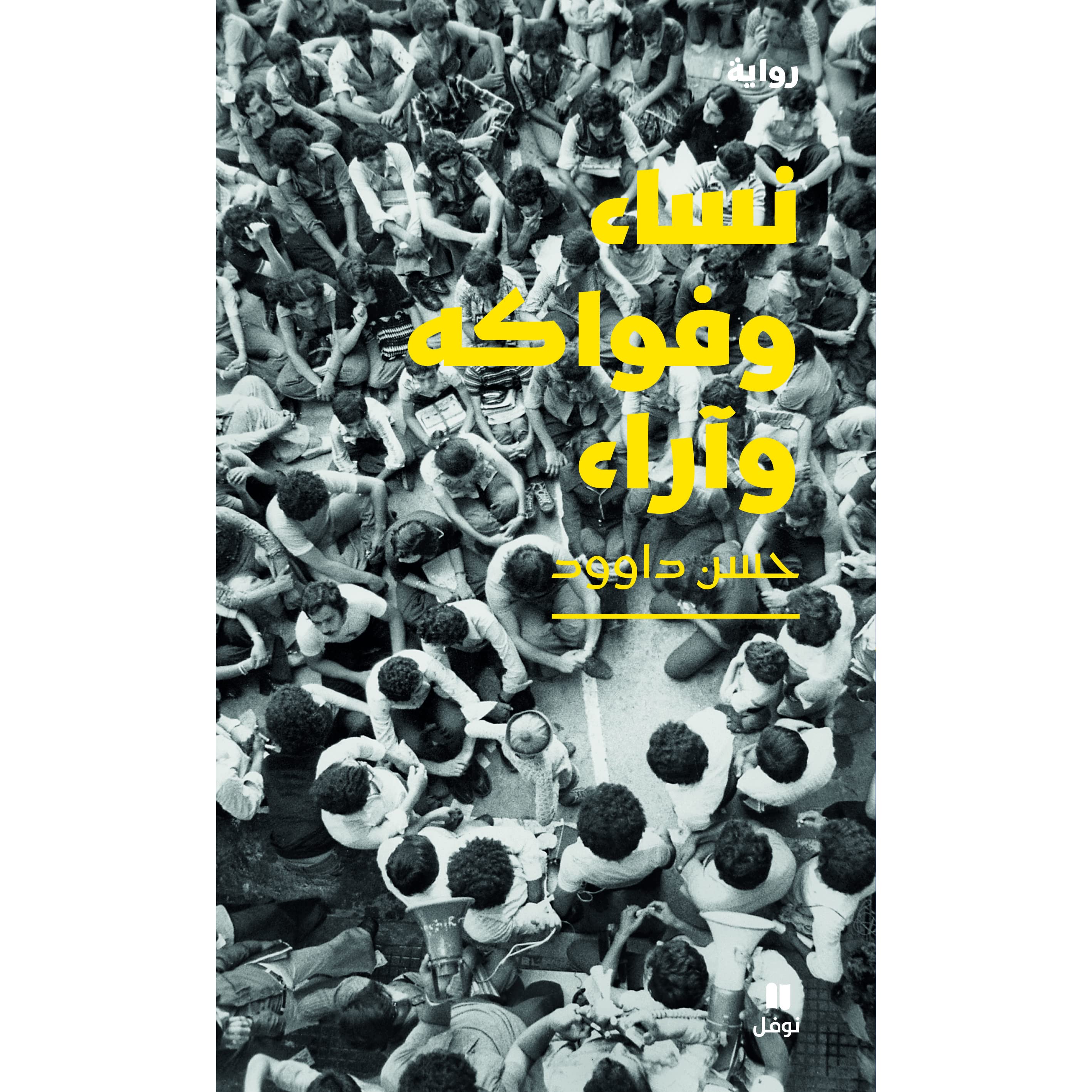من يعرف الروائي حسن داوود معرفة شخصية، ويتابع أعماله الروائية المتتالية، لا بدّ أن يقول: "وأخيراً"، بمعنى ها إنه رضي أخيراً أن يجعل من بعض سيرته موضوعاً لروايته. وهو لم يخفِ ذلك في صفحة التنبيه إذ قال: "حتى لو استلهمت الرواية مظاهر من عيش حقيقي، فلن يكون ذلك إلاّ فاصلاً في سياق قائم في أساسه على التخيّل".
ومفاد هذه السيرة أنّ الروائي حسن داوود كان طالباً في كلية التربية، قسم تعليم اللغة العربية وآدابها، وأنه قضى خمس سنوات في ربوعها، من العام 1968 وحتى العام 1973، حين تخرّجه أستاذاً منها. ولئن كان اتّضح أن التفصيل السيريّ الذي ارتضى الروائي -أخيراً- أن يخرجه من طيّ الذاكرة، لا يعدو كونه مادّة أوّلية لمعالجة روائية فذّة وعميقة تقوم على فلسفة التحوّل الدراماتيكي في شخصية الكائن البطل، فإنه جدير بالتنويه لكونه، أي كلية التربية، مكاناً بل ملتقى لكلّ طلاب وطالبات لبنان – ما قبل الحرب الأهلية- ممن كانوا ينتمون إلى الطبقة الوسطى، بغالبيتهم العظمى، ويحملون بزور التغيير الاجتماعي والسياسي، ويتولّون قياد الحراك الطالبي في الجامعة اللبنانية قاطبة، في عزّ الانتفاضة الطالبية بباريس واتساع أصدائها إلى البلدان العربية، مضافاً إليها الحراك المؤيّد للقضية الفلسطينية بين الطلاب والطالبات وغيرها.
الرواية الجديدة لحسن داوود، بعنوان "نساء وفواكه وآراء" (دار نوفل - 2020) وهي كلمات مقتبسة من فيلم "زوربا" الشهير المأخوذ عن رواية اليوناني كازانتزاكيس والذي قام ببطولته انطوني كوين ، تفتح أفقاً جديداً، على ما عهدناه في أعمال داوود، لاعتبار مهم وهو عودة الكاتب إلى استثمار بعض من سيرته الشخصية لينفذ إلى أعماق إنسانية، ويستجلي إيماءات أدقّ مما بلغه في تأمّلاته السابقة عن الجسد والعمر والمرض (في "أيام زائدة" و "غناء البطريق") وعن الأهل في إطارهم الأوّلي ("روض الحياة المحزون") وعن الحبّ الأوّل ("نقّلْ فؤادك") وعن التحوّل الباطني المفضي إلى التحرر من ظواهر الدين ("لا طريق إلى الجنّة") وأثر المدينة في الفرد كما في الجماعة الهابطة من الريف ("نزهة الملاك" و"سنة الأوتوماتيك").
في الفصل الأول من الرواية (ص:7-53) والأطول، يتمكّن الروائي ورواته من رسم كلّ مكوّنات الوضع الأوّلي؛ من تعيين المسرح المكاني الذي يتمحور حول كلية التربية، الكائنة في محيط ما يسمى الأونيسكو، أما الزمان فكان في أوج "الزمن الجميل"، أي عام 1968، وفقاً لحساب محمد صافي إحدى الشخصيات الرئيسية في الرواية، إذ امتدّ "من منتصف الخمسينيات حتى منتصف السبعينيات"(ص:13). وما تلى العام 1969 وتظاهراته كان مؤشراً إلى نهاية هذا الماضي الجميل. وعلى أي حال، يشكّل "الزمن الجميل" هذا اللايتموتيف المتواتر في مفاصل الرواية ليذكّر القرّاء بأنّ ما يُروى إنما يندرج في سياق الانهيار التدريجي لكلّ شيء في ما أمكن للعين الفردية أن تحصيه، عين محمد صافي، ثم شوقي وبطرس وإبراهيم علواني وصالح وكاتيا ونبيلة ويوسف، من طلاب السنة الأولى، وهم من شلّة الشعراء منهم (والتي يصرّ الروائي على حذف الهمزة منها لإبقاء لفظها بالعامية، الشعرا) ممن اتّفقوا على "المبالغة" في كلّ شيء. ولا تلبث أن يتكشّف للقرّاء مقدار هذه المبالغة لدى كل من هذه الشخصيات على حدة؛ يوسف وتطرّفه في مواجهة الخطر وتحدّي الآخرين في نسبة الخوف حتى ارتكابه العنف، وتحدّيه سلطة والده وتمرّنه المتواصل على "الخروج من سطوة أبيه" (ص:47) وفي ما يجب فعله "ليتغلب على هشاشته وخجله "، ومحمد صافي المتطرّف في دفاعه عن التنوّع الذي كانت الشّلة تمتاز به حيال هجمة التجانس والأحادية، حتى اليسارية في حينه، التي كانت قائمة من حولهم، وإبراهيم علواني الذي علِق بفتاة بشعة وتكبره بأربع سنوات وأصر على الزواج بها، وزهير المصرّ على فهم الماركسية التي عزم على الانخراط في صفوف المنتمين إليها من غير طائل، وصالح الذي أمكنه تحقيق إنجاز استحقّ معه بلوغ ذروة ما تحقق "في سنوات لبنان العشرين أو في العاشرة والنصف صباحاً من يوم 11 شباط 1968"(ص:14) حين باس زميلته كاتيا في الصف! وإلى جانبهم شخصية حسان جعلها الروائي راوياً لمّاحاً، أشبه بالنافخين من وراء الستارة في مسرحيات أريستوفان، ولا يلبث أن يتوارى في سائر فصول الرواية الاثنين والعشرين ليخلي مكانه لمحمد صافي.
شلة الشعراء
وسواء حسب صالح ذلك اليوم التاريخي المشهود في مساره الشخصي، أو حسبه محمد صافي بداية الانحدار في سلّم ذلك الزمن الجميل، فإنّ موجة من الضّحك تنتاب القارئ بسبب مقدار التضخيم، بل النفخ الكاريكاتوري لأفعال الشخصيات الذين يسميهم الراوي "شلة الشعرا" ممن يفتقدون في وعيهم إلى أي رابط بالواقع، على نحو ما تمّ وصفهم متلبّسين بصفاتهم الأساس - وهم في سنتهم الجامعية الأولى – يؤدّون أفعالهم تبعاً لها، ويتحمّلون تبعاتها راضين حاسبين أنها الحقيقة المطلقة، ثمّ يزيدونها إلى الزمان الجميل أو ينقصونها منه.
ولكنْ أين الحبكة؟ بل أين الأحداث المتعاقبة والمنسلّة بعضها من بعض؟ للإجابة أقول إن لا حبكة معقّدة أو متشابكة في رواية حسن داوود، وإنّ الزمن بما يحمله من عوامل إنضاج أو إيلام في النفس والجسم كفيل وحده بتطويع الأشخاص الذين جعلهم الروائي موضوعاً للوصف والسرد والتأويل، وإن مجرّد متابعتهم في تحوّلاتهم التي غالباً ما تكون سلبية ولصيقة بواقعهم الذي لطالما أبوا الإقرار به. ومع ذلك تواصل الشلّة، ممثّلة بواحد هو محمد صافي، البحث عن الأصدقاء القدامى ممن بقي على قيد الحياة، ولا سيما وداد، الفتاة التي كان قد أعجب بها لحظة دخوله إلى الكلية، وانخراطه في الحياة الجامعية. وللحال تنكشف لصافي مصائر الشخصيات تباعاً؛ يوسف المتطرّف في حزبياته وانغماسه في الحرب الأهلية، وقد انتهى به الأمر محكوماً بوسواس ملاحقته لاغتياله أو إلحاق الأذى به. وبوليت، هذه الزميلة التي كانت أسقطت من حسبانها جنسيتها الفرنسية الثانية، حين قررت الدخول إلى كلية التربية – وكانت لا تزال صلة الوصل بينه وبين وداد فتاته الأولى- سرعان ما تنجلي الوقائع عن مرضها وتهالك حالها. وفي ما يشبه التعارض والالتباس غير المتوقّع، يكاد يقع محمد صافي في عشق بوليت، وهما لا يزالان في حمأة البحث عن وداد، صديقتها من تلك السنة الجامعية الأولى والمصيرية. ولكنّ بوليت هذه لا تلبث أن تغادر لتقضي آخر أيامها في باريس، لدى أخيها، في نوع من القفلة الدرامية والسقطة ما قبل النهائية لذلك الزمن الجميل.
أما وداد، وهي حبّه الأول، فقد حوّلتها الأيام، من فتاة ملء القوام فاتنة إلى امرأة ترتدي "ذلك السواد الهابط من قمة رأسها إلى قدميها"(ص:184) بل يكفيها ذكرى من ماضيها مثابرتها على التدخين، فحسب.
ولئن فاتني أن أورد القفلة الدرامية الأخيرة، والمتمثّلة في اكتشاف محمد صافي، الشخصية الأكثر وعياً للذات، وشك التهام المرض كبده، فإنني لا أتردد في تقديم خصال، بل انشغالات تميّزت بها رواية داوود عن غيرها. ولعلّ أهمها انشغال الروائي في التأمّل الاستعادي الذي يباشره بدءاً من عمق ذاته وصولاً إلى أعماق ذوات الشخوص الذين تحفل بهم الرواية، أو تقيم الاحتفال لهم، احتفالاً سريرياً يفضي بهم إلى الإقرار بذنْب طالما واروه في طوايا ضمائرهم الحيّة، وسط موات عموميّ لا لبس فيه.
التأمّل في مسلك المبالغة وصنوه التطرّف وما يؤول إليه من إنكار للواقع التعددي الذي كان عليه طلاب السنة الأولى (محمد صافي، ويوسف، وبطرس، وصالح علواني، وبوليت، ووداد)، والتأمّل في الذات "المعتمة" ومعاتبتها وصولاً إلى معاقبتها وصفعها "خدّي واحداً بعد الآخر"(ص:176)، ثمّ تجريب النفاذ عبر جدران المستحيلات: النفاذ عبر الزمن، أعني الماضي، لالتقاط فتات الذات، وهو ما تجلّى في عودة الروائي إلى زمن أوّل من أزمنته الأولى العديدة، ومحاولته النفاذ إلى مشاعر الآخر، سواء كانت حبيبة أولى أو زميلاً من ذلك الزمن الجميل، المتهاوي من أعلى سلّمه منذ العام 1968.
"ليس وجهي الذي تغيّر، بل كلامي أيضاً، بل وحتّى صوتي..." (ص:190) أو ليس أصدق إنباء من هذا الكلام يقوله محمد صافي، الناطق بلسان المؤلّف، على ظنّي، للدلالة على جوهر التحوّل الذي يصيب المرء، بفعل بطلٍ أعظم منه عضلاً وقوة وإقداماً وتمرّساً وتجاوزاً للنبرات والخذلان، عنيت به الزمن؟
ولعلّ قراءة الرواية تجيب عن أسئلة أخرى، أو تطرح أسئلة فاتتني، وهي كثيرة، ومنها يقظة العامية في حوارات الشخصيات، على سبيل المثال، لا الحصر.