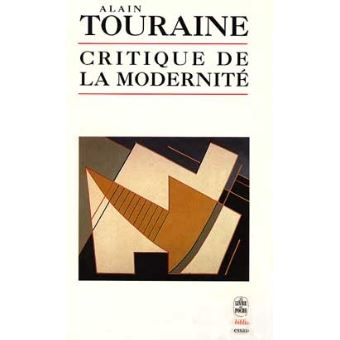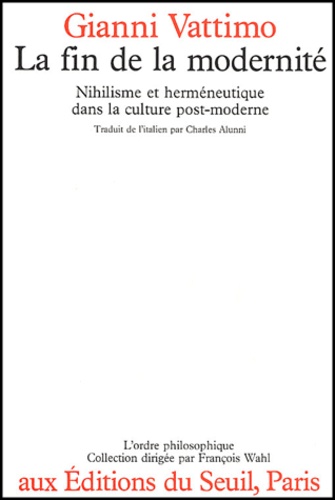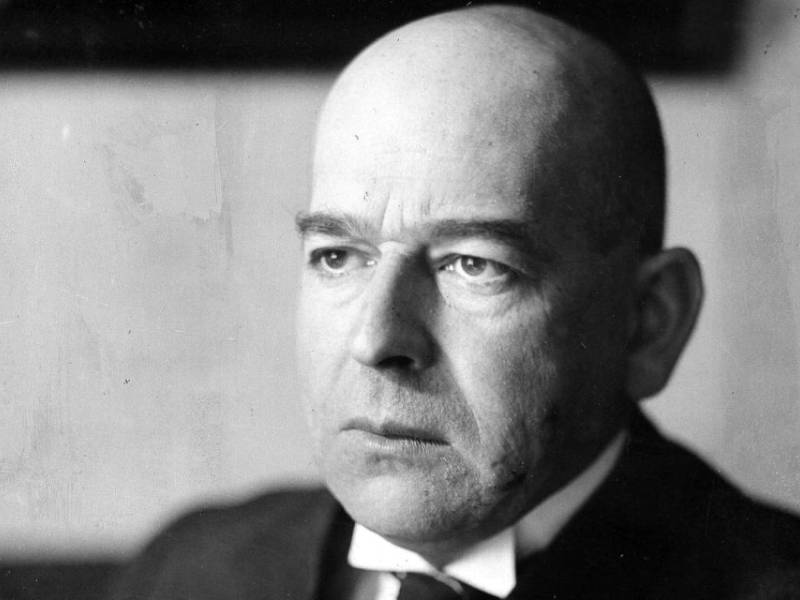يتناول مؤرخو فلسفة الحداثة في نشوئها التاريخي المرتبط بإنسية النهضة الأوروبية (ابتداءً من القرن الخامس عشر)، وبالتحولات العلمية الغربية الحديثة (ابتداءً من القرن السادس عشر)، وبعصر الأنوار الأوروبي (القرنين السابع عشر والثامن عشر)، وبالثورات الغربية الثلاث (البريطانية والأميركية والفرنسية) التي منحت الأفكار الحديثة القدرة على التغيير الاجتماعي السياسي الاقتصادي. لا ريب في أن إسهامات الحداثة الأوروبية هذه جليلة يستحيل على المرء أن ينكر أثرها الحضاري العميق في حركة التاريخ الحديث والمعاصر، بيد أن تطور العلوم واضطراب الأوضاع السياسية الكونية التي أشعلت على وجه الخصوص القارة الأوروبية في القرن التاسع عشر والقرن العشرين أفضيا إلى مساءلة هذه الحداثة والتشكيك في طبيعة إنجازاتها الثقافية والاجتماعية. الحجة الأقوى أملت على الجميع الاتعاظ بأمثولات العنف الاحترابي الذي سوغه العقل الغربي، فكاد يفني المجتمعات الأوروبية في حروبها الذاتية الإلغائية وفي مغامراتها الاستعمارية الشنيعة. وعليه، طفق الناس يتهيبون التناقض المرعب بين رقي عقل الأنوار الغربي في جوهر مقاصده، ووحشية المسلك العنفي الأوروبي في مذابح الحروب العالمية وفتوحات التوسع الاستعماري الحديثة.
من جراء هذه المساءلة، ومواكبة للتحولات الجسام التي أصابت المجتمعات الإنسانية المعاصرة، انبرى غير فيلسوف ينادي بنهاية الحداثة وبزوغ زمن ما بعد الحداثة. فإذا بقيم الحداثة العقلانية تسقط في محنة الانتقاد والتعطيل، وإذا بقيم ما بعد الحداثة تستعيد بضعة من قيم التراث، لا سيما تلك التي ترتبط بحرية الوجدان، ومقام العاطفة، ووظيفة الحدس، وموقع الجماعة في حياة الإنسان، ومنزلة الانتماء ووعي التراث، وما إلى ذلك من موضوعات كانت الحداثة قد انتقدتها وعرتها وفضحت انحرافاتها واستصفت جواهرها الباقية المفيدة.
حداثة بودلير الجمالية
كيف يمكننا، مع ذلك، أن نعرف الحداثة من غير أن نسقط في محنة الاختزال والتشويه؟ يعتقد الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو (1926-1984) أن نص كانط "ما الأنوار؟" (Was ist Aufklärung؟) يحمل إلينا بذرة الحداثة في أول نشأتها. فيعرف الحداثة موقفاً يقفه المرء من الوجود الراهن، وطريقة في التفكير والشعور والمسلك والتصرف تستدعي وعي الإنسان. أما المثال الذي يسوقه من أجل إظهار هذه السمات، فنص التعريف الذي أنشأه الأديب الفرنسي بودلير (1821-1867) حين رسم أن الحداثة تدل على الانتقالي العابر، والعزوفي الهارب، والانعتاقي الجائز، والترددي الحائر. إنها صورة الفن في نصف مشهديته، في حين أن النصف الآخر يعتصم بقيم الثبات والرسوخ والديمومة. ومن ثم، يبدو أن فوكو آثر في الحداثة معاينة الموقف الجمالي التفكري، رافضاً أن تدعي القدرة على عقلنة الواقع وتغيير العالم.
ليوتار يعزز مقام الحداثة في استجلاء ما بعد الحداثة
بيد أن الانقلاب الأخطر استثاره الفيلسوف الفرنسي جان - فرانسوا ليوتار (1924-1998) الذي اعتقد أن الأزمنة المعاصرة خرجت من دائرة الحداثة ودخلت زمن ما بعد الحداثة. ومع ذلك، ينبغي القول إن ليوتار لم يخرج على الحداثة، خصوصاً في كتابه "الوضع ما بعد الحداثي" (La condition postmoderne)، بل وصف التحول الطارئ على الحداثة نفسها. جل ما قاله أن المجتمع الإنساني ما برح يختبر، منذ القرن التاسع عشر، ضربين متناقضين من الاستقطاب الفكري: التصور الليبرالي، والتصور الماركسي. لا يعني التناقض أن الخطابين لا يلتقيان على الإطلاق، بل يدل على استنادهما إلى مصالح متعارضة ومقولات اجتماعية متنابذة. أما مواضع التقاء التصورين فتتجلى في اعتمادهما على مكتسبات الحداثة: الاستناد إلى مرجعية العقل المطلقة، وتعزيز مقام الفرد وحريته الذاتية المنيعة، والإيمان بالتقدم العلمي، والتفاؤل بتطور المجتمع الإنساني وتوجهه إلى مثال الكمال الأعلى، والوثوق بفضائل المباحثة العقلانية المفتوحة، وتأييد المبدأ الذي ناصره الفيلسوف الفرنسي لوي ألتوسر (1918-1990) حين أعلن أن العامل الاقتصادي يمهر الوجود التاريخي مهراً دامغاً ويضبط حركة التطور الاجتماعي ويوجهها بحسب مقاصده ومصالحه ومنافعه. أعتقد أن هذه الخصائص تعرف أفضل تعريف جوهر الحداثة على تنوع تجلياتها التاريخية.
في إثر الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي نزلت بالمجتمعات المعاصرة في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، تبين أن التناولات الشمولية والسرديات الحاوية والتصورات الجامعة لم تعد تفيد الناس في تحليل أسباب التأزم واستشراف الحلول الناجعة، لذلك كان لا بد من تغيير أنماط التفكير وأصناف السلوك حتى يستطيع الإنسان أن يتدبر مباغتات الحياة. بما أن حداثة القرنين التاسع عشر والعشرين ارتكزت على مثل الخطاب التسويغي التفسيري الاحتضاني الشمولي هذا، كان من الضروري الأعراض عنه واعتماد نسق جديد من التفكير يلائم ما سماه ليوتار وضع ما بعد الحداثة.
لكن اللافت في تحليل ليوتار أنه استثار موجة عارمة من الأدبيات التحليلية التي طفقت تستثمر الحدس الذي انطوت عليه عبارة "ما بعد الحداثة". فإذا بليوتار يتحول، بحسب عبارة فوكو، إلى مؤسس فكري ينتج القول الثقافي الجديد (fondateur de discursivité)، ويستنهض همم الآخرين من أجل استنبات نصوص تحليلية أخرى تعالج التحول الجليل الذي أصاب الأنظومة الفكرية الحديثة برمتها. ومع أنه من الصعب تعريف الحداثة تعريفاً مانعاً جامعاً، إلا أن الثابت في هذا كله أنها ألهمت جميع الردود التي أرادت انتقادها أو تعطيلها أو تقبيحها أو إسقاطها نهائياً. من المفيد إذاً أن يستعرض المرء بعض التناولات التي اجتهدت في تقويم الحداثة، أو إعلان نهايتها، أو حتى تسويغ موتها، وذلك قبل أن نخلص إلى استجلاء موقف الفيلسوف الألماني هابرماس (1929-...) الذي يصر على استمرار الاستثمار الناشط في مقولات الحداثة.
نقد الحداثة العقلانية المجردة
حاول عالم الاجتماع الفرنسي ألن تورين (1925-...)، في كتابه "نقد الحداثة" (Critique de la modernité)، أن يفضح مساوئ الحداثة من غير أن يسوغ محاسن اللاحداثة، أو أن يناصر مبدأ معاداة الحداثة في ما تنطوي عليه من قيم إنسية هادية. غير أنه سرعان ما أدرك أن الحداثة حمالة أوجه، إذ تعد الإنسان بالتحرر، ولكنها لا تلبث أن تأسره بقيود بنيوية غير منظورة، ذلك بأن هذه الحداثة التي سعت إلى عقلنة الحياة وتحريرها من سحريتها الغيبية، تحولت إلى أداة رقابة وإدماج وقمع. أما دليله على ذلك فالاختلاف الواضح بين حداثة استطاعت في القرن التاسع عشر أن توحد جميع أبعاد الفرد والجماعة، وحداثة أخفقت في القرن العشرين في صون المسعى الائتلافي هذا، وجزأت الإنسان ومنعته من استيعاب التغيير في صميم كينونته، راسمة الحدود الفاصلة بين العقلانية الآلية والذاتية الوجدانية.
من الضروري، والحال هذه، أن نستصفي في الحداثة أبعادها البناءة الراقية، فنقصي الانحرافات العقلانية، ونعيد إلى الفرد كرامته وحريته الواعية القادرة على الاضطلاع بالقرار الحياتي المسؤول. ومن ثم، تتميز الحداثة المتجددة، في نظر تورين، بأعراضها عن الموقفين المتطرفين اللذين ينجرف فيهما الإنسان المعاصر: إما الخضوع الأعمى لسلطان المعرفة، وإما الانكفاء المرضي إلى أحضان الجماعة المتشنجة المتقوقعة على ذاتيتها الأصولية. بين هاتين المنزلتين يعثر تورين على منزلة معتدلة تروم أن تجعل للفرد مقاماً فاعلاً يؤهله للاضطلاع الحكيم بمسؤوليات الحياة، من غير أن يخضع لمشيئة الجماعة أو لحتميات الاجتماع والاقتصاد والسياسة. فالفرد هو المرجعية الأخلاقية الأساسية التي منها تنبثق كل القرارات الوجودية الخليقة بتعزيز حرية الإنسان الراغب في اختبار قيم الحب والأخوة والتضامن.
الحداثة الأخرى المختلفة
يعلن عالم الاجتماع الألماني أورليش بك (1944-2015)، في كتابه "مجتمع المخاطرة. على طريق حداثة أخرى" (Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne)، أن البشرية تختبر اليوم المخاطر الإفنائية التي جرتها عليها حداثة المغامرة المسرفة في انتهاك الطبيعة والكرامة الإنسانية، لذلك لا بد لنا من تعطيل مفاعيل الحداثة الإهلاكية هذه، واستجلاء حداثة أخرى مختلفة تتميز بإدراكها النبيه كل ضروب التعدي على الحياة والنبات والحيوان والإنسان. الحقيقة أن الحداثة التي كانت تروم استنقاذ الإنسان من براثن الجهل والتخلف، قذفت به في مجاهل الألغاز والمعميات والمخاطر والمغامرات. أبلغ مثال على الانحراف الكوني هذا التلاعب الجيني الاستنساخي، والاختبارات الفيروسية القاتلة، وانتهاك المحميات الطبيعية، وتفاقم آثار الاحتراب الاستعماري التوسعي المنفعي. لا بد، والحال هذه، من إنشاء سياسة واقعية (Realpolitik) كوسموبوليتية تعالج انسدادات الدولة الوطنية العاجزة، وتضبط انحرافات التكتلات الصناعية الضخمة، وتقوم مسالك الإنتاج العلمي حتى يراعي مصالح الناس الفقراء المعوزين.
نهاية الحداثة
في موازاة هذه التنبؤات، يستلهم الفيلسوف الإيطالي جياني فاتيمو (1936-...)، في كتابه "نهاية الحداثة" (La fin de la modernité)، خطاب النهايات الذي صاغه هايدغر حين أعلن أن المتافيزياء الغربية بلغت منتهى غايتها في إنجازات التقنية الحديثة. يسوق فاتيمو مثال الفن المعاصر الذي استنفد كل طاقاته الابتكارية الجديدة، وقضى نحبه قضاءً موسوماً بالنصر الجدلي الذي فازت به مثالية هيغل المطلقة، وقد جمعت كل المتناقضات وصهرتها في بوتقة الإنجاز المتسامي الأقصى، منبئًة بحلول زمن الاكتمال الانغلاقي. انتهت الحداثة، بحسب فاتيمو، بانتهاء المتافيزياء وبلوغها في أعمال نيتشه (1844-1990) حدود الاستنفاد الذاتي المطلق. غير أن المطلوب ليس تجاوز (Überwindung) الحداثة، بل الانكفاء (Verwindung) إلى ذاتيتها المعطلة حتى تستشفي وتبرأ من أسقامها. قد يكون من المستحيل، في نظره، أن نتجاوز الحداثة، كما يتجاوز المرء حاجزاً من الحواجز. أما الانبراء أو الدخول الاستشفائي العلاجي فيها، فيساعدنا في الاضطلاع السليم بكل تحدياتها ورهاناتها، ذلك بأن موت الفن تعبير من تعبيرات نهاية المتافيزياء، وقد أنجزها هيغل واختبرها نيتشه وعاينها هايدغر معاينة حصيفة. ومن ثم، ينبغي أن نعتصم بموقف الانكفاء الانبرائي الذي يجعلنا نطلب الالتحاف الحق برداء الحداثة حتى يجللنا ويرسم لنا مشهد كينونتنا التاريخية الراهنة.
الحداثة الفائقة
في سياق تحليلي مختلف، يسعى عالم الإثنولوجيا الفرنسي مارك أوجه (1935-...)، في كتابه "اللاأمكنة: مدخل أنثروبولوجيا الحداثة الفائقة "(Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité)، إلى استجلاء الوجه الجديد الذي يرتسم على مشهد الحداثة المفرطة في تجريد الهندسة المدنية من كل أصناف الحضور الإنساني الحي. اللافت في هذه الهندسة تكاثر اللاأمكنة التي لا تحتضن الروح الإنسانية ولا تحمل هوية الناس ومعاناتهم، مع أننا نجتمع فيها على طريق ترحالنا. من هذه اللاأمكنة المطارات ومحطات القطار والساحات العامة والفنادق والمسارح والأسواق، وأيضاً مخيمات العبور التي يكتظ فيها النازحون واللاجئون. اللامكان نقيض المكان الأليف الذي يجسده المسكن الذي نركن إليه، أو المقهى الذي نرتاده بانتظام، أو النادي الذي نمارس فيه رياضتنا المفضلة. في هذه اللاأمكنة يلتقي الناس من غير ميعاد، ويحملون في ذواتهم غربة الحداثة القاهرة، ولكنهم يختبرون الإكراه التقني الذي يجبرهم على الانتقال من موضع إلى آخر، لا سيما حين يحصلون على بطاقة سفرهم، خلافاً لدروب الغابة التي لا تفضي إلى أي مكان أو مسالك الجبال التي تراعي مبادرة الأقدام السائرة وتصون حرية حركاتها. ومن ثم، يعتقد مارك أوجه أن الحداثة تفوقت علينا، إذ نجحت في ضبط معالم هويتنا الفردية والجماعية، وهيمنت على مقام الأحداث، بحيث أضحى الوجود كله مرتبطاً بالهندسة المدنية التي تنزع عن المكان صفة التلاقي الإنساني، وتحوله إلى منعزل التوحد والاختلاء الانفرادي.
خلافاً للحداثة، تتصف الحداثة الفائقة بثلاث خصائص بارزة: الفيض الحدثي الذي يتجلى في تكاثر الأحداث التاريخية العصية على الوصف والتحليل، والفيض المكاني الذي يتحقق في قدرة الإنسان على الانتقال الفوري السريع إلى جميع الأمكنة المتاحة، وأيضاً في تقنية استحضار مشاهد العالم أجمع على شاشات التلفزة والتواصل، وفردنة المراجع أو رغبة الفرد في تفسير المعلومات التي يكتسبها تفسيراً ذاتياً لا يستند إلى سلطة المعنى التأويلي الذي تعتمده الجماعة.
الحداثة المتفاقمة
إبرازاً لسمات الإفراط والتضخم والتعظيم التي طفقت تسود في أدبيات مناهضي الحداثة، ومنهم الفيلسوف الفرنسي جان بودريار (1929-2007) في تحليله خصائص الواقع المتفاقم (hyperréalité)، يعلن الفيلسوف الفرنسي جيل ليبوفتسكي أن الحداثة في القرن العشرين اختبرت ثلاثة أطوار: الأول (1965-1983) اتسم بالنقد الماركسي الذاتي، والثاني (1983-1991) انطبع بنزعة ما بعد الحداثة، والثالث الذي استهل في عام 1991 وما برح منبسطاً حتى اليوم تميز بالحداثة المتفاقمة (hypermodernité). إذا كان زمن ما بعد الحداثة تغلب عليه الفردانية وأعراض انحلال السياسيات، لا سيما تلك التي تظهر في تهافت الواجب الاجتماعي والالتزام في أحزاب الانتساب الحركي النضالي، فإن زمن الحداثة المتفاقمة ينطوي على دلالات مستلة من زمن ما بعد الحداثة، ولكنها تتجاوزه في تطلبها الجذري، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والسوق المفتوحة والثقافة المعولمة. ومن ثم، يعتقد ليبوفتسكي أن الحداثة ثارت على نفسها حين أكبت تتطلب مزيداً من كل شيء حتى الثمالة التي تخدر فينا لذة الإشباع السليم، لذلك يختبر الإنسان المعاصر في الحداثة المتفاقمة خيبة الخيبات كلها، إذ تنشئ الرغبة المستهلكة فراغاً كيانياً لا تقوى أي حداثة على ملئه.
الحداثة التي لم تحدث بعد
يؤكد برونو لاتور (1947-2022)، في كتابه "لم نكن قط حداثيين" (Nous n"avons jamais été modernes)، أننا لم ندخل زمن الحداثة ولم نكن قط حداثيين. الحداثة الأوروبية انتهت قبل أن تولد، إذ إن فكرة التقدم نفسها سقطت، مستنده في ذلك أن العالم مؤلف من أغراض هجينة ما برحت تتكاثر في اختلاط مربك بين مستويات العلم والاقتصاد والسياسة والفن والأيديولوجيا وسائر ضروب التعبيرات الثقافية المتضاربة. أما مشكلة الأغراض الهجينة هذه فعصيانها وتمردها وامتناعها عن التعريف وعن الانسلاك في النطاق العلمي أو التقني، ذلك بأنها، من جراء تعقد بنيتها الغرضية، تنتمي إلى السياسيات والاقتصادات والثقافيات. كذلك القول في مسألة السلطة التي خرجت من دائرة الفعل السياسي، وأضحت خاضعة لنفوذ الصناعيين والعلماء والتقنيين.
ومن ثم، أصبحت مقولات الحداثة النقدية عاجزة عن تسويغ الطبيعة الهجينة التي استقرت عليها مثل هذه الأغراض. من أخطاء الحداثة المميتة أنها تهوى الثنائيات الحادة، فتفصل بين الطبيعة والتقنية، بين حيادية العلوم الموضوعية وانخراطية المجتمعات الإنسانية الوجدانية، بين العالم العارف والسياسي الممتهن، بين الإنساني واللا إنساني. بسبب هذا الفصل، لم تستطع الحداثة أن تدرك أغراض العالم في ارتباط بعضها ببعض، وتشابك صلاتها، وتعقد بناها، وتناسل أجزائها. الحقيقة أن هذا الفصل ليس فعلاً يعبر عن دخولنا زمن الحداثة، إذ إنه يدل على أننا ما برحنا نعجز عن فهم محتويات العالم الحديث، لذلك لسنا بحداثيين بعد.
لا بد، والحال هذه، من الاستعانة بمقولات الأنثروبولوجيا التي سبقت الحداثة حتى نستطيع أن ندرك الترابط الجوهري بين الطبيعيات والثقافيات، بين التقنيات والسياسيات، بين الأسطوريات والاجتماعيات. لا ريب في أن المقاربة الأنثروبولوجية هذه تناسب مجتمعات ما قبل الحداثة التي كانت تستند في تصوراتها إلى فرضية الترابط العضوي بين أغراض العالم، ما دمنا لم نحرر المعرفة من الاجتماعيات والسياسيات، فإننا لم ندخل الحداثة. وربما يستحيل علينا دخولها، إذ إن العالم الذي نحيا فيه أضحى مؤلفاً من كائنات بشرية وأغراض هجينة، أي من شبكات اجتماعية - تقنية شديدة التعقيد نعجز عن فصل عناصرها، أو فك ارتباطاتها، أو استجلاء بناها المتداخلة المتشابكة. وحده التحليل الفطن الذي يستند إلى فرضية الفاعل - الشبكة (acteur-réseau) يمكننا من فهم التحولات العميقة التي تصيب العالم من جراء تعاظم الاختراع التقني المفضي إلى تكاثر الأغراض الهجينة.
الحداثة غير المكتملة
يبدو لي أن التناولات النقدية التي تنطوي على تنبؤات تفضي إلى فرضية سقوط الحداثة لا تستقيم استقامة معرفية بناءة، إذ إنها تهمل الحقيقة الثابتة التي تملي علينا أن نستند إلى الحداثة من أجل انتقادها وتجاوزها، ذلك بأن ما يدل على استمرار الحداثة أفقاً معرفياً كونياً وحيداً إنما هو المواظبة على استخدام حدسها الأصلي في جميع اجتهادات التقويم والتعطيل والاستعاضة والاستبدال. أعني بالحدس الأصلي هذا الوثوق المستنير بالأبعاد الوظيفية التكاملية التي ينطوي عليها عقل الأنوار والحداثة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من أجل استجلاء طبيعة الحدس الهادي هذا، لا بد من استحضار اجتهادات الفيلسوف الألماني هابرماس الذي ما فتئ يصر على أن الحداثة المتجلية في عصر الأنوار الأوروبي لم تنجز كل وعودها الحضارية، إذ إنها تتصور العقل تصوراً حيويا تاريخياً منعتقاً من كل تصلب دوغمائي، وتعتمد مبدأ التعددية التي تصون الاختلافات وترتقي بها إلى مصاف التنوع الأصلي، من غير أن تصهرها في بوتقة المعرفة الأحادية الإكراهية المطلقة. إذا كانت عقلانية الحداثة قد ضلت الطريق وغالت في تمكين التقنية وتعزيز هيمنتها، فإن العقل الأداتي لا يختزل كل إسهامات الأنوار، ذلك بأن العقل الحديث ليس أحادي البعد أو المدى، على حد تعبير الفيلسوف الألماني ماركوزه (1898-1979). ثمة ثلاثة أبعاد تنطوي فيه: البعد التغريضي (objectivante) المرتبط بالمعرفة الأداتية المهيمنة في التقنية والعلم، والبعد التعبيري المقترن بالجماليات (expressivité esthétique)، والبعد التشريعي المعياري (normative) اللصيق بالأخلاقيات. وعليه، يمكننا أن نلطف آثار العقل الأداتي الحديث بمكارم العقل التواصلي الذي يراعي الأبعاد الجمالية والأخلاقية في الحياة الإنسانية.
ومن ثم، يتضح لنا أن المطلوب صون الغنى الوظيفي الذي تختزنه العقلانية الحديثة. لا يرمي هابرماس إلى نقد العقل وتقبيح الحداثة، بل إلى إظهار تنوعات الممارسة العقلية التي تنطوي على الوصف المعرفي، والحكم المعياري، والتعبير الاستذواقي. لا بد من الحفاظ على الحداثة وعلى عقلانيتها، شرط الكشف عن طاقات الإسهام الجليلة التي تختزنها اختزاناً لم يستنفد الإنسان المعاصر جميع موارده. لا عجب، والحال هذه، من أن يقترن العقل بمقام اللغة التي تتيح لنا أن ننوع اختباراتنا في العالم، إذ تارة تساعدنا في وصف الوقائع، وتارة تؤهلنا للتعبير عن مشاعر وجداننا، وطوراً تجعلنا نبلغ الآخرين خلاصة الأفكار التي أينعت في وعينا. في جميع الأفعال التواصلية هذه، لا تني الحداثة تستثمر موارد العقلانية استثماراً ذكياً يجعلها تراعي تنوع الحضارات، واختلاف الثقافات، وتباين الاختبارات البشرية المحلية.
خلاصة القول إن الحداثة لم تنجز بعد، ولم تستنفد حتى ندعي القدرة على تجاوزها. أما السبب في عدم إنجازها فرحابة القابليات التغييرية التي تنطوي عليها، ومن أهمها على الإطلاق اجتهادها في توثيق الرباط التكاملي بين تجليات ثلاثة من العقل: العقل التقني العلمي، والعقل التعبيري الجمالي، والعقل التشريعي الأخلاقي. غالباً ما يهمل منتقدو الحداثة أن الأبعاد الثلاثة هذه تنقذ العقلانية الأوروبية من انحرافاتها التاريخية، وتضمن لها سبيل الاستشفاء الذاتي المطرد، ذلك بأن من خصائص الحداثة قدرتها على انتقاد ذاتها، وتطوير مفاهيمها، وتحديث مقولاتها، وتجديد آفاقها، وابتداع سبل خلاقة وفتوحات واعدة من استجلاء معنى الحياة، أو حتى لامعنى الوجود والعبثية اللصيقة به. فالحضارة التي تنتقد ذاتها انتقاداً جذرياً تغييراً لا خوف عليها مطلقاً.