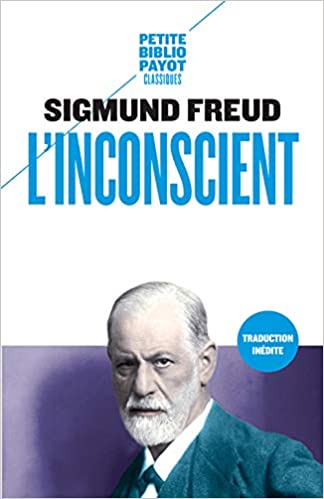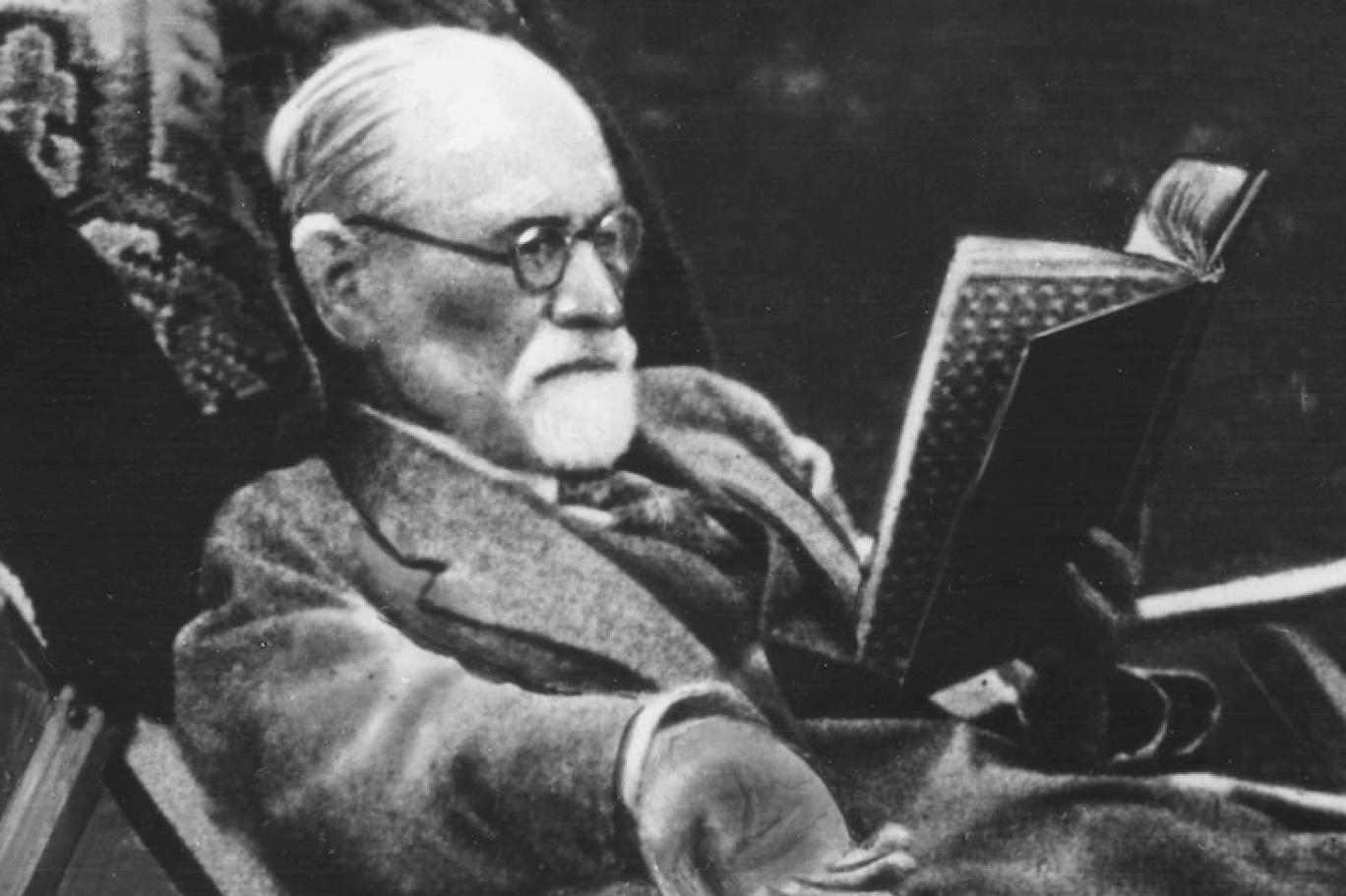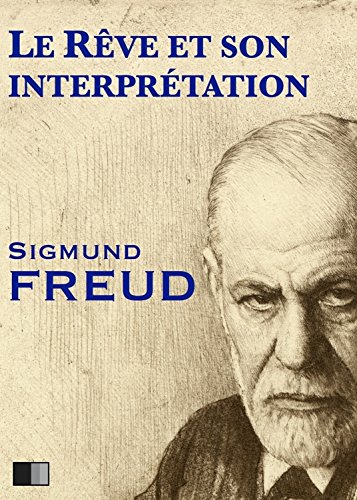كان الأديب الألماني توماس مان (1875-1955) يصرح، في امتداحه مؤسس علم النفس التحليلي، بأن فرويد "يفصح عن فكره إفصاح الفنان الموهوب"، ذلك بأن أبرز إسهاماته أتت في استجلاء مقام اللاوعي في النفس الإنسانية، ولو أن الآخرين كانوا قد سبقوه إلى هذا التحليل، ومنهم الشاعر الصوفي والفيلسوف الألماني نوڤاليس (1772-1801) الذي استخدم اصطلاح اللاوعي، والفيلسوف الألماني كارل روبرت إدوارد فون هارتمان (1842-1906) الذي استخدم الاصطلاح عينه في عنوان كتابه "فلسفة اللاوعي" (Philosophie des Unbewussten). ثمة فلاسفة سبقوا أيضاً فرويد في تحليل بنية اللاوعي تحليلاً دقيقاً، ومنهم الفيلسوف عالم الفيزيولوجيا الألماني كارل غوستاف كاروس (1789-1869) الذي ميز في كتابه "تطور تاريخ النفس" (Psyche. Zur Entwicklungsgeschichte der Seele) اللاوعي المطلق من اللاوعي النسبي.
ارتباط الدين ببنية اللاوعي
لا ريب في أن فرويد تناول موضوع الدين في سياق تحليل بنية اللاوعي، إذ أكب يعتني بمسألة الاختبار الديني في أبرز أعماله، فعالجها أولاً في كتابه "الطوطم والمحرم" (Totem und Tabu)، وعاد إليها في بحثه "مستقبل وهم" (Die Zukunft einer Illusion)، وختم خلاصاته في دراسته إرباك في الثقافة (Das Unbehagen in der Kultur). في جميع هذه التناولات، عمد إلى تحليل اللاوعي تحليلاً يروم التقيد بالعلمية الصارمة. غير أن هذه الصفة ما لبثت أن أشكلت على كثير من الباحثين النقديين الذين لم يؤيدوا مثل الادعاء المعرفي هذا. في جميع الأحوال، تشير الكتابات التي تناول فيها فرويد مسألة الدين إلى أنه كان يربط ربطاً وثيقاً التصورات الدينية التوحيدية الكتابية (لا سيما روايات موسى ويوسف) بالإرث الفكري الإغريقي، خصوصاً الأسطوري منه المتجلي في التراجيديا (أوديب).
في المحاضرة التي تناول فيها فرويد عام 1917 صعوبة التحليل النفسي، أشار إلى الإزعاجين الجسيمين اللذين أصابا البشرية في صميم كرامتها: نجم الأول عن نظرية كوبرنيكوس (1473-1543) التي أبان فيها أن الأرض ليست مركز الكون، بل نقطة ضائعة في الرحابة الكونية شبه المطلقة، ونشأ الثاني من نظرية داروين (1809-1882) التي افترض بواسطتها أن أصول الإنسان ليست ناشبة فيه، بل في البنية الحيوانية التي انحدر منها. وما لبث فرويد أن أضاف الإزعاج الثالث الذي جرته على البشرية مقولة اللاوعي التي تحرم الأنا من ادعاء السلطة المطلقة على ذاتها. فالإنسان لم يعد سيد منزله الداخلي، بل أضحى عرضة للدوافع والغرائز الدفينة التي تستثير فيه التصورات والأفكار والمسالك والتصرفات، بحيث لا يستطيع أن يتطور تطوراً ثقافياً إلا بفضل الإعراض التدريجي عن الاندفاعات التأسيسية.
الاختبار الديني المقترن بعقدة قتل الأب
على نهج تقسيم الاختبارات العقلية والوجدانية الثلاثي الذي اعتمده غير فيلسوف من فلاسفة العصور الحديثة، من أمثال أوغست كونت (1798-1857)، وكيركغارد (1813-1855)، ونيتشه (1844-1900)، يجزئ فرويد تطور البشرية إلى ثلاث حقبات: الأولى إحيائية طوطمية، والثانية دينية تتصف بالعصاب الجماعي، والثالثة علمية تتميز بالتصعيد الارتقائي التعويضي (sublimation). ومع أن التصور الثلاثي هذا لم يقبل به علماء البيولوجيا والأنثروبولوجيا، فإنه يدلنا على طريقة ربط الدين بالعصاب، ويحيلنا على نظرية نشوء الاجتماع من جراء قتل الأب الأصلي المهيمن على نساء القبيلة. تشير هذه الجريمة رمزياً إلى حظر سفاح القربى، أي إلى التشريع التأسيسي الذي استولد المعية الإنسانية السليمة.
غير أن قتل الأب الأصلي لم يحرر أهل القبيلة، ولم يعتق غرائزهم من ضرورات الكبح الذاتي، بل استثار في الوقت عينه الشعور بالذنب والرغبة في المعاهدة. نشأ الشعور بالذنب من موقف الإعجاب والإكرام الذي أخذ يقفه أبناء القبيلة من سلطان الأب المقتول الذي لم يعد يلقي الرعب في القلوب ويستثير الحقد في النفوس. أما المعاهدة، فطفق يستحسنها جميع الذين جمعهم ذنب القتل من غير أن يتيح لأي واحد منهم أن ينوب مناب الأب. فما كان عليهم فإن تناصروا لكي يدرؤوا عنهم مخاطر الاستئثار بالقوة.
ومن ثم، فإن الرابط الاجتماعي ينشأ من تناصر الإخوة المذنبين. لا شك في أن فرويد لم يحد قيد أنملة عن هذا التحليل، ولو أنه عد قتل الأب حدثاً رمزياً أدخل الإنسانية في طور الالتئام الاجتماعي القانوني. وعلاوة على ذلك، عاين في الأديان التوحيدية، لا سيما المسيحية، أثر هذه البنية الانتظامية المستندة إلى حدث القتل، إذ حل ابن الله محل الأب الأصلي، واستبدل المسيحيون العشاء السري (قداس الإفخارستيا) بالمواظبة على الوليمة الطوطمية التي تتغذى بأغنى الكائنات الحيوانية إلهاماً وأرفعها مرتبة.
في الكتابات الأولى التي تناولت الدين، أكب فرويد على تحليل الشعائر الدينية ليعاين فيها أفعالاً هلوسية إرباكية تفضي إلى تأزم داخلي (العصاب) يدفع بالإنسان إلى الاضطراب النفسي الناجم عن كبح الغرائز الطبيعية المتقدة في باطنه، ذلك بأن قمع بعض الاندفاعات الغرائزية والتخلي الإكراهي عنها يسوغ نشوء الأنظومة الدينية التي تعزي الناس المحرومين من الاستمتاع بمثل الحيوية الغريزية الجياشة هذه. غير أن التحليل النفسي الذي يسوقه فرويد لا يعدو أن يكون مجرد وسيلة من وسائل معالجة الاضطراب النفسي. ومن ثم، فإنه تحليل حيادي لا تصح فيه صفة الديني أو اللاديني، بحسب ما أشار إليه فرويد في 9 يناير (كانون الثاني) 1909 في رسالته إلى القسيس اللوتري والمحلل النفسي السويسري أوسكار بفيستر (1873-1956).
الدين وقلق الوجود
استهل فرويد، في كتابه الشهير "مستقبل وهم"، تحليل الظاهرة الدينية، راسماً أن الحضارة ينبغي أن تستلهم القيم الأخلاقية حتى تضمن نزاهتها واستقامتها، وتحمي نفسها من الميول الفردية الهدامة. بحسب الطبيب المحلل النفسي السويسري جان-ميشل كينودوز (1934-...)، كان فرويد يضم إلى القيم الأخلاقية هذه القيم الوجدانية النفسية، والمثل الثقافية العليا، والأفكار الدينية الرفيعة. يبين كينودوز في كتابه "قراءة فرويد: استكشاف أعماله استكشاف الترتيب الزمني" (Lire Freud. Découverte chronologique de l"œuvre de Freud) أن التصورات الدينية تجسد القيمة الأخلاقية الأرفع التي تضمن ازدهار الحضارة الإنسانية ورقيها.
بيد أن فرويد نفسه عاد، في كتابه عينه، ينتقد الأديان، لا سيما الدين المسيحي، ويحرض الناس على النظر إليها نظرتهم إلى وهم طفولي ينبغي التحرر منه حتى يبلغوا طور النضج، ذلك بأن الأديان، في نظره، توهم الإنسان بأنه قادر على تلبية رغائبه الدفينة، ومن أشدها استثارة للنفس رغبة الطفل البائس في الفوز بالحماية والعطف والمحبة. سر سحر الأديان نابع من سر قوة الرغائب المكتومة هذه. أما أصل هذه الرغائب، فناشب في عقدة أوديب التي تنشئ بنية الشخصية الإنسانية، وتدفع بالإنسان إلى الاستئثار بعاطفة الأم في حال الطفل الذكر، وقياساً على ذلك، بعاطفة الأب في حال الطفلة الأنثى. غير أن هذه العقدة تستجر على الإنسان الشعور بالذنب ورغبة التطهر التي تسهم في بناء الأنظومة الأخلاقية الضابطة.
في كتاب "مستقبل وهم"، يقارن فرويد الطقوس الدينية بالشعائر المدنية التي تروم حماية الإنسان من ذاته القلقة. فالأديان تعفي الإنسان من أزمة العصاب على قدر ما تتيح الطقوس الجماعية احتواء قلق المؤمنين ومعالجته معالجة رمزية، ولكنها تبقي على حال العصاب التوهمي الذي يفضي إلى الهذيان والهلوسة، إذ تحبس على الإنسان في قفص الحاجة الدائمة إلى الحماية الأبوية. ومن ثم، ينبغي للمؤمن أن يستعطف الأب بواسطة التقيد الصارم بالمبادئ والأحكام الأخلاقية السائدة.
ضرورة الدين في تهذيب الغريزة الإنسانية الجياشة
في كتاب "إرباك في الثقافة"، يشبه فرويد أثر الدين في النفس بأثر التخدير الذي يصيب الأعضاء، مقتدياً بماركس الذي وصف الدين بأفيون الشعب، ما دام الإنسان لم يعثر على مركزه الذاتي، فإن الدين سيظل بمنزلة الشمس الوهمية التي تحوم حول الإنسان السليب الاتزان. غير أنه ما لبث أن طور تحليله في الكتاب عينه هذا، مستجلياً جانباً لافتاً في الاختبار الديني استثارته مراسلاته للأديب الصوفي الفرنسي المتوج بجائزة نوبل رومن رولان (1866-1944) الذي كان يرفض اختزال الشعور الديني ورده إلى حال الارتكاس الطفولي. كان رولان يعتقد أن الإيمان "شعور محيطي" رحب الامتداد يجعل الوعي الفردي يتماهى بالكون ويذوب فيه ذوباناً منعشاً. لم يستنكف فرويد عن تحليل الشعور المحيطي هذا، ولو أنه أخضعه لضرورات الأنظومة الدينية.
لا بد من التذكير بأن الاختبار الديني عنصر من عناصر الثقافة التي يعاين فيها فرويد مجموع المؤسسات الرمزية التي تحرر الإنسان من حيوانيته. بما أن الطبيعة الإنسانية تنطوي على الانفعالات والغرائز والدوافع والحاجات، فإن الإنسان، لكي يحيا في المجتمع حياة سليمة، ينبغي له أن يبطل هيمنة هذه العناصر. ومن ثم، كلما ارتقى مستوى الاجتماع الإنساني، تعاظمت تضحيات الأفراد الذين يتخلون عن قسط من غرائزهم، لا سيما الجنسية منها. في كتاب "إرباك في الثقافة"، ينسب فرويد سبب العصاب الفردي إلى الثقافة التي تضطر الفرد إلى الامتناع والتزهد والحرمان الألمي من أجل استنقاذ السوية الإنسانية، ذلك بأن الثقافة تحمي الإنسان من غرائزه، ولكنها تفرض عليه اضطراباً هذيانياً يربك وجدانه.
في بعض الأحيان، ينتفض الأفراد على نظام الثقافة الحرماني، فيثورون ويخالفون القوانين. غير أن اقتناع الانتظام في المؤسسة الثقافية الرمزية لا يلبث أن يستدرك الثوران، فيعزي الناس ويعوضهم من التضحيات والحرمانات، محرضاً الجميع على الاستهلاك والتسلية، والاحتفاء بالوطنيات الجامعة، وتذوق الجماليات الشعائرية في الطقوس الدينية، لذلك يبدو الدين في منزلة التعزية التي تمنحها الأنظومة الثقافية من أجل إسعاد الناس الخاضعين لضرورات الحرمان الإكراهي الذي ينشئ الاجتماع الإنساني السليم.
في جميع الأحوال، ما برح الدين في نظر فرويد قائماً في أساس الحضارة الإنسانية، وفي أصل المسعى الذي يدفع بالإنسان إلى التزهد بالاندفاعات الغرائزية المهلكة، ولكن ما سر ديمومة الدين في المجتمعات الحديثة والمعاصرة التي أعرضت بواسطة العلوم والتقنية عن جميع أصناف الوهم؟ ليس ما يمنع الفكر النقدي من تدبر أحوال التدين المعاصر. إذا كانت الأديان تزود الناس الأجوبة الشافية التي تستثيرها اختبارات القلق النفسي، فإن العلم، على سبيل المثال، لا يجوز له أن ينوب مناب الدين، إذ إنه لا يستطيع أن يجيب عن مثل الاستفسارات الوجودية القصية هذه. على طريقة المفكرين العقلانيين، لا يهمل فرويد سلطان التصورات الدينية، بل يكب على إظهار أثرها في توطيد عرى الروابط الاجتماعية وترسيخ بنيان الجماعة، من غير أن يغفل محنة الإقصاء العنفي الذي تجره المبايعة الدينية على الآخرين.
بين حكم الرغبة ومنطق العقل
لا شك في أن فرويد كان شديد الإصرار على نعت الدين بالوهم. غير أن ذلك لا يعني أن الوهم خاطئ، بل يدل على أن الإنسان يطمح إلى الامتلاء الكياني الأشمل. ضلال الوهم أنه يخضع لمنطق الرغبة الملتبسة، عوضاً عن أن يتقيد بمعايير الحقيقة الموضوعية، ولكن إذا تقيد الإنسان بأحكام العلم، بطل الوهم وسقط من تلقاء ذاته. أما خطورة هذا الوهم، فتكمن في أنه يعطل مقتضيات البحث المنطقي، متشبثاً بمعتقد جماعي يلبي بعضاً من جوانب الرغبة الإنسانية. ومن ثم، فإن السبب الذي دفع فرويد إلى رفض الإيمان الديني إنما يتعلق بطبيعة المعتقد الذي يعطل حس الشك والمساءلة والنقد في ذهن المؤمنين، فيتحول الاختبار الإيماني إلى سد منيع يصد الناس عن التفكير الحر، الذاتي، النقدي، المتطلب، ويحبس عليهم في أوهام طفولية مرضية تزين لهم أنهم يعالجون بها حاجاتهم العصابية المربكة.
ربما يكون فرويد محقاً في الارتياب من هيمنة ذهنية المبايعة الدينية العمياء. غير أن عقلانيته تضطره إلى امتداح الجانب الإيجابي المفيد في المعتقد الديني الذي يجعل الناس يقبلون تدبير اندفاعاتهم الغرائزية تدبيراً نفسياً سليماً على قدر ما يتخلون عنها طوعاً بمؤازرة الشعائر الدينية الجماعية، ذلك بأن المعتقد، حين يضعف ويتقهقر، يفقد قدرته الإقناعية التي تؤهله لمساعدة الناس في قبول الممنوعات الثقافية الأساسية كالقتل وسفاح القربى. وعليه، ينبغي أن يدرك الناس أن المحرمات الأساسية ضرورية في انتظام الاجتماع الإنساني.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولكن كيف يستطيع المجتمع، بمعزل عن الاختبار الإيماني، أن يستثير في وجدان الناس الطاقة الوجدانية التي تستعين ببعض الوهم الديني من أجل إقناع الناس بصون القيم الأخلاقية العظمى صوناً يستنهض الرغبة القادرة على الائتمار والمبايعة؟ إذا قارن المرء الوهم الديني بالوهم العقلاني الذي تستثيره العلوم، اتضح له أن الفكر العلمي، ولو أنه يستند إلى فرضيات قابلة الطعن ويغتذي بآمال الإمساك المعرفي الصارم، لا يتردد البتة في تقويم مسلماته، ومراجعة عملياته، ومساءلة خلاصاته. فهل نستطيع أن نعتمد المساءلة العلمية المزعجة في نطاق البنيان الاجتماعي الذي يقتضي الاعتصام بمبادئ التربية السليمة المستندة إلى شرعة حقوق الإنسان؟
حاول فرويد أن يستعيد سؤال الوهم الديني في كتابه "إرباك في الثقافة"، متناولاً جانباً من جوانب الاختبار الإيماني يتعلق بفضيلة محبة القريب، ولكنه ما لبث أن عاين وهمية المثال الإنجيلي هذا واستعصاءه على التحقق، إذ إن الوقائع التاريخية تبرهن لنا أن الناس لم يحبوا بعضهم بعضاً. ومن ثم، تتحول وصية المحبة الأخوية، حين يستحيل تطبيقها في الحياة اليومية، إلى عبء نفسي يفضي ببعض الناس إلى اليأس، وببعضهم الآخر إلى الرياء والمكر والمخادعة الرخيصة، لذلك يعتقد فرويد أن الوهم الديني ينطوي على رغبة طوبوية مثالية تضع الناس أمام حائط الاستحالة العملية قبل أن تقذف بهم في لجة الانهيار.
الدين بحث حر عن المعنى المطلق
يعد فرويد نفسه يهودياً ملحداً يحيا من دون الله، ويعتقد أن الإنسان في تدينه إنما يخسر من ذاته أكثر مما تكسبه إياه المبايعة الدينية. من المستغرب ألا يتناول مسألة الاختبار الصوفي الروحاني. غير أنه في كتابه "نتائج، أفكار، مشكلات" (Ergebnisse، Ideen، Probleme) الذي يستعيد الملاحظات التي دونها في لندن في عام 1938، وقد ضمنها باقةً من الاستنتاجات العيادية، يعلن أن التصوف حال غامضة من الإدراك الذاتي يتناول به الإنسان الملكوت القائم خارج الأنا. بعض الباحثين يربطون هذا الوصف بمقولة الشعور المحيطي التي كان رومن رولان قد حدثه عنها. في جميع الأحوال، يتسم تحليل فرويد بالسمة العقلانية التي تتحرى أصل الاختبار الديني لتعثر عليه في رواية أسطورية أصلية تجعل الإنسان المؤمن خاضعاً لمنطق الرغبة الملتبسة التي تجسد له، في الوقت عينه، مصدر القوة وسبب الاضطراب والانسداد. أما مقصده الأقصى، فيقضي أن يتجاوز الإنسان إرباكات الطفولة وعقدها الدفينة حتى يبلغ طور النضج الوجداني السليم.
بيد أن فرويد أخطأ حين حصر الاختبارات الوجدانية في ملء الشواغر النفسية والحرمانات الجنسية، ذلك بأن الاختبار الإيماني، إذا كان على مقصده الصافي، لا يروم سد الثغرات الوجودية وشفاء الاضطرابات النفسية، بل يسعى إلى استجلاء المعاني الإنسانية القصية المطلقة التي تهب الناس القدرة على فهم سر الحياة. ليس الدين علاجاً لاضطرابات الوعي وأسقامه الناجمة عن الرغبات المكبوتة والغرائز الحيوانية، بل اختبار فردي حر يحمله الناس على وجوه شتى، يساعدهم في اختبار عمق المعنى الوجودي المنحجب وراء الأشياء والظواهر والأحداث. أصاب فرويد في تشخيص أحوال المؤمنين النفسية، ولكنه أخطأ في جعل الدين مجرد تعزية نفسية تساعد الإنسان في التعويض عما فقده من عاطفة الأهل وعشق الحبيب وود الأليف. ليس الإيمان الحق علاجاً للنفس المريضة، بل مسعىً وجداني حر يطلب فيه الإنسان معنى الوجود في رحابة المساءلة المتطلبة. ومن ثم، فإن الإيمان، خلافاً لفرويد، محنة استفسارية وجودية شاملة تستنهض كيان الإنسان بأسره. لا يؤمن الإنسان إيماناً سليماً حتى يشفى من مرضه النفسي، ذلك بأن المريض النفسي لا يحتاج في المقام الأول إلى الإيمان، بل إلى العلاج. الأصحاء الذين لا يحتاجون إلى اختبار المساءلة الإيمانية إنما هم الذين يظنون أنهم امتلكوا معنى الوجود وأمسكوا بأسرار الحياة.