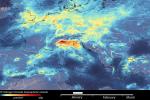في اليوم الأول للاحتفال بيوم الأرض في 22 أبريل (نيسان) 1970، لم يكن التغير المناخي وإزالة الغابات والزراعة المختلطة بالمواد الكيماوية، تُمثل أزمة وجودية للعالم كما هي حال الآن، بل كانت القضية ببساطة هي التلوث، وكانت أميركا هي المُنقذ، إذ خرج 20 مليون أميركي يمثلون عُشر سكان الولايات المتحدة في هذا الوقت استجابةً لدعوة من أعضاء في الكونغرس ونشطاء البيئة للضغط من أجل حماية الهواء والماء والأرض وجميع الكائنات الحية من سموم المجتمع الصناعي، وسرعان ما انتشرت الدعوة إلى العالم أجمع ليصبح هذا التاريخ يوماً للأرض، فما الذي حوّل أميركا من قائد للعالم في إنقاذ البيئة قبل 50 عاماً إلى متجاهل لها، ومُنسحب من جهود المجتمع الدولي، ليس فقط في شؤون البيئة واتفاق باريس للمناخ، بل ومن اليونيسكو، وأخيراً من منظمة الصحة العالمية.
قوة شعبية دافعة
خروج الأميركيين بهذه الكثافة للتظاهر وتنظيم الفعاليات من الساحل الشرقي للبلاد إلى الساحل الغربي، ومبادراتهم القوية لزرع الأشجار وجمع القمامة من الشواطئ، كانت من القوة التي أجبرت الرئيس ريتشارد نيكسون والكونغرس على الاستجابة السريعة لمطالب الحركة البيئية الوليدة، فأُنشئت وكالة حماية البيئة، وصدرت مجموعة قوانين مثل قانون الهواء النظيف والماء النظيف وقانون حماية الكائنات المعرّضة للانقراض، وانتقل الحراك الأميركي إلى أوروبا والعالم أجمع ليصبح بداية حركة بيئية عالمية امتدت لتشمل 180 دولة وجعلت الأمم المتحدة هذا التاريخ يوماً عالمياً للأرض.
ولولا تفشّي وباء كورونا حول العالم وما صاحبه من سياسة الإغلاق، لشهدت عواصم وكبريات المدن العالمية احتشاد مئات الملايين من المدافعين عن البيئة، لجذب الانتباه للقضايا البيئية المُلحّة، وعلى رأسها أزمة التغير المناخ والاحترار العالمي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
قيادة أميركية
تأثير يوم الأرض امتدّ إلى العالم تحت قيادة أميركية مؤثرة، إذ أدرك خبراء وزارة الخارجية الأميركية أن المشاكل البيئية لا تتوقف عند حدود الدول، ولهذا أسّسوا آليات لمناقشتها بشكل مشترك مع الدول الأخرى، وتمثل التحدي في كيفية عمل الدول المختلفة معاً. ففي عام 1970، كانت أكاسيد الكبريت والنيتروجين المنبعثة من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في بريطانيا، تنتقل عبر الرياح لمئات الأميال قبل أن تعود إلى الأرض في شمال أوروبا في شكل أمطار حمضية وضباب وثلوج، ما كان يضر بالغابات والبحيرات في دول مثل السويد وألمانيا.
ومع إدراك الجميع أن حلول هذه المشاكل تحتاج إلى عمل جماعي مشترك، شجعت الولايات المتحدة الدول الأخرى على عقد أول اجتماع عالمي حول البيئة في ستوكهولم، عاصمة السويد في يونيو (حزيران) عام 1972، شارك فيه ممثلون عن 113 دولة تبنوا إعلان ستوكهولم الذي أكد حق الإنسان في بيئة تسمح بحياة كريمة تحافظ على صحة البشر وحياتهم.
وعلى عكس موقفها اليوم، كانت الولايات المتحدة المُحرك الفاعل للمؤتمر، وتقدم الوفد الأميركي بسلسلة إجراءات، منها وقف صيد الحيتان وتنظيم إلقاء النفايات في المحيطات وإنشاء صندوق عالمي للحفاظ على الأراضي البرية والمعالم الطبيعية.
قلق الدول النامية
لم يستقبل عددٌ كبيرٌ من الدول الضغوط الأميركية بترحاب، فقد كانت فرنسا والمملكة المتحدة قلقتين من أن الإجراءات التنظيمية لإعلان ستوكهولم قد تعوق مشروعهما الوليد المشترك المتمثل في أسطول طائرات الكونكورد الأسرع من الصوت التي دخلت الخدمة عام 1969 واشتهرت بأنها من الملوّثات للبيئة، كما كان الشك والتوجس يساوران معظم الدول النامية التي اعتبرت أن المبادرات الأميركية والأوروبية البيئية الجديدة، جزء من أجندة غربية تستهدف منع الدول النامية من التصنيع.
برنامج دولي للبيئة
وبسبب قيادة الولايات المتحدة للعالم الغربي، وافقت الدول الصناعية على تأسيس وتمويل أول معهد عالمي للبيئة تحت اسم "برنامج الأمم المتحدة للبيئة" الذي قاد مفاوضات أقرت اتفاقية فيينا للبيئة عام 1985 وأعقبها "بروتوكول مونتريال" عام 1987 الذي قيّد إنتاج المواد التي تضرّ بطبقة الأوزون، وما زال هذا البرنامج يقود الجهود الدولية للحدّ من التلوث والتغير المناخي وحماية التنوع البيولوجي.
كما كانت الولايات المتحدة منذ السبعينيات وحتى بداية التسعينيات أكبر مساهم في صندوق البيئة العالمي الذي يدعم عمل برنامج الأمم المتحدة حول العالم، إذ كانت المساهمة الأميركية تشكل حوالى 30 في المئة من إجمالي ميزانيته.
خطر التحول الأميركي
وعلى الرغم من أن الرئيس نيكسون الجمهوري كان من أكثر الداعمين المتحمسين لحماية البيئة عبر جهود دولية تدفعها الولايات المتحدة، إلّا أنّ الحال بدأ بالتغير عام 1994 حين سيطر الجمهوريون على مجلسي الشيوخ والنواب وشرعوا في تخفيض المساهمة الأميركية في تمويل صندوق البيئة بنسبة 84 في المئة حتى أصبحت أقل من مساهمة بلد صغير مثل هولندا بنحو 30 في المئة، على الرغم من أن الاقتصاد الأميركي يماثل 20 ضعفاً الاقتصاد الهولندي.
ومع وصول الرئيس ترمب إلى الحكم وحرصه على تطبيق سياسة "أميركا أولاً"، أعلن في الأول من يونيو عام 2017 انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ الذي تعهّدت خلاله 195 دولة بخفض الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 26 في المئة أقل من مستويات عام 2005 بحلول عام 2025 بهدف منع زيادة حرارة كوكب الأرض من الارتفاع درجتين إضافيتين عن المستوى الذي كان عليه قبل عصر الصناعة.
وبينما تتطلّب المشاكل الدولية وجود قدوة وقيادة عالميَّتَيْن، ظلت الدول النامية تترقب ما إذا كان ينبغي عليها الالتزام بالاتفاقات الدولية حال انسحاب الدول الكبرى منها أو عدم انصياعها لهذه الاتفاقات، وكما يقول إدوارد لاك، خبير الأمم المتحدة، فإنّ انحسار دور الولايات المتحدة يضع الأمم المتحدة في حالة غموض ويصبح المجتمع الدولي أقل قدرة على حل مشاكله الأساسية.
دوافع ترمب
يقول خبراء في مجال الطاقة إن دوافع ترمب الرئيسة وراء الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ أنه أراد إلغاء حدود الانبعاثات الكربونية التي أُقرّت في عهد أوباما من أجل إنعاش توليد الطاقة بالفحم وخلق وظائف بقيمة 30 مليار دولار خلال سبع سنوات، كما سعى إلى التنقيب في أراضي النفط الصخري والغاز لتحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط، ما تسبّب في إطلاق مزيد من غاز الميثان الذي يدمر الأوزون في طبقة الستراتوسفير في الغلاف الجوي.
ومع ذلك، اعترضت حوالى 130 شركة أميركية كبرى على قرار الانسحاب الأميركي وواصلت الالتزام بمعايير الاتفاقية، ولعل هذا ما يفسر انخفاض معدل انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 2.1 في المئة عام 2019 وفقاً لتقرير أصدرته مجموعة روديوم الأميركية.
وعلى الرغم من الأضرار البالغة التي سببها كورونا على الحياة العامة والحياة الاقتصادية، إلّا أنّ انخفاض حركة المواصلات والطلب على الكهرباء وتراجع النشاط الصناعي، أدت إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى مستويات أقل من الأزمة الاقتصادية السابقة عام 2008، لكن ذلك التراجع لا يقترب من المعدل المستهدف لخفض درجات الحرارة، إذ سيظل العالم في حاجة إلى خفض الانبعاثات بمعدل 7.6 في المئة كل عام طوال هذا العقد أي حوالى 2800 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون هذا العام كي يصل مستوى زيادة الحرارة إلى أقل من درجة ونصف فوق مستوى الحرارة المسجل قبل عصر الصناعة.
الجمهوريون وليس ترمب
وفي حين يبدو للبعض أن الرئيس ترمب استهدف المنظمات الدولية منذ أن خاض حملته الانتخابية عام 2016 وأنه الآن يفعل ما كان يتحدث عنه بما في ذلك انسحابه من منظمة اليونيسكو وأخيراً قراره عدم تمويل منظمة الصحة العالمية، إلّا أنّ عدداً كبيراً من المراقبين في واشنطن، يقولون إنّ عدم الارتياح للمنظمات الدولية كانت على الدوام من سمات سلوك الجمهوريين سواء كانوا من القوميين أو الانعزاليين أو من المؤيدين لليمين المتطرف الذين يحاربون العولمة.
وترجع كراهية هذا التيار للمنظمات الدولية إلى فكرة أساسية، وهي أن المؤسسات الدولية تسرق السيادة الأميركية منذ عقود عدّة، وأنه لا يمكن للأميركيين الاعتماد على المنظمات الدولية في ضمان أمنهم أو حماية مصالح بلادهم بالشكل المناسب.
ويشير محللون إلى أن هذا الخط حدّده الحزب الجمهوري عام 1984 على اعتبار أن تلك هي الطريقة المثلى كي يواجه الرئيس رونالد ريغان السوفيات الذين كانوا يستخدمون الأمم المتحدة لصالحهم من وجهة النظر الأميركية.
غير أن هذا التوجه اكتسب زخماً أوسع منذ ذلك الحين، فهناك تاريخ طويل من محاولات الجمهوريين تقويض المنظمات الدولية أو خفض تمويلها أو تشويه سمعتها مع كل قرار يتّخذه مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية أو يتعلّق بعمليات حفظ السلام ولا يروق للمحافظين، بل إن معركة ترمب مع منظمة الصحة العالمية ليست سوى أحدث حلقة في سلسلة مستمرة من هذا التوجه الجمهوري، على الرغم ممّا تقوله الإدارة الأميركية عن فشل منظمة الصحة العالمية في تحذير الولايات المتحدة من خطر تفشّي الفيروس في الوقت المناسب أو اتهام المنظمة بالتستّر على الصين وعدم الشفافية.
تاريخ من التوجس
وظل الجمهوريون عبر التاريخ في حالة توجّس تجاه المنظمات الدولية، فلأسباب تتعلّق بالحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، قرر الرئيس ريغان انسحاب أميركا من منظمة اليونيسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم) التي تُعنى بالحفاظ على المواقع الأثرية والثقافية حول العالم، ولم تعد الولايات المتحدة إلى اليونيسكو إلّا عام 2001 عندما تولّى الرئيس جورج بوش الابن رئاسة البلاد.
وفي عام 1995، قدّم رئيس مجلس النواب الجمهوري نيوت غينغريتش مشروع قانون كي تنسحب الولايات المتحدة الأميركية من المنظمة الدولية ككل وطرد مقر الأمم المتحدة من البلاد خلال أربع سنوات، غير أن المشروع لم يخرج من إحدى لجان مجلس النواب آنذاك، ومع ذلك فقد وصفت الناشطة السياسية المحافظة فيليس شافلي هذا المشروع بأنه "وطني وسيادي".
ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ رفض الجمهوريون التصديق على اتفاقية البحار عام 1982 التي أيّدها قادة البحرية الأميركية وحظيت بدعم دولي، وفي عام 2012، اعترض الجمهوريون على اتفاق أممي يتعلّق بأصحاب الاحتياجات الخاصة، كما احتوت إحدى أدبيات الحزب الجمهوري عام 2016 على قسم بعنوان "القيادة الأميركية السيادية في المنظمات الدولية". وبعد عام، انسحب الرئيس ترمب من منظمة اليونيسكو للمرة الثانية، كما انسحب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2018. وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ترمب "المستقبل ليس لأنصار العولمة وإنما للدول المستقلة ذات السيادة". وقبل ذلك، ألمح الرئيس الأميركي مراراً إلى فكرة التخلّي عن أقوى وأقدم التحالفات العسكرية في العالم وهو حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكن الكونغرس أضاف في مشروع الميزانية الدفاعية عام 2019 نصاً يمنعه من استخدام الأموال في وقف عضوية أميركا في "الناتو".
وعلى الرغم من أن إدارة ترمب سلّمت الأمم المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أوراق انسحابها رسمياً من اتفاق باريس للمناخ، إلّا أنّ تنفيذ الانسحاب لن يتم عملياً إلّا في اليوم التالي للانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل، لكن نائب الرئيس السابق جو بايدن والمرشح الديمقراطي المفترض في الانتخابات الرئاسية، أعلن أنه سيعيد الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس حال فوزه في المنصب الرئاسي.