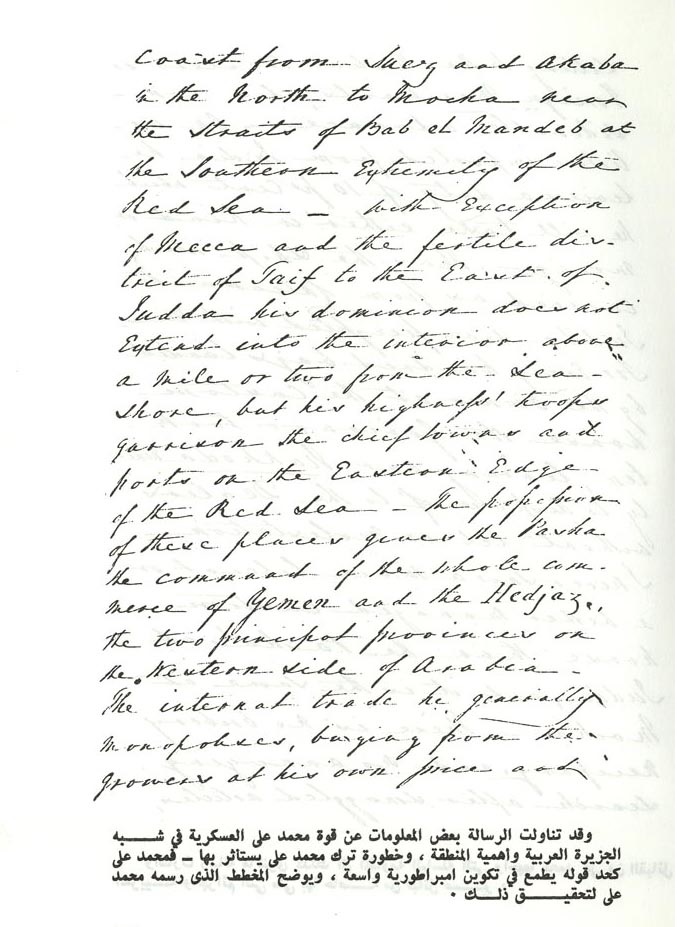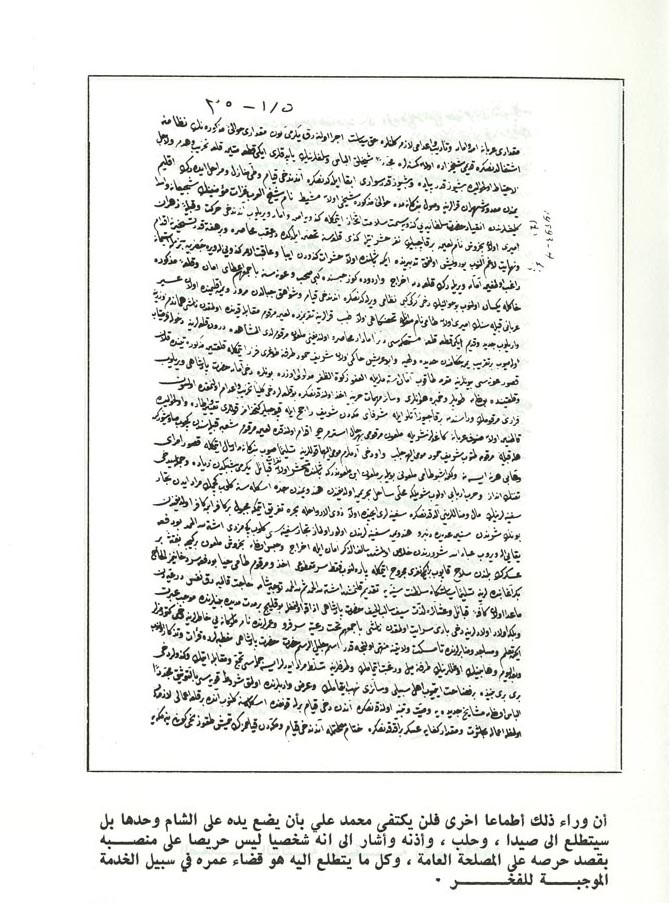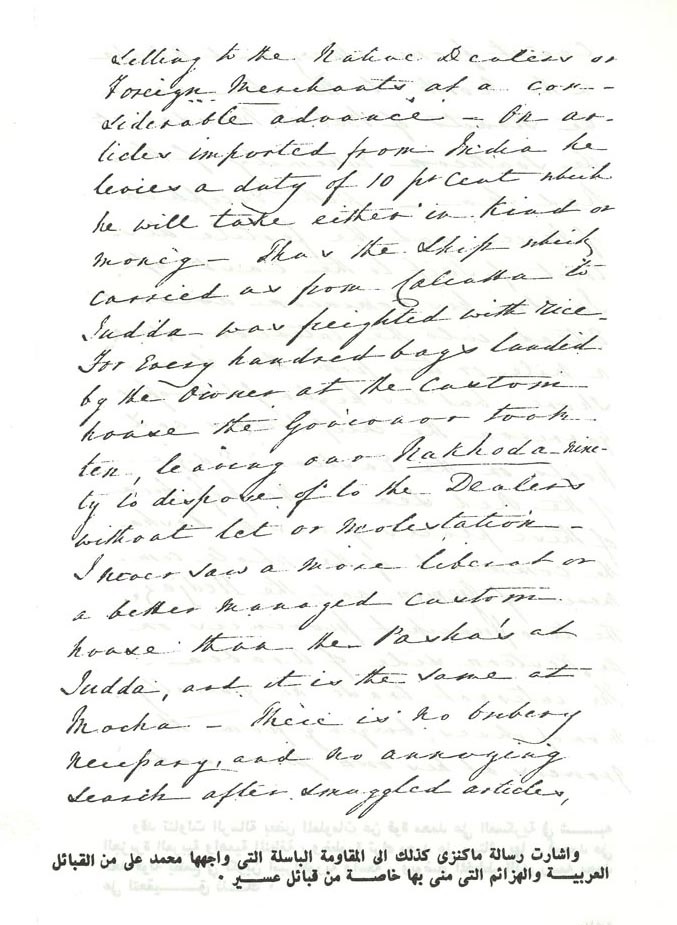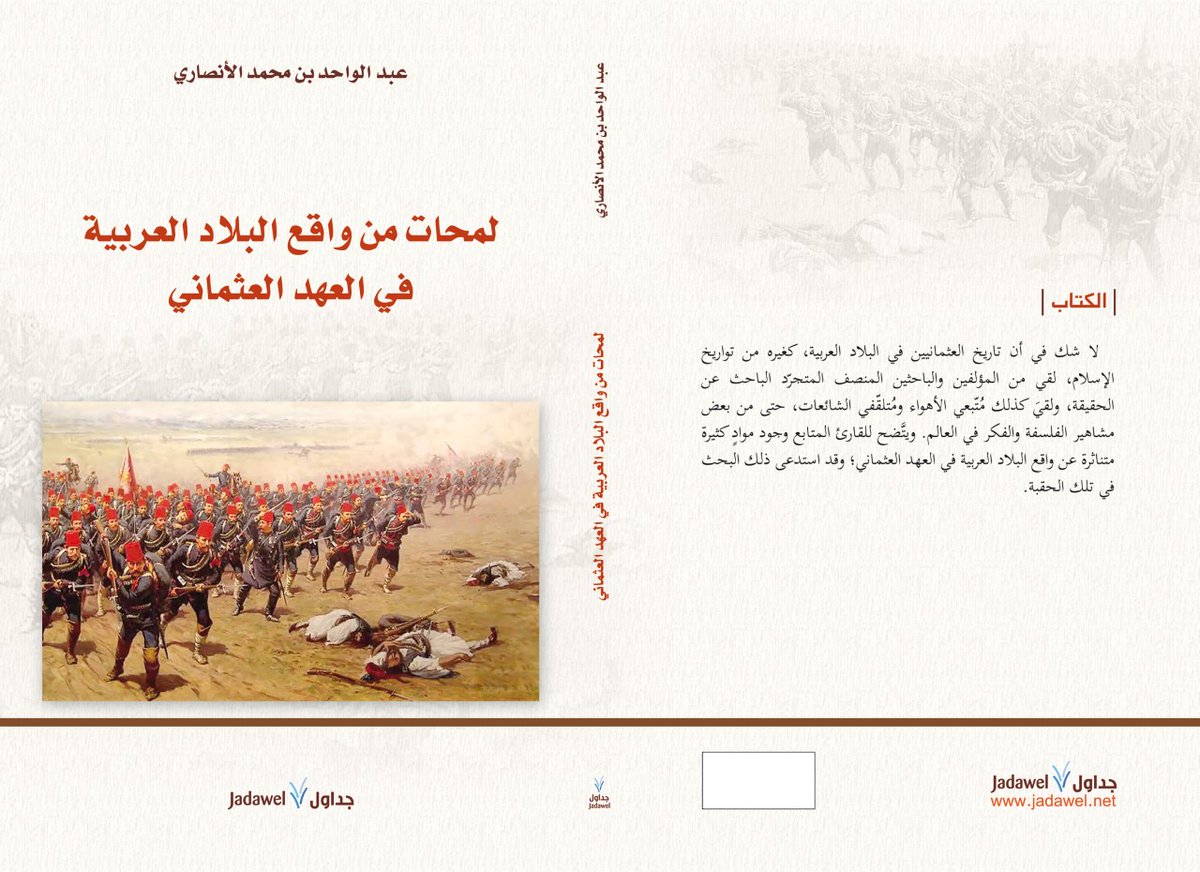عندما نعودُ إلى الوثائق التاريخية التي يضم الأرشيف العثماني كثيراً منها، فإن شيئاً واحداً كان ثابتاً لا يتحوَّل في هواجس الدولة العلية، هو نزعة الاستقلال والكرامة عند العربيّ، الذي يأبى أن يصبح تابعاً في أرضه وموطن أجداده، حتى وإن كان ذلك باسم "الخلافة" التي احتلّ باسمها العثمانيون أجزاءً واسعة من المنطقة العربية، ولم يكن الاستثناءُ سوى أقل القليل.
لذلك، ينشغل باحثون ومؤرخون في قراءة ذلك الإرث التاريخي، لفَهم دوافع العثمانيين نحو اتخاذ العرب الذين يلمزونهم بكل نعوت التحقير، أنداداً مرعبين، لا تسامح مع أي طموح لهم بالنهضة، حتى وإن أقروا للعثمانيين بالزعامة ذلك الحين، ولم ينازعوهم غنائم "الخلافة" وخراجها المالي وزخمها السياسي، وفقاً لما تكشفه الوثائق والشواهد التي حصلت عليها "اندبندنت عربية" في استقصائها.
يأتي ذلك متزامناً مع ما يُوصف بتجدد الأطماع التركية في مناطق عربية عدة، مثل سوريا والعراق وليبيا وقطر، إثر تدخل حكومتهم في شؤون ما استطاعوا من دول عربية، بصورة يراها الأمين الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى "أخطر من التدخلَين الإيراني والإسرائيلي".
الاستحواذ على "البردة ومفتاح الكعبة"
بطش إسطنبول أيام إمبراطوريتها، وإن ظهر في الشام والعراق موئل الخلافة قبل العثمانيين، فإنه أكثر ما كان واضحاً في تعامل السلاطين مع مصر والجزيرة العربية، فما إن أخضع سليم الأول كيان دولته في إسطنبول حتى اتّجه نحو مصر يغزوها على الرغم من كونها دولة تدين بالإسلام، ما جعل بقية الأقطار الإسلامية القريبة مثل الحجاز والشام تفهم رسالة القوة الجديدة، فجعلت تلك المراكز تبحث بكل ما أوتيت من سياسة وحنكة تحاشي شر الترك بإعلان الطاعة لهم إقليماً بعد آخر، لدرجة أن شريف مكة "أبا نمي" ما إن سمع أن سليم الأول سيطر على مصر حتى بعث إليه ابنه "رهينة"، ومعه "بردة النبي عليه السلام ومفتاح الكعبة المشرفة والروضة الشريفة"، ضمن هدايا عديدة لتجنُّب الزحف نحو إقليمه، وفقاً للباحث السعودي الدكتور سعيد بن طوله، في التمهيد لكتابه عن "سفر برلك"، التي مثّلت واحدة من أشد جرائم العثمانيين قسوة في الجزيرة العربية، كما سيأتي.
لكن، تقديم القرابين لم يشفع للعرب، فالسلطان لم يكن استحواذه على مصر في 1517 سوى البداية، فما إن فرغ من فرض هيمنته عليها حتى انصرف جهده إلى أمر، بدا أنه كان الغرض الأساس من غزو مصر، وهو "الشرعية الدينية".
ومن أجل الحصول على تلك الغاية لا بدّ من تدبير أمر "الخلافة"، والسيطرة على "الحرمين الشريفين"، ولذلك انصرف الحاكم العثماني إلى تلك الغاية، مرتكباً في سبيلها ما وسعه من "جرائم الحرب"، وزرْع الخلافات والرعب، وشنّ الحملات العسكرية، وقطْع آذان الأسرى، وترويع الساكنة بالجملة، وتهجيرهم، وإحراق المكتبات ونهبها.
وكان أمر الخلافة آل إلى الدولة العثمانية في تحقيق الباحث التاريخي فهد بن عبد الله السماري بعد أن "ضمّ السلطان سليم الأول عام 1517، وعام 1516 مصر والشام والحجاز والعراق إلى دولته، فنمت بذلك دولته بعد أن كانت إمارة صغيرة ومنحة من السلاجقة منحتها للأمير عثمان خان الذي كان نصيراً ثم نديداً فسلطاناً".
ضرائب وبطش ونهب
لكن، السلاطين من آل عثمان على الرغم من حبهم الهيمنة باسم "الخلافة" لم تكن الجزيرة العربية محل اهتمامهم الفعلي في توفير خدمات الدولة من الأمن والعيش الكريم لسكّانها، إلا بالقدر الذي يوظفون الحرمين الشريفين في اكتساب الشرعية الدينية، وموانئ بحار العرب في تأمين تجارتهم، وإدارة حروبهم مع القوى المنافسة، مثلما يوثق الأكاديمي السعودي ناصر العقل.
وتبعاً لذلك وجد كثيرٌ من أبناء الجزيرة العربية في فترات مختلفة الإمبراطورية العثمانية عبئاً عليهم، فلا هي تقوم بعمارة أرضهم التي تتسلط عليها، ولا هي بالتي تترك شأنها لأبنائها لينهضوا بها كما فعلوا في القرون السابقة، ما شجّعهم على المبادرة بإدارة شؤونهم، كما فعل ابن سعود في الدرعية، وآل عايض في عسير، والشريف في الحجاز، وغيرهم، فكان ذلك مبرراً عند العثمانيين كافياً للعدوان بحجة البقاء تحت "عباءة الخلافة".
وفي نجد، منشأ الدولة السعودية منذ أربعينيات القرن الثامن عشر الميلادي على سبيل المثال، يشير العقل إلى أنّ "الدولة العثمانية لم تكن تأبه بالمنطقة وأحداثها، وليست عندها ذات شأن، ولذلك لم يكن لها على نجد سلطة مباشرة، بل كانت مهملة تتنازعها الإمارات المحلية أو المجاورة، وكان يقتصر وجودها في جزيرة العرب على اليمن والحجاز والبحرين والأحساء، وقد يكون لوالي الأحساء من قبل الأتراك شيء من الإشراف غير المباشر على نجد واليمامة بخاصة، وقد انقطع ذلك باستقلال زعيم بني خالد براك بن غرير بالأحساء عن الدولة العثمانية سنة 1080 هـ".
ولفت إلى أن ما كان من تبعية في بعض المراحل، كان "مجرد الاعتراف بالسيادة وحلب الضرائب أو تأمين السُّبل وتوفير المؤن ونحو ذلك، ولم يكن لها تدخل فعلي في الشؤون الداخلية، فكانت ولايات الإمارة والقضاء والحسبة والمرافق تُجرى من قِبل أهل الأقاليم أنفسهم، لا للدولة العثمانية وولاتها فيها حل ولا عقد، وهذا يرد به على الذين توهموا أنّ الإمام محمد بن عبد الوهاب والدولة السعودية خرجوا على الخلافة"، حسب قوله.
ضرب العرب بالعرب
ومع تزايد الدعوات لنهضة عربية على أسس إسلامية تعود إلى النهج النبوي وجدت الطليعة حسب الباحث السماري، وهو أمين عام لدارة الملك عبد العزيز المتخصصة في الأبحاث التاريخية بالسعودية، في "نهضة الدولة السعودية الأولى في نجد، وكان تأييد هؤلاء جاء متأخراً، فاستطاع المناوئون مثل السلطان ومحمد علي وبقية من الباشوات وبعض علماء الدين أن يركزوا الحملات الدعائية والعسكرية على نجد".
ذلك أنّ السلطان والمحيطين به يرون أن انتصار الدعوة الإسلامية بقيادة آل سعود خروج عن طاعة الخليفة وانفصال عن الإمبراطورية، وفي الوقت نفسه يرى السلطان في محمد علي انفصالياً آخر لعله قد يضعف الدولة العثمانية حين يستقلّ بمصر، فيغري الشام والعراق بالانفصال، كما فعل داوود باشا، حين استقلّ بالعراق حيناً.
وهكذا ضرب السلطان محمود حينها نجداً بمصر، وضرب السعوديين بمحمد علي، "مؤملاً هزيمة محمد علي أكثر من حرصه على هزيمة السعوديين، وتؤكد الوثائق الخلاف الواقع بين محمد علي والسلطان، التي كان محمد علي يحرص فيها على أن يكون طريقه إلى نجد والدرعية عبر الشام، ويدلي بحجج ويبرر، كما يطلب أن يكون والياً على الشام، وضمها إليه".
هل هو غسل العار؟
وحتى بعد القضاء على السعوديين تسجّل وثيقة الكابتن جيمس ماكنزي من فرقة خيالة البنغال الخفيفة عن محمد علي ونفوذه في المنطقة قول الكابتن "لا أعتقد أن نفوذ محمد علي سوف يستمر طويلاً، لأن الأتراك غير محبوبين في شبه الجزيرة العربية"، مبرراً أنه لا يمكن الإبقاء على الأجزاء المتناثرة من أملاك محمد علي المترامية الأطراف، لأن "نظام حكمه لا يستند إلى أساس شعبي"، ما يؤدي إلى انهيار صرح الإمبراطورية، وتحوّله إلى حطام.
وكانت حيازة السعوديين في عهد دولتهم الأولى لمكة والمدينة المنورة ألحقت العار بسمعة السلطان العثماني سليم الثالث، "فإن خليفة المسلمين وسادن الحرمين الشريفين لم يكن قادراً على تأمين الحج لرعيته، وبعد إطاحة السلطان سليم الثالث حاول السلطان الجديد الذي كان في السابق لعبة في أيدي الانكشارية إعادة الحجاز مهما كلّف الثمن إلى حظيرة الإمبراطورية العثمانية، واتضح أنه لا أمل في محاولات دفع والي بغداد ووالي دمشق إلى العمليات النشيطة ضد الوهابيين، وكانت الإمكانية الواقعية لدحر إمارة الدرعية هي استخدام قوات والي مصر المتقوي" حسبما يوثق المستشرق الروسي أليكسي فاسيلييف في تاريخ العربية السعودية من القرن الثامن عشر وحتى نهاية القرن العشرين.
ويستوقف الباحث محمد أديب غالب لدى تناوله "أخبار الحجاز ونجد في تاريخ الجبرتي" أن طوسون بن محمد علي باشا سيّره أبوه وهو فتى لم يبلغ العشرين من عمره في الحملة الأولى على حكّام الدولة السعودية، فأبحر سنة 1226 هـ من السويس إلى ينبع فامتلكها، وزحف بجنوده على الحشود السعودية فردوه إلى ينبع، ولمّا علم والده بانحداره أمدّه بنجدة، فاشتد بها أزره، وتقدّم إلى المدينة المنورة، فاحتلّها بعد تهديم سورها، واستسلام حاميتها، ثم دخل مكة المكرمة بلا مقاومة.
وفي صيف عام 1228 هـ كما يروي غالب زحف السعوديون على طوسون باشا وجيشه، فاستولوا على الأراضي التي بين الحرمين الشريفين، ولمّا بلغ والده انتصارهم سار بنفسه لنجدة ولده، فنزل جدة ثم أقام بمكة المكرمة مدة قصيرة، وأدّى فريضة الحج، ثم عاد إلى مصر، وظل طوسون يقاتل السعوديين إلى أن بلغ بعض المواقع في نجد، ثم اضطر إلى الرجوع إلى المدينة المنورة، بسبب قلة المؤن والعتاد، واستردّ السعوديون أكثر المواقع التي كان استولى عليها، وعاد إلى مصر بسبب بعض القلاقل.
استعباد الأسرى وسبي النساء
ويستحضر أليكسي فاسيلييف كيف كان تحرك إبراهيم باشا بعد خيبة طوسون نحو الدرعية في مارس (آذار) 1818، إذ بعد خضوع شقراء له توجه إلى ضرما، التي كان يدافع عنها محاربون أشداء من الخرج، ورغم القصف المدفعي واستخدام تكنيك الحصار لم يتمكّن باشا من إرغام الحامية على الاستسلام، إلا أن القوى لم تكن متعادلة، واقتحم جنود إبراهيم المدينة ونكّلوا بأهلها جزاءً لهم على المقاومة، وقطعوا آذان القتلى، كما هي العادة، وأرسلوها إلى القاهرة، ونهبوا المدينة عن آخرها، وبذلك فُتِحَ الطريق نحو الدرعية.
وعندما اتّجه إبراهيم باشا إلى الدرعية تمكّن من حسم المعركة بالمدفعية التي دمّرت تحصيناتها، كما أن توارد الأغذية والذخيرة والإمدادات طوال الوقت إليه أمّن النجاح لزحفه البطيء، وانتهت ستة أشهر من المعارك الطاحنة، فقد فيها السعوديون أقرباء الإمام بمن فيهم ثلاثة من إخوانه، وذكرت رسائل إبراهيم باشا أن السعوديين خسروا 14 ألفاً من القتلى و6 آلاف من الأسرى وغنم 141 مدفعاً، بينما تشير رواية ابن بشر إلى استشهاد 1300 شخص من السعوديين.
قطع الآذان
غير أنّ الجرائم العثمانية لم تتوقف عند هذا الحد، إذ تجاوزوا ما كانت تقوم به "داعش" في السنوات الحالية، وتعاملوا مع أسراهم العرب باعتبارهم عبيداً، على الرغم من حظر الشريعة الإسلامية التي يرفعون لواءها استعباد المسلم مهما ساءت الظروف.
وليس هذا ضمن ما ترويه المصادر السعودية في ذلك الوقت، لكن أيضاً المصرية المحسوبة على العثمانيين في ذلك الوقت، فيوثق المؤرخ المصري الجبرتي أن "عسكر المغاربة العرب (مجندون ضمن الجيش العثماني) الذين كانوا ببلاد الحجاز كان بصحبتهم من أسرى الوهابية نساء وبنات وغلمان، انزلوا عند الهمايون (مجلس وزراء بني عثمان في إسطنبول)، وطفقوا يبيعونهم على من يشتريهم مع أنهم مسلمون أحرار".
كما ذكر الكابتن الإنجليزي فورستر سادلير، في مذكراته "رحلة عبر الجزيرة العربية"، أنه حين رافق بعض الجنود في أثناء عودتهم نحو مصر، شاهد معهم "الجمال والخيول والنساء والأطفال والعبيد الذين سلبوهم خلال غاراتهم".
ويقول بوركهاردت المُطّلع من كثب على سير الحملة، إن هؤلاء الجنود "قتلوا ونهبوا في الطريق غالبية الوهابيين، وأرسلت إلى القاهرة 4 آلاف أذن اقتطعت من الوهابيين، وأعدت لإرسالها إلى الأستانة".
يمتهنون حتى حلفاءهم
لكن، نقمة العثمانيين على عرب الجزيرة العربية، لم تتوقف عند محاربيهم، فهذا شريف مكة الذي كان بين أوائل العرب إدانة للأستانة بالطاعة، نال حظه من إهاناتهم، إذ يوثق أليكسي فاسيلييف أن "شريف مكة غالب غدر به عميل السلطان محمد علي باشا في أواخر 1813، بزعم أن السلطان طلب ذلك، وأرغم الشريف غالب تحت تهديد الموت على أن يصدر أمره إلى أبنائه ليكفوا عن المقاومة. ونفاه بعد ذلك إلى القاهرة، وعيّن بدلا عنه صنيعته يحيى بن سرور، وهو من أقرباء الشريف غالب، وصادر أموال الشريف من نقود وأثاث وبضائع وبن وتوابل، بلغت قيمتها ما يعادل 250 ألف جنيه إسترليني".
وكانت النتيجة المباشرة لغدر محمد علي حسب الراوي "تجلَّت في غضب سكان الحجاز، خصوصا البدو، ولجوء كثير من عوائل الوجهاء إلى الوهابيين خوفاً من التنكيل ومشاركتها في الحرب إلى جانبهم".
فقهاء على فوهات المدافع
ويتوقف المستشرق الروسي فاسيلييف عند نهاية الدولة السعودية الأولى، ويروي كيف عُذِّب الأمراء والعقداء والفقهاء، وأطلقوا النار عليهم فرادى وجماعات، كما ربطوهم إلى فوهات المدافع، ومزقوهم بالقذائف تمزيقاً، وأرغموا سليمان بن عبد الله حفيد محمد بن عبد الوهاب على الاستماع إلى أنغام الربابة قبيل الإعدام، ساخرين من مشاعره الدينية.
وفي مدن وواحات جبل شمر والقصيم والدلم قتلوا أفراد عوائل الوجهاء والأعيان والعقداء، واستولوا على أموالهم، وأرسلوا أفراد عوائلهم وعوائل آل سعود وآل الشيخ ووجهاء نجد مع نحو 400 شخص، بينهم نساء وأطفال للإقامة في مصر.
وكتب الكابتن ج. سادلر أن تاريخ حملة إبراهيم باشا عموماً يكشف عن "سلسلة من أبشع القساوات الوحشية التي اقترفت خلافاً لأكثر الالتزامات قدسية، ففي بعض الحالات اغتنى من نهب القبائل نفسها التي أسهمت بقسط في انتصاراته، وفي حالات أخرى ينتزع ثروات أعدائه المغلوبين أنفسهم الذين تمكنوا في وقت ما من تحاشي غضبه".
وفي ربيع 1822 وصل قائدٌ مصريٌّ جديدٌ هو حسن بك، الذي انشغل بجمع الإتاوات والنهب، ورغم كل ذلك فإن السعوديين احتفظوا بجذور عميقة بين أهالي نجد، سمحت بعودة الدولة السعودية الثانية والثالثة، إلا أن الأتراك وحلفاءهم في المنطقة ظلوا يحاولون صناعة العراقيل أمام وجودها، إذ بعد سقوط الدرعية بـنحو 100 عام حاول حاكم المدينة فخري باشا، آخر أيام العثمانيين أن يقنع الملك عبد العزيز مؤسس الدولة السعودية الثالثة (الحالية) بأن يكون ضمن مجهود إسطنبول الحربي الرامي إلى قمع ثورة الشريف في الحجاز. وذلك بغية التخلُّص من عنصرين عربيين مهمين في الإقليم ليستفرد العثمانيون بالمشهد.
لكن، فطنة الملك عبد العزيز ومعرفته بمرامي باشا وحكومته، جعلاه يتحاشى الاصطدام مع الفريقين، حتى جاءت اللحظة المناسبة التي اقتضت توحيد أجزاء السعودية المعروفة اليوم، إذ جرى ضمّ إقليم الحجاز إلى بقية أجزاء المملكة الوليدة آنذاك، بعد نهاية الحرب العالمية الأولى.
إحراق الجثث في عسير
في جنوبي السعودية واجه العسيريون تقدُّم تحسين باشا إلى عقبة "شعار" متسلحاً بالمدفعية، لكن المقاتلين العرب في ما يذكر إبراهيم الحفظي في "تاريخ عسير خلال خمسة قرون"، استماتوا في صدّ الغزاة، وادّعوا أنهم "يريدون الاستسلام، ثم حين اقترب منهم الأتراك واجهوهم بالنيران، ثم التحمت القوتان فذبحت أعداد كبيرة من الطرفين، ولم ينج من العسيريين إلا ما يقرب من المئتين وخمسين، وعرفت تلك الموقعة بملحمة شعار، إذ جمع الأتراك قتلى العسيريين وأحرقوهم في بطن الوادي، ثم دفنوا قتلاهم قرب العقبة، وكانوا يدفنون الثلاثة والأربعة في قبر واحد".
وأثارت حادثة إحراق الأتراك قتلى العسيريين حفيظة رجال القبائل الخمس التي حرق عددٌ من أبنائها وهم بللحمر وبللسمر وبنو مالك وربيعة وفيده، فاندفع للانتقام من كل قبيلة خمسون رجلاً للثأر من الغزاة.
إلا أنّ الجرائم العثمانية توالت بعد ذلك، فما كاد يتغلب على ابن عايض في حربه الاستنزافية معه، حتى تصالح معهم على اتفاق يقضي بتسليم نفسه وعتاده ورجاله، إلا أن النتيجة كانت الغدر بهم، والانتقام منهم على الرغم من عهد الصلح الذي لم يلتزمه قائد جيش الترك في عسير.
لكن، موريس تاميزيه في كتابه "رحلة في بلاد العرب الحملة المصرية على عسير 1834"، يؤكد أنه "لم تمضِ فترة قصيرة على مغادرة نائب السلطان محمد علي للأراضي العسيرية مخلّفا بها حاميات عسكرية، حتى أصبح السكان لا يطيقون وجود هذه الحاميات المعادية على أرضهم، حيث بدأت حرب الاستقلال التي انتهت بإخراج الأتراك نهائياً إلى ما وراء حدود عسير. والعرب يدركون ما قد يحدث لأبنائهم الذين أخذهم الأتراك رهائن، لكن حب الحرية طغى على العطف الأبوي لديهم، والفرد يضحي بالعائلة من أجل مصلحة الأمة".
التجاسر على الشرف
ولهذا، يعتقد الأكاديمي السعودي محمد آل زلفة أنه ما من منطقة في الجزيرة العربية عانت صلف العثمانيين وبطشهم كما عانت عسير، وهي التي لم تستسلم إلى الغزاة الترك تحت كل الظروف، بل كانت في حربٍ وسجالٍ معهم مستمر.
وكان بين سلوكيات العثمانيين التي زادت من نقمة العرب المحافظين نحوهم، هو استسهالهم الجرأة على الأعراض، وتعاطي المحرمات في ذلك العهد. ويتداول الأهالي جنوبي السعودية بعض الروايات التاريخية التي يزاوجون فيها بين التغنّي ببطولات فرسانهم، وتخليد جرائم العثمانيين في ذاكرتهم كابراً عن كابر.
ومن بين تلك الروايات أنه "عندما استحلّ أحمد باشا بعضاً من عسير طلب منه أهل القرية الأمان، فوافق أحمد باشا، لكنّ العثمانيين لا أمان لهم فما هي إلا أيام وليالٍ حتى طمع أحمد باشا، وطلب من شيوخ قبائل عسير نساءهم، فاجتمع شيوخ عسير واتفقوا على أن يموت الجميع إشارة بسبابة اليد للأسفل، وكانت الخطة أن توضع النساء العسيريات أمام الجيش حتى يرى الرجل أمه وأخته وزوجته أمامه فإمّا أن يُقاتل قتال الأبطال وإما أن تذهب أمه وأخته وزوجته إلى الأتراك، وفعلاً وضعن في المقدمة، وقدموا وهم يرقصون فتوقع أحمد باشا وجيشه أنهم أقبلوا لتسليمهم الحرائر، لكن ما هي إلا دقائق حتى عادت النساء إلى الخلف، ثم انقضّ رجال عسير على الترك، وقتلوهم جميعاً، ولم ينجُ منهم إلا أحمد باشا، وساعده الأيمن محمد عون وشرذمة قليلة معهم هربوا إلى الحجاز مقرهم آنذاك".
الطربوش في اليمن فرض بدل العمامة
في اليمن، كان النهج العثماني نفسه لم يتغير في السيطرة، فحسب فاروق عثمان أباظة، تولّى القائد العثماني في عسير أحمد مختار باشا السيطرة على الحديدة، ومنها اتجه إلى صنعاء التي ضجت من سياسة الغدر والخيانة التي اتّبعها العثمانيون مع زعيم الإسماعيلية ومع أمير عسير من قبل رغم تعهدهم تأمين حياتهما، وعادت ذاكرة اليمنيين إلى ما عهدوه من الأتراك من غدرٍ وخيانة منذ وصولهم إلى اليمن للمرة الأولى في الأربعينيات من القرن السادس عشر، عندما غدروا بحاكم عدن، ثم حاكم المخا وأولاده، رغم تعهدهم لهؤلاء ضمان سلامتهم.
وهكذا، اتبعت الإدارة العثمانية في اليمن أسلوباً لإخضاع قبيلتي أرحب وحاشد، وذلك من خلال إحضار رؤوس القتلى إلى صنعاء يحملها الأسرى من رجال القبليتين.
وحاول الأتراك صبغ اليمنيين بالصبغة التركية، حتى إنّ الوالي أحمد فيضي باشا أصدر أوامره في عام 1895 بإلزام جميع الموظفين العثمانيين في اليمن لبس الزيّ التركي، واستبدال العمائم بالطربوش، كما استحصل إعانة من أهالي صنعاء في السنة نفسها مقدارها أربعة وعشرون ألف ريال، كما تحصّل منهم في العام التالي مباشرة إعانة مالية أخرى مقدارها سبعون ألف ريال على الرغم من أنهم كانوا يعانون الشدة والضيق، بل إن الأتراك بحثاً وراء الثروة خرّبوا "باب شعوب" و"باب السياخ"، وأخرجوا من الجدار المحيط بالأبواب ألواحاً من الرصاص والنحاس، ولم يراعوا الأهمية التاريخية لها.
وكان من بين المأمورين الأتراك من عملوا على إرهاب اليمنيين والإساءة إليهم ليملؤوا قلوبهم بالرهبة والخوف من الإدارة العثمانية، وكان من أعنف هؤلاء مأمور يدعى "مرزاح"، أخذ يحبس الكثيرين من اليمنيين وزعمائهم ويهينهم ويعذبهم من دون تحقيق أو مراعاة، لمكانتهم بين ذويهم، وعندما كثرت مظالم المأمورين الأتراك تصدّت لهم جماعة يمنية سرية تقوم بوضع ألغام من البارود والمتفجرات حول بيوت المأمورين.
حرق 300 قرية انتقاماً
وضمن حركات المقاومة اليمنية تجاه الأتراك كان الشيخ علي المقداد عوناً وناصراً للأتراك، ثم انضمّ إلى المقاومة، فاستدعاه أحد القادة الأتراك، ثم أمر الجنود بربطه بعجلة مدفع تركي استهزاءً به، وتنكيلاً حتى كُسِرت يده وأُغمى عليه، وعندما أفاق الشيخ آل على نفسه أن يعمل بقية حياته على تخليص بلاده من الأتراك وحكمهم الجائر، ولمّا علمت حكومة الولاية بذلك أصدرت أوامرها بحرق بيته انتقاماً وتنكيلاً.
واستمرّ المقداد يحارب ويغزو مراكز الأتراك ويطارد مأموريهم وجنودهم في فضاء "آنس" و"مخاليفة" مع طائفة من الأعوان، إلى أن فشلت الحكومة التركية في القضاء عليه، فأخذت في البطش مسعورة، وأحرقت كل القرى اليمنية التي دخلها الشيخ علي المقداد بعد نهب ما فيها حتى خربت في البلاد ثلاثمئة قرية، بعضها قرى اشتهرت بدراسة العلوم الدينية.
جرائم ثورة العرب
واصلت الحكومات العثمانية المتعاقبة البطش بمن استطاعت من العرب في الجزيرة العربية، خصوصاً في الحجاز التي لا يزال يدين لها بالطاعة، إلا أن دخول إسطنبول في خضم الحرب العالمية الأولى إلى جانب ألمانيا، حرَّك نوازع العرب نحو الاستقلال، فما كان من الشريف حاكم مكة، إلا أن حالف الإنجليز لتخليصه من الأتراك أحلاف أعدائهم الألمان، وهذا ما حدث.
لكن، الحكومة العثمانية التي لا تقبل من محكوميها العرب إلا الطاعة العمياء، أمرت الشريف الحسين أن يصدر إعلاناً بالجهاد المقدس في أقطار الإسلام ضد دول التحالف، "وألحت عليه في إرسال المجاهدين الذين أعدّهم لحرب السويس وسيناء، فأرسل الشريف برقية إلى الصدر الأعظم وأنور باشا في 1334هـ، وفيها يكشف عن نيته ويشترط لإعلان الجهاد وإرسال المجاهدين ثلاثة شروط، وهي: العفو العام عن المتهمين السياسيين من العرب، ومنح سوريا والعراق إدارة لا مركزية، وجعل شرافة وإمارة مكة وراثية في أولاده، فإن استجابت الحكومة فإنه يتعهد حشد القبائل العربية من المجاهدين بقيادة أبنائه في العراق وفلسطين، وإذا لم تقبل الحكومة فلا تنتظر منه شيئاً سوى الدعاء لها بالنصر والتوفيق".
الاختطاف والتهجير
لم يكن هذا ما ينتظر العثمانيون من أداتهم في الحجاز، ولذلك أمعنوا في إهانته بالرد عليه، بأن الأمور الثلاثة خارجة عن اختصاصه، وعليه أن يُرسل الجند، وزيادة على ذلك ستحتفظ الحكومة العثمانية بابنه فيصل (كان في دمشق حينئذ) رهينة عندها حتى انتهاء الحرب. لكن، الشريف لأنه يبيت نية إعلان الثورة الكبرى، لم ينصع إلى الأوامر العثمانية.
وهكذا انطلقت الثورة، واستمات العثمانيون في الانتقام من العرب، بالتشويه والقتل والتهجير، ولذلك بعثت إلى المدينة وفق توثيق الباحث المدني سعيد بن طولة نقلاً عن مؤرخي المرحلة في الديار الحجازية والعربية، أشرس رجالها فخري باشا، الذي قاد المعارك ضد الشريف، وحاول أن يفرض نفسه على العرب بالقوة، رغم أن رسائله التي وثّقها الباحثون إلى دمشق وإسطنبول كانت شديدة البذاءة في الحديث عن العرب الذين يساندونه، ويصفهم بالوقاحة، بينما تنعت الصحف العثمانية الناطقة بالعربية الشريف بأنه "أبو جهل القرن الرابع عشر الهجري"، ما دفع العرب إلى إنشاء منبر للرد، كان جريدة "القبلة" التي عبَّر فيها العرب عمّا يختلج في صدورهم منذ حين ضد مظالم العثمانيين.
وهكذا، اشتدت المعارك بين الفريقين، فلجأ فخري باشا إلى البطش، وقرر بعد خسارته عديداً من المواجهات مع العرب، أن يُهجِّر سكان المدينة المنورة بطريقة وحشية، اختلف المؤرخون في المآرب منها، إلا أن أحداً لم يختلف في اتصافها بأبشع أنواع الجنون وغياب الرحمة، كما يروي أهل المدينة أنفسهم عن تلك الحقبة.
وقال الشريف إبراهيم العياشي، الذي كان ممن أجلوا ثم عاد بعد ذلك إلى المدينة، "أجلى فخري باشا أهل المدينة بصورة وحشية، أشبه بصورة إجلاء الفلسطينيين عن بلادهم، يخرج الرجل من داره فلا يرجع، فتخرج المرأة تبحث عنه فلا ترجع، والقطار الحديدي يقلّ هذا وتلك، وفي كل محطة ينزل من لا يركب بلا زاد ولا غطاء، البنت في دمشق والأب في إسطنبول، ومن أدرك السابقة فرّ بأهله إلى الشريف في مكة". إلى غير ذلك من الأهوال التي لم تنج منها حتى النساء ساعة الوضع، ولا طلاب حلق العلم في زوايا المسجد النبوي الشريف.
أكل لحم القطط والأموات
وأدّت السياسة التي انتهجها فخري إلى دخول مدينة النبي في مأساة جماعية لم تستثن أحداً، إلى حدّ دفع المتخصص في التاريخ العثماني سلطان الأصقة يقول إنها ترقى إلى "جريمة حرب، ولا فرق بينها وما وقع للأرمن"، لولا أنّ العرب ليسوا بمثل تنظيمهم، وإلا فإنها جريمة يجب أن لا تسقط بالتقادم.
ويروي الصحافي السعودي علي حافظ، كيف أن قسوة الأوضاع وصلت إلى أن "أكل البعض القطط والكلاب وجثث الموتى وهم لا يعرفونها، باعها عليهم بعض المجرمين الذين لا يخافون الله، واشتراها من لا يعرفها من الجوع الذي عمّ البلد".
وروى الضابط ناجي كجمان، في مذكراته، وهو كان من الجند العثماني في المدينة، أنهم في أواخر أيامهم تلقوا "نبأ واقعة غريبة، وهي أن رجلاً من قبيلة قدمت من الحبشة، وكانت تسكن في أكواخ من الصفيح على أطراف المدينة، أخرج جثة امرأة دُفنت لتوها، وقطع أفخاذها وأذرعها ووضعها في كيس، ثم ذهب إلى السوق فباعها، وبينما هو قادم إلى كوخه قبضت عليه الدوريات، واعترف في التحقيقات التي أجريت معه أنه اضطر إلى ذلك، وأنه باعها في السوق بعد أن طبخها في قدر. لقد وصلت المجاعة إلى هذا الحدث، وبدأت القطط والكلاب التي في الشوارع تختفي واحدة تلو الأخرى".
فخري باشا، وكيل العثمانيين في المدينة، لم يكتفِ بالخراب والجرائم التي ارتكبها جنوده في حق ساكني المدينة المقدسة، لكن أضاف إليها العدوان على الحرم النبوي الشريف، وجعله مستودعاً للذخيرة ومعسكراً للمقاتلين، كما أن حجراته، حيث مرقد النبي عليه السلام نهب هداياها، وأرسل جزءاً منها إلى إسطنبول، والجزء الآخر فرّقه على هيئة رواتب شهرية وهبات على جنوده، بينما تثبت الوثائق التي نشرتها "اندبندنت عربية" في وقت سابق، وكان بعضها من مصادر العثمانيين أنفسهم، ولم يعترض أحدٌ على صدقيتها، إذ لا تزال إسطنبول تعرض بعض تلك المقتنيات في خزائنها، وتصفها بـ"الأمانات المقدسة".
سجال مع أردوغان
وكانت فعلة العدوان على الحجرات النبوية والتهديد بتفجير القبة الشريفة أو نقل الجسد النبوي إلى إسطنبول، لم تزل تثير حتى يومنا هذا غضبة عديد من العرب، إلا أنّ الأتراك الذين يصنفهم البعض بـ"العثمانيين الجدد"، لا يتقبلون أي تناول لفخري باشا وتاريخه في المدينة المنورة إلا على وجه التبجيل. وهذا ما أثار السجال بين الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان وكاتب عربي، تساءل "هل تعلمون في عام 1916 قام التركي فخري باشا بجريمة بحق أهل المدينة النبوية فسرق أموالهم وخطفهم وأركبهم في قطارات إلى الشام وإسطنبول برحلة سُميت (سفر برلك) كما سرق الأتراك أغلب مخطوطات المكتبة المحمودية بالمدينة، وأرسلوها إلى تركيا؟ هؤلاء أجداد أردوغان وتاريخهم مع المسلمين العرب".
إلا أنّ هذا التساؤل الذي لم يكن غير إحالة إلى ما تتضمنه كتب التاريخ عن جريمة "سفر برلك"، استفزّ أردوغان، وردّ على ذلك بتهديد الكاتب بملاحقته قانونياً وسط ترحيب من قناة "الجزيرة" القطرية، مؤكداً "إن لم ندرك جيداً حقيقة فخري الدين باشا ودفاعه عن المدينة المنورة، يخرج علينا من لا يعرف حدوده، ويتطاول على أجداد أردوغان، ويعاديهم إلى حدّ اتهامهم بالسرقة".
وفي اتصالٍ مع الناشط العربي، علي العراقي، المقيم في ألمانيا الذي كان مثير الجدل المذكور، يروي لـ"اندبندنت عربية" أن احتقار العرب ظل سمة للقادة العثمانيين حتى اليوم، وأن بين ما يفسِّر ذلك شعورهم بالنقص أمام العرب بوصفهم أمة النبي محمد وأهل الحرمين الشريفين والخلافة التي يتطاولون عليها، ويفعلون باسمها الأفاعيل. ولذلك حاولوا طمس كل مجد للعرب حين تولوا الحكم، ولم يقيموا أي بنيان أو مؤسسات ذات قيمة في موئل العرب الأصيل، الجزيرة العربية، ولم يكن الحرمان استثناءً، فأهملوهما أشد الإهمال، حتى إنّ القطار الذي يذكر على أنه من مآثرهم، لم يعبّدوا طريقه إلا في آخر أيامهم، وبأموال التبرعات من العرب والمسلمين.
كانوا "داعش" ذلك الزمان
وقال "يعلمون أن التعلق بالزمن القديم وتحديداً الدولة العثمانية قد يصنع لهم شعبية في الوطن العربي الكبير، لذلك يلمِّعون تاريخ تلك الدولة البائدة بأفلام ومسلسلات عالية الدقة والجودة، والأكثر من ذلك هم سخّروا فضائيات ورجال دين عرباً مع الأسف يمجّدون تلك الحقبة، وهذا أسلوب يتّبعه العدو بما يسمّى بـ(الحرب الباردة). ولطالما وجد أردوغان مجالاً للطعن بالعرب فيستحيل أن يتركه من دون استغلاله، ومهاجمة العرب وتحديداً الدول التي وقفت وما زالت واقفة ضد مشروعه الخبيث. لذلك لا نستغرب من استفزازه بتغريدة".
وحول ما إذا كان للعثمانيين تأويل غير شائع لأسلوبهم في التعامل مع البلدان العربية التي يحتلون، يعتقد أنه "لا تختلف أفعال الدولة العثمانية بالقتال عن أسلوب (داعش) أبداً، فقد امتازوا بالتمثيل بالجثث وقطع الرؤوس وتعليقها لإرهاب من يقف ضدهم، وأكبر خطأ تاريخي أن تُوصف هذه الدولة المجرمة بالخلافة! خلافة مَنْ؟ وكيف؟ وبأي حق تُوصف بالخلافة والقانون بتلك الدولة كان مبنياً على الخيانة وقتل الأب وتسميم الابن؟ لم يقوموا أبداً بتوحيد المسلمين، بل على العكس ضاع كثيرٌ من بلاد المسلمين، مثل الأندلس والجزائر، وكانت الدولة العثمانية في أوج قوتها".
الجرائم في حق "المعرفة"
كما يتداول العرب جناية التتار الوثنيين على إرثهم الثقافي لدى غزوهم بغداد، يذكرون بأسى أفعال العثمانيين في حق النفائس العلمية لدى اقتحامهم مدناً، مثل الدرعية والمدينة المنورة.
ويروي الباحث السعودي حمد بن عبد الله العنقري، أن الخطوة الأخيرة لجيش إبراهيم باشا وصوله إلى الدرعية التي بدأ حصارها 1818، وبعد مُضي أكثر من ستة أشهر اضطر الإمام عبد الله بن سعود إلى طلب الصلح من باشا، وكان من شروطه "المحافظة على الدرعية وأهلها، وعدم هدمها". إلا أن المبعوث التركي مثل سائر من قبله وبعده لم يفِ بوعده، إذ لم ينج من تخريبه حتى الكتب والمكتبات ودور التعليم.
ويضيف، أن الآثار المباشرة للحملة طالت كل المناطق التي مرّت بها، إذ "صاحبها نهبٌ وتدميرٌ لجميع الممتلكات، مثل المنازل والقصور والأمتعة، والكتب والزروع والحيوانات، فدمِّرت البيوت وأُحرقت المزارع، وقطّعت النخيل في الدرعية، بل إن السرعة والرغبة في التدمير دفعا الحملة إلى هدم بعض الدور والمنازل وأهلها مقيمون فيها، ومن ثمّ إشعال النار فيها".
ويوثق نقلاً عن المؤرخ ابن بشر أنّ الحملة حرقت في حريملاء (شمالي الرياض) بعض الكتب في مكتبة الشيخ عبد العزيز بن سليمان بن عبد الوهاب وصادرت بعضها الآخر، ليتبيّن في ما بعد أن الحملة من بين أهدافها "نقل المخطوطات النجدية إلى خارجها"، وذلك لتحقيق أهداف عدّة أهمها حسب الباحث الذي استقصى بحياد "مآل المخطوطات النجدية" في ظل تلك الحملة، كان "حجب مصدر التلقي الرئيس للعلم المتمثل في تلك المخطوطات لما تمثله من رافدٍ مهمٍ للعلماء وطلبة العلم، ما أدى إلى حرص تلك القوات على جمعها بعد قضائها على بعض علماء نجد بالقتل أو الترحيل إلى مصر". وهم علماء عائلة آل الشيخ والمقربين منهم ومن عائلة آل سعود الحاكمة، بوصف الحملة قصدت استئصال تأثير العائلتين في الإقليم نهائياً.
ويؤكد الباحث العنقري أنه بعد الاستقصاء يمكن تصنيف المخطوطات التي جُمِعت وصودرت من نجد إلى مجموعتين: مجموعة إبراهيم باشا، التي جمعها قبل رحيله من نجد، وأمر بنقلها معه إلى المدينة المنورة بطلب من أبيه، ومجموعة حسين بك، وهي التي جمعها قائد الحملة الجديدة الذي عرف بالقسوة والشدة في أثناء إقامته في نجد، إذ استطاعت هذه الحملة جمع 342 كتاباً، وغالبيتها من مكتبة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن مشرف، ومن الكتب التي قام قاضي الحملة محمد أمين زاده بأخذها من مكتبة الشيخ عبد العزيز بن سليمان بن عبد الوهاب، حيث صادر معظمها، وأشعل النيران في ما تبقى منها، ووصف ابن بشر هذه المكتبة بأنها مكتبة عظيمة. ومجموع هذه الكتب في المجموعتين 872 مجلداً، وبالمصاحف وأجزاء المصاحف 992 مصحفاً وجزءاً وكتاباً.
وتشير الوثائق العثمانية، التي وثقت مصادرة تلك الكتب، إلى أن "الباب العالي صدرت توجيهاته بالموافقة على وضع الكتب التي أتى بها إبراهيم باشا في أثناء عودته من الدرعية في مكتبة المدرسة المحمودية (الكتبخانة السلطانية) وإرسال كشف بأسمائها".
نهب نفائس مكتبات المدينة
كان ذلك في عهد حملة إبراهيم باشا في الدرعية، وبعدها بنحو 100 عام، عندما يئس فخري باشا من فرض حكم العثمانيين في المدينة المنورة، كان بين أهم النفائس التي صارت غير موجودة بالحجرة النبوية، نفائس المخطوطات التي تضمنتها مكتبتا "عارف حكمت، والمحمودية" في المدينة المنورة.
وتوثّق مجلة المنهل السعودية قبل 60 عاماً، كيف أنّ "اختيار فخري باشا للمكتبتين من دون سائر المكتبات لأنهما أكبر مكتبتين في المدينة، ولصلتهما بالنسبة التركية"، ولم ينقل فخري كل ما في المكتبتين، إنما اكتفى بالمخطوطات فقط، وترك المطبوعات في المدينة.
ويروي بن طوله أنّ المخطوطات المنهوبة، حُمِلت إلى سكة الحديد بغرض الوصول بها إلى إسطنبول، لكن الحرب كان قد حَمِي وطيسها فسار بها القطار وتوقف في دمشق، حيث أُنزلت ونُقِلت إلى مسجد التكية السليمانية، ووضعت في عددٍ من الغرف الملحقة به والمخصصة لطلاب العلم. ثمّ إن الشريف فيصل بن الحسين أعادها معه إلى المدينة المنورة عام 1337 هـ بعد انتهاء الحرب وجلاء الترك ودخول فيصل مدينة دمشق.
ومثلما كان يخشى الناقدون للعثمانيين على العبث بكنوز التراث، فقد تعرَّضت المكتبتان لإهمال، دفع إلى فقد نحو 87 كتاباً من مكتبة عارف في مجموع المراحل التي أعقبت عدوان الأتراك عليها. بينما تعرّضت أجزاء مهمة من مكتبة المحمودية إلى التلف، إذ فاض عليها نهر "بردى" في أثناء وجودها في دمشق، وأصاب جزءاً من محتوياتها، قبل أن تعود هي الأخرى إلى المدينة المنورة.
وجهة النظر العثمانية والتركية
تختلف مبررات العثمانيين في حملاتهم على الجزيرة العربية، فالأولى التي كانت بداية القرن التاسع عشر، وتركّزت على إسقاط الدولة السعودية الأولى بعد تمددها نحو الحجاز حيث مكة والمدينة، برروها بتوحيد أجزاء الدولة الإسلامية حسب زعمهم، خصوصاً أنّ السعوديين سيطروا على المدينتين المقدستين، وأثار ذلك مخاوف العثمانيين بنزع الشرعية عنهم، كما سبقت الإشارة، فلا معنى لخليفة لا يحكم الحرمين الشريفين، كما يخشى السلطان من أن تحذو بقية المناطق العربية حذو السعوديين، لتبقى مجردة من الشام والعراق وحتى مصر التي كلّف واليها محمد علي باشا بالحملة من جانب الأستانة.
أمَّا الحملة الثانية التي قادها فخري باشا، فجاءت في سياق الحرب العالمية الأولى التي استغلّ شريف مكة أحداثها، للاصطفاف مع الحلفاء للتخلص من الأتراك، الذين نفد الصبر معهم، إذ كانوا يتهمون الشريف الحسين بأنه كان "يميل إلى جانب الإنجليز، ويقيم علاقات سرية معهم، حتى قبل الحرب العالمية الأولى".
ويذكر السلطان عبد الحميد، في المذكرات المنسوبة إليه، أنّ فكرة إنشاء الدولة العربية كانت موجودة في وقته، وأنها كانت خطة مقترحة من الإنجليز وجمال الدين الأفغاني، ويقول "وقعت في يدي خطة أعدّها في وزارة الخارجية الإنجليزية مهرج اسمه جمال الدين الأفغاني وإنجليزي يدعى بلنت قال فيها بإقصاء الخلافة عن الأتراك. واقترحا على الإنجليز إعلان الشريف حسين أمير مكة خليفة على المسلمين".
وهكذا، فإنّ العثمانيين لا يرون أي حق للعرب بالتفكير في تقرير مصيرهم، وعليه فإنهم يرون قمع أي كيان يؤسسونه مشروعاً، مهما طبع ذلك من عنف وخروج عن أخلاق الإسلام.
أطماع الأمس هي أطماع اليوم
لكن، الأتراك بعد عصر دولتهم الوطنية التي أنشأها أتاتورك تركوا العرب وشأنهم، إلا أن الاستقطاب السياسي في المنطقة ووصول حزب العدالة الإسلامي إلى الحكم في تركيا، أعاد التدخل القديم نفَسه مجدداً، حسب ما يرى الباحث العربي علي العراقي الذي يؤكد أن "أطماع الأتراك الحاليين استعمارية بحتة، يصرحون بها ليلاً وينفذونها نهاراً، فتركيا اليوم أصبحت حاضنة لكل من يحمل شراً للسعودية، تفتح لهم الأبواب، وتمنحهم الإقامات، بل والتجنيس والبيوت والقنوات الفضائية لمهاجمة السعودية جهاراً نهاراً، مستغلين كل حدث يحدث بها، وكأنّ لا شيء يوجد بهذه الأرض غير السعودية. شاهد إخوان مصر والخليج واليمن وسوريا، بل حتى الحوثي أصبح مقرهم العالمي تركيا، يهاجمون السعودية ويشككون بإنجازاتها، ويحرّضون عليها، تاركين بلاداً عربية مدمرة منكوبة وشعوباً مهجّرة مظلومة بالقرب منهم، ومنشغلين بالسعودية".
ليسوا ملائكة
غير أن وكالة الأناضول الرسمية في تركيا، وإن كانت لا تخجل من الدفاع عن نهج الحكم العثماني في المنطقة العربية قبل انهيار الإمبراطورية، فإنها لا ترى من الممكن تحميل العهد الجديد أخطاء الماضي إن حدثت.
وتقول "الحكم العثماني لم يكن حكماً ملائكياً، وفيه من فترات الضعف والخور والجور والظلم ما لا يستطيع أحدٌ إنكاره، كشأن عامة الممالك والإمبراطوريات، لكن مع ذلك لا يجب مسايرة الاتهامات الموجهة إلى التاريخ العثماني التي لا تنبني على أساس صحيح، والأهم من ذلك لا يسوغ استخدام قصاصات التاريخ لضرب أتراك العصر، فحتى إن كانت هناك تجاوزات للأجداد فإنه لا يُحاسب عليها الأبناء".