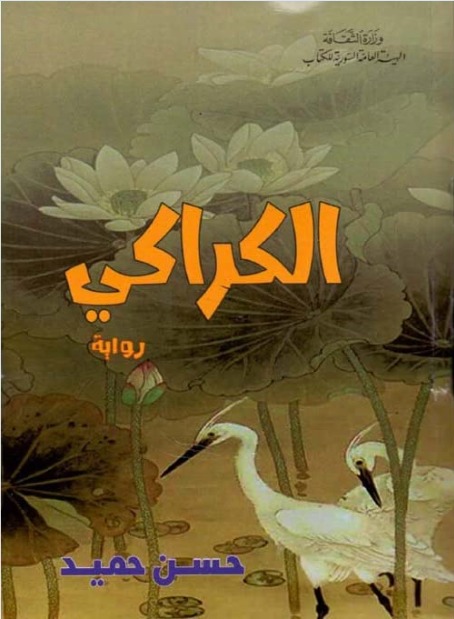في رواية "الكراكي" وهي الرواية السابعة للروائي والقاص الفلسطيني حسن حميد، يرث الراوي الافتتاحي في الرواية صندوقاً كبيراً، توارثه أربعون من أجداده، ولم يجرؤ أيٌّ منهم على فتحه، حتّى إذا ما أقدم هو على ذلك، يعثر على كتاب يتحدّث عن حياة جدّه الياس الشمندوري يؤسس للرواية التي نحن بصددها. وفي المضمون، يتناول الكاتب الحياة الفلسطينية، على ضفاف بحيرة طبرية، في مرحلة تاريخية معيّنة.
في الاصطلاح، الكراكي طيور تعيش قرب المسطّحات المائية، ويُعرف عنها تعلّقها بالمكان. وفي الرواية، هي طيور أليفة، تتواجد بين البيوت، وقرب الكنيسة، ولا تخشى الاقتراب من الناس. ويرد ذكرها في سياقات مختلفة في الرواية. يقول الراوي في أحدها: "وهذه الدانية البادية هي طيور الكراكي تتقدّم من دون خوف أو خشية، جميلة ملوّنة كما لو أنّها قطيع من الدهشة الآسرة" (ص 43)، ويقول في سياق آخر: "طيور كبيرة الحجم، طويلة الأرجل، عالية الرقاب... ملوّنة الرؤوس والأرجل والأجنحة" (ص 50)، ناهيك بسياقات أخرى لا يتّسع المقام لذكرها. ولعلّ الكاتب يرمز بها إلى الشعب الفلسطيني، المتجذّر في أرضه، المتعلّق بالمكان، في جميع الأزمنة.
ثنائيات السرد
يقوم النسيج الروائي في "الكراكي" على مجموعة من الثنائيات التي يتحرّك بينها مكّوك السرد. وهي: الغجر/ العرب، البداوة/ الحضارة، الواقع/ السحر، الخال القديم/ الخال الجديد، فضّة/ الزهروري، الأب طنّوس/ الأم هدلة، عبّودة/ ماريا، وغيرها. على أن المساحة النصّية الناجمة عن حركة المكّوك تختلف من ثنائية إلى أخرى. وهذه الحركة داخلية غالباً بين طرفي الثنائية الواحدة، وخارجية نادراً بين ثنائية وأخرى. وتُعْتَبَر المدى الحيوي الذي تتمظهر من خلاله الأحداث الروائية المختلفة.
يُشكّل الحشد الغجري الذي يحطُ رحاله في قرية الصبيرات، في أجواء كرنفالية احتفالية، يختلط فيها الطبل والزمر والرقص، فرصة للتفاعل بين أطراف مجموعة من الثنائيات آنفة الذكر. ويتمظهر هذا التفاعل في تبادل الخدمات والخبرات بين مجموعتين بشريّتين: غجرية بدوية زمانية وافدة، وعربية حضرية مكانية مقيمة. يقوم رجال المجموعة الأولى بتنييض أواني القرية، وتقوم نساؤها بوشم الصبايا، وضفر الخرز، وخياطة الأقمشة. وتقوم المجموعة الثانية، رجالاً ونساءً وأطفالاً، بصنع الأواني الزخزفية والزجاجية والفخّارية، ونسج الأقمشة، وطبخ الطعام، وتقديمها إلى الضيوف، في احتكاكٍ واضح بين البداوة والحضارة.
ويتمظهر التفاعل في قيام الكاهن العجوز الذي يقود الوافدين، ويتولّى شؤونهم الروحية، ويؤمن المقيمون بكراماته في الاستسقاء وحل المشاكل المستعصية، بالبحث عن كاهن صغير بعلامات معيّنة لا يعرفها سواه، ليحلّ محلّه بعد موته. ويتمظهر التفاعل في علاقة الحب المستحيلة التي تنشأ بين فضّة الغجرية والزهروري العربي. ويتمخّض عن هذا التمظهرات تظهير الشخصية الفلسطينية، بمروءتها وكَرَمها، وإيمانها بالخوارق والغيبيات، وبراعتها في مزاولة الحرَف وطهو الطعام، وامتلاكها أسباب الحضارة المتعلّقة بفنون العيش وأدواته، ما يؤكّد قدم العلاقة بالمكان، وتاريخية التفاعل معه. ويدحض ادعاءات الصهاينة ومزاعمهم وأساطيرهم.
التفاعل الداخلي
وإذا كان التفاعل المذكور أعلاه، بتمظهراته المختلفة، يتمّ بين مجموعتين بشريّتين مختلفتين في أسلوب الحياة ونمط العيش، فإنّ تفاعلاً من نوع آخر يتمّ ضمن المجموعة الواحدة، ويتمظهر في علاقة الصداقة العميقة، القائمة على الإيمان الديني، بين الأب طنّوس راعي كنيسة القرية الذي اختُطفت زوجته ومجموعة من الأخوات في الوادي الكبير، في ظروفٍ غامضة، تاركةً له الاهتمام بابنتهما الوحيدة ماريا، وبين السيدة هدلة، أم عبّودة، التي غادر زوجها، وهي حامل بابنهما، ولم يعد.
هكذا، يجتمعان في الفقد وحاجة كلٍّ منهما إلى الآخر. الأب طنّوس يقوم بدور الأب الروحي لهدلة وابنها في إطار مهمّته الرعوية، يقف إلى جانب الأم، يشدّ أزرها، يحتضن الابن، ويقوم بتعليمه القراءة والكتابة والفنون، فيشكّل تعويضاً للزوجة عن زوجها المفقود، وبديلاً للابن عن أبيه الغائب. وفي المقابل، تفتح هدلة بيتها للأب طنوس، وتمدّ مائدتها له، وتهتمّ بابنته، فتشكّل تعويضاً معنوياًّ له عن زوجته المخطوفة، وبديلاً للابنة عن أمّها الغائبة.
ولعل الخدمة الأهم التي يسديها الأب طنّوس لهدلة وأسرتها تتمثّل في رفع العبء الثقيل الذي ألقاه الكاهن الغجري العجوز على كاهلها، باختيار ابنها عبودة كاهناً جديداً بديلاً له، فيعجّ منزلها بأصحاب الحاجات والمؤمنين بالكاهن الصغير ما يؤدّي إلى مرضه، حتى إذا ما أشاعت بين الناس خبر انتهاء مدّة التكليف الممنوحة لابنها، وأشارت عليهم بالذهاب إلى الكنيسة، يرتفع العبء عنها، ويستعيد الابن صحّته. وهذه الواقعة تجسّد تحوّلاً في حياة الجماعة الدينية من الإطار الفردي القائم على الخوارق والمعجزات إلى الإطار المؤسّسي في حرم الكنيسة. وفي جميع الأحوال، يعكس التفاعل بين الأب طنوس والسيد هدلة قدرة الشخصية الفلسطينية على التضامن والتكافل في الملمّات.
يتفرّع عن هذا التمظهر الذي يلبس لبوس الصداقة نوعٌ آخر، يلبس لبوس الحب، فتنشأ علاقة حب بين عبّودة الذي يختلف إلى الكنيسة طلباً للعلم، وماريا ابنة الأب طنّوس خلال قيامها بتدريسه بعض الدروس. وتنمو هذه العلاقة من الاعتراف المتبادل بالحب، إلى تبادل اللمسات والعناق والقبل، والاتفاق على الزواج بمباركة الأب والأم، حتى إذا ذهبت ماريا في بعض الأخوات إلى الخالصة للتسوّق تتأخر في العودة ما يقلق عبّودة وطنوس عليها، ويدفعهما للبحث عنها في الخالصة والناصرة والقدس، غير أنهما يعودان خاويي الوفاض سوى من خبرٍ يتيم يفيد بذهابها إلى الشام للتسوّق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
نهايات سلبية
حين تعود ماريا، بعد غيابٍ طويل، في موكبٍ من العربات المحمّلة بما ندر وحلا، تجد أن والدها قد مات، وحبيبها قد غادر القرية بعد يأسه من عودتها، فتدلّ رأسها، وتحني عنقها. ولا تختلف هذه النهاية عن نهاية العلاقة بين الزهروري ابن القرية وفضّة الغجرية التي تعود إلى القرية، بعد غياب طويل، في موكب من الغجر، طالبةً حبيبها، فتعلم أنّه غادرها منذ سنوات للبحث عنها، وتغيب عن الوعي. في هاتين النهايتين، يعيد التاريخ نفسه، ولو بشكل مختلف، فأبو عبّودة يغادر بيته، ويختفي في ظروف غامضة، تاركاً زوجته تعيش على ذكريات حبّه. وأمّ ماريّا تُختَطَف في ظروف غامضة أيضاً تاركةً زوجها يجترع مرارة فقدها. وقيام كلٍ من عبودة والزهروري بالبحث عن حبيبته تعيده أم عبّودة بعد أربعين عاماً على اختفاء الزوج.
يصطنع حميد حسن لروايته خطاباً روائياًّ يقوم على: تعدّد الأصوات الروائية، المزج بين خطّيّة السرد وتكسّره، ووظيفية اللغة. ولكلٍّ من هذه المقوّمات دورها في تحديث الخطاب وترهينه. فتعدّد الأصوات يتمّ، بشكل مباشر، من خلال إسناد الكاتب مهمّة الحكي إلى ثلاثة رواة، على الأقل، هم الراوي الافتتاحي الذي يكتفي بافتتاح الرواية، عبّودة الراوي الأساسي، والزهروري الراوي الفرعي. ويتم تعدّد الأصوات، بشكل غير مباشر، حين يفسح الراوي الأساسي أو الفرعي، في الوحدة السردية التي يقوم برويها لشخوص أخرى بالمشاركة في الروي، من قبيل: الأب طنوس، والأم هدلة، وماريا، وفضة، وغيرهم.
أمّا خطّية السرد فتنتظم العلاقة بين بعض الوحدات السردية، فيما يتكسّر السرد في العلاقة بين وحدات أخرى. هذه الخصيصة في المزج بين الخطّية والتكسّر في السرد، تُضاف إلى خصيصة تعدُّدِ الأصوات، لتضفيا معاً على الخطاب الروائي طابعاً حداثياًّ. وتأتي اللغة الروائية بما تلعبه من وظيفة سردية جميلة بتراكيبها القصيرة والمتوسطة، وبما تلعبه من وظيفة أنتروبولوجية حضارية بمفرداتها الكثيرة، لتعكس جمال الطبيعة الفلسطينية، وغنى الثقافة بكل ما يتعلّق بفنون العيش وأساليب الحياة.
على الرغم من هذه الخصائص الناجحة في الحكاية والخطاب، فإن النجاح يجانب الكاتب في تحديد زمن حصول بعض الوقائع الروائية. ويمكن الإشارة، في هذا السياق، إلى أنّ ثمّة بلبلة في تحديد المرحلة التاريخية التي ترصدها الرواية بين بداية الرواية ووسطها، ففي حين تُضمر واقعة وراثة الصندوق الأثري الذي يحتوي على الكتاب/ الرواية عن أربعين جداًّ قِدَمَ زمن وضعه، فإن واقعة وجود جنود شقر على جسر بنات يعقوب قد تُحيل إلى زمن الانتداب البريطاني لفلسطين، على أبعد تقدير. فكيف يستقيم التعبير عن واقعة روائية قبل حصولها بمئات السنوات، على الأقل؟ وفي السياق نفسه، يقع الكاتب في تناقض زمن حصول الواقعة الواحدة؛ ففي حين يشير في إحدى الصفحات إلى أنّ آخر عهد الزهروري بفضّة كان بعد لقائهما الأوّل في أجران المياه الساخنة في طبرية، نراه يشير في صفحة أخرى إلى قيام الزهروري بالتصدّي للمبروك يحيى لدى محاولته اختطاف فضّة، على مرأى من الجميع، بينما يهمّ الحشد الغجري بمغادرة القرية، وهذه الواقعة متأخرة زمنياًّ عن الأولى، ما يعني أنّه رآها للمرة الثانية ودافع عنها. غير أن هذا الارتباك في تحديد زمن حصول بعض الوقائع لا ينتقص من روائية الرواية وجماليتها، فتبقى مصدراً للفائدة ومورداً للإمتاع.