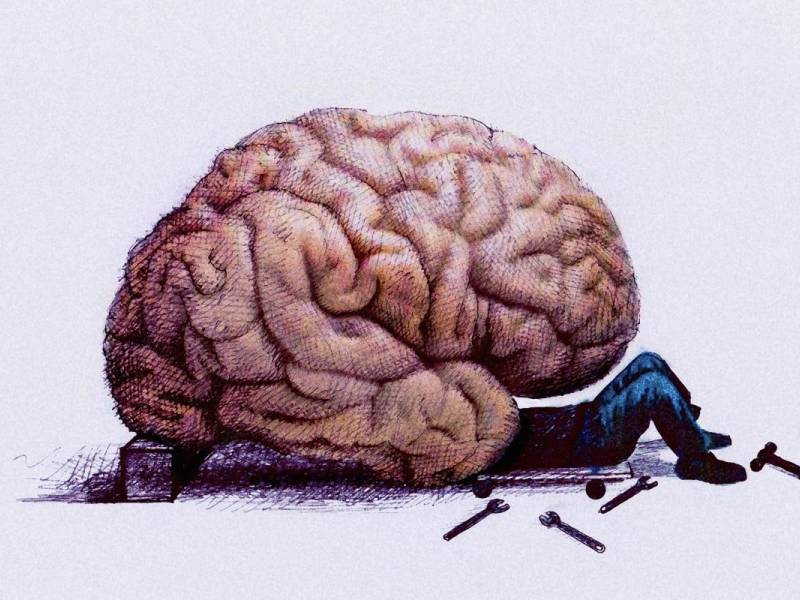ملخص
في كتابها "رحِم العالم: أمومة عابرة للحدود" (دار تنمية – القاهرة)، تنشغل الناقدة الاكاديمية شيرين أبو النجا، من منطلق نسوي، يراعي الفروق الثقافية بين الشرق والغرب، بطرح الأسئلة بأكثر من الانشغال بالإجابة عليها.
تسعى الناقدة شيرين ابو النجا الى نقض المستقر في الأذهان عن مفهوم الأمومة في مختلف الثقافات البشرية عموماً، وفي الثقافة العربية، على وجه خاص، على اعتبار أنها "لم تسمح بتحويل الأمومة إلى سؤال يحثي مطلقاً"، بحسب ما أوردته في المقدمة. وقد تصدَّر المقدمة سؤال: "هل تحتاج الأمومة إلى كتاب؟". ويلي المقدمة متن من 14 فصلاً، يرصد تجليات الأمومة في أعمال أدبية وفنية وسيرية، وبحوث أكاديمية، وحكايات وأمثال وأغاني ورسوم شعبية، وفي نصوص قانونية ودينية وطقوس اجتماعية، ومشاهد تلفزيونية، وغير ذلك. ويصل هذا المتن إلى أن مع "كل هذا الحضور القوي تبقى الأمومة من المسلمات التي لا تستفز العقل البحثي ولا تدفع إلى السؤال أو التساؤل". ثم في الختام تنطلق أبو النجا من السؤال الاتي: "هل للأمومة خاتمة؟"، وتقف بالذات أمام ما قدمته الحرب على غزة، من نماذج للأمومة، لا يكاد أن يكون لها نظير في أي مكان آخر في العالم.
منذ عام 2020 عكفت أبو النجا على إنجاز هذا الكتاب، لكن الأمر تحوَّل، كما تقول، "إلى رحلة مغايرة تماماً؛ كشفت لي كثيراً عن نفسي وعن الآخرين والأخريات. يمكنني الآن أن أستخدم شكلاً مختلفاً للتحقيب: ما قبل الكتاب وما بعده". وتوضح أبو النجا الأمر على هذا النحو: "في غمرة الانغماس في النصوص الأدبية والأفلام والأغاني والصور الفوتوغرافية التي تجعل من الأم مركز المعنى، إما مباشرة وإما عبر طرق المجاز المبطَّن والاستعارات البلاغية، تم تحييد الفرضية الأساسية التي شكَّلت نقطة انطلاق الكتابة". وتضيف: "لكن الأكيد أن السؤال الذي بدأت به قادني – مع كل نص – إلى أسئلة أخرى أكثر تعقيداً، وكان القرار أنني لن أحمل نفسي العبء الذي يقتضي عدم المغادرة من دون تقديم تفسير بعد علامة الاستفهام".
أجمل الأسئلة
واستقرت أبو النجا عند قناعة بأن "أجمل الأسئلة هي تلك التي تبقى يتيمة الإجابة في كل مرة يطرح فيها السؤال ذاته". ورأت في السياق ذاته أن اليقين البحثي الوحيد الذي يمكن الانطلاق منه نحو رحلة أو رحلات أخرى للإجابة عن "أسئلة معلقة كالذبائح"، هو ربما، أن هناك علاقات قوى تجد فائدة في تسييد نموذج أحادي للأم، وهو نموذج ظهر بوضوح وانعكس في الآداب والفنون على مختلف أشكالها، وفي الثقافات الشعبية من خلال الحكايات والأمثال والأغاني والرسوم. و"أسئلة معلقة كالذبائح" هو عنوان ديوان للشاعرة المصرية فاطمة قنديل، صدر عام 2008 عن دار "النهضة العربية" في بيروت، وجدت أبو النجا أنه "يعبر تماماً عن وضع الأسئلة الخاصة بالأم والأمومة عموما" ص236. وأصبح هذا النموذج الأحادي، وفق ما انتهت إليه أبو النجا، جزءاً من الذاكرة الجمعية عبر الاحتفال بأيام مخصَّصة للأم مثل عيد الأم، أو تحويل مناسبات نضالية – مثل اليوم العالمي للنساء – إلى حديث عن فضل الأم.
وكشفت النصوص التي تناولتها الكاتبة على مدار أربعة عشر فصلاً، والأخرى التي لم تتناولها، على حد تعبيرها، أن الأم ليست واحدة بل متعددة، وحتى في هذه التعددية لا يمكن الحصر أو التحديد. وتوضح أبو النجا في هذا الصدد أنها كلما كانت تُذكِر نفسها بأن هدف هذا الكتاب ليس الحصر، "كانت النصوص التي أقع عليها تزداد في العدد"، ومن ثم تملَّكها الإحساس بالخسارة: "لأنني لم أتمكن من تناول كل هذه النصوص البديعة". لكنها على أي حال باتت مقتنعة بأن "الأمومة كفعل ودور وممارسة لا تقف بمفردها في عزلة عن كل العلاقات التي تتقاطع معها"، وهي بالتالي "تتشكل طوعاً أو قسراً في ظل هذه العوامل المتغيرة".
وترى ان أصحاب معسكر الأمومة كغريزة يرفضون هذا القول جملة وتفصيلاً، ويحيلون المسألة بأكملها إلى قوانين كونية وأخلاقية وأعراف مجتمعية، تجعل من الأمومة غريزة كامنة تحتل المساحة النفسية الأنثوية. وهو ما يجعل أي امرأة لا تعبر عنها كما أقرَّ النص السائد المُعْتمَد بمثابة امرأة غير طبيعية. وفي الوقت ذاته "يحضر الأب في المشاهد الروائية في شكل يتسم بالعنف أو الترهيب أو التهميش؛ وعندما يكون حضوره بهيَّاً أو فاعلاً يدخل الأمر في نطاق الاستثناء" ص 238.
خطاب الأزمة
ركّزت أبو النجا في المقدمه على ما لاحظته من اختلاف موقع مفهوم الأمومة ومصطلحها في الثقافة العربية عن نظيره في الثقافة الغربية؛ التي حوَّلت الأمومة برأيها، إلى مجال بحثي يرتبط بالواقع وبالتجربة المعيشة، وكشفت عن الثغرات التي يتم من خلالها إقصاء النساء وتحجيم ذاتيتهن في مجالات العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية التي لم تهمل بدورها الجوانب الاقتصادية والسياسية. وتذهب في هذا الصدد إلى أن "جرأة النظرية النسوية في الغرب وتطورها وقدرتها على إرساء معطياتها في البحث، يشكل جوهر الاختلاف الذي أدى إلى عدم البحث في مفهوم الأمومة في الثقافة العربية" ص 24. وأرجعت ذلك إلى أسباب عامة قد تبدو كسبب ونتيجة في آن واحد، الأول يتمثل في موجات الاستعمار المتعاقبة على العالم العربي، ويتمثل الثاني في الفكر الديني الذي كان هو سلاح المقاومة والمواجهة الأول إزاء تلك الموجات، فيما كان هم مفكري النهضة لا يتجاوز محاولة شرعنة الحقوق الأساسية للنساء.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبالقدر نفسه أهملت القضايا النسوية في مرحلة ما بعد الاستعمار، باعتبارها ليست أولوية في بناء مجتمع جديد. وأضافت أبو النجا إلى ما سبق، سبباً ثالثاً، اعتبرته نتيجة طبيعية للسببين السابقين، فبرأيها، قد تم وصم الفكر النسوي كفكر مستورد من الغرب، لا أصل له في المجتمع، ويهدف إلى هدم القيم والمبادئ وطبعاً مفهوم العائلة. وتوقفت أبو النجا هنا عند كتاب نصر حامد أبو زيد "المرأة في خطاب الأزمة" 1994، الذي لاحظ تطابق المنطقين السياسي والديني في ما يتعلق بدور المرأة وهو الأمومة، مؤكداً أن "مناقشة أهمية هذا الدور خارج إطار مسؤولية المجتمكع ككل، يعد إهداراً لدور مؤسسات التنشئة والتربية، وتعامياً عن أثرها الخطير الذي يكاد يكون أعمق من دور الأسرة والأم".
الأم الفلسطينية
ترى أبو النجا أننا إذا اعتبرنا أن الأدب هو أحد أشكال البنية الفوقية، فإن دور أونموذج الأم في المجتمعات – البنية التحتية – ينهل كثيراً من شخصيات طرحها الأدبان العربي والعالمي، على الرغم من عدم وعي المجتمعات أحياناً، والعكس صحيح. فالأدب قدم شخصية الأم اعتماداً على ما هو سائد في المجتمعات ويحظى بقبولها. ولاحظت أن ماركيز نجح في شكل ما في تصوير نموذج "الأم الأبوية" في قصته "الأم الكبيرة" – ترجمة محمود علي مراد- تلك المرأة التي حكمت مملكة ماكوندو 92 عاماً، وحين اقترب أجلها احتاجت إلى ثلاث ساعات لتعدد عناصر ما تملكه في هذه الدنيا. وحينها كان لا بد من تسجيل الأموال المعنوية، فبذلت تلك الأم جهداً كبيراً يشبه "الجهد الذي بذله أسلافها قبل وفاتهم ليكفلوا سيادة جنسهم". وتضيف أنّ ماركيز عندما يبدأ في وصف الأملاك غير المرئية للأم الكبيرة، يتجلى معنى الأبوية بمنظور مختلف. يكثف ماركيز المجاز في هذه القصة؛ لتتحول الأم من جسد وذات إلى رمز أبوي سلطوي يختزن في ممارساته الفعلية والخطابية نموذج الأم الأبوية.
تقول أبو النجا: "اقتربتُ من النهاية التي كنتُ أدفع الكتاب نحوها، عندما اندلعت الحرب على غزة في 7 أكتوبر(تشرين الاول) 2023. وفي خضم كل الأسئلة المستحيلة التي نتجت عن مشاهد الإبادة الجماعية، قفز السؤال في قلب الكتاب: ماذا عن الأم الفلسطينية؟". وتضيف: "كانت الأمهات يطلقن الزغاريد عند وقوع شهيد فلسطيني، لكن الرد على "طوفان الأقصى" لم يترك مساحة لزغرودة واحدة، ليس لشيء، بل لمجرد توالي القصف والقتل، بما لا يدع لحظة واحدة لأي شيء آخر. تعددت نماذج الأمومة في هذه الحرب، "وأظهرت بطولات وآلاماً وأحزاناً بقدر متساو". وتتوالى الأسئلة: "ماذا نطلق على هذا النموذج؟ أمهات تحت القصف، أم أمهات الحروب، أم أمهات منسيات؟ كيف يتحول الرحم إلى آلة؟ وكيف تتحول الأمهات إلى أرقام؟ وكيف يتحول النحيب والبكاء إلى مشهد على الشاشة؟ وكيف يختزل كل هذا الدمار في جملة بسيطة في نشرات الأخبار؟".
هل مسموح للأمهات أن يعبرن عن مشاعرهن بوسيلة أخرى غير البكاء؟ في سياق إجابتها على هذا السؤال لاحظت أبو النجا أن علوية صبح لخَّصت في "مريم الحكايا" هذه الفكرة في مشهد رقص "أم ابتسام" في حفل زواج ابنتها، الذي وجدته الساردة مشابهاً لرقص أمها في مأتم ابنها. الرقصة ذاتها واللوعة متشابهة والعبء واحد. لكن المعجزة هائلة: مخلوق يخرج من رحم امرأة في مفتتح رواية "الكلمة الأجمل" للكاتبة الآيسلندية أودو آفا أولافسدوتي. تشرح الكاتبة أنه في عام 2013 "دعيَّ الآيسلنديون إلى انتخاب أجمل كلمة في لغتهم، فاختاروا اسماً من تسعة حروف، يشير إلى مهنة طبية: "القابلة"، وشرحت لجنة التحكيم أن الكلمة تتشكل من مقطعين، يعني الأول الأم والثاني النور، وبجمع المقطعين يصبح معنى الكلمة "أم النور".