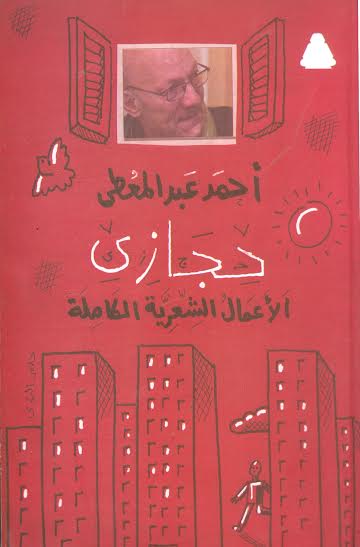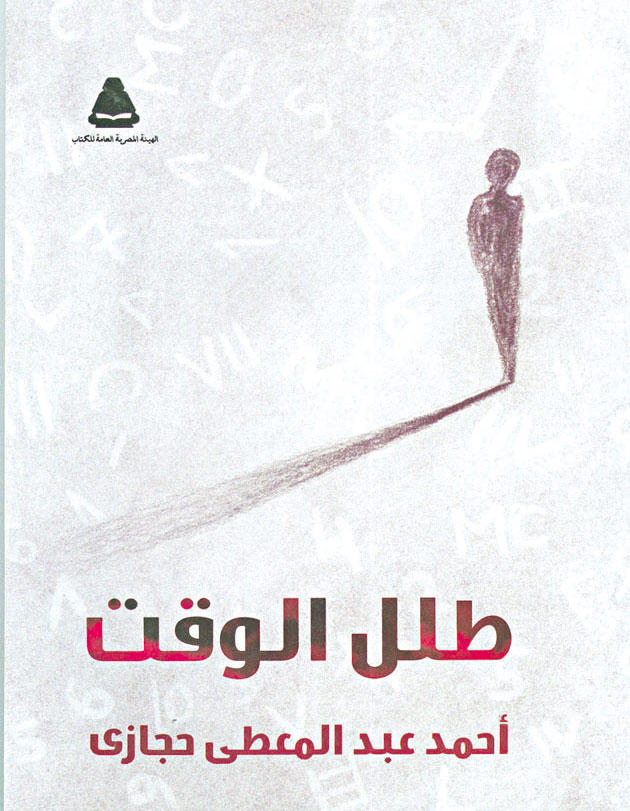إذا كان وصف "الحكيم" هو أصدق الأوصاف التي يمكن أن نطلقها على الشاعر الراحل صلاح عبدالصبور، فإن وصف "الفارس" هو ما يميز الشاعر الرائد أحمد عبدالمعطي حجازي (1935)، فلا أحد ينسى قصيدته الهجائية الشهيرة في عباس محمود العقاد التي تبدأ بقوله: "من أي بحر عصي الريح تركب / إن كنت تبكي عليه نحن نكتبه" / حتى تبلغ ذروتها الموجعة حين يقول: / "يا من يحدث في كل الأمور ولا / يكاد يحسم أمراً أو يقربه". وكان ذلك انتصاراً لقصيدة التفعيلة التي رفضها العقاد محيلاً إياها إلى "لجنة النثر" أثناء رئاسته المجلس الأعلى للفنون والآداب في مصر، فصاوله حجازي مستشعراً فروسيته وإن كان "أصغر فرسان الحلبة" سناً. وفي عصر عبدالناصر لم يبرر أي خروج عن الديمقراطية على رغم إيمانه بالمشروع القومي بل وتأليفه كتاب "عروبة مصر" وقناعته بالمكتسبات الاجتماعية فى الستينيات.
ومع انقلاب السادات على كل شيء هاجر حجازي شأن عقول مصرية كبيرة إلى باريس، لكن عينه ظلت على مصر منتصراً لهبتها الشعبية في الـ 17 والـ 18 من يناير (كانون الثاني) عام 1977 بقصيدته التي تبدأ بقوله "لكأنها الرؤيا قيامتك المجيدة"، وبعد عودته لمصر في الثمانينيات وقف مدافعاً عن التنوير والدولة المدنية الحديثة والديمقراطية والمواطنة، ومهاجماً جسوراً للإرهابيين ودعاة الدولة الدينية، وهو ما اتضح فى ديوانه "طلل الوقت" وبالتحديد فى القصيدتين اللتين هاجم فيهما الإرهابيين الذين تمكنوا من قتل فرج فودة وحاولوا اغتيال نجيب محفوظ.
وعوّض صمته الطويل شعرياً بكتابة المقالات التي تعيد الاعتبار لكل ما هو تنويري، وكان حجازي الاسم الأبرز بين الأسماء التي دعيت إلى إحياء الأمسيات الشعرية في إطار الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ولا يزال يحرص على لقاء محبيه أسبوعياً في صالون يحمل اسمه داخل بيت الشعر العربي في القاهرة، ويكتب بانتظام لجريدة "الأهرام" ولمجلة "إبداع".
سألته محاولاً إرجاعه للماضي حين وُصف بأنه شاعر المدينة التي "بلا قلب" عن رأيه في وصف الناقد إحسان عباس لهجاء شعراء العرب للمدينة بأنه غير أصيل ومجرد تقليد لهجاء الشعراء الغربيين لمدينتهم، لأن المدينة عندنا ليست سوى قرية كبيرة فقال: "لا أوافق على هذا إطلاقاً لأنه غير مفهوم، بحيث لا يمكن أن نشير إلى شاعر من شعراء الشعر الحر ونقول إنه متأثر بشاعر غربي محدد، على نحو ما قيل عن العقاد والمازنى مثلاً، كما أنه لا يعقل أن نصف حركة واسعة ونامية ومتواصلة بأنها تقليد لشعراء غربيين، وهذا كلام غير صحيح وأستغربه جداً من ناقد في حجم إحسان عباس".
الثقافة الغربية
وكان هذا السؤال فاتحة سؤالي عن جَمعه بين استيعابه لتراثه العربي واطلاعه على الثقافة الفرنسية وكيف أثر هذا في شعره؟ فقال إن: "الواقع أن علاقتي وعلاقة جيلي بالثقافة الأجنبية علاقة سابقة على معرفتي باللغة الفرنسية، لأن الأجيال التي تتابعت منذ الطهطاوي وصولاً إلى هيكل وطه حسين ومحمد مندور ممن تعلموا في فرنسا، والعقاد والمازني وعبدالرحمن شكري ولويس عوض وزكي نجيب محمود ممن اتصلوا بالثقافة الإنجليزية، كانوا مصادرنا لمعرفة الثقافة الغربية بشكل عام، وقد استفدت منهم جميعاً قبل سفري إلى فرنسا". قلت له: "ذكرت في بعض كتاباتك أنك بدأت بالرؤية الرومانسية للعالم مستخدماً لغتها وصورها، ثم انتبهت لآراء نقاد الواقعية، حدثنا عن هذا التحول الشعري المهم"، فقال: إن "التحول من الرومانسية إلى الواقعية له علاقة وثيقة بالشاعر وبالظروف التي مر بها وأدت إلى تحوله، وقد بدأت علاقتي بالشعر أواخر الأربعينيات من القرن الماضي، وكانت الرومانطيقية المصرية في أوجها في الشعر والرواية والسينما والأغنية، حتى يمكن القول إن الرومانطيقية أصبحت شعبية بفضل عبدالوهاب وغنائه لكيلوباترا والجندول والكرنك، وفي هذا السياق ظهرت الأعمال الواقعية الأولى لكمال عبدالحليم وعبدالرحمن الشرقاوي، وبدأ محمود أمين العالم وعبدالعظيم أنيس فى نشر كتابهما في الثقافة المصرية، وقد ساعد في هذا التحول ظهور الجماعات اليسارية أيضاً، وأصبحت المطالب الاجتماعية مقدمة على كل شيء، وهكذا رأيتني أنتقل من عالم إلى عالم ومن ثقافة القرية إلى ثقافة المدينة ومن الرومنطيقية إلى الواقعية ومن قراءة المنفلوطي إلى قراءة طه حسين والحكيم، وهذا ما ظهر في ديواني الأول ’مدينة بلا قلب‘ الذي تخليت فيه عن قصائدي الرومنطيقية باستثناء قصيدة واحدة".
الاتصال بالواقع
وامتداداً لهذا سألته: "هل توافق على وصف واقعية الشعر الحر بأنها واقعية بلا ضفاف، وأنها بعيدة عن واقعية غدانوف؟"، فقال: "حين يكون المقصود الحديث عن الواقع فهذا موجود في كل الاتجاهات، الكلاسيكية والرومنطيقية والواقعية، والعبرة تكمن في الحدود التي يحددها منظرو المذهب بناء على معطيات مختلفة، فالواقع كان مادة فيكتور هوغو الرومانتيكي وكان لدى كتاب المسرح الفرنسي الذين سبقوه، وهذا كله غير الواقعية عند إميل زولا التي أصبحت اشتراكية في أواسط القرن الـ 20 عند أراغون وإيلوار، ولهذا يمكن القول إن الاتصال بالواقع ومواجهة مشكلاته هما مادة الأدب والفن بشكل عام".
وسألته: "أثناء رئاستك لتحرير مجلة ’إبداع‘ نشرت ملفاً عن ’الحداثة وما بعدها‘ فهل ترى واقعنا غير مهيأ لفلسفة ما بعد الحداثة لأنه لم يكمل مسيرة الحداثة بعد؟" فأجاب: "الحقيقة لا الحداثة ولا ما بعد الحداثة هي الشاغل الذي يشغلني، وإنما التأسيس والثقافة التي تؤسس والاتصال بمصادرها المختلفة، فنحن في حاجة للأساس حيث أجد اللغة تفقد فصاحتها ووجودها، وأنظر إلى أسماء الدكاكين والمحال والإعلانات فلا نجد عامية فقط بل عبارات هزلية، وأصبحت اللغة مادة لممارسة الهزل والسخرية واللامبالاة وعدم الشعور بالمسؤولية، وهذا ليس قاصراً على عامة الناس بل موجود في خاصتهم".
مع العقاد
سألته عن ملاحظاته على دور مجامع اللغة العربية في هذا الصدد فرد بالقول: "إن دور هذه المجامع تال لدور المدارس، فقد أنشئت المجامع لكي تزود الفصحى بالمفردات التي لا بد من أن يملكها الناس في هذا العصر، لكننا وصلنا إلى مرحلة أصبحت اللغة التي ورثناها مجهولة، وأصبحنا نخطئ في أبسط الأشياء ومؤسساتنا الرسمية تساعد في هذا". وسألته : "قلت ذات مرة إنك لم تشعر بقربى نفسية وروحية مع رائد من رواد النهضة بقدر ما شعرت بها مع العقاد، فما سر هذه القربى على رغم هجائك القديم له واختلافكما في رؤية الشعر؟"، فقال: "الميزة الأساس في عقلانية العقاد هي صراحته أحياناً إلى حد الاندفاع، فهو لا يتحفظ ولا يتستر، وهو كاتب كبير ومثقف واسع الثقافة، ولكنه أيضاً شاعر، وحياة العقاد تعطي أمثلة كثيرة، فهو قد بالغ في نقد شوقي وتعمد إيذاءه، وهذا موقف غير مقبول، لكنني أشير إلى شيء في العقاد أو خصلة أستطيع أنا أن أجد قربى تربطني بها، ولا تنس أنه النائب الوحيد الذي قال "إننا سنحطم أكبر رأس في البلاد يعتدي على الدستور"، وكان يقصد الملك فؤاد، فسجن تسعة أشهر وخرج من السجن إلى ضريح سعد ليقول: "ظللت جنين السجن تسعة أشهر/ وها أنا ذا في ساحة الخلد أولد / عداي وصحبي لا خلاف عليهم / سيعهدني كل كما كان يعهد".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعندما اختلف مع النحاس قال له: "أنت رئيس الوفد لأننا انتخبناك، أما أنا فكاتب الشرق بالتفويض الإلهي". وفي صراعه معنا كان مبالغاً جداً في رفضه وكان عنيفاً، وعنفه في نظري له أصل ينتمي للفضائل أكثر من الرذائل لأنه يعود لصدقه واعتزازه بنفسه وإيمانه بأن ما يمتحنه وينتهي إليه هو الحق".
مراجعة القناعات
ثم جئت إلى قصيدة النثر التي وصفها بالقصيدة الخرساء فقلت له "امتدحت قصيدة النثر عند بودلير ولوتريامون ولافورغ وغيرهم، لكنك عارضت قصيدة النثر العربية، فما سر هذا التناقض"؟ فقال: "لست حكماً في ما يتصل بقصيدة النثر الفرنسية لأن هذه القصيدة تحتاج إلى أن أكون من أبناء هذه اللغة حتى أستطيع أن أحكم فيها، فاللغة ليست معاني قاموس بل هي إحساس وثقافة وذكريات نعرف بعضها ونجهل بعضها، لأنها موجودة في عقلنا الباطن وطفولتنا، وفي اعتقادي أن اللغة قبل أي شيء أصوات، وبما أنها أصوات فالصوت أداة أساسية في الشعر خصوصاً وفي النثر والحديث اليومي، وهذا الاستخدام للصوت داخل في نظم القصيدة، وقد اصطلح البشر على أن يكون الإيقاع عنصراً أساسياً في اللغة الشعرية، وأنا أقرأ لبودلير قصيدته المنظومة كما أقرأ له قصيدة النثر، فعلاقتي باللغة الأجنبية محدودة لا تسمح لي بالحكم، وبالتالي فمن الخطأ أن تكون هذه العلاقة مرجعي حين أكتب بلغتي أنا، ولهذا أرى أن قصيدة النثر العربية في الثلاثينيات، فقد كتبها مطران، وما قبلها لم تجد لها مكاناً تصبح فيه ضمن تراثنا الشعري".
قلت له: "أنت تمتلك شجاعة مراجعة قناعاتك فهل لنا أن نتوقع موقفاً مغايراً من شعراءالأجيال الجديدة الذين وصفتهم بأنهم يتحدثون عن رولان بارت وغولدمان ولا يستطيعون قراءة صفحة من ديوان الماسة؟"، فقال: "أحياناً نجد أنفسنا في وضع مستفز يسمح للمبالغات بأن تجد طريقها للنشر، لكنني أرى أن الأجيال الجديدة فيها شعراء حقيقيون، وعندما أجد أن القصيدة التقليدية التي ثرت عليها عادت من جديد في أعمال هؤلاء الشباب، فلا أجد سبباً يدفعني للطعن في عملهم، كما أنني لم أحل أبداً دون نشر قصيدة النثر أو قراءتها، وأنا أقرأ طه حسين فأستمتع بإيقاعاته في نثره، فكيف لا أطرب لإيقاع قصيدة النثر؟".
ما نفتقده الآن
وسألته أخيراً: "استقبل أنور المعداوي وعبدالقادر القط ورجاء النقاش قصائدك الأولى بحفاوة كبيرة، فكيف ترى حال النقد الآن؟ هل خلت الساحة من الأسماء الكبيرة؟"، فقال: "للأسف لا توجد أسماء كبيرة، ليس لأن مصر عاجزة عن إنجاب النقاد ولكن لأن المناخ لا يساعد في إظهار أسماء كبيرة، فقد استطاع النقاش والقط والمعداوي أن يؤكدوا حضورهم الكبير من خلال مجلة ’الرسالة‘ التي لم تكن وحدها، فحين كانت تصدر كان هناك أيضاً ’المقتطف‘ ومجلات أدبية أخرى وصل عددها إلى الـ 20 حين كان تعداد المصريين 18 مليوناً فقط، وهذا إضافة إلى الصحف الثقافية إذ كانت جريدة ’المصري‘ تنشر كتابات الداعين للواقعية، وينطبق ذلك على صحيفتي ’السياسة‘ و’البلاغ‘ أيضاً، وكانت هناك صفحة يكتب فيها بانتظام نقاد في حجم طه حسين ومندور ولويس عوض، وباختصار كان لدينا مناخ عام زاخر بالإبداع والنقد وهذا ما نفتقده الآن".