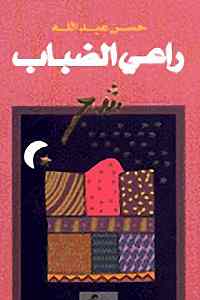بات حسن عبد الله، الذي رحل الثلاثاء 21 يونيو (حزيران)، شاعراً معترفاً بموهبته، ولم يكن بعد في رصيده سوى قصيدة واحدة كتبها حين كان فتى يروي قصصاً لرفاقه، ويتنقل بين المدينة (بيروت) شتاءً والقرية صيفاً.
وبعد نشر ديوانه الأول، "أذكر أنني أحببت" (1972)، فالثاني الذي يضم قصيدة واحدة طويلة، "الدردارة" (1981)، على اسم نبع في قريته الخيام بجنوب لبنان، تكرّس شاعراً مفرداً مرحّباً به، في الأوساط الثقافية اللبنانية عموماً والبيروتية خصوصاً.
وعلى الرغم من ذلك، ومن تحوله واحداً من "شعراء الجنوب" الذين يغني قصائدهم مارسيل خليفة وخالد الهبر ومقاتلو الأحزاب اليسارية والمنظمات الفلسطينية إبان الحرب، توقف عن نشر الشعر، بل توقف عن كتابته بغزارة الموهبة التي لا تُخفى. لقد نالت الحربُ من هذا الشاب، أحد خريجي الجيل الأول في الجامعة اللبنانية الذي حمل شعارات تحررية عربية وعالمية. لقد أحسّ بـ"ضجيج كبير" حوله، "ضجيج دموي وذي طابع عبثي أحياناً، ضجيج أحدثته الحروب الصغيرة المتلاحقة، ضجيج في عالم الأدب والشعر والنقد والمؤتمرات والمهرجانات، ضجيج كبير في حياتي أيضاً. كل ذلك جعلني أجنح نحو الصمت، وكلّما أصغيت إلى صخب الشعر والشعراء من حولي كنت أتمسّك بصمتي. وقد لذ لي ذلك".
لكن هذا التواري مع الأصحاب في بيروت لم يسقطه سهواً، إذ حفظه المشهد الثقافي، اسماً لا يُنسى، من دون أن يسعى هو إلى ذلك. فالموهبة تكفّلت بذلك، ونجحت.
الكتابة للأطفال
وفي الحياة القليلة التي تراجع إليها مؤلف "أجمل الأمّهات" و"من أين أدخل في الوطن؟"، بين المقهى والأصحاب و"البيت المهجور" الذي يقيم فيه وحيداً، بنى حسن عبد الله عالماً واسعاً رحباً ومغلقاً في آن. وإذ عاد لا يكتب الشعر إلا نادراً، ويترك ما يخطّه على الورق، اعتاد التردد على وظيفته كما لو أنه بطل قصة "المعطف" للأديب الروسي نقولاي غوغول. وفي الأثناء، ومع روتين معيشته، احترف الكتابة للأطفال. لعلّه انشد لرغبة عميقة، ولعلّه هرب من العبث المقيم الذي يُفرغ الأشياء من معانيها. وألّف ستّين كتاباً للصغار، نقل إليها "التجربة الإنسانية"، وفق تعبيره معتزاً بما أنجز. فهي ليست نصوصاً "ساذجة"، وفي الوقت نفسه لم يستسغ "فلسفة المسؤولية" الكفيلة بتعكير أدب الأطفال وتحميله الوعظ وثقل الدم. فكتابات حسن عبدالله للأطفال، ومثلها شعره بعد خوض هذه التجربة، مهضومة وتستفيد من ثقافته وبراعته في السرد والقص من دون ادعاء أو تعالٍ على القارئ.
وقد تعاون مع المخرج برهان علوية فحوّلا قصة "مازن والنملة" إلى فيلم. واستحق جوائز عدة.
ويروي حسن عبد الله (في مقابلة خاصة): "لقد عشت طفولة ملحمية بالفعل، ولا أظن شخصاً ممّن أعرفهم عاش ما يشبه هذه الطفولة. تصوّر طفلاً يعيش، على مدى عشر سنوات، أربعة أشهر من كل عام في خيمة في البرية في الصيف، مع أبناء عائلته وأبناء العائلات الأخرى حول بحيرة جميلة جداً، تحف بها البساتين والكروم من كل جانب. هذا كان يحدث لي كل عام. وقد صادقت الأسماك والطيور والحشرات على أنواعها، ونباتات الأرض، والتراب والأحجار والشمس والبراري اللامتناهية قبل أن أصادق البشر. لقد كنت كائناً بريّاً متوحّشاً بكل ما في الكلمة من معنى، وقد طبع ذلك شعري بطابع حاسم بحيث لا أستطيع أن أرى العالم والأحداث بمعزل عمّا تركته طفولتي من آثار على شخصي. لقد جسّدت قصيدتي "الدردارة" جزءاً بسيطاً من هذه التجربة. وسأظل عالقاً في أجواء هذه القصيدة إلى الأبد. وستظل تجربة طفولتي تؤثر باستمرار، على لغتي وانفعالاتي ونظرتي للأشياء من أي نوع كان. ولعل المرح في بعض قصائدي والسخرية والميل نحو القص عائدة لهذه الطفولة، خصوصاً أنني كنت قارئاً نهماً للسير الشعبية والروايات منذ المرحلة المدرسية الابتدائية، وكانت تتجمّع حولي حلقة من زملائي الصغار الذين أروي لهم، يوميّاً، ما أقرأه من قصص وخرافات. وحنيني الدائم إلى الطفولة هو حنين إلى الحرية المطلقة والصفاء المطلق والصدق والدهشة بكل شيء، والصخب والمرح واللعب. ولعل صفة اللاعب هي الصفة التي تساعدني بشكل قوي في كتابة الشعر في الحياة".
العودة إلى الشعر
وبعد سنوات الصمت الشعري تلك، لم يكن غريباً أن يُطالبه الناشر البارز رياض نجيب الريس بما لديه من قصائد كي تُجمع وتُنشر. وعلى الرغم من أن حسن عبد الله قابل تلك الدعوة بوعد، إلا أنه تلكأ، فطارده الريس بتكرار الطلب، حتى استجاب الشاعر وانقطع في منزله، ولم يخرج إلا وقد أنجز ديوانه الثالث "راعي الضباب" (1999).
ولم يكن "راعي الضباب" مجرد جمع لقصائد، إذ أبعد الشاعرُ كثيراً مما كان حفظه على الورق المتروك في الأدراج. بل إنه بعدما كان سلّم الناشر مجموعة جاهزة منذ 1986، عاد وسحبها. فآنذاك، وبعد التجربة الكتابية المتعددة، كان حسن عبد الله قد تجاوز الشاعر الموهوب إلى صاحب الصنعة. وراح يُعمل مبضع الجرّاح في القصائد. والنتيجة، قصائد بسيطة ظاهراً ولكن وراء تلك البساطة مشقة. وإذ تمكن من لعبة استبعاد ما ليس ضرورياً في التعبير الشعري، يعترف بأن "هذا ليس أمراً هيّناً، إنه باهظ التكاليف، لأن الشاعر مضطر في هذه الحال إلى أن يزن الأمور بميزان بالغ الدقّة والرهافة ويبحث عن وسائل تعبير بديلة عمّا هو سائد". ومع عنايته بالمفردة، تراجعت الصور، لا سيما المجرّدة منها، لمصلحة الوقائع والأخبار المستقاة من الواقع اليومي والعادي. وإضافة إلى النباهة وخلاصات التأمل المكتوبة ببساطة وبأقل ما يمكن من كلمات، تقرأ في شعر حسن عبد الله الجديد هذا سرداً يحاكي القص للأطفال. فالشاعر هنا صار ميالاً إلى التواضع العفوي بقدر ما هو مشغول.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إلى هذا، قصائد "راعي الضباب"، ومثلها قصائد "ظلّ الوردة" (2012)، واقعية تحيل القارئ إلى الحياة الخاصّة للشاعر. ويقول: "أشعاري شبيهة بحياتي، ويساعد ذلك على استيعابها بشكل أفضل، وأطمح أن يتمكن القارئ الذي لا يعرفني من أن يقترب منّي كصديق، عبر ملامسة أشياء حياتي في هذه القصائد، ففيها يوجد بيتي وأشياء بيتي، والمقهى الذي أرتاده، والمشهد الطبيعي الذي أستمتع به، والذاكرة الحسيّة التي تشكّل معظم صوري والناس الذين عرفتهم وعرفوني".
يضيف: "تخفّفت إلى أقصى حد ممكن، من كل ما هو شائع في لغة الشعر الراهن، لقد كان ميلاً جارفاً لا أفقه سببه نحو البساطة والتوجه المباشر أحياناً ووضوح الكلمة والصورة والعناية ببناء النص، والحرص على ذلك لأنه من دون بناء مقنع لا توجد قصيدة بتاتاً، مهما كان حجم الاستعراض الشعري في النص وقوّته".
نقد القصائد الإرهابية
خلف هذه التجربة الخفرة في بعدها الشخصي والتي تعبّر عن نفسها في صنعة القصيدة ومضمونها على حد السواء، ثمة نقد للشعر والثقافة. فهو يصف "العدد الكبير من القصائد التي تنال إعجاب القرّاء، بالقصائد الإرهابية". ويضيف: "إنها قصائد سطوة ظاهرية وشكليّة، قصائد صاخبة برّاقة مموّهة بالذهب، ولكنّها ليست ذهباً. قصائد تدّعي الشعر وتوهم به، من دون أن تكون شعراً حقيقياً، وقصائد تسير في الناس بقوّة الدعاية والإعلام وقرع الطبول، فلا تصادق القارئ وتؤاخيه، بل تتعالى عليه وتتركه، وتجعله يفقد شيئاً فشيئاً صلته الحميمة بالشعر والشعراء وينساق للبريق والضجيج اللذين تثيرهما كاميرات التلفزيون والمنابر الفخمة الشاهقة. إنه صخب الانحطاط وبريقه ومشيته المتبخترة، في عالمنا الراهن، وقد تفاقمت هذه الحالة لدرجة لم يعد هناك كاتب حر، ولا قارئ حر، ولا حل لهذه الأزمة إلا بالعودة إلى الكلمة الحيّة الحارة والبسيطة التي تنقل بالفعل تجربة حية وحارة وبسيطة. فإذا حدث ذلك بهدوء وبلا صخب وضجيج بلاغي وادعاءات فارغة، فإن الأمل بعودة الفاعلية الجمالية والوجدانية والأخلاقية لشعرنا العربي هو أمل كبير".